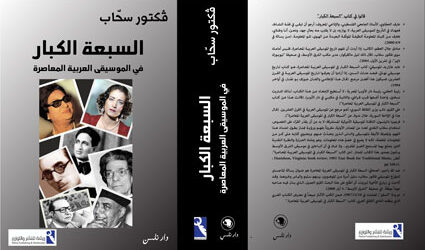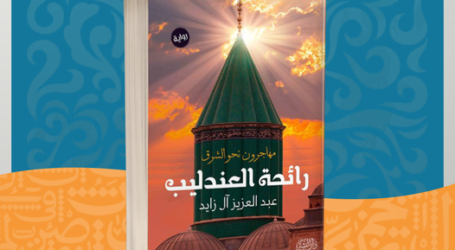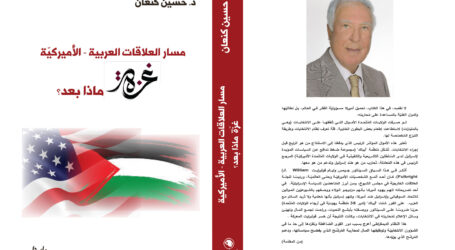الأمّ في سيرة الوقت للكاتِب معجب الزهراني
الطيّب ولد العروسي
صدر للدكتور معجب الزهراني كِتاب جديد بعنوان: “سيرة الوقت: حياة فرد- حكاية جيل”، في الرباط، عن منشورات “المركز الثقافي للكِتاب”، وهي سيرة حافلة بالمعلومات والنوادر والحِكم، وهي بمثابة وثيقة أنتروبولوجيّة تُدخِلنا في معمعان الحياة اليوميّة لطفلٍ وُلد في قرية سعوديّة اسمها “الغرباء” وهي ” قرية من تسعة بيوت تتوسّطها ساحة عامّة كانت مسرحاً مفتوحاً لأشكال الحياة الهادئة والصاخبة” مليئة بالأشجار المُثمرة، والوديان والاخضرار، وفي الوقت نفسه يعاني أهلها من صعوبة الحياة: ” قرانا كلّها آنذاك لا تزال تحت الصفر، ولذا لم تكُن تحلم بخطوط الهاتف والأسفلت، بل بمولّد كهربائي ينير عتمتها طرفاً من اللّيل لا غير”.
للتعرّف أكثر إلى قرية “الغرباء” يقول الكاتِب: “والحقّ أنّنا كنّا نحسب الفقر والمرض أموراً عاديّة تماماً بالنسبة لأمثالنا، ولذا لم نكُن نميل إلى التذمّر والشكوى فضلاً عن اليأس..”. ممّا يبيِّن أنّ سكّان هذه القرية كانوا معزولين عن التطوّرات الحديثة “بفضل ذلك المقهى الشعبي الذي نتسابق على سرره الليّنة مساء كلّ خميس لنقترب من الجهاز العجيب الذي يطلّ منه رجال أنيقون ونساء فاتنات وكأنّما يأتون من عوالِم أخرى”. وهنا يتّضح أنّ التلفاز وصل متأخّراً إلى القرى، ولم يكُن في متناول الجميع، بخاصّة في قرية نائية.
وإذ نواصل قراءة سيرة الزهراني، نكتشف كيف أخذت أُطُرُ حياته تتّسِعُ باكتشاف الكهرباء ثمّ السيّارة والحياة المدنيّة بكثير من التساؤل والدهشة، وأحيانا بشيء من الصدمة، ولاسيّما عندما انتقل من قريته إلى مُدن سعوديّة أخرى وصولاً إلى الرياض. حيث تعايش مع عوالِم حديثة، سواء في لقاءاته مع أسرته المُغتربة فيها، أم في بناء الصداقات، وحتّى في المأكل والمشرب والمَلبس.
هذا الجانب المدهِش في سيرة الزهراني يشكِّل ركناً أساسيّاً من أركانها، غير أنّ ركناً آخر لا يقلّ عنه إشراقاً وهو دَور الأمّ في هذه السيرة، سيرة البوح من دون لفّ ودَوران، حيث يكتشف القارئ من خلالها أنّ المجتمع القروي السعودي في خمسينيّات وستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي كان مجتمعاً منفتحاً على العالَم، على الآخر، يعزِّز هذا الانفتاح وجود تجّار من اليمن ومن أصول قوقازيّة ودُول عربيّة أخرى، علاوةً على وجود نَوع من الحريّة التلقائيّة والعفويّة في تعامل الناس وفي علاقاتهم اليوميّة؛ ففي القرية يعيش الإنسان منسجماً مع الطبيعة ومع الآخرين: كانت الأمّ تنتظر ابنها العائد من الدراسة “جاءت أمّي وعمّتي لاستقبالي، وكم شعرت بالزهو حين رأيتُ الفرح يشعّ من وجهَيهما غير مصدّقتَين ما تريان من أشياء جلبها أصغر الأبناء نهاية السنة الأولى من سفره!”، هذا فضلاً عن حضور المرأة بشكلٍ لافت وهي تُجابه الصعاب وتتحدّى القدر مُساهِمة في بناء نفسها وأسرتها بكثيرٍ من النقاء والصفاء، فهي تجتمع مع الرجال وتتسوّق تبيع وتشتري، تزرع وتحصد وترعى “ولا يُمكن لهنّ أن يَحلمن بالذهاب إلى سوقٍ قريب أو بعيد هذه تشتري زجاجة عطر أو مكحلة أو مرآة أو مشطاً أو علبة كريم للوجه والشعر”. كما كانت تسهر على تربية أولادها حيث يؤكِّد الكاتب: “وحين مات أبي وهو فوق الأربعين بقليل فيما يبدو تركَ بيتاً عامراً بأرملتَين وخمس بنات أكبرهنّ على مشارف البلوغ، وثلاثة أولاد أكبرهم في حوالى العاشرة، وأصغرهم أنا”.
تلك كانت هي الحال، حين سهرت الأمّ على مستقبل أولادها. وهنا يلفت كاتبنا الذي عاش يتيم الأبّ، يلفت نظرنا إلى أنّ يتيم الأبّ يُواجِه مشكلات هي أدنى بكثير من تلك التي يُواجهها يتيم الأمّ، وذلك لأنّ الأمّ، بعد وفاة زوجها، تبقى ساهرةً على أولادها، بينما الأبّ، بعد وفاة امرأته، يتزوّج من امرأة أخرى، فتكون معاملتها في أغلب الحالات قاسية مع اليتامى، مُشيراً إلى “مَثَلٍ شائع يفيد بأنّ اليتيم من أبيه يبقى في حضن أمّه، واليتيم من أمّه يُرمى فوق الدمنة” (أي المزبلة). ولا يكتفي الكاتب بذلك، بل يحمد الله أنّه تربّى من دون الأبّ الذي تكون سلطته في الكثير من الحالات قاسية وصداميّة، بينما الأمّ تتعامل بلطف وتفهّم وربّما بشيء من القسوة الرحيمة لأنّ عواطف جادّة وغير قمعيّة تُسيّرها، فهو يقول: “ولا يسألن أحد على حماية الأسرة قبل أن نكبر نحن الأولاد، لأنّ أمّي كانت تتحوّل إلى نمرة شرسة عندما تشعر بعدوان صغير أو كبير يوشك أن يوقع على أحد منّا، أو على شيء من مزارعنا وأملاكنا”.
وفي حالة “سيرة الوقت”، كان الأبّ متزوّجاً بامرأتَين (الأمّ وضرّتها) وهُما تعيشان في وئامٍ وتناغمٍ تامَّيْن، همّهما الأكبر إثبات الذّات وحماية أطفالهما والسير بهم إلى برّ الأمان، والسهر على تربيتهم وتشجيعهم على شقّ طريقهم إلى الغد الأفضل. نقرأ في “سيرة الوقت”: “نهضت أمّي بدَور تنظيمي جعلها تدير البيت طوال النهار، وتطوف الأسواق الشعبيّة من وقتٍ لآخر لتبيع الفواكه أو عقد البرسيم والشعير وما تيسَّر من الدجاج أو الغنم لتشتري الملابس والقهوة والسكّر والشاي وبقيّة حاجيّات البيت”. أمّا العمّة، أي زوجة الوالد، فقد تولّت “مشقّات العمل الزراعي فأبدت عليه صبراً، وله إتقاناً يحسدها عليهما كثيرون”. بل الأدهى من ذلك أنّ الأم “تعهَّدت بلبس ثياب الرجل حتّى تنفكّ من ضغوط أعمامها، وظلّت القابلة المفضّلة لكلّ أطفال القرية، وكثيراً ما كانت تسري منتصف اللّيل مع رفيقات لها لتعود قرب الفجر بأكياس مليئة بالحشائش”. كما كانا يسهران على سيول “وادي سالم” :” مرّات قليلة رأيت أمّي وعمّتي تبكيان بحرقة وهُما تريان سيول “وادي سالم” تكتسح الحقول ومحاصيل الذرة أو الحنطة على وشك النضوج”. يتواصل حضور الأمّ على مدى هذا النصّ السيِّري، ويصف كاتِب السيرة حينما عاد من المدينة وشاهدته نساء القرية، يصِف المشهد بقوله: “وفي الطريق مررتُ بمجموعة من نساء قريتنا يعملن في الجرين- البيدر- ويبدو أنّني لم التفت ولم أسلّم عليهنّ كالعادة، ما جعل إحدى قريباتي تسأل أمّي عمّا جرى لولدها الشابّ العاقل المؤدّب الذي بدأ يتكبّر على الناس!”.
ويقول الكاتب حينما تزوّج من واحدة من أسرته “وكانت الطفلة الصغيرة أوّل ابنة دخلت المدرسة من قريتنا”. لكنْ، بعد أشهر قليلة من الزواج، بدأت الأمّ تحسّ بالغيرة من كنّتها “والأمّ الغيورة بدت دائماً متوتّرة ومستعدّة لاختلاق أيّ مشكلة مع ابنها المُختطَف داخل علّيتها القديمة، ما يعني أنّ بعض مقولات فرويد كانت تتحقَّق عمليّاً أمامي”.
لم تكُن هموم المرأة وانشغالاتها محصورةً في البيت، بل كانت حاضرة في الحقول والأسواق وفي تربية أجيال مُتماسكة، فعاشوا في وئام وتوازن مع متغيّرات الحياة، متّحِدين ومتحَدّين الصعاب، فوصلوا إلى مناصب مهمّة في مختلف القطاعات التعليميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. هذا النَّوع من الحريّة المتوافرة لدى المرأة في عملها، وفي اجتماعها بالرجال، يكاد يكون معدوماً في المُدن التي تعلّم فيها د. الزهراني لاحقاً، بخاصّة مع انتشار الحركات المتطرّفة التي سجنت المرأة في فضاءات ومفاهيم مدمِّرة ليست لها أيّ علاقة بسماحة الإسلام.: ” أزعم أنّني من الجيل المحظوظ بالنسبة إلى مَن سيأتي بعدنا، حيث أصبحت رؤية النساء في ساحة أو طريق أو مزرعة شبه مستحيلة”.
يواصل الزهراني تلك المُقارَنة بين نساء القرية ونساء مَن يسمّيهم بعد الصحوة: “والويل لمَن يتابعهنّ ويكرّر النظر في صدر نافر لأنّ عصا المطوّع المنزوي كالأفعى في بعض المنعطفات تظلّ تتربّص بظهورنا ومؤخّراتنا!”. ويرى الزهراني أنّ ” ثقافة قرانا كلّها كما تبدو “علمانيّة عفويّة” في العمق لأنّها منظومة قيَم وأفكار دنيويّة مرتبطة بالعمل المُنتِج…”.
كانت المرأة فيها لا تهتمّ بشكل لباسها أو حجابها كما يؤكّد الكاتِب، بل كانت تكدح وتتحدّى صعوبات الحياة، لقد كانت الأمّ أيضاً، الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه: ” كنتُ مستلقياً في حضن أمّي في بيت أحد أعمامها، فسقط في عيني شيء من السقف جعلها تحترق وأنا أصرخ بأعلى صوتي، إلى أن خرجن بي إلى الساحة، وراحت إحداهنّ تغسل وجهي بالماء عديد المرّات وتلحّ على أمّي المذعورة كي تفتح عيني، وفعلا خفَّ الألم ونمتُ في الحال”.
“سيرة الوقت” سيرة ذاتيّة تكاد تكون إضاءات تنير زوايا معتِمة في مجتمعاتنا، نجدها لدى الكثير من كُتّاب السيَر الذاتيّة من جيل الدكتور الزهراني، فالكاتب الجزائري رابح بلعمري يعتبر أنّ السيرة الذاتيّة تسهِم في إيضاح بعض الجوانب التاريخيّة لمرحلة معيّنة من حياة الكاتِب، ويمكن اعتمادها كوثيقة أثريّة. والكلام نفسه يُدلي به وبجرأة شديدة المرحوم سهيل إدريس حينما كشف المسكوت عنه في أسرته، وخصوصاً في تعامل والده الحقيقي مع الناس يوميّاً، وهو الشيخ الورع، كما نجد البوح نفسه عند محمّد شكري في سيرته “الخبز الحافي” التي سجَّل فيها دقائق التركيبة الأسريّة التي عاش فيها. “سيرة الوقت” صورة في غاية الوضوح والصدق للمجتمع القروي الذي عاش فيه الكاتِب، والذي كان يقدّر المرأة التي تساعده في تجاوز الصعاب. (aaplumbingsa.com)
***
(*) كاتب جزائري مُقيم في فرنسا.
(*) مؤسسة الفكر العربي- نشرة أفق.