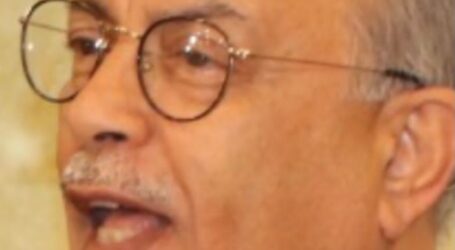التعليم العالي من التنوير إلى النيوليبراليّة
د. محمّد نجيب عبد الواحد
يدين التعليم اللّيبراليّ المُعاصِر بوجوده إلى العديد من الأفكار التنويريّة والصيَغ التربويّة التي نشأت عن الحركة الفكريّة التي قادها مفكّرون وفلاسفة تنويريّون أمثال كانط وروسّو وديكارت وفولتير وهيغل وغيرهم في القرنَين السابع عشر والثامن عشر، والتي عُرفت باسم “التنوير” Enlightenment، حيث شكَّلت العديد من مفاهيم التنوير ومبادئه ومُمارسَاته المُنبثقة عن العلمانيّة، التي هدفت في ما هدفت إلى إبعاد التعليم عن الدّين، العمود الفقري للتعليم اللّيبرالي الحاليّ.
لقد دعا تيّار التنوير هذا إلى الانفصال عن التقليد الديني عبر فكرة راديكاليّة واحدة: رؤية الرجل كعضو في المجتمع، أكثر من كونه “ابن الله”، وإلى استبدال الأهداف الدينيّة القديمة المُرتكِزة على التعليم التلقيني/الحفظي، الهادف بشكل رئيسي إلى “خدمة الله”، بأهدافٍ اجتماعيّة جديدة ركَّزت على سعادة الشخص على وجه الأرض، وبخاصّة سعادته كعضو في المجتمع؛ ذلك لأنّ الحركة التنويريّة لم تقتصر على التعليم بل هدفت في الأصل إلى تحرير المجتمع ككلّ من العقائد السائدة، ورفض كلّ ما كان يعنيه العصر الظلامي بالنسبة إلى المجتمع، وكما قال نيتشه “إنّ العنصر الأساسي في الفنّ الأسود للظلاميّة ليس في أنّه يريد التعتيم على الفَهم الفردي، بل يريد تسويد صورتنا عن العالَم، وتظليم فكرة وجودنا”.
قيَم التنوير وثماره
تبلورت القيَم التي أفرزتها الحركة التنويريّة (القيَم اللّيبراليّة للتنوير) بشكلٍ تامّ خلال القرن التاسع عشر واتَّخذت أهميّة مركزيّة مُستندةً إلى دروسٍ عمليّة ممّا بات يُفهم على أنّها “رسالة التنوير”. في هذه الحقبة، وعلى مدى ما يقرب من قرنَين من الزمان، بقيت شؤون البحث والتدريس ومُمارسات الأعمال والسياسة الاقتصاديّة والسياسة تُقاد جميعها بقيَمٍ “مُطلَقة”، مبشِّرة ونبيلة مثل العقلانيّة Rationalism، والشموليّة العالَميّة Universalism، والحُكم المُطلق على الأشياء Absolutism، والإيجابيّة Positivism، والموضوعيّة Objectivity، والاستقلاليّة عن السياق، واحتقار التناقضات، والتفكير الخطّي، والتسليم بوجود المعرفة غير السياسيّة، والإيمان بالعِلم، والتفاني في الالتزام بالتقدّم التقاني المُستمرّ. أدّت جميع هذه القيَم في العالَم إلى حالة من الإيمان بقيمة التعلُّم وبالدَّور الشامل للتعليم في المجتمع ونِطاقه. والأهمّ من ذلك أنّ التفكير النقديّ والنقاش الحرّ باتا يمثّلان الحجر الأساس للتعليم التنويري.
تمخَّض عن هذه المهمّة مُنتجات ثلاثة تمثَّلت بالديمقراطيّة والتعليم العامّ الحكومي (ما قبل الجامعي) والجامعة الحديثة، والأهمّ من ذلك أنّ جميع هذه الإبداعات أتَت مُترابِطة في ما بينها: الديمقراطيّة تمكّن التعليم العامّ، وتُوفّره للجميع؛ الجامعات الحديثة تَدعم الحكومة وتُنوِّر الجمهور لمُحاسَبة الحكومات أمام الناس؛ والجامعات تعتمد على التعليم العامّ الجيّد، وتُسهِم بدَورها في تحسين هذا التعليم.
تربَّعت الجامعة البحثيّة الحديثة على رأس هذه الإبداعات، تلك التي كرَّس مفهومها فيلهلم هومبولت في برلين في العام 1810 كنِتاجٍ لمشروعٍ ليبراليّ صُمِّم للنهوض بالحقيقة من خلال البحث العلمي، وتطوير الفكر العقلاني والنقدي من خلال التعليم، وتنوير الجمهور المجتمعي الأكبر. هذه الأهداف شكَّلت الأساس المنطقي للوظائف الثلاث التي طالما تبنّتها جامعات العالَم كافّة (الوظيفة التعليميّة، الوظيفة البحثيّة، الوظيفة الاجتماعيّة)، والتي ساعدت على إظهار الجامِعة كمؤسَّسة عامّة تمّ تصميمها لتعليم الطلّاب على رؤية حياتهم فيها بطريقة محدَّدة، كأفرادٍ في مجتمع وثقافة وطنيّة.
في ظلّ النيوليبراليّة
لم تَجرِ الرياح كما اشتهت سُفن التنوير. فالقيَم والنظريّات السياسيّة الموروثة من القرن التاسع عشر والمولودة في عصر التنوير لم تُعِدّ الدول والمُجتمعات لمُواجَهة ظواهر مُزعزِعة مثل العَولَمة واقتصاد السوق والثورة الرقميّة وما رافقها من “اقتصاد معرفي”. لقد شهدت ثمانينيّات القرن الماضي بزوغ تيّارٍ جديد تحت اسم اللّيبراليّة الجديدة (النيوليبراليّة Neoliberalism) انطلق، كما هو معلوم، في أميركا عندما بادر الرئيس الأميركي ريغان بإجراءات إصلاحيّة رسمت تغييراً جذريّاً في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في أميركا، مكرِّسةً تحوّلاً عن النهج “التقدّمي” الذي كان سائداً خلال السنوات الخمسين السابقة لعَهده، ومرسِّخةً لفلسفةٍ اجتماعيّة واقتصاديّة جديدة تبنّت بشكلٍ تامّ قيَم ومُعتقدات “السوق”: خفْض النفقات العامّة للخدمات الاجتماعيّة، وتخفيض اللّوائح الحكوميّة، وخصْخَصة الخدمات التي تُسيطر عليها الحكومة، وإحالة مفهومَي “الصالح العامّ” و”المجتمع” إلى التقاعد كونهما باتا مفهومَين “قديمَين”. وسرعان ما بدأت حكومتا ريغان وتاتشر في الولايات المتّحدة وبريطانيا بتطبيق هذه المُعتقدات على القطاع العامّ، ولاسيّما على التعليم والرعاية الصحيّة من ضمن بَرنامجٍ إصلاحيّ رفع اسم “الإدارة العامّة الجديدة” وقدَّم طريقة جديدة للتفكير بالجامعة كشركة.
وهكذا تسلَّلت النيوليبراليّة إلى مؤسّسات التعليم العالي حاملةً مشروعاً معرفيّاً اتّجه إلى تجسيد المجتمع كنظامٍ اقتصاديّ للشركات يتمّ فيه إعادة تأهيل الأفراد كمؤسّسات أو رجال أعمال، حيث تركَّز تأثير هذا التيّار بشكلٍ أساسي على تسليع التعليم العالي (Commodification) وإنتاج نَوع جديد من الهويّة الاجتماعيّة لطالبيه، هويّة الذّات كرائد أعمال، ما أَفقد الجامعات مهمّتها الإيديولوجيّة بعد أن بدأت بتشجيع الطلّاب على التفكير في أنفسهم كعملاء لها (زبائن) بدلاً من أن يكونوا مُواطنين في دولة.
لقد صاغ شهيد جاويد بوركي، الباحث الشهير في التحديث اللّيبرالي الجديد في مجال التعليم العالي، بعض المبادئ والأحكام الرئيسة للتحوّل في هذا القطاع، والتي تمحورت حول:
- الخصْخصَة في مجال التعليم العالي؛
- تقليص دعْم الدولة المالي المباشر في المجال التعليمي؛
- تسويق التعليم (المُنافَسة بين المؤسّسات التعليميّة)؛
- التوجُّه نحو الربحيّة (إنتاج وبَيع الخدمات التعليميّة)؛
- إنشاء سوق عالَميّ للخدمات التعليميّة؛
- دمْج النُّظم التعليميّة الوطنيّة في الاقتصاد التعليمي العالَمي.
وماذا عن عالَمنا العربيّ؟
لم يَجِد النموذج النيوليبرالي صعوبة في الانتشار عالَميّاً. وما سهَّل لهذا الانتشار أنّ الجامعات عرفت العولَمة منذ أكثر من مائة عام، أي قبل بزوغ العصر الحالي للعَولَمة، حيث شُرِع منذ ذلك الزمن بمُحاكاة النموذج الغربي للتعليم العالي في جميع أنحاء العالَم، وبقي التشابه المُذهل بين الجامعات شاهداً على عولَمتها الرّاسخة.
لقد بيَّن عالِم الاجتماع جون ماير من جامعة ستانفورد في دراسة شملت المَناهج الجامعيّة عبر العالَم أنّ الجامعات في البلدان النامية (ومنها العربيّة) تتّسم بشكلٍ خاصّ بكونها هَياكل محليّة تقوم بنسْخ مَناهِج الجامعات الغربيّة، تأكيداً لمبدأ الشموليّة العالَميّة Universalism في التعليم العالي. لكنّ ما يدعو إلى التأمّل هنا أنّ الجامعات في هذه البلدان باتت تؤدّي دَوراً أشبه بـ “حصان طروادة فكري” يَنشر معرفة لا تُلائم بالضرورة ثقافة البلدان التي تعمل بها (كِتاب “الجامعة في القرن الواحد والعشرين” تأليف يِهودا إلكانا وهانس كلوبر، 2006)!
تنوَّعت مظاهر انتشار النموذج النيوليبرالي في قطاع التعليم العالي في المنطقة العربيّة بين الخصخصة الكلّيّة أو الجزئيّة التي تميّزت بانتشار الجامعات الخاصّة الربحيّة (مع غياب شبه تامّ للجامعات الأهليّة أو الوقفيّة) وفروع الجامعات الأجنبيّة، وتبنّي الجامعات الحكوميّة أنماطَ تعليمٍ جديدة مأجورة كالتعليم المفتوح والموازي و “المُمتاز” والافتراضي…إلخ.
لن يتّسع المجال هنا للحديث عن مَكامن “الظلاميّة” في الجامعات العربيّة، سواءً تلك الناجمة عن القصور في مُواكَبة التعليم اللّيبرالي التنويري، أم تلك الناجمة عن “الانزلاق” في المُمارسات المُتناقِضة للنيوليبراليّة، إلّا أنّه يُمكن الاستنتاج بسهولة، أنّ التعليم في هذه الجامعات انساقَ بشكلٍ طبيعي، ومن حيث لا يَحتسِب، وراء المَوجة النيوليبراليّة من دون أن “ينعم” كما يجب بقيَم التنوير. نتيجة لذلك، باتت الجامعات العربيّة مَوطناً لهويّتَين اجتماعيّتَين مُتنافستَين: من ناحية، فإنّ الطالب حين يدخل الجامعة يرى نفسه موجوداً فيها لتلقّي خدمة وتعزيز رأسماله البشري، ومن ناحية أخرى، تُحاوِل الجامعة مُمارَسة دَورها التقليدي كمُنتِجٍ وحامٍ وغارسٍ للهويّة والثقافة الوطنيّة.
هل كان بالإمكان مُقاوَمة المدّ النيوليبراليّ في التعليم العالي؟
في الحقيقة، لم يكُن ذلك من السهولة بمكان لا على المستوى العالَمي، ولا العربي بعد أن أصبحت النيوليبراليّة واحدة من الاستعارات المهمّة في تغييرات التحديث في بداية القرن الحادي والعشرين، وأصبح العالَم أكثر براغماتيّة وتنافسيّة و”فوضويّة”، وازداد الطلب على التعليم العالي لتلبية متطلّبات الاقتصاد المَعرفي، وانتقلنا بجامعاتنا إلى النمط الاستيعابي الجماهيري (Massification).
ما سبق يقود إلى الاستنتاج بأنّ النيوليبراليّة، كالعولَمة، فَرضت نفسها على الجامعات في كلّ مكان، كشرٍّ لا بدّ منه! وذلك على الرّغم من نشوء تيّارٍ مُضادّ اتّسم بالتمسّك العقائدي بالعقلانيّة والموضوعيّة، والإيمان بالعلوم الاجتماعيّة غير السياسيّة. تسبَّب هذا التيّار بتحويل الإيمان “الأعمى” بـ “الطريقة العِلميّة” نفسها إلى شكلٍ آخر من أشكال “الأصوليّة” أَطلق عليه إرنست غيلنر في العام 1992 تعبير “الأصوليّة التنويريّة”. وبغضّ النظر عن جدوى هذه “الأصوليّة” في الظروف الحاليّة، فإنّ ما يهمّ هنا هو حقيقة أنّ مجموعة القيَم التنويريّة لم تعُد بحدّ ذاتها كافية عندما يتعلّق الأمر بالتعامُل مع عالَمنا المُعقّد والفوضوي، وذلك على الرّغم من قصص النجاح الهائلة للتنوير في خلْق مَعارف جديدة في القرون القليلة الماضية، وربّما حان الوقت للتفكير بـ “تنوير جديد”. على هذا التنوير المرجوّ توافره في أذهان المدرّسين أن يُحقِّق بشكلٍ خاصّ نَوعاً من التفتّح القويّ تجاه أخطار النيوليبراليّة على التعليم. من أجل ذلك، يحتاج الأكاديميّون في الفضاء الجامعي العربي إلى استجابات إبداعيّة تُمكِّنهم من اختراق المنطق النيوليبرالي وإيجاد مساحة لمُقاوَمته.
لقد حان الوقت في جامعاتنا لإجراء مُناقشات عامّة حول نوع المجتمع المطلوب، والاتّجاه الذي تسلكه السياسات النيوليبراليّة بالنسبة إلى المجتمع ومؤسّساته، والمسارات البديلة التي يُمكن أن تؤدّي إلى نظامٍ اجتماعي عادل واحتوائي (Inclusive). هناك العديد من المَسارات التي تؤدّي إلى مجتمع جيّد، وجميعها يرتكز على الجامعات الوطنيّة كواحدة من العناصر الرئيسة. لكنْ، وقبل ذلك، سيترتّب على هذه الجامعات أن تستعيد قِيَمَها التقليديّة وهياكلها الحَوْكَميّة وأدوارها في المجتمع إنْ أرادت أن تُقارِب المَسارات التي تؤدّي إلى التنمية البشريّة والمجتمعيّة.
***
(*) باحث سوري مُقيم في فرنسا
(*) مؤسسة الفكر العربي- نشرة أفق