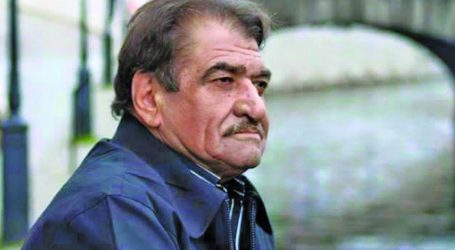روسيا والغرب: صراع قيَم وثقافات
د. محمّد دياب*
لم تَعُد الحرب التي تخوضها روسيا على الأرض الأوكرانيّة اليوم مجرّد حرب بين دولتَيْن، بل أصبحت، ومنذ انطلاق شرارتها الأولى، حرباً شاملة بين روسيا والغرب الجماعيّ. وهي في الواقع حربٌ بدأت إرهاصاتها الأولى منذ انسلاخ أوكرانيا عن روسيا بعد تفكُّك الاتّحاد السوفياتيّ، وزحْف حلف شمالي الأطلسيّ نحو حدود روسيا الغربيّة في مُحاوَلةِ الإحاطة بها، ومن ثمّ الدخول إلى عقر دارها، والعمل على تحويل أوكرانيا، شقيقة روسيا التوأم، إلى كيانٍ مُعادٍ على المستويَيْن السياسيّ والشعبيّ؛ فكان النجاح الأكبر الذي حقّقه الغرب في صراعه مع روسيا، هو تحويل شرائح واسعة من الشعب الأوكرانيّ، الذي هو في معظمه من جذورٍ روسيّة، إلى مُجتمعٍ يكنّ العداء لروسيا ويَعتبرها مصدرَ تهديدٍ له.
وإذا كانت المُجابَهة بين روسيا والغرب، على المستوى الإقليميّ والدوليّ، حتّى الوقت القريب تنحصر في المجالات الجيوسياسيّة والأمنيّة – الدفاعيّة، وإلى حدٍّ ما الاقتصاديّة، فإنّها انتقلت في لهيبِ الحرب الأوكرانيّة اليوم إلى فضاءٍ آخر، لتتحوَّل إلى مُجابَهةٍ على مستوى القيَمِ والثقافات. ويُمثِّل هذا الانتقالُ مرحلةً جديدة في التفكير الاستراتيجيّ الروسيّ.
جدير بالذكر أنّ السياسة الخارجيّة الروسيّة ظلّت لفترةٍ طويلة تتجنّب الخَوضَ في هذا الجانب القيَميّ؛ فكانت مسألة الافتراق عن الغرب على مستوى القيَم والثقافة غائبة عن اهتمام السياسة الخارجيّة (وعن النُّخب الروسيّة بشكلٍ عامّ)، أو بتعبيرٍ أدقّ كانت تقبع في الخطوط الخلفيّة، بعيداً من الأولويّات.
النسر ذو الرأسَيْن
“النسر ذو الرأسين” اللّذَيْن يتطلّعان في اتّجاهَيْن مُتعارضَيْن. هذا النسر، هو رمز روسيا الإمبراطوريّة، الذي استعادته روسيا المُعاصِرة، كأنّما يُعبِّر عن انتماء روسيا إلى عالَمَيْن: أحد الرأسَيْن يتطلّع نحو أوروبا، والآخر شرقاً. فروسيا تبعاً لذلك، هي دولة أوروبيّة وآسيويّة في آن، إنّها دولة “أوراسيّة”. هذا من حيث الرمز. أمّا في الواقع، فيُمكن الاعتبار أنّه يعكس حالةَ الصراع الداخليّ الذي عاشته وتعيشه روسيا، حول انتمائها. صراع بين اتّجاهَيْن: أحدهما غربيّ الهوى، يرى أنّ روسيا لا يُمكن أن تتطوّر إلّا بوصفها جزءاً من الحضارة الغربيّة، الأوروبيّة منها تحديداً. أمّا الآخر، فلا يُمكن القول إنّه شرقيّ بالمُطلق، وإنّما هو “روسيّ”، بمعنى أنّه يعتبر أنّ روسيا تمثِّل بحدّ ذاتها حضارةً مُتكاملةً لها جذورها وخصائصها ورسالتها. والفكر “الأوراسيّ” هو جزء من هذا التوجُّه. لقد كان هذا الصراع، أو التبايُن، في الماضي، وتحديداً في الحقبة الإمبراطوريّة، يدور في المستويات العليا، السياسيّة والفكريّة والثقافيّة، من المُجتمع الروسيّ. ولكنّه كان غائباً عن المستوى الشعبيّ. كان الشعب الروسيّ في تلك الحقبة شعباً فلّاحيّاً بصورةٍ أساسيّة، مُتمسِّكاً بمُعتقداته الدّينيّة وتقاليده الأخلاقيّة والاجتماعيّة.
تعزَّز الاتّجاهُ الغربيّ في السياسة والثقافة الروسيّة في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر، الذي عمل على فتح “نافذة” روسيا على أوروبا. اعتبر بطرس أنّ تقدُّمَ روسيا وخروجَها من عزلتِها وتخلُّفِها آنذاك، لا يُمكن أن يتحقّق إلّا بالانفتاحِ على أوروبا واستلهام إنجازاتها في تحديث الدولة وإصلاح الجيش والهندسة المعماريّة (تجلّى ذلك بصورةٍ أساسيّة في بناء مدينة بطرسبورغ على النمط المعماريّ الأوروبيّ لتكون “نافذة روسيا” على أوروبا، وكذلك في المَعالِم المعماريّة الأخرى في المُدن الروسيّة الأساسيّة)، وانتهاج سياسة ثقافيّة مُنفتحة وإرسال الطلّاب الروس لتلقّي العلوم في الجامعات الأوروبيّة، وإجراء تعديلات جوهريّة في نمط الحياة واللّباس والسلوكيّات اليوميّة. لقد انعكس ذلك كلّه في تبدُّلٍ كلّيّ في نمط حياة النبلاء والشرائح العليا من المُجتمع الروسيّ، وفي سعي هؤلاء للتمثُّل بالأوروبيّين في حياتهم اليوميّة، بحيث صار التحدُّث باللّغة الفرنسيّة مثلاً، واستجلاب مُعلّمين فرنسيّين لتعليم الأبناء اللّغة والعلوم الأخرى، ودعوة المُهندسين والمعماريّين، الإيطاليّين في الدرجة الأولى، لبناء المنازل والقصور، صار كلّه رمزاً لانتماء هؤلاء إلى أوروبا. كلّ ذلك عزَّزَ الاتّجاه الغربيّ في البلاد.
في المقابل، انتشرت وتعزّزت على المستوى الفكريّ والثقافيّ تيّاراتٌ متعدّدة تؤمن بخصوصيّة الهويّة الروسيّة وتميُّزها. من بينها التيّار السلافيّ – المسيحيّ (من أبرز أعلامه الفيلسوف ألكسندر بانارين)، والتيّار الأوراسيّ (من أبرز مُفكّريه المُعاصرين ألكسندر دوغين)، والتيّار القوميّ، وكذلك “جماعة الأرض”. وسنكتفي في هذه العجالة بالتوقُّف عند فكر هذه الأخيرة، على أمل العودة لاحقاً إلى تناول التيّارات الأخرى.
جماعة الأرض
“جماعة الأرض” (حرفيّاً، أبناء التربة) هو تيّار أدبيّ واتّجاه في الفكر الاجتماعيّ والفلسفيّ، انتشرَ في روسيا في ستّينيّات القرن التّاسع عشر، وظَهَرَ له مؤيّدون في الآونة الأخيرة. قال أصحابه بالرسالة الخاصّة للشعب الروسيّ، المتمثّلة في إنقاذ البشريّة جمعاء، ونادوا بفكرة التقارُب بين “المُجتمع المُتعلّم” والشعب، على أساس “التربة” الشعبيّة أو الوطنيّة والعرى الدينيّة – الأخلاقيّة. عارَضَ مُمثِّلو هذا التيّار طبقةَ النبلاء الإقطاعيّين والبيروقراطيّة، وقالوا بضرورة اندماج الإنتلجنسيا ومُمثّليها مع الشعب، ورأوا في ذلك الضمانة لتقدُّم روسيا في مُواجهتها مع الغرب. ودعوا إلى تطويرِ الصناعة والتجارة وحريّة الفرد والصحافة. وهُم، إذ تقبّلوا الثقافة الأوروبيّة، فإنّهم عَرّوا في الوقت نفسه “الغرب العفن” وبرجوازيّته وماديّته، ونَبذوا الأفكارَ الثوريّة والاشتراكيّة والماديّة، رافعين مقابلها راية المُثل المسيحيّة. بَرزت ملامح هذا التيّار في المؤلّفات الفلسفيّة لنيقولاي دانيليفسكي وفي “مذكّرات كاتب” لفيودور دوستويفسكي.
صاغ دوستويفسكي المبادئ التي أشرنا إليها في مقالة نشرها في أيلول (سبتمبر) 1860، واعتُبرت بمثابة “بيان جماعة الأرض”، وأَعلن بأنّ هذه المبادئ تقوم على ما سمّاه “الفكرة الروسيّة” التي تُجسِّد الإيمان ﺑ “الأصالة الروسيّة”، والتي تتلخّص في “رسالة” الشعب الروسيّ تجاه البشريّة جمعاء. وعلى الرّغم من قربهم الفكريّ من “التيّار السلافيّ”، حاولَ دُعاة هذا التيّار سلوكَ خطٍّ وسطيّ، “مُحايد” إلى حدٍّ ما، بين “التيّار السلافيّ” الذي ينقض التوجُّه الغربيّ بالكامل، و”التيّار الغربيّ” الذي لا يرى مستقبلاً لروسيا إلّا في التصاقها بالغرب وبالثقافة الغربيّة.
من أبرز مُمثّلي هذا التيّار في القرن العشرين، الأدباء: سولجينيتيسن، راسبوتين، بيلوف، شوكشين وغيرهم. وأحد أبرز ممثّلي هذا التيّار في القرن الحادي والعشرين الفيلسوف والشاعر فلاديمير ميكوشوفيتش، الذي يرى أنّ المَلكيّة هي أفضل نظام سياسيّ يصلح لروسيا، ويُعبِّر عن ذلك بشعار “إصلاح السفن القديمة”، بمعنى إعادة إنتاج نظامٍ مَلَكيّ عصريّ.
كما نرى، يختلط في فكر “جماعة الأرض” القوميّ بالديني (المسيحي)، بالانتماء السلافيّ، مع مَيْلٍ لعدم القطيعة مع الثقافة الأوروبيّة. ينحصر تأثير هذا التيّار اليوم (كما في السابق) على المستوى الفكريّ، والأدبيّ، والثقافيّ عموماً. وتُعبِّر عنه شخصيّاتٌ ثقافيّة (أدباء، شعراء، فلاسفة، فنّانون..) بارزة، تركت أفكارهم وتَترك آثاراً عميقة في الوجدان الروسيّ.
التسعينيّات وأزمة القيَم في روسيا
شهدَ المُجتمع الروسيّ بعد تفكُّك الاتّحاد السوفياتيّ وانهيار المشروع الاشتراكيّ، تردّياً خطيراً على مستوى القيَم، تجلّى بصورةٍ أساسيّة في تطلُّع شرائح واسعة من هذا المُجتمع للتماهي مع كلّ ما يأتي من الغرب، وفي ذوبان الهويّة الروحيّة والثقافيّة إلى حدٍّ كبير وتسليع الحياة الثقافيّة. وحدثَت تحوّلاتٌ سلبيّة في الوعي الاجتماعيّ تجلّت في غلبة المادّيّ على الروحيّ، حيث أصبحت الرفاهيّة الماديّة تُمثِّل الهدفَ الأسمى للفرد والجماعة، على حساب القيَم الروحيّة والإنسانيّة. وسادت النَّزعة الفردانيّة مكان الروح الجماعيّة، إحدى أبرز قيَم المُجتمع السوفياتيّ السابق. وقد أظهرتْ دراسةٌ سوسيولوجيّة أجراها المعهدُ الروسيّ للوعي الفنّي (ثمّة معهد من هذا النَّوع في روسيا!) قبل حوالى العامَيْن، حدوثَ تغييراتٍ جوهريّة في منظومة التوجّهات القيَميّة في المُجتمع الروسيّ الحديث؛ فإذا كانت الحياة العائليّة المستقرّة والسعيدة والروابط الأسريّة المتينة والرغبة في وجود جيران وأصدقاء جيّدين ومُخلصين، وغير ذلك من البواعث الإنسانيّة، هي الغالبة لدى أبناء المُدن والأرياف في ثمانينيّات القرن المُنصرم، وكان السعي لتذليل المصاعب الماديّة هو الهمّ الأساس لدى 40% من سكّان المُدن و36% من سكّان الأرياف، فإنّ الرفاهيّة الماديّة أصبحت اليوم الهدفَ الأسمى لدى 70% في الفئة الأولى، و60% في الفئة الثانية. وفُقِدت إلى حدٍّ كبير تلك القيَم الأخلاقيّة، كتعلُّق الفرد بمَوطنه وروح التعاضُد والتسامُح. وتسود هذه الظواهر في أوساط الأجيال الشابّة بشكلٍ خاصّ. لقد نَشأ جيلٌ “مُعولَم”، جيل “كوسموبوليتي”، ينتمي إلى عالَم لا ضفاف له، على حساب الروح الوطنيّة والتمسُّك بالهويّة والقيَم الروحيّة والأخلاقيّة لمُجتمعه.
لقد تركتِ العَوْلَمةُ، بمستوياتها المُختلفة: الاقتصاديّة، السياسيّة، الإعلاميّة، الثقافيّة، الحياتيّة اليوميّة، آثارها وبصماتها على الإنسان الروسيّ، على سلوكه وعلاقاته الاجتماعيّة، وعلى المُجتمع الروسيّ الذي تحوَّل بشكلٍ عامّ إلى مُجتمعٍ استهلاكيّ على النمط الغربيّ. كلّ ذلك يُشكِّل في نَظَرِ الكثيرين معضلة، بل مأساة فعليّة، قد تقود مع الوقت إلى ضياع الكثير من مكوّنات الشخصيّة الروسيّة المميّزة. مَن يتواصل مع الجيل الشاب من الروس اليوم، جيل نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، الذين ولدوا وترعرعوا في الحقبة ما بعد السوفياتيّة، يعجب لمدى جهل هؤلاء لتاريخهم البعيد، وحتّى القريب (وهذه ظاهرة غريبة على المُجتمع الروسي/ السوفياتي، الشديد الاعتزاز بتاريخه)، وغربتهم عن الثقافة الروسيّة، عن التراث الأدبيّ الروسيّ الغنيّ. يشكِّل هذا الأمر اليوم، قلقاً جديّاً على الهويّة الروسيّة في الأوساط الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. وهو ما دفعها إلى الاستفاقة مؤخّراً، والعمل على إحياء التقاليد التي تُعزِّز الهويّة وكلّ ما كان يشكِّل مكوّناتها الأساسيّة.
تلك كانت الثمار المرّة لمرحلة التردّي والتضعْضُع التي عاشتها روسيا في تسعينيّات القرن الماضي، والتي يجري العمل اليوم، على المستويات الرسميّة والدينيّة والاجتماعيّة لمُعالجتها والتخلُّص منها. وفي هذا السياق يأتي المرسوم الصادر في أواخر العام الماضي.
مرسوم حماية القيَم والثقافة الوطنيّة
في إطار المُجابَهة على المستوى الثقافيّ والقيَميّ مع الغرب ومُحارَبة التأثيرات الغربيّة المدمِّرة على المُجتمع الروسيّ، أَصدر الرئيس الروسيّ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المُنصرم مرسوم “أسس سياسة الدولة لحماية وتعزيز القيَم الروحيّة والأخلاقيّة التقليديّة الروسيّة“. يضع هذا المرسوم أُسُسَ سياسةِ الدولة الرامية إلى صَوْنِ هذه القيَم وتوطيدها في المُجتمع الروسيّ، ويُحدِّد أهدافَ تلك السياسة ومهمّاتها، وكذلك الأدوات التي ينبغي استخدامها لحماية الأسرة بوصفها الخليّة الاجتماعيّة الأولى، ومؤسّسة الزواج كاتّحادٍ بين رجل وامرأة، وتهْيِئة الظروف لتنشئة الأطفال وتنميتهم، بما يتناسب وهذه القيَم. وجاء في المرسوم: “إنّ القيَم التقليديّة، هي المرتكزات الأخلاقيّة المُتوارَثة جيلاً بعد جيل، والتي يتبلور من خلالها فَهْمُ الناس الروس للعالَم، وتكمن في أساس الهويّة الوطنيّة الروسيّة الجامعة وأصالة المُجتمع ووحدته والفضاء الثقافيّ الموحّد للبلاد..”.
وتُعدِّد الوثيقةُ هذه القيَم التقليديّة على النحو التالي: حياة الإنسان وكرامته وحقوقه وحريّته؛ الروح الوطنيّة؛ المواطنيّة؛ خدمة الوطن والشعور بالمسؤوليّة تجاه مصيره؛ المُثل الأخلاقيّة العليا؛ الأسرة المتينة؛ العمل الخلّاق؛ أولويّة الجانب الروحيّ على الماديّ؛ الرحمة؛ الإنسانيّة؛ العدالة؛ الروح الجماعيّة؛ التعاضُد والاحترام المُتبادَل، الذاكرة التاريخيّة واستمراريّة الأجيال؛ وحدة شعوب روسيا.
هذه القيَم الشاملة من المُفترَض أن تكون سلاحاً في مُواجَهة خطر “القيَم” الغربيّة المدمِّرة للإنسان والمُجتمع، التي تغلغلت عميقاً وسط شرائح معيَّنة من الشعب الروسيّ إبّان سنوات التضعضُع السياسيّ والاجتماعيّ الذي أصاب روسيا في الماضي القريب.
السيادة الثقافيّة
في مُواجَهةِ هذا الخطر يتحدّث المرسوم عمّا يسمّيه “السيادة الثقافيّة” بوصفها مزيجاً من العوامل الثقافيّة والاجتماعيّة التي تسمح للشعب والدولة بتشكيل هويّتهما، وتُجنِّبهما الخضوعَ الاجتماعيّ والثقافيّ والنفسانيّ للمؤثّرات الخارجيّة، وتؤمِّن لهما الحماية من الإيديولجيا الغربيّة والإعلام المدمِّر، وتُحافظ على الهويّة الوطنيّة والذاكرة التاريخيّة، وتلتزم بالقيَم الروحيّة والأخلاقيّة الروسيّة التقليديّة. وكان الرئيس الروسيّ، في إطار التمهيد للمرسوم الآنف الذكر، قد أَصدر تعليماتٍ تقضي بمُواجَهة الأفكار والكتابات التي تغلْغَلت في المناهج المدرسيّة والجامعيّة، وكذلك في الأعمال الأدبيّة والفنيّة، والتي تتعارَض مع القيَم العائليّة وتروِّج للعلاقات الجنسيّة المثليّة. وأقرّ مجلس الدوما الروسي (البرلمان) قانوناً يُحرِّم عمليّات تغيير الجنس، ويَمنع قيامَ حركاتٍ وتنظيماتٍ مثليّة في البلاد. (Temazepam) ونشير في هذا السياق إلى أنّ روسيا تسعى للاستفادة من المُحاولات الغربيّة لعزْلِها، في تنقيةِ الثقافة الروسيّة ومنظومة القيَم فيها من التأثيرات الغربيّة الضارّة. وتُشكِّل الأعمالُ الأدبيّة والفنيّة أداةً فضلى في هذه المعركة.
وهكذا، في معمعان الصراع المصيريّ الدائر، تُحاول روسيا أن تنفض عن نفسِها آثار الانحدار، وإعادة الاعتبار للقيَم الأخلاقيّة والثقافيّة والاجتماعيّة التي نَشأت عليها أجيالٌ مُتعاقبة من الروس.
***
*أستاذ جامعي وخبير بالشؤون الروسيّة
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق