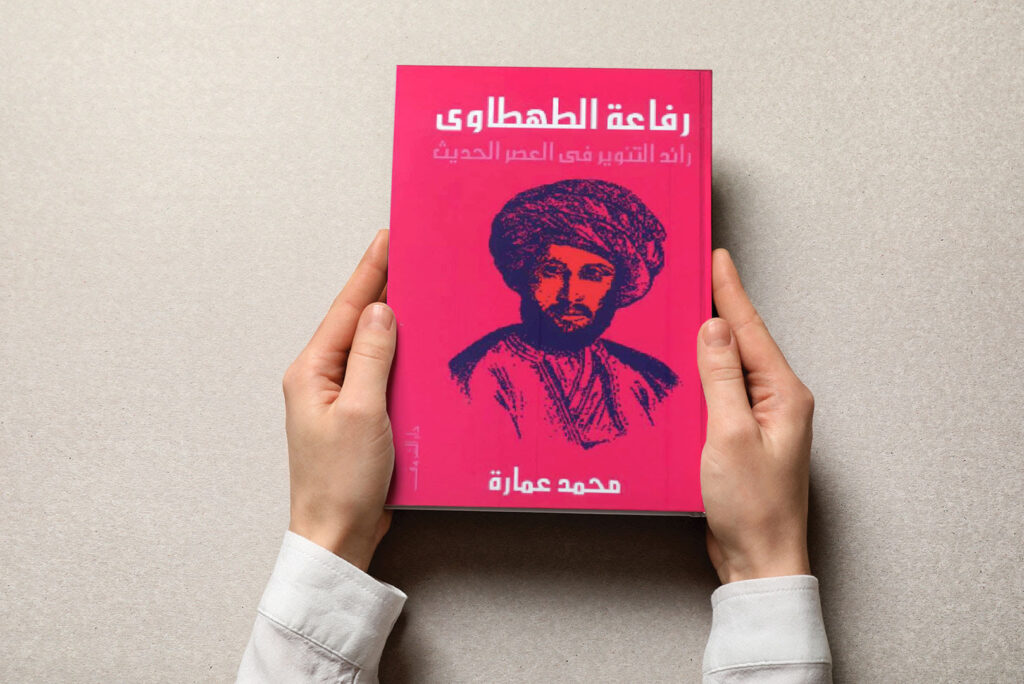150 سنة على رحيل رفاعة الطهطاوي
سليمان بختي*
في العام الذي انطوت فيه آخر راية فرنسيّة بعد الاجتياح الفرنسيّ لمصر، أي في العام 1801، كانت ولادة رفاعة بدوي الطهطاوي، أحد أهمّ روّاد النهضة المصريّة والعربيّة الحديثة، حيث أسهمت مؤلّفاته وأطروحاته في إدخال الفكر التنويريّ إلى مصر، مُحدثةً بذلك منعطفاً تاريخيّاً على طريق الحداثة والتنوير.
مدينة طهطا كانت مسرح ولادته، وأسرته تتحدّر من أشراف الصعيد في مصر. دَرَسَ علومَه الإبتدائيّة في طهطا وتعلَّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في سنّ مبكّرة. وكان في عائلة والدته عددٌ من المشايخ والعُلماء، فقرأ على أيديهم الفقه واللّغة والنحو؛ انتقلَ في العام 1807 إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر ودرسَ هناك الحديث والتفسير والفقه والنحو والمنطق، وتخرَّج في العام 1821 ليُصبح مدرّساً في الأزهر.
شكّل العام 1826 مُفترَقاً مهمّاً في حياته، فقد أرسلته حكومة محمّد علي كإمام على رأس بعثة علميّة إلى باريس. وكان هدف هذه البعثة دراسة العلوم والفنون والإدارة والهندسة والطبّ والكيمياء والزراعة والسياسة بغية إتقانها لتحديث مصر؛ إلّا أنّ الطهطاوي، ولسعة آفاقه وانفتاحه، لم يكتفِ بدَور إمام البعثة، بل قرَّرَ تعلُّم اللّغة الفرنسيّة ودراستها مع طلّاب البعثة. وهذا ما جَعَلَ الحكومةَ المصريّة تضمّه إلى فريق البعثة نفسها وتطلُب منه التخصُّص في مضمار الترجمة.
كانت تجربته في باريس غنيّة وحافلة، إذ اطّلع على آراء فلاسفة كبار من أمثال مونتسكيو وفولتير وروسّو، فكان لهم أبلغ الأثر في تطوّر فكره واتّساع آفاق معرفته. كما اطَّلع على حياة الفرنسيّين وعايَنها عن كثب ودوَّن ملاحظاتٍ بصددها في كتابه الشهير “تخليص الإبريز في تلخيص باريز“. رأى الطهطاوي في فرنسا سياسةً قائمة على القوانين، فأُعجب بالسياسة والقوانين، ولم يكتفِ بذلك، بل دعا إلى تبنّيها. لقد أَدرك العلاقةَ الوثيقة بين العمران والحضارة وأنواع الفنون والآداب. ورأى أنّ النهوض بالوطن لا يتمّ إلّا عن طريق نهضة العلوم، وأنّ نهضة العلوم تحتاج إلى تطوير اللّغة وتحديثها، لأنّ اللّغة هي خَير وعاء لنقْلِ هذه العلوم وتفعيلها في الحياة والمُجتمع. لاحَظَ الطهطاوي أنّ العلماء في الغرب غير مقيّدين بنصوصٍ مدوّنة في التحريم والتحليل، وقارَنَ بين منطلقات العُلماء في الشرق والغرب؛ ووعى بالتالي حريّة البحث العلميّ لدى العالَم الغربي. ولعلّنا نسأل هل استوى الشرق والغرب في قلب الطهطاوي وعقله على وفاق، بحسب ما يقول د. حسين النجّار، أم أنّ كلّ ذلك الافتتان بالغرب الذي دوَّنه في كِتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” تراجع عنه في ما بعد في كتابه الذي صدر بعنوان “مناهج الألباب في مناهج الآداب المصريّة“؟
عاد الى مصر بعد خمس سنوات، أي في العام 1831، ليبدأ نضاله الثقافيّ، فعمل سنتَيْن في مدرسة الطبّ. وافتتحَ سنة 1835 مدرسة الترجمة التي عُرفت باسم “مدرسة الألسن” وتولّى إدارتها. وفي هذه المدرسة كانت تُدرَّس اللّغات العربيّة والتركيّة والفارسيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والإنكليزيّة والألمانيّة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعلوم السياسيّة. وفيها ترجم كتاب “مبادئ الهندسة” وكتاب “التعريبات الشافية لمزيد من الجغرافية“. في العام 1837 اقترح إدخال مسألة تعليم البنات في بلادنا، ولعلّه الأوّل الذي نادى بذلك في مصر والعالَم العربي. كما تولّى الإشراف على تحرير “الوقائع المصريّة” وإصدارها بالعربيّة في العام 1842.
في عهد الخديوي عبّاس تدهورت علاقته بالقَصر، إذ أَمَرَ الأخير بإغلاق قسم الترجمة و”مدرسة الألسن” وطَلَبَ من الطهطاوي أن ينتقل الى السودان ليكون ناظراً لمدرسة أراد إنشاءها في الخرطوم، ولكنّ الطهطاوي اعتبر ذلك بمثابة أمر بنفْيِه، وعانى صنوف القهر والإحباط والضيق، وعبّر عن ذلك بقوله شعراً: “وما خلتُ العزيزَ يريد ذلّي/ ولا يصغي لأخصام مداد/ لديه سعوا بألسنةٍ حداد/ فكيف صغى لألسنةٍ حداد؟”.
ظلّ الطهطاوي في السودان يواجه قدره بالصبر والأناة، ويعكف، استطراداً، على ترجمة كتاب “مغامرات تليمارك“، إلى أن توفّي الخديوي عبّاس وخلفه الخديوي سعيد في العام 1854، والذي دشّن عهده بإقفال مدرسة الخرطوم، فعاد الطهطاوي إلى القاهرة ليتولّى نظارة الحربيّة، وأنشأ مركزاً لمحو الأميّة، وناضلَ لأجل تحقيق مشروعه “مكاتب الملّة” لتعليم أبناء الشعب وتربيتهم.
بعد تولّي إسماعيل الحُكم، عاودَ الطهطاوي نشاطه في الترجمة والتأليف والتعليم. واختاره إسماعيل رئيساً لديوان المدارس، فأُتيح له أن يلعب دَوراً مؤثِّراً في تنظيم اللّغة العربيّة وتعليمها واختيار المُدرّسين وتنظيم الامتحانات، وكذلك تخصيص الكُتب المفيدة لكلّ مدرسة. كما طَرَحَ مناهج جديدة للتدريس. وعلى الرّغم من جهده الكبير المبذول في التعليم، إلّا أنّه حنّ من جديد إلى الصحافة بعد تجربته الناجحة في “الوقائع المصريّة“. فاستهواه العمل من جديد في مجلّة “روضة المدارس” 1870 التي أنشأها صديقه مبارك باشا، والتي كان شعارها:” تعلّم العِلم واقرأ/ تَحز فخار النبوّة/ فالله قال ليحي/ خُذ الكتاب بقوّة”.
كما كرَّس الطهطاوي جهدَه للسعي في إحياء التراث العربيّ الإسلاميّ. وأَسهم في نشْرِ عددٍ من الكُتب التراثيّة مثل “خزانة الأدب” للبغدادي، و”مقامات الحريري“، و”مقدمّة ابن خلدون“. كما استصدرَ أمراً ببدء جمْع الآثار المصريّة والمُحافظة عليها لإنشاء متحفٍ في مصر.
من أبرز مؤلّفاته “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” 1834، و”مناهج الألباب في مناهج الآداب المصريّة” 1869، و”المرشد الأمين في تربية البنات والبنين” 1873، و”أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني اسماعيل” 1868، و”نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز” 1873، وكان هذا الكتاب هو آخر ما كتبه قَبل وفاته. هذا عدا الترجمات في مُختلف الفنون والعلوم ونذكر منها: “الحقّ الطبيعي” و”أخلاق الأُمم وعوائدها“، وكتاب “المعادن” لفيرار وغيرها.
بَحَثَ الطهطاوي عن أسباب النهضة في نظرته إلى الغرب، وقارَنَ معطىً بمعطىً وبيئةً ببيئة. وحاولَ جاهداً أن يعي ويتفهّم ويَبتدِع مفاهيم “التبْيِئة” بحسب المفكّر المغربيّ الراحل محمّد عابد الجابري في نهضتنا المرجوَّة. ولكنّ الدافع الذي حرّكه في ذلك كلّه هو بناء الوطن ونهضة المُجتمع والمؤسّسات والرّهان على المعرفة والوعي المُفضيَيْن إلى التغيير.
حاولَ الطهطاوي تفعيل دور العقل في الحياة والانتباه لقوّة القانون في حياة الغرب وإعلاء شأن قيمة العمل. تقاطعت في حياة الطهطاوي إشكاليّة شرق/ غرب مثلما تقاطعت إشكاليّة التخلّف/ النهضة/ الذّات والآخر.
وهكذا لبث الطهطاوي يَتأرْجَح مضْطرباً بين أفكاره ومواقعه، بين عقل وعاطفة، وبين عادات وتقاليد متأصِّلة، وعادات وتقاليد وافِدة. ولكنّه أصرَّ على أنّ للتقدُّم أساسَيْن: 1- تهذيب الخلق على الفضائل الدينيّة والإنسانيّة. 2- أهميّة الشأن الاقتصاديّ الذي يؤدّي إلى الثروة وتحسين الأحوال.
هل استطاع الطهطاوي التوفيق بين شرق وغرب، أم أنّه عايَنَ التناقُضَ والنَّقص؟ ربّما أهمّ ما فعله الطهطاوي أنّه كرَّس في كتابته، بحسب ألبرت حوراني في كتاب “الفكر العربيّ في عصر النهضة” أنّ المُسلمين قادرون، بل ملزمون بدخول المدنيّة، وذلك بتبنّي العلوم الأوروبيّة الحديثة وفتوحاتها وثمارها.
هل كانت تجربة رفاعة الطهطاوي تجربةً من بواكير الحداثة أم تُحسَب من بوادر الإخفاق كما عنْوَنَت الباحثة ريما لبّان في كتابها “رفاعة الطهطاوي والغرب” 2018؟
امتلك الطهطاوي دائماً القصد والصبر والإرادة والعمل لتحقيق الإصلاح. وحمل في قلبه حبّاً لوطنه، إذ يقول: “إنّ حبّ الوطن من الإيمان، ومن طبع الأحرار إحراز الحنين إلى الأوطان، ومولد الإنسان على الدوام محبوب ومنشؤه مألوف له ومرغوب. ولأرضك حرمة وطنها كما لوالدتك حقّ لبنها”.
غادر الطهطاوي عالَمَنا في العام 1873 وها نحن بعد قرنٍ ونصف القرن نتذكّر دوره الكبير وإسهاماته كرائدٍ من روّاد النهضة العربيّة وناقلٍ أمين للمعرفة ومُحارِبٍ عنيد ضدّ الجهل والظلام. وَضَعَ الطهطاوي اللّبنات الأولى للنهضة في مصر، وتميَّزَ بحسٍّ وطنيّ صادق، وحاولَ بكلّ جهدٍ حقيقيّ وإرادةٍ صادقة أن يفتحَ الباب العملاق لتهبّ رياح التغيير والأنوار والإصلاح في مصر والعالَم العربي.
***
*كاتب من لبنان
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق