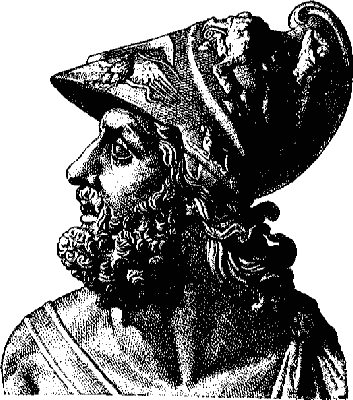الغوص في أعماق الوجدان وعباقرة التاريخ
محمد الحجيري
عقدتُ العزمَ منذ فترةٍ أن أثابرَ على الغوصِ عميقاً في وجداني لأتفقّدَ مخزوني المعرفيّ، وأذهلني أنّه امتنعَ عليّ الولوجُ، إلى بعضِ الأمكنةِ والزوايا في ذاكرتي. شعرتُ وكأنّما ذاكرتي تجهلُني، تتوجّسُ خيفةً منّي، تشكُّ بي وبأمري، ولا تتعرّفُ على بصمتي، وفهمتُ أنّها تتعمَّدُ أن توصدَ أمامي كلَّ المسالك المعهودة… ولكنّها، ربّما لاختباري، تركتْ لي مسلكاً ضيّقاً خانقاً بائساً…وَلَجْتُهُ بصعوبةٍ وببطءٍ شديدينِ،…بلغتُ القرن السابع عشر، وطالعني اسحاق نيوتن وهو منهمكٌ في تصنيفِ المُنحنيات التكعيبيّة، إنّه لعملٌ جبّارٌ لا تكفي لتتبُّعِهِ ولرصدِ حساباتِهِ وتفرٌّعاتها لا الدفاترُ ولا الأوراقُ ولا الأقلامُ…تابعتُه قليلاً، فتملّكني الأسى والحزنُ، لِما كان العالِمُ الكبيرُ فيه مِن شِدّةٍ وضيقٍ وتعبٍ…
تركتُ العبقريَّ غارقاً في أوراقِه وحِساباتِهِ الـمُضنِيَة الـمُميتهِ، وغُصتُ أعمقَ وأعمق، فبلغتُ القرنَ الحادي عشر. في غرفةٍ مُغِمَّةٍ مُعتِمةٍ، يجلسُ رجلٌ عليلُ المُحيّا، ينسخُ كتاباً على ضَوْءِ سِراجٍ تَجَمّرَ فتيلُه… راقبتُهُ، إنّه العالمُ الجليلُ، الحسنُ بنُ الهيثم، ينسخُ كتابَ المجسطي لبَطْلَمْيوس ليبيعَهُ كعادتِه ببضعةِ دراهمَ يقتاتُ بها. فهو مريضٌ وجائعٌ ولم يأكلْ شيئاً منذ يومَيْن…
يبدو أنّه هذه المرّةَ، لن يُفلحَ في إنهاءِ نسخِ الكتاب… لقد تمكّنَ منه الوباءُ، فها هو ينزفُ بغزارةٍ من أنفه وعَيْنَيْهِ، ولم يستطعِ الوقوفَ من مكانه…حَزِنَ قلبي على العالِمَيْنِ الـمِسْكينَين، وعدتُ أدراجي من مجاهِلِ وأدغالِ ذاكرتي إلى عالمي وأخيراً، يبدو أنّ ذاكرتي قد اطمأنَّتْ إليّ قليلاً، وتَعَرَّفَتْ على بصمتي التي التَبَسَتْ عليها منذ أيامٍ خَلَت، ربّما يكونُ مردُّ ذلك الالتباسِ إلى التَقَهْقُرِ والبطءِ المؤلمَين اللّذين حاقا بأساليبي المعهودةِ لها، لجهةِ فاعليّـتي وسرعتي في التقصّي والاستدلال، وربّما لغيابي الطويلِ عنها، إذ إنّني قد كنتُ مُنْشغِلاً طويلاً في غمرةٍ، فُرِضَت عليّ، من توافه المسائل، حيثُ لا وجودَ لجوهرٍ يستدعي الغوصَ في ذاكرة…

ذاكرتي، هذا الكائنُ العجيبُ الذي عهدتُهُ فضاءً يتّسعُ للكَوْنِ ولِما وراء الكون بأسرهما، ها قد خفَّفَ – الحمدُ لله – من حظرِهِ عليّ، ومن منعي تلمُّسَ بعضِ أشيائي، التي وَضّبتُها في غابرِ الأزمنة، واستودعتُها في خزائنِهِ الخَفِيَّةِ، المُتداخِلةِ الأبعاد زمناً وحيّزاً، والتي تركتُ بعضها على رفوفِهِ المَطْويَّةِ طيَّ عَجَبٍ، كدفاترَ بلا أوراقٍ لا يُحصى عديدُ صفحاتِها، المُتفاوتَةِ التَمَكُّنِِ والوجودِ أيضاً زمناً وحيّزاً … ربّما تكونُ رعودُ هذه الليلةِ العاصفةِ قد أيقظتْ ذاكرتي من سُباتِها وخَرَفِها، فأخَذَتْني بحلمها…
ها قد فَتَحَتْ لي بوابةَ ولوجٍ إلى مدينةِ العلم والنور، إلى الإسكندرية، إنّها حقبةُ مُنتصفِ القرنِ الأوّل بعد الميلاد، يجلسُ الهندسيُّ الفلكيُّ مانالاوس السكندريّ خلفَ منضدةٍ، في مكتبةِ الإسكندرية، وعلى المنضدةِ ريشةٌ، ومحبرةٌ ورزمةٌ من رقاقات الجلود التي يُكتب عليها. كان الرجلُ يكتبُ كتابَه الثالثَ والأخيرَ من مؤلَّفِهِ “في الأشكال الكريّة”، حيث تَضَمّنَ هذا الكتابُ أوّل نموذجٍ هندسيٍّ معروفٍ للهندسة على البسيط الكُرِيِّ، وحيث يُعرَّفُ المثلثُ والزاويةُ الكرويّان لأوّل مرّة في التاريخ المعروف…كان الرجلُ غارقاً في التفكير. ولقد تمكّنتُ بعد جهدٍ من فهمِ هواجس وأفكار العالِم الذي أشتهرَ بدقّتِه في الصياغة، وبصرامتِه المنطقيّة-الرياضيّة، في إقامةِ وبناءِ الأدلّة والبراهين : منذ أسبوعٍ وهو يُفكّرُ، كيف له أن يكتبَ برهانَ القضيّةِ الخامسة من كتابه الثالث، فبُرهانُه يستندُ إلى مُقدّمةٍ (صيغة) غيرِ معروفةٍ من قبلُ، أقامَ الدليلَ عليها، ولكنّ تضمينَه هذا الدليلَ في كتابِه، يرتّبُ عليه أن يزيدَ عشرين صفحةً إضافيةً على عدد صفحات المؤلَّفِ (هذا في غياب الترميز الذي نستخدمُه راهناً في الرياضيّات الحديثة)، ويبدو هذا إسرافاً في رقاقات الكِتابة، وغيرَ منطقيٍّ، نظراً لتعلُّقِه جوهراً بمُقدّمةٍ (أي بمعلومةٍ وسيطة) لا أكثر، وأخيراً عقد العالِمُ العزمَ أن يتركَ في كتابه أحْجِيَةً مُعنِتَةً للناسِ على الأزمانِ، إذ قرّرَ استخدامَ صيغةِ المقدّمة دونَ الإشارةِ إلى مصدرِها، أو إلى برهانِها…وبنى دليلَ القضيّةِ الخامسة من كتابه الثالث، على هذا الأساس ولِمؤلَّفِ مانالاوس، وبالأخصّ، للقضيّة الخامسة من كتابه الثالث قصّةٌ، تؤكّد من جديد وحدةَ الحضارة البشريّة واستمراريتها التاريخيّة، وتدحضُ مزاعمَ الصراع بين “الحضارات”. لقد فُقِد مؤلَّفُ مانالاوس في الكريات الذي وضعه مؤلِّفُة باللّغة اليونانيّة، ولكن لحسن الحظِّ حُفِظَتْ منه ترجمتُه العربيّة التي قام بها، وفق ما ذُكِر في الفهارس القديمة، حنين بن اسحاق. ومسألةُ إقامة الدليل على الصيغة التي أستخدمها مانالاوس مقدّمةً دون دليلٍ في مبرهنته، قويت على الأزمان وبقيت أُحجيةً طيلة تسعة قرونٍ، حتّى نبغ الأميرُ أبو نصر منصور بن عراق فحلّها. لقد حاول هندسيّو الحقبة العربيّة إصلاح مؤلَّف مانالاوس، لنرى إذا ما الذي جرى: عدت أدراجي من أعماق ذاكرتي من مكتبة الاسكندرية في القرن الأوّل ووجدت أمامي مسلكاً نحو خوارزم في نهاية القرن العاشر…إنّه مرصد خوارزم ومدرستها، يجلس عالم جليل المحيّا في أحد القاعات وراء منضدة وبيده ريشة يكتب بها …إنّه الأميرُ أبو نصر منصور بن عراق، لقد كتب:
//بسم الله الرحمن الرحيم
مقالةُ في إصلاح شَكلِ كتاب مانالاوس
قال أبو نصر إنّي كنتُ أظنّ أن الماهانيّ اخترمَ (=مات) قبلَ إتمام ما ابتدأه من إصلاح كتاب مانالاوس في الكريّات وأنّ شيئاً عرض لم يتمكّن معه من إكمال الغرض، الى أن نظرتُ فيما عمله أبو الفضل الهَرَوِيُّ من إصلاح هذا الكتاب، فوجدته يقول في صدره، إن جماعةً من المهندسين راموا تصحيح هذا الكتاب فلمّا لم يقدروا عليه، استعانوا بالماهاني فأصلح المقالة الأولى، وبعضَ الثانية، ووقف عند شكلٍ ذكروا أنّه صعبُ المرام عسير البيان. ثم بيّن أبو الفضل الهَرَوِيُّ ذلك الشكلَ، إلا أنّه سلك فيه غير مسلك مانالاوس، وأنا وإن كنت أنوي إصلاح هذا الكتاب فإني عندما وقفت على ما ذكره أبو الفضل، رأيت أن أُبَيِّنَ هذا الشكلَ أوّلا على ما يليق بمسلك مانالاوس في كتابه وهذا هو الذي ذكره…//
*اخترم==مات
الماهاني==عالم من الحقبة العربية
الهروي== عالم من الحقبة العربية
وأقام ابن عراقٍ الدليل على مقدّمة مانالاوس، واللاّفت أنّ هذه المقدّمة تثير الغرابة وتبدو معزولةً في الزمان والمكان لأنها تعبّر عن لامتغيّرٍ في الهندسة الإسقاطيّة التي نشأت في القرن السابع عشر، علما أن بابوس السكندري (القرن الرابع) قد تناول بعض المسائل التي تتعلق بالهندسة الإسقاطية كالتقسيم المتناسق (division harmonique)، وأغلب الظن أن هذه الأعمال لم تصل إلى علماء الحقبة العربية….