الرّمز والأسطورة في القصيدة الحديثة… أنسي الحاج نموذجًا
د. رفيق أبو غوش
لم يعد الرّمز في القصيدة الحديثة وسيلةً من وسائل إثراء الصّورة الشّعرية فحسب، إنما أصبح عنصرًا بنائيًا مهمًا في تشكيل هذه الصّورة. ولكي يتشكّل الرّمز الفنّيّ يجب أن يمرَّ عبر الصّورة، لأنه شكلٌ فنّيّ من أشكالها، وكلّما كان الرّمز موحيًا، كانت الصّورة أكثر قدرةً على الإيحاء، وأكثر مرونةً على الحركة. فالرمز حركة، وقناع يكشف رؤية صاحبه، ويضعنا أمام المشهد الماثل في حياته.
ولأن شاعر الحداثة دائم القلق، وأسير التّساؤل عن ماهية الوجود ومعناه، وهوالمؤمن بوجود عالمين متناقضين، طرحَ الأسئلة وفخّخها، وهذه إشكالية الحداثة التي سعت قصيدة النّثر إلى حمل لوائها، والتّرويج لها. وقد نجحت القصيدة في ذلك من خلال طرح المسائل ومقاربتها بروحٍ جديدة. فالمسائل التي طرحتها ليست جديدةً بمرجعيّاتها، إنّما جديدة بطريقة طرحها، ومعالجة إشكاليّاتها. فقلقُ الشّاعر ليس ” قلقًا نفسيًا مؤقّتًا، إنما هو قلقٌ ذهنيّ معرفيّ وجوديّ متسائل لا يستنيم إلى يقين”([1]). وهذا القلق جلبَ الغموضَ إلى شعره بتأثيرٍ من التّصوّف وتغيير الواقع، وغياب الحقائق الإنسانية. فحضرت الأسطورة هربًا من هذا الواقع، وإمعانًا في مقاربة الأسئلة الوجودية، وتخصيبًا للأدب بعناصرَ جديدة، وعودةً إلى منابع الإنسانية الأولى المتخفّفة من التّعالقات المادّية والتّأثيرات النفسيّة بالغة التعقيد، وذلك، لإنعاش هذه الذاكرة لأن ” الذاكرة الإنسانية هي أمُّ الأساطير التي عاشتها الإنسانية منذ القِدم، وإلى عصرنا هذا، بل لعلّها في إطار هذه الحضارة المعاصرة أكثر فاعليةً ونشاطًا منها في عصورٍ مضت”([2]).
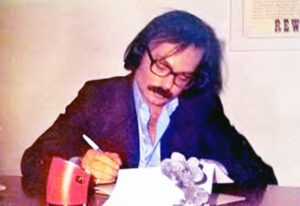
وإذا كانت الأسطورة قد شكّلت مصدر إلهامٍ لبعض الشعراء، فالشّعر في بعض تجلّياته هو” وليد الأسطورة، وهذان – الشعر والأسطورة – يلتقيان في أن كليهما يمنح الزّمان صفة الدّيمومة، حيث بوسعنا أن نرى في الأسطوريّ والشعريّ الحاضر المستمرّ والمستقبل الدّائم”([3]).
إزاء القلق والضّياع هذين، وعدم القدرة على فتح نافذة في جدار الحقائق السميك، حضرتِ الأسطورة ” لتفسّر بها الشّعوب ما ينزل بها، ولتتنفّس من خلالها تنفّسًا بعضه روحيّ، وبعضه بطوليّ، وبعضه تاريخيّ، وبعضه فنّيّ”([4])، ولتضفي على اللوحة المثقلة بالعبث والفوضى توازنًا يضبط إيقاع العناصر المتباينة، ويشحنها بطاقةٍ تفتح نافذةً للرؤية على هذا الاستلاب الذي يغشى الواقع، ويسعى إلى تفكيكه وردم الإخفاقات القائمة في مساره. وقد استحضر شعراء الحداثة رموزَ وأساطيرَ الأقدمين للولوج إلى ما وراء الرؤية، وتوظيفها لأجل إيجادِ واقعٍ جديد. ومن هذه الرموز: الماء، تموز، المسيح، العذراء، سيزيف، زوس، أوديب، قدموس، الحجّاج ولعازر وغيرها.
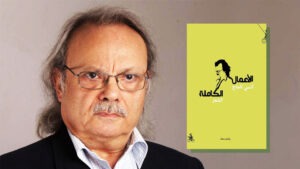
- الرّمز والأسطورة في شعر أنسي الحاج: يفتتح أنسي الحاج ترميزاته بالولوج إلى ما وراء الرؤية، وينفذ إلى ما وراء الواقع، متجاوزًا حدود الأنا، دافعًا بها إلى لحظة التّوتّر عندما يفشلُ الواقع في احتضان آماله. فينكسرُ الفراغ الهلاميّ بين انتمائه إلى هذا الواقع، وبين الأسئلة المنتشرة على مساحة قلقه. ما معنى الرّمز؟ سؤالٌ يطرحه على نفسه ولا ينتظر الإجابة المؤجّلة، بل يجيب من فوره: الرّمز فمٌ في الماء، وحالةً من حالات القمع والاضطهاد، وسفرٌ في الغّيب، وقوةٌ تعيد شحن الحاضر بسلكٍ نورانيّ، في عالم لولبيّ مقفل، ينسحب إلى أعماق الماضي، فيُخرج من دلالته المعهودة إلى دائرةٍ مغلقة على الأسرار، مفتوحة في ما وراء المرئيّات.
” وما معنى الرّمز؟ فمٌ في الماء
لكنّي فمٌ أصلع وأعمالي مخترقة وبلا هدف
الرّمز غيب
وسرّتك تغيّبُ العالم كدّوار الماء
الرّمز قوّة، ووهجك كسلٌ مسلّح”([5]).
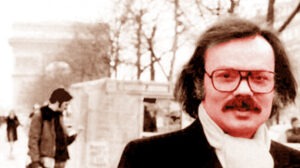
والماء الذي شكّل دلالة على الحياة والخصوبة، يراه أنسي الحاج رمزًا للغياب والجدب. لقد نظر إلى نهر النّيل نظرةً غائمة، فالنيل، بهذا الكّم من المياه المتدفّقة، لم يروِ عطش الشّاعر إلى الحقيقة. فإذا كان هذا النّهر هبة الله للبلاد الواقعة على ضفّتيه، والرّئة التي تتنفّس منها، فهو عند الشّاعر يسير بلا هدف، ويتفرّج على دخان المكتبات الصّفراء التي تجفّفها شمس الرّمال اللاهبة، ويتحوّل إلى نهرٍ فاغرٍ فمه للأشباح، ممعنٍ في الغياب، ساعٍ إلى إقصاء الذّاكرة التاريخية، فضلاً عن حجب الرؤية عن الخصوبة والحياة، ليصبح بؤرةً قاحلة لا وجود للأمل فيها.
” النّيل يتفرّج
لا يتفرّج النيل لكن
فمه مفتوحٌ للأشباح والنّظرات مبللّ
بدخان المكتبات الصّفراء
مجفّفٌ بنهارٍ طويل”([6]).
إلا أن هذا النيل في الجانب الآخر من الرؤية ليس المكان المقفل، ففي دائرةٍ أخرى، تستدعي الذّات المثقلة شريط الأمجاد وصوت التّاريخ، وتفتح نافذةً للأمل يتسرّب منها فعل الحياة، ونداء الماء، وحقول الخصب، فيعود النهر إلى دوره، وتتبدّل هويّته من مكانٍ مجدبٍ إلى رياضٍ واهبةٍ للحياة، ودافعةٍ الموت إلى تخوم الصّحراء، فيقول:
” وجدنا فيك نيل المفاتيح
طاولة الزّهر…
والعناوين مصحّحة
ولبؤة المطر
وشعرة الحضارات
أنت الموفور الرّزق حامي الحمى”([7]).
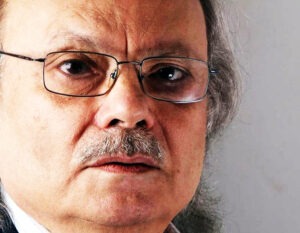
في قصيدة أهذا أنت أو القصّة يحشد الشّاعر طائفة من الرّموز، ويمنحها معنى الدّيمومة والصيرورة. فإذا هو حفيدُ إيل، وسليلُ نسل جلجامش، وربيبُ أوغاريت، وابنُ صور، وعاشقُ عشتروت، وحارسُ الأودية وملكوت الجمال. إنه متجذرٌ في أرض الحضارات، وقريبٌ من نهر الأبجدية. هو قدموس، أبو الأبجديات، وأبجديّته ألهمت العالم.
” يعود تاريخي إلى إيل والبعل
طبعوني في جلجامش وتربّيت في أوغاريت
صور صيدون بيبلوس
زارت معي اليونان
وزخرفني الفرس
وامتزجت بي عشتروت عن طريق الكحل
وسكنتُ قريبًا من النّهر
ذبحتني الآلهة
وذبحتها”([8]).
هو الإله إيل، والبطل الخارق. وهو البعل، وإله الجمال. وهو زوس الإله الذي سجن الرّيح نزولاً عند رغبة حبيبته. وهو” العاشق الذي يعلو على البشر بألوهيّته… والعاشق الذي يعلو على العشّاق في عشقه”([9])، وهو “أوديب” الذي قتل جدّه ليصبح بطلاً شعبيًا، ثمّ تزوّج أمّه معترفًا بالنسب الأموميّ.
” أعرف أنني زوس
الذي هبط عليك في السّجن
مطرًا من الذّهب
وأنجب منك ذكرًا
قتل جدّه حسب النبؤة وصار
بطلاً شعبيًا من اليونان حتى آسيا الصّغرى”([10]).
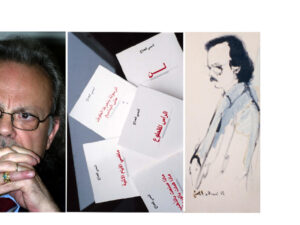
وهو عاشق” داناي“([11]) المسجونة في سجنٍ لا يمكن اختراقه، ولا هي تستطيع الخروج منه. لقد تمنّعت على الإله، فكيف يمكن أن تنقادَ إلى الشّاعر؟ إنها ملهبةُ القلوب، لكنّها تمثّل برمزيّتها العفاف المطلق في علاقتها مع الرّجال. يستحيل الوصول إليها، فهي الضامئة أبدًا، ونار الرّغبة المتأجّجة، المُوقدة جذوة الحبّ. وهي إلهة أنسيّة، حملها الموج إليه، فأنجب منها، ثم ألقاها في البّحر بصورة “أفروديت” ([12]). وعادت إلى سجنها القديم داخل الأسوار، لكن إلقاءها إلى المستقبل عذراء” صلاة إلى الحب، وعشقٌ صوفيٌ يُوقدُ المزيد من نار الحبّ، نار الاستجابة للحبيب، نار الرّغبة الضّامئة أبدًا، وأبدًا غير المرتوية”([13]).
” فليس غير زوس خليقًا بك
إله البرق والرياح والغيوم
………………..
غيره لا طريق له إلى داناي
الإلهة الحورية العشيقة الزّائلة
التي حملها الموج إليّ عذراء
فأنجبتُ كل ما أنجبتُ منها وألقيتها
على الموجإلى المستقبل عذراء”([14]).
ويحضر يسوع في قصيدة فصلٌ في الجلد في ذروة التّشكيك والتّجديف، فيقيم الشّاعر توازنًا بين واقعٍ يعيشه، وحلمٍ يسعى إلى تحقيقه، ويجرى تعديلاً بنيويًا على الرّمز بحيث يتحوّل رمز التّضحية والقيامة إلى رمز العجز والصّمت الرّهيب. القيامة تعني النّهوض والخلاص وتجديد الحياة، وعوضًا من أن يشكّل يسوع رافعة التغيير، إذ به يُمنى بالعجز، ويفشل في فعل القيامة، كما سيفشل الشّاعر من بعده. لقد بدا دور يسوع معطّلاً، والمرحلة التي يعيشها صعبة وعصيّة على التّغيير، وديك الصّباح الذي يعلن انبثاق النور يشبه أبا الهول في صمته الأسطوريّ فلم يعد يصيح ويوقظ الفجر.
“أبا الهول خذ صمتي وامنحني يسوع
ديكك لا يصيح
ديكك لا يصيح
يسوع أنقذ نفسك”([15]).
لقد أنكرَ الشّاعر موجبات الإيمان، واسترسل في رفضه، وواصل أفقه المسدود تضييق الخناق على أحلامه، فرفضَ قيامة لعازر من الموت. فهل تمسّك الشّاعر بفكرة الاستنقاع والموت والعجز؟ وهل صار قدرُ النّاس أن يلزموا قبورهم تحت الشّمس؟ ” لأن لعازر قلتُ هلمّ لعازر خارجًا؟ مُرْني فأبقى. إنني أعتصم بالقبر فعلى القبر السّلام وفي القهر المسرّة ([16]). مبدّلاً هويّة الأشياء، وسيميائية الدّلالة، ومحرّفًا كلام الله، وفاق ما ترتضيهمشاعره.
وينكسر الرّمز في قصيدة أوراق الخريف مريم العذراء، وما تمثّله هذه الأوراق من اقتراب موعد الموت، وما يمثّله الخريف من سقوطٍ للأشياء استعدادًا لقيامها من جديد، وتبدّلٍ في هويّة الزّمن. فيصبح رمز الألوهةمريم العذراء رمزًا للكآبة والذّبول والانطواء.
” كنت عهدَ الكتابة أُسمّي
مثلاً
أوراق الخريف مريم العذراء”([17]).
ثم ينكسر الرّمز مرّةً أخرى مع نوح والطّوفان الذي ابتلع الأرض بحيث” لم تجد السّفينة ماءً يحملها، ولم تجد أيًّا منًا لتحرمه الطّوفان”([18]). فيتحوّل رمز الخلاص إلى موتٍ محقّق، وتتحوّل القيادة إلى ضربٍ من الوهم. هذا العالم يسير بلا قيادة، والزّمن هباءٌ منثور، ليعود ويستقطب الرّمز وحركة الماء، ويقرّر واقعًا عاجزًا عن الوصول إلى برّ الأمان، وبالتّالي عجز الشّاعر عن تغيير الواقع البشع، وتكوين عالمٍ جديد.

ويتقمّص الشّاعر شخصيّة شهريار ([19]) في انتقامه من المرأة التي ارتكبت الخطيئة، وفعلت المعصية، إلا أنه يتمايز عنه، فهو لم يجد المرأة التي طلبها لينتقم بها من بنات جنسها. وإذا كان شهريار قد قتل ما قتل، فإنه عجز في النّهاية عن إكمال فعل القتل، لأن الحبّ انتصر في النّهاية، وتغلّب على الحقد. وإذا كان القتل عند شهريار هو قتل الجسد، فإن القتل عند الحاج هو قتل الرّوح. وهو قتل متبادل، يفنى فيه الحبيبان، لتتكلّل مشاعر الحبّ بالخلاص، والتّحرّر من الثأر، ولتصبح الحياة أجمل مع المرأة التي يحبّ، ويتحقّق فعل المساواة والتّوازن.
” فطلبت من الوزير أن يأتيني على عادتي منذ سنين
ببنتِ ليلةٍ وأقتلها
فراح وما وجد
فاقترحت ابنته شهرزاد أن تمثّل بنات البلاد
وجاءت وقالت:
أحببتها أحبّتني، قتلتها
والفرق بيني وبين شهريار الأبله إنها أيضًا قتلتني.([20])
إنه يصحّح العلاقة الالتباسية بين مفهوم الذّكورة المتحكّم بالعلاقة غير المتكافئة بين الرّجل والمرأة، ومفهوم الأنوثة التي إذا ما أُعطيت فرصتها، فإنّها تستطيع أن تصنع المعجزات، وأن تتحكّم بمسار الأمور. إذذاك، تصبح المرأة “سلامها نبيذ وحربها ذهب.”([21]) وإذا كانت شهرزاد قد احتاجت إلى ألف ليلة لتتحرّر وتحرّر بنات جنسها، فهو بالحب لا يحتاج إلا إلى لحظة واحدة ليحوّل حياة البشر إلى السّعادة، وليحدث ثقبًا في جدار الظّلم.
إنّه أنسي الحاج سادن الهيكل في مملكة الشّعر، وصاحب الرّمز المتحرّك في دائرة الرّؤية،فالرمز الشّعري ” مرتبطٌ كلَّ الارتباط بالتّجربة الشّعورية التي يعانيها الشّاعر، والتي تمنح الأشياء مغزىً خاصًّا”([22]).
وبهذا اتّجه الرّمز مع أنسي الحاج اتّجاهًا مغايرًا للمألوف، فأسقط عن شخوصه فعلَ القيامة والخصب والألوهة، وعمل على قلب المعادلة بما يرضي ثورته ونزقه الشّديد. ولعلّه في ذلك، كان يبغي تحرير الرّمز من ثِقلِ التّاريخ، ودفعهِ في شرايين قصيدة النّثر ليُثبتَ من جديد أن مساحة الشّعر وبخاصّةٍ شعريّة قصيدة النّثر قادرة على حملِ هذا الموروث من دون أن تنوء أو تستنجدَ بعكاكيز التّراث.
***
[1]– عبد الرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة، المرجع نفسه، ص 45.
[2]– عبد الناصر حسن (2009) الحب عند رواد الشعر الحديث، رموزه ودلالاته (ط1)، القاهرة، شركة الأمل للطباعة والنشر، ص 24.
[3]– عبد الناصر حسن: المرجع نفسه، ص 25.
[4]– عبد الرحمن القعود: المرجع نفسه، ص 48.
[5]– أنسي الحاج: لن، المصدر نفسه، ص 59.
[6]– أنسي الحاج: ماضي الأيام الآتية، المصدر نفسه، ص 113.
[7]– ماضي الأيام الآتية: المصدر نفسه، ص 114.
[8]– أنسي الحاج: ماضي الأيام الآتية، المصدر نفسه، ص 124.
[9]– عبد الكريم حسن: قصيدة النّثر، المرجع نفسه، ص 102.
[10]– أنسي الحاج: ماضي الأيام الآتية، المصدر نفسه، ص 25.
[11]– هي إبنة الملك أكريسوس اليوناني، سجنها أبوها في برج منيع خوفًا عليها من الإله جوبيتر وفق الميثولوجيا اليونانية.المرجع: ويكيبيديا.
[12]– أفروديت أو فينوس إلهة الحبّ والجمال والشّهوة في الأساطير اليونانية،والحب المقصود ليس هو الحب بالمعنى الرومنسي، بل المقصود هو إيروس(الحب الجسدي أو الجنسي)، وهي واحدة من الألهة الإثني عشر اللواتي يعشن على جبل الأولمب. وعُرفت عند العرب في الجاهلية بإسم اللات الصنم الذي جيء به من اليونان.المرجع: ويكيبيديا.
[13]– عبد الكريم حسن: قصيدة النثر، المرجع نفسه، ص 111.
[14]– أنسي الحاج: ماضي الأيام الآتية، المصدر نفسه، ص 26.
[15]– أنسي الحاج: لن، المصدر نفسه، ص 51.
[16]– أنسي الحاج :لن: المصدر نفسه، ص 44.
[17]– المصدر نفسه، ص 161.
[18]– أنسي الحاج: ماذا صنعت بالذهب، المصدر نفسه، ص 85.
[19]– شهريار الملك شخصية أساسية في حكايات ألف ليلة وليلة، كان ملكًا عادلاً إلى أن اكتشف خيانة زوجته مع عبده، فراح يتزوّج في كل ليلة فتاة، ثم يقتلها، إلى أن جاءت شهرزاد التي تميّزت بالذكاء والفطنة فراحت تحكي له في كل ليلة حكاية. ولا تنهيها إلا في الليلة التالية حتى تضمن عدم قتلها إلى أن روت له أكثر من ألف حكاية في ألف ليلة وليلة. وبذلك جعلته يحبها ويتزوجها وتنقذ بذلك بنات جنسها. المرجع: ويكيبيديا.
[20]– أنسي الحاج: ماذا صنعت بالذهب، المصدر نفسه، ص 154.
[21]– المصدر نفسه، ص 88.
[22]– عز الدين اسماعيل: الشّعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، المرجع نفسه، ص 198.







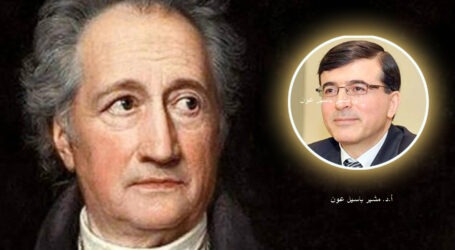
![“الوجوديّةُ البيضاء”[1]](https://aleph-lam.com/wp-content/uploads/2023/07/363036068_995679311565541_137518692139679454_n-455x250.jpg)