أحمد قعبور: تخفَفت من وطأة الإيديولوجيا وأجمل ما فيّ أخذته من المرأة.
دارين حوماني
من منّا لا يذكر “أناديكم” و “يا رايح صوب بلادي” و”نحنا الناس” و”روح شوف مستقبلك” و”شو صار بكفر منخار” لم يكتب أو يلحّن أحمد قعبور أغنية للكبار والصغار إلا وعلقت في مكان ما في داخلنا.. أحمد قعبور إبن مدينة بيروت المولود في العام ١٩٥٥ درس المسرح في الجامعة اللبنانية وتابع دراسته في دار المعلمين بناء لرغبة أمه، وغنّى ولحّن، أستاذه الأول والده محمود رشيدي أول عازف كمنجا في بيروت والروح الحاضرة فيه سيد درويش وعمر الزعني، غنّى الناس وأوجاعهم، غنّى القضية الفلسطينية والجنوبيين، والآن يغني المرأة الوطن بكل ما فيها، هاجس “القضية” حاضر دوماً في أغانيه، نال جائزة القدس للثقافة والإبداع في العام 2016، أحمد قعبور المنحاز للإنسان أولاً أينما كان وجعه كان لنا حوار معه حدّثنا فيه عن ألبومه الجديد “لمّا تغيبي” وعن فرحه ووجعه ومبادئه الأساسية..

لنبدأ من ألبومك الجديد “لمّا تغيبي” أخبرنا عنه، ماذا يريد أحمد قعبور أن يقول؟
“لمّا تغيبي” هو عنوان أغنية من ١٨ أغنية في الألبوم الجديد، يحكي الألبوم عن قضية أساسية هي المرأة، المرأة تعنيني وأعتقد أن أجمل ما فيّ أخذته من المرأة، من أمي وأختي وزوجتي والصديقات اللواتي مررن في حياتي، أعتقد أن المرأة تبلسم الجروح التي يُحدثها الرجل. “لمّا تغيبي” كتبها صديق خسرته من أكثر من ١٥ عاماً، شاعر شاب توفي بحادث سيارة إسمه باسم زيتوني، وقد لحّنت الأغنية بعد كتابتها مباشرة ولكن كلما دخلت الأستديو أفشل بغنائها، أتذكر باسم وأشعر بغصّة، إلى أن غنّيتها أخيراً. هناك منحى إنساني في بقيّة الأغاني، فيها شيء كمن عاش في ملجأ فترة وخرج ورأى النور وأحبّ أن يغنّي بهدوء دون أن يتنازل عن جوهر القناعات الأساسية التي لها علاقة بالحب، بالعدالة الإنسانية وبالكرامة الإنسانية، بحلمنا أن نعيش في بلاد مطمئنة على كوكب مطمئن لأن الكوكب كله لم يعد مطمئناً. يتضمّن الألبوم ٤ أغاني بأصوات ٤ صديقات أنا كتبت الأغاني ولحنتها. أغنية غنتها شانتال بيطار عن المخطوفين وحكايتهم في لبنان، أغنية عاطفية غنتها صديقتي الفلسطينية أمل عكوش إسمها “دق الباب”، إيفون الهاشم غنّت أغنية “ما في شي” عن تعنيف المرأة لأني منحاز جداً لهذا الموضوع وأمارسه بشكل يومي، إستعدت بصوت “نادين حسن” أغنية قديمة عزيزة على قلبي “يا ستي ليكي ليكي” أداء وتوزيع نادين حسن. يتضمن الألبوم أيضاً ثلاثية، ٣ أغاني عن الأب إخترت منهم ٤ أبيات لمحمود درويش والبقية لصديقة إسمها بثينة سليمان. هناك أيضاً أغنية عن بيروت والتي ترافقني دوماً “بيروت زهرة”، وأخيراً أغنية أتمنى أن لا تُحدث لي مشاكل “مين عطاك الحق” أخاطب فيها المستبد والظالم الذي يعتقد أنه يمتلك كل الحقيقة وكل المعرفة فأقول له “مين عطاك الحق”.
هل تواجه الفنان أحمد قعبور تحدّيات معيّنة عند اختيار وتقديم الأغنيات التي تشبهه؟
طبعاً التحدّي الأكبر أن أحافظ على المنحى التمرّدي الذي أطلقته من أول أغنية “أناديكم” حتى آخر أغنية في الألبوم الجديد، هو إنحياز دائم للإنسان ومظلوميّة الإنسان ورغبته في أن يكون حرّاً وأن يكون على أرض حرّة، منحاز لحقوق النساء والأطفال، التمرّد كما كنت أقول لطلاب الجامعة “عليّ أن أتمرّد على نفسي قبل أن أتمرّد على الآخرين”، أنا بحالة تمرّد على الذات قبل الآخرين وأسعى دائماً أن أكون مختلفاً ومتجدّد الإختلاف، ليس بقصد الإستعراض، هناك نسق فني في البلد أصبح مثل القدر الأعمى أمضيت عمري ولم أنغمس به، أعلن تمرّدي على هذا السوق الإستهلاكي وتحويل الفن الي سلعة وأجدّد إنحيازي لما هو جميل بالروح جميل بالمعنى جميل بكل عناصره الفنية.
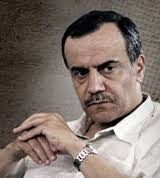
ألا يشكّل غيابك لفترات عن الوسط الفني إعطاء مساحة أكبر لما يسمّى بالإنحدار الفني الذي نعاني منه وخصوصاً أنك ستلمس لدى الأجيال الجديدة حاجة الى الأغنية الإجتماعية والإنسانية وربما السياسية التي تقدّمها، دليل على ذلك أنهم يردّدون أغانيك التي ولدت قبلهم؟
المشكلة أنّ هذه الأغنية التي أنتجها، أنتجها بمقومّاتي الخاصة، لست طفلاً مدلّلاً في إحدى الشركات أو إحدى الطوائف أو أحد الأحزاب. كل شغلي، كما يقول الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، بأظفاري. لذلك فإن عملي يحتاج وقتاً وليس غريباً أني تجاوزت الستين ولا أزال أنتج أغانيّ بنفسي، هناك جهات إنتاجية غالباً ما تفرض شروطاً لها علاقة بالمعنى أو بالإستهلاك، وأنا لست مضطراً، وأعتقد أنه بالنهاية مع الوقت الناس لا تلتفت الى الكمية بل الى النوعية، كثير من الأغاني تولد اليوم سرعان ما تموت غداً، أنا أزعم أني أهتم بالنوعية وإذا احتاج العمل وقتاً أطول فإنني أكون “عم بعجن عجيناتي، عم حضّر زعتراتي”، إنني أحاول أن أقول شيئاً جديداً وغير ممجوج.
أغنياتك لطالما كانت تحمل هاجس “القضية”، هل ثمّة إنقطاع في داخلك عن القضايا التي كنت تحملها سابقاً؟
أبداً لا يوجد انقطاع، إنما التعبيرات اختلفت، حتى بمراحل سابقة، ففي العام ١٩٧٦ عندما كان الجنوب محتلاً غنّيت “جنوبيّون” وكان هناك رفض ورغبة في مقاومة هذا الإحتلال. لاحقاً في العام ١٩٨٣ غنّيت للجنوب بلغة أكثر إنسانيّة “يا رايح صوب بلادي” وغنّيت عن أشخاص من لحم ودم وعندهم حكايا خاصة، تطهّرت وتخفّفت من وطأة الإيديولوجيا واتّجهت أكثر للإنسان وأزعم أني أحاول أن أدخل الى العمق الإنساني أكثر وأتخفَف من وطأة العنوان العريض للإيديولوجيا. وبالعودة الى الجنوب مثلاً لحّنت جزء من قصيدة للشاعر الراحل “عصام العبدالله” تتعاطى مع هذه القضية بمنحى أكثر حباً، أكثر عمقاً وأكثر شاعرية.
إنّ متلقّي أغانيك سيشعر بحضور ثورة ما، نداء ما، ثمّة إحتجاج يريده أحمد قعبور أن ينتقل الى الناس، وأرى أن محاولتك أو رغبتك في المشاركة السياسية هي تكريس في مكان ما للقضايا التي تحملها في أغانيك، ما قولك في ذلك؟
لا أستطيع أن أصدّق أن المثقف أو اليساري أو الفنان الذي يتفجّع على حبيبته التي تركته يكون بلا موقف من قضايا الإنسان الأساسية. لا يمكن أن أصدّق أن الذي ينحاز لقضية محقة في مكان ما يتجاهل ويتعامى عن قضية محقة في مكان آخر. طبعاً أنا منحاز كليّاً وصاحب مبدأ في كل مكان وكل زمان. البعض ينحاز فيقول هناك ثورة في البحرين وإرهاب في سوريا أو ثورة في اليمن وداعش في سوريا، هذا العمى الإيديولوجي أو التعامي أو الإيديولوجيا التي تعمي البصر والبصيرة أحاول أن أكون خارجها والذي يغنّي لوجع الناس فإنّ وجع الناس واحد ودم الناس واحد وإذا قُتل أطفال بصنعاء وإذا حوصر أطفال في كفريا والفوعة وإذا برزت عظام الجائعين في مضايا والزبداني، هذا وجع واحد وأيّاً كان المحاصِر وأيّاً كان المحاصَر فأنا أنحاز لهؤلاء وآخر همّي إنتماءاتهم الطائفية أو الإيديولوجية أو المذهبية. الذي نشهده اليوم هو عمى سياسي سببه البلوكاج الإيديولوجي وهناك الكثير ممّن يدّعون اليسارية ويدّعون الإنحياز للثورات يستنسبون ويقفون على مرتفع عالي ويقولون هذا إرهاب وهذا ثورة وهذا ما أريد قوله في أغنية “مين عطاك الحق”.

كان للطفل دوماً على امتداد زمن الفنان أحمد قعبور مساحة ممّا يقدّمه، “فكرة السنابل” “مسرح الدمى اللبناني” والأغاني التي خصّصتها دوماً لهم، هل يحضر أحمد قعبور طفلاً وهو يقدّم هذه الأعمال؟
بالتأكيد خاصة عندما أكتبها أو ألحّنها أو أسجّلها. أذكر عندما كنا نسجّل أغاني لمسرحية “شو صار بكفر منخار” صار الأستديو حديقة أطفال وصرنا نضحك كما لو أننا فعلاً أطفالاً. هنا أريد أن أستشهد بالفنان التشكيلي بيكاسو الذي قال “عندما نتقدّم في العمر إنّما نتقدّم نحو طفولتنا” وهذا هو السرّ الجميل الذي يفسّر علاقة الأجداد والجدّات مع الأطفال وقد صرت جدّاً وهذا الطفل الذي في داخلي لا يزال لديه أشياء كثيرة يريد أن يقولها، لديه الكثير من “الحدّوتات” يريد أن يسمعها، لديه أحلام متمسّك بها، ربما الرّاشد الذي في داخلي ماتت أحلامه أما الطفل فلم تمت أحلامه.
قلت مرة “كان أبي يمنعنا من رؤيته وهو يعزف، لاحقاً فهمنا أن العزف لم يحمل إليه إلا الأسى والمرض”، ماذا حمل العزف لأحمد قعبور؟
الغيتار أولاً والبزق ثانياً والعود ثالثاً، كل وتر من أوتار الآلات الموسيقية كنت أعزف فيها حياتي. أنا أؤمن بالإنسان الدي يغني الناس وليس يغني لهم، أي أنهم يصبحون هم الأغنية، يطلق الأغنية ويسمعها مثل كل الناس ويتأثر بها وينتقدها ويحبها أو لا يحبها مثلي مثل الآخرين. الآن كلما أعزف أتذكّر الوالد لأن الوالد كان فناناً، هو أول عازف كمنجا في بيروت وعزف في فلسطين ورجع منها مريضاً، وتحوّلت الكمنجا وكذلك الفن بين يديه من حلم للتعبير الى وظيفة مملّة ورتيبة بشَعت علاقته بالآلة الموسيقية فلم يكن يريد أن يجدّد القصّة معنا. إخوتي إلتزموا أما أنا فيبدو أنني كنت متمرّداً منذ طفولتي، كنت بعمر ال ١٩ عندما غنّيت “أناديكم” قال لي أبي: “يعني أصرّيت وعملتا يا بابا”…
إذا أردنا أن نقول أن ثمّة شخصاً ما أثّر في مسيرتك الفنية والنضالية، من هو هذا الشخص الذي وإن لم يحضر بجسده قربك فهو حاضر بروحه دوماً معك؟
الحقيقة أنّ مصادر التأثّر كثيرة والوجوه التي علّمتني والعيون التي تطلّعت إليّ عندما كنت صغيراً أثّرت فيّ إن كان من الأقربين أو الأبعدين، أوّلهم محمود رشيدي والدي، ولقبه رشيدي لأن جدّه رشيد، الذي علّمني أصول الإيقاعات والمقامات عبر سماعي القرآن من الجوامع المجاورة لبيتنا فكان يقول لي بلهجته البيروتية: “تعا يا أبي هيدا مقام الرصد هيدا مقام النهوند هيدا الإيقاع سماعي…” يستغرب كثيرون أني لم أدرس الموسيقى، دراستي هي المسرح والسينما ولكن ملمّ جداً بالموسيقى في التأليف والتلحين والكتابة الموسيقية. كان لدى أمي رغبة جامحة أن نكون متعلمين لنواجه ظروفنا القاسية، وقد أقنعتنا أمي أنها تعرف القراءة والكتابة وتفتح كتاب التاريخ وتقول لي “سمعلي” وهي لا تعرف القراءة وأنا “سمعلا وخاف وأحفظ كرمالا طلع إنو كرمالا كرمال الدنيا كللا”. لاحقاً الأستاذ سليم فليفل إبن محمد فليفل الأخوين فليفل علّمني الأناشيد ٤ سنين. أيضا الأستاذ حوزيف عتابا علّمني في دار المعلمين وكان له أثر كبير في حياتي. أما عن الآخرين، الأيقونات الآخرين، لا يمكن إلا أن أذكر سيّد درويش الحاضر معي بثورته، بجماله، بفرحه وبشبابه. وبالتأكيد عمر الزعني البيروتي الذي حفر بوجداني كثيراً وأعتقد أن سيد درويش وعمر الزعني هما اللذان ساهما في صنع هويتي الفنية.

نلت جائزة القدس للثقافة والإبداع في العام 2016، هل تعني لك هذه الجائزة بالتحديد كونها من جهة فلسطينية تكريماً لما قدّمته من أعمال لأجل فلسطين وكذلك لإنتمائك الى القضايا الإنسانية جمعاء؟
كلّما قابلت فلسطيني أو فلسطينية يسألونني من أي قرية فلسطينية أنت، وتكون الدهشة عظيمة عندما يتأكدون أنني لست فلسطينياً. كنت منذ أيام في الأردن تسألني صديقة أردنية تعرّفت إليها هناك “مش معقول، ليش لتغني عن الإنتفاضة وعن الضفة وعن أم الفحم وعن غزة؟” بالنسبة لي “المطارح للي فيها وجع مطرحي”. حتى محمود درويش في أحد نشاطاتنا المشتركة سألني “من وين من فلسطين” قلت له “يا محمود أنا من بيروت بس هيك تهمة بتشرفني”. طبعاً الوجع الأول والقضية الأولى هي القضية الفلسطينية ويا ليتها هي الوحيدة الآن، الآن هناك القضية السورية والعراقية واليمنية والمصرية، وأعتقد أن من ينحاز فعلياً للقضية الفلسطينية يجب أن ينحاز لكل المظلومين، أن تكون مع القضية الفلسطينية هذا إختبار أخلاقي وإنساني لكل القضايا في العالم، لا أصدّق الذي يقول أنا مع الشعب الفلسطيني وبنفس الوقت مع قتلة آخرين.
قمت بدور “وديع حداد” المناضل الفلسطيني في فيلم “كارلوس” للمخرج “أوليفيه أساياس” وشاركت في مهرجان “كان” السينمائي، ألا يعود الممثل في داخلك يناديك لتعود إليه؟
هذه هي حسرتي الكبيرة، أنا أحب المسرح وأحب السينما، هذه هي دراستي، ولكن في عمر ال ١٩ عندما أطلقت “أناديكم” كانت ورطة لكنها ورطة جميلة والكل صار يسألني ماذا تريد أن تغني من جديد والكل يشجعني على إقامة الحفلات، وأنا أردّد أن مشروعي المسرحي والسينمائي سيكون في العام القادم وكبرنا وشبنا، وهكذا كانت مشاركاتي السينمائية والمسرحية قليلة ومنتقاة. الموسيقى أخذتني لكن عوّض عن ذلك المسرح مع الأطفال، لحنّت لأكثر من ٢٠ مسرحية للأطفال وأنا فخور بذلك ورغم أن تجاربي السينمائية قليلة لكن تجربة فيلم “كارلوس” كان تحديّاً كبيراً لي وكذلك شخصية “وديع حداد” وهو فيلم عالمي، طبعاً كان هناك نقاش مع المخرج أساياس لأن هناك إلتباسات كثيرة حول تعريف وديع حداد، جزء من الغرب يرى فيه إرهابياً وأغلب العرب يرون فيه مناضلاً وكان مطلوبٌ مني أن أؤدّي الدور فاشترطت على أساياس أن أقدّم الدور بما يتناسب مع قناعاتي لكوني منحازاً، وإن كان وديع حداد في ذلك الزمن يغامر في القضية الفلسطينية ولكنه كان صادقاً في قضيته على عكس كثير من الناس الذين يحملون شعار القضية ويخونونها كل يوم، كانت هذه التجربة تحدّياً سياسياً وتحديّاً فنيّاً كبيراً لي. جاءتني عروض بعدها وكان من الصعب عليّ أن أقبلها لأنها تتناقض مع قناعاتي رغم أن فيها مغريات كبيرة.
أغانيك تحاكي الذاكرة الشعبية والجمهور يشتاق ل”فرقة الطرابيش”، أليس من عودة للطرابيش في مكان ما؟
مؤسسات البلد فيها مشاكل إنتاجية كبيرة، وإعادة إنتاج أغاني جديدة لفرقة الطرابيش تحتاج وقتاً وجهداً ومقوّمات، عندي أفكار لكن الأهمّ من الإنتاج هو أنني لا أريد للطرابيش أن يطلّوا إذا لم يكن لديهم شيء جديد ليقولوه، دائماً إذا كرّر الفنان التشكيلي نفسه يحترق. لديّ شيء للطرابيش، لقد أصابهم الإحباط والحزن وأريد أن أطلق رسالة لأولادهم وأولادهم يطلقون رسالة لهم ليحرضوهم “إنتو قلتولنا روح شوف مستقبلك وها أنا مستقبلك ليش انتو قاعدين”، إنها فكرة وأنتظر أن تتبلور أكثر.

بيروت محمود رشيدي، بيروت المقاومة الشعبية، بيروت اليسار، بيروت الحريرية، بيروت مدينتي، وكأنك تعيد إكتشاف بيروت في داخلك كل مرة، ماذا تركت هذه البيروت في أحمد قعبور الإنسان، وما الذي تنتظره من بيروت الآن؟
بيروت هي الحضن الذي تربيت فيه، هي الملجأ الذي تخبأت فيه، هي القصيدة التي كتبتها، هي المدينة التي حوصرت فيها أيام الإجتياح الإسرائيلي، هي المدينة التي هربت في أزقّتها عندما كانت الميليشيات اللبنانية والفلسطينية والسورية تقصف بعضها البعض، هي المدينة التي أحببت فيها زوجتي، هي المدينة التي في بحرها رأيت أحبّائي يرحلون في المراكب، هي المدينة التي أخاف عليها خوفي على أولادي، وهي المدينة التي أعتقد اليوم أني أخسرها يوماً بعد يوم، أخسر هويتها العمرانية، أخسر هويتها الإنسانية والإجتماعية. مدينة بيروت لا تكون مدينة إلا إذا كانت حاضنة وجامعة وإذا كانت بثقافة واحدة بلون واحد لا تكون بيروت وإذا لم تكن مرحّبة بالشاعر المطارد من العراق أو بالمطرب الغير مرغوب به في سوريا أو بالذي يفتش عن تجربة جديدة قادماً من مصر ، هذه هي بيروت التي نشأت فيها كل القيادات الفلسطينية التي تقرأ لكل القصائد والدواوين وتبقى هي القصيدة الأحلى، لكن هذه بيروت الآن مختلفة وأنا حزين جداً في بيروت الآن لكني متعلّق بها ولا يمكنني تركها ولكني أشعر أن البقاء فيها متعب ولأجلها أطلقت أغنيتي “بيروت زهرة” في الألبوم الجديد، عمر الزعني قال منذ مئة عام “ضيعانك يا بيروت” وأنا الآن بعد مئة عام لا أريد أن أقول لعمر الزعني “ضيعانك يا بيروت” وكأنني أرفض موتها. المدينة فكرة ليست أبنية، بالتأكيد الواجهة العمرانية لها أهميتها، إنها تتبشّع، هناك ناطحات سحاب وأبراج تفصل بحر بيروت عن عمق المدينة، هناك بيوت تعوّدت عيوننا عليها لم أعد أجدها. عادةً يطرأ على المدن تبدّلات لكنها تكون تبدّلات سلسة لا ننتبه لها، إذهبي الى باريس الآن واذهبي بعد خمسين سنة ستجدينيها هي نفسها، بيروت كل خمس سنوات تتغيّر حجراً وبشراً، بيروت التي يعرفها أبي هي غير بيروت التي أعرفها أنا وهي غير بيروت التي يعرفها أولادي، هذا التقطّع بالذاكرة مدمّر. هذا على مستوى الواجهة العمرانية والشكل والهوية الهندسية لكن هناك مشكلة أخرى هي هوية المدينة، لا يمكن أن تكون بيروت مكسر عصا لمن يدّعي أنّه يحقّق إنتصارات أيّاً كانت الإنتصارات، إنتخابية أو عمرانية، هذه المدينة إحترقت في الإجتياح الإسرائيلي سنة ١٩٨٢ وهذه المدينة هي التي انطلقت منها جبهة المقاومة الوطنية وهي المدينة التي أُطلقت منها الأغاني والقصائد للبنانيين وفلسطينيين وسوريين ومصريين وعراقيين تُعاقب الآن ويجري تدجينها كما تمّ تدجين جميع العواصم العربية.








