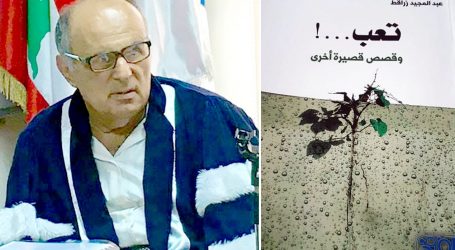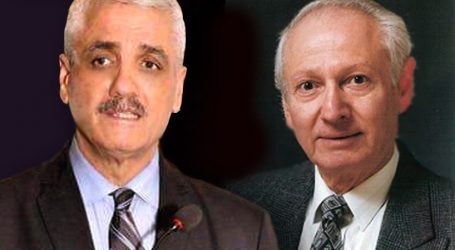علي العلي،في كتابه “جماليات المكان،حيّزًا وفضاءً، يستكملُ مغامرته التي باشرها مع “الأنثى..نواةُ الفن الأولى”!
د. مصطفى الحلوة
(رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)
في مستهلّ المراجعة النقدية ، التي قدّمتُها ، منذ سنوات ست لباكورة أعمال د. علي العلي البحثية “الأنثى..نواةُ الفن الأولى” ، تحديدًا في 4 حزيران 2016 ، طرحتُ السؤال الآتي : “هل قَدَرُ الفنان التشكيلي أن يُديمَ البقاء في شرنقة مرسمه ، يجيئنا بلوحةٍ تلو لوحة ، نصفّق له حينًا ، ونُقلِّبُ الشفاه حينًا آخر ، ولتبقى معزوفة التقييم مُترجّحةً على إيقاع إعجاب ، وعلى إيقاع إنكار، إلى أن يجفَّ حبرُ الريشة بين يديه ؟ ” . وأضفت ، لعلَّه السؤال ، الذي خامر علي العلي وأرّقه ، إلى حدِّ القلق المعرفي الوجودي ، مما دفعه إلى التفلُّت من أسار المرسم ، بعد أن أمضى “محكومِيَّته” – إذا جاز التعبير – وقد امتدّت هذه ” المحكوميّة” لسنوات عديدة ، أنجز إبَّانها عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الرائعة والمتفرِّدة .
هكذا كان لعلي أن يُباشر مغامرة ” سندباديَّة” ، طاعنةً في المسافات والزمن . لقد راح يمخرُ بسفنِهِ عباب أوقيانوس الفنّ ، فيتعرّف أسراره المغلقة، ويدخل إلى مغاور ألغازه “العلاء دينية ” !
فمع “الأنثى .. نواةُ الفن الأولى ” ، وهو مشروعه البحثي لحيازة الدكتوراه، كان الفصل الأول من تلك المغامرة الشاقة والشائقة في آن . وفي. فصل ثانٍ ، بعد إعداد عُدَّتِهِ المعرفية ، ولم تكن ثمة هدنة مُحارب ، ها هو اليوم يستكمل مغامرته ، فيأتينا بهذا المؤلَّف ” جماليّات المكان ، حيِّزًا وفضاءً / رؤى ومفاهيم في التشكيل الفني ” .
في مراجعتي النقدية ، آنفةِ الذِكر ، قلتُ في مؤلَّفِهِ “الأنثى..نواةُ الفن الأولى ” ، إنه كتابٌ مرجِعٌ في بابه ، يتَّسِمُ بالابتكار والجِدَّة ، مما يُؤهِّلُهُ ليكون في قِمّة الأعمال البحثية المعتبرة . واليومَ أستعيدُ ما كنتُ قد قُلتُه ، وأسقِطُهُ بحرفيّته على المؤلَّف ، الذي ننتدي حولَه ، في ظلال هذا الصرح الجامعي الزاهر !
ولعلي ، عبر هذا التقييم ، قديمِهِ وجديدِه ، أتقاطعُ مع الباحثة المُجِدَّة والمرموقة د. إلهام كلاّب ، التي لفتت ، في تقديمها هذا الكتاب ، إلى الإصالة، التي يتميّزُ بها باحثُنا ، فرأت أن عليًّا “يجترحُ دروبه الفنية والفكرية ، مُجانبًا الدروب المطروقة والمسارات التقليدية المتكرّرة ، بحثًا عن نافذةٍ ، لا تزالُ مُغلقةً في خفايا الإبداعات الفنيّة ، وعن باب غفلت عنه أيدي مؤرّخي الفنون ” (راجع الكتاب ص 7 ). وفي توصيفها الكتاب ، رأت إليه منجمًا لمن “يتوقُ إلى معرفة ، بل هو محفّزٌ لاختراق الجدار التقليدي ، في مقاربة تاريخ الفنون العربية ، الحافل والغني ” . (راجع الكتاب ، ص 8 ) .
بل لقد ذهبت بعيدًا ، إذ رأت أن الباحث تصدّى لموضوع ، لم تألفه بعدُ الدراسات الفنيّة ، في العالم العربي ، وتفتقده حتى اليوم مكتبات معاهد الفنون ” (راجع الكتاب ص 9 ) .
هذه الشهادة ، من لدُن صاحبة اختصاص في علوم الفن وفلسفتِهِ ، تجدُ صُدقيّتها في منطوق الآية القرآنية الكريمة : ” وشهِدَ شاهدٌ من أهلها ” ! (سورة يوسف / 26 ).

في الكتاب / مضامينَ ومحطاّتٍ ورسائل!
على مدى 176 صفحة ، من القطع الصغير ، حفل الكتاب بتقديم مكثّفٍ وراءٍ للباحثة د. إلهام كلاّب (ص: 7-9) ، يلي ذلك مقدَّمة الكاتب (ص: 11 – 15 ) ، انطلق عبرها من ثابتة ، فحواها أن أي ظاهرة تاريخية ، لا يمكن تصوُّرُها ، خارج حدود دعائم ثلاث : الإنسان ، والمكان والزمان . بل إن أيّ ظاهرة ، بمعزلٍ عن طبيعتها ، ترتبط بالإنسان ، ولا يمكن تصوُّر أيّ فعل تاريخي في فراغ ، بعيدًا من فضاء أو مكان .
بهذه الثابتة ، كان باحثنا يُمهّدُ السبيل للدخول إلى عوالم بحثه ومتاهاته (راجع ، ص 12 ) . وفي تصويب على الهدف المركزي للبحث ، فهو يتمثَّلُ في تعميق الوعي التشكيلي بالمكان ، بما هو حيِّزٌ ، وبما هو فضاءٌ ، وتبايناتهما ، وإلى أيّ مدى ينعكس على البناء الثقافي والاجتماعي والفني (راجع، ص 13 ) .
من خلال هذا المنحى التنظيري ، كان الباحث علي العلي يتطلَّعُ إلى التوقّف عند الحضور التسجيلي للفنان ، الذي لا يكون إلاّ في المكان ، حيِّزًا أو فضاءً ، مهما حاول أن ينأى بنفسِهِ عنهما (راجع ، ص 13 ) .
وبهدف الترجمة العملانية للمسألة ، فإن هذا البحث لا بُدَّ أن يُطِلَّ على تجارب بعض التشكيليين اللبنانيين المعاصرين ، من خلال دراسة وقوعات المكان في أعمالهم (راجع ، ص 13 ) .
وإذْ توزّع البحث على قسمين ، فقد اتخذ القسم الأول ، كعنوان رئيسي : “المكان والعبارات الرديفة” ، وليضمّ عنوانين فرعيين (sous-titre) ، أولهما: “بعض الشقيقات” ، وهي (الامتداد ، المجال ، البيئة ، المحل ، الموضع ، الخلاء ، الفُسحة ) . وعن ثاني العنوانين الفرعيين ، فقد جاء بعنوان : “الثلاثي الإشكالي: الحيِّز ، المكان ، الفضاء ” .
أما القسم الثاني ، فقد اندرج تحت العنوان المركزي الآتي : “المكان ، حيِّزًا وفضاءً في التشكيل الفني ، ” ولترد تحته ثلاثة عناوين فرعِيّة ، وهي: الفضاء التصويري ، الفضاء التشكيلي ، كيانات ووقوعات .
“عبر نظرة فاحصة إلى قِسمي الكتاب ، يتبيّن أن القسم الأول ، حالَ الاستفاضة فيه ، يصلح أن يكون كتابًا مستقلاًّ قائمًا بذاتِه ، نظرًا للسِمة التنظيرية المعمّقة التي يتّسِمُ بها . علمًا أن الباحث جعل من هذا القسم الأرضية التي انبنت عليها عمارة القسم الثاني ، الذي يُجسّدُ الجانب العملاني التطبيقي للبحث .

في البُعد المنهجي للبحث / تحديدًا للمفاهيم وتوسُّلاً للمنهج الملائم
لعلّ ما يلفتُ النظر ، في القسم الأول من الكتاب ، الانطلاق من تحديد المفاهيم والمصطلحات ، وهي مسألةٌ لا يُعيرها كثيرون من الباحثين الاهتمام الكافي ، مما يشكّل ثغرة منهجية ، بل عيبًا منهجيًا ، لا يمكن التسامح معه.
ولاغرو ، فإن تحديد المصطلحات والمفاهيم هو أهم الركائز التي تدعم محتوى أي بحث ، ذي سِمة علمية . علمًا أن تعريف المصطلح ، يقومُ على تبيان تشكُّلِهِ وبنيتِهِ ، وتحديد وظيفتِهِ ، وسرد أنواعه ، في حين أن تعريف المفهوم يقتضي ذكر الخصائص ومراحل التشكُّل وتطوّره وتياراته ، وإلى مسائل أخرى . وبما يخصُّ المفاهيم ، فثمّة مفهومٌ عام ، ومفهوم إجرائي يرتبط بزمان ومكان محدّدين . فقد يختلف المفهوم ، من مجتمع لآخر ، ومن زمن لزمن ، لاختلاف الظروف وعوامل شتّى . وهذا يسِمُ المفاهيم ، وكذا المصطلحات ، ببُعد صيروري !
انطلاقًا من وعي علي العلي لهذه المسألة – أي تحديد المصطلحات والمفاهيم – فقد استهلّ القسم الأول ، كما أشرنا آنفًا ، بمطالعة وافية تحت عنوان “بعض الشقيقات ” ، متوقّفًا عند التعابير والمصطلحات المقاربة لمفردة المكان ، وهي ، بحسبِهِ ، مُتعدّدة وكثيرة . وقد لفتنا استخدامُهُ تعبير الشقيقات وليس الأخوات ! فهل تقصَّدَ ذلك ، وهو يعلم الفارق بين مُفردتَي الأخت والشقيقة (الأخت هي ما يجمعك وإيّاها صُلبٌ أو بطنٌ ، في حين أن الشقيقة هي من يجمعك وإياها نفسُ الأب ونفسُ الأم ) !
في هذا المجال ، راح باحثنا إلى جلاء بل استجلاء معاني العبارات المقارِبة للمكان ، من مثل (الامتداد ، المجال ، البيئة ، المحل ، الموضع ، الخلاء الفُسحة )، خالعًا على كل منها التوصيف الذي يُلائمه ، بل ذهب إلى أن العبارات المرادفة للمكان ” تحيا كل منها بصفاتِهِ وخصائصه : مكان الامتداد بتناهيه ، المجال بانتظامه ، البيئة والتزامها الإنسان ، والمحل والموضع بحجمهما ، والخلاء بإشكالاته ، الفسحة واتساعها ، والحيِّز بمشاكستِهِ ، وجميعها أمكنة متصنعة وذات فعل وتأثير ، يحتضنها الفضاء الشمولي ، الذي هو بدوره إشكالي ” (راجع : ص 80 ) .
تدليلاً على النزعة المتأصِّلة ، لدى باحثنا ، في تحديد المفاهيم ، ثمّة مثلٌ صارخٌ في موضع آخر من الكتاب . ففي استجلاء مفهوم المنظور (perspective) ومفهوم “التمثُّل” (représentation) ، في تاريخ فن الرسم ، وانعكاسات ذلك على تغيير صُور المكان والرؤية الفنية ، كان للباحث بعض تحفُّظ عن عبارة ” التمثُّل” ، التي وجدها ترجمةً مُباشرة للعبارة الأجنبية ، إذْ رأى أن عبارة “الحضور ” قد تكون أكثر أمانةً للحالة ، وتوصيفًا أدقّ للدور المنوط بالمكان ، ضمن فضاء اللوحة ، ورأى أن ثمة ما يُبرِّر ذلك (راجع، ص 132) .
في هذا السبيل ، وتعليلاً ، راح إلى مُعجم “المنهل” ، كما توقّف عند إحدى المفردات الفرنسية (présentationisme) ليجدَ أن ترجمتها ، مُعجميًّا، هي “الحضوريَّة” ، وهي “المذهب الفلسفي ، الذي يؤكّد أن المعاني الخارجية حاضرة في الذهن . ومما يُشار إليه ، في هذا المجال ، أن باحثنا يُشدِّد على البُعد أو الدور الوظيفي لأي مصطلح أو مفهوم .
.. وبما يخص المنهج المتّبع في الكتاب ، فقد توسَّل الباحث منهجًا تكامليًّا ، قوامُهُ المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ، إضافةً إلى المنهج المقارن . وهذا ما انتهجه في كتابه “الأنثى.. نواة الفن الأولى “. وتعليلاً لاعتماده المنهج التكاملي ، يُشير الباحث ، في مقدمة الكتاب ، إلى أن هذا المنهج “يُوفِّر القراءات النقدية الدقيقة ، بوجوهها المختلفة ، للآثار الفنيَّة والمدوّنات والأعمال والنصوص” (راجع مقدمة الكاتب ، ص 14 ) .
وإذْ أفاد علي العلي من المناهج الثلاثة ، التي ذكرنا ، فقد كان ، كما “الأركيولوجي” ، يعمدُ إلى التنقيب في عمق أطروحاتِهِ ، ليصل إلى أماكن قصِيَّة، لا تخطرُ على البال . ولم يكن ثمة استطراد ، كما قد يُخيَّل للبعض ، ممن لا يُغادرون القشور إلى اللُباب !
لقد آثر علي العلي سلوك الدروب المعرفية الوعرة ، المحفوفة بالمخاطر . ففي مرجعه السابق “الأنثى.. نواةُ الفن الأولى ” ، ولج متاهات الميتولوجيا ، وخاض في رمال الفلسفة المتحرِّكة ، وعلوم الأديان ، وليعرِّج على محطات الانتروبولوجيا . وها هو في هذا الكتاب ، يترسَّم الدروب عينها . بل راح ، في مقاربتِهِ أطروحة المكان، إلى مجموعةٍ من علماء الرياضيات المشتهرين من أمثال: عالم الرياضيات الألماني Johan Carl Gauss (1777 -1855) ، وعالم الرياضيات الألماني أيضًا Riemann (1826 – 1866 ) ، وكذلك عالم الرياضيات الألماني “هلمهولتز” (1821 -1894) ، وعالم الرياضيات الروسي “لوبا تشيفسكي (1792 – 1856) . ولم يكفِهِ ذلك ، بل راح إلى علم النفس ، وإلى الأدب ، ليستزيد في هذا المجال .
وفي استنطاقه الفلاسفة ، حول أطروحة المكان ، فقد راح بداءةً إلى أفلاطون ، الذي عدّ المكان ” حاويًا وقابلاً للشيء ” ، ثم إلى أرسطو ، فإلى فلاسفة عرب ، الشيخ الرئيس ابن سينا وابن رشد ، وسواهما ، وصولاً إلى فلاسفة الغرب المعاصرين .
ومما يشي بالنزوع الفلسفي ، لدى باحثنا ، ما نراه بجلاء في خاتمة الكتاب ( ص 166 ) ، طرحُهُ عددًا من الأسئلة ، ذات طابع فلسفي ، وهو يتكلم على حميمية المكان ، التي تُفضي إلى أنسنتِهِ . وقد كانت هذه الأسئلة : هل يُولدُ المكان؟ ينمو؟ يشبُّ ، يشيخ ، ثم يموتُ ويتحلّل ؟ وهل الأمكنةُ أجيالٌ تُسلِّمُ الراية لمن يليها ؟ وهل للمكان سِماتٌ شخصية ، تجعلُهُ متميِّزًا ، أو على الأقل مختلفًا عن غيره من الأماكن ؟
..هذه الأسئلة ، بقدر ما تُعبِّر عن قلقٍ معرفي ، لدى باحثنا ، فهي تندرج تحت فلسفة العمران ، وبذا تكتسب بُعدًا صيروريًّا خلدونيًّا .
في هذا المقام ، إذْ نستعيد قولاً لبول فاليري : “وُلِدَ علم الجمال ذات يوم من ملاحظة فيلسوف وشهيته ” ، فإننا من مقلب معاكس ، نرى أن تعمُّق علم الفن والجمال جعل علي العلي يحطُّ الرحال عند أبواب الفلسفة !

في وقوعات الأمكنة / التشكيل الفني في لبنان
في الجزء الذي خصَّصه الباحث لوقوعات الأمكنة في التشكيل الفني لبنانيًا، وهو بمنزلة “تمرين تطبيقي” ، إذا صحَّ القول ( ص ص : 139 – 163 ) ، يستعرض تعاطي عدد من الفنانين التشكيليين (المدينة والحي والقرية وبيوت العبادة والبيت والمؤنسن ومحترف الفنان ) . وقد خَلَص إلى أن المكان يشغل مساحة واسعة في أعمال الفنانين التشكيليين اللبنانيين ، أسوةً بمعظم أقرانهم العرب . وقد حضر المكان لديهم بمختلف الثقافات والأنماط . وفي عِداد الفنانين الرسامين ، يستحضر الفنانين البيارتة ، عاشقي بيروت : مصطفى فروخ وعمر الأنسي وجنا طرابلسي ، كما رسّام الحي البيروتي حسن جوني (زقاق البلاط) . كما استحضر الرعيل الثاني من رسّامي بيروت الحرب وما بعد الحرب ، الذين طغت على أعمالهم مسحةٌ من التشاؤم ، بخلاف الجيل الأول “البيروتي ” .. وإلى رسّامي المعابد ، من كنائس وجوامع (أمين الباشا وحليم جرداق ) وسواهما كثيرون ، وصولاً إلى عُشّاق مدنهم من المعاصرين (محمد عزيزة ، ورفيق شرف ، ومصطفى حسن ومحمد قدّورة إلخ ) .
حبّذا لو توسَّع علي العلي ، في هذا الباب ، فقد بدا متعجِّلاً ، ولم يُورِدْ بعض اللوحات العائدة لكثيرٍ من الفنانين الذين أتى على ذكرهم لِمامًا . وثمة فنانون آخرون طرابلسيون وشماليون ، لم يتسع لهم هذا الباب !

خاتمة : “ومن يتهيّب صعود الجبال / يعِشْ أبدَ الدهرِ بين الحُفر!
كثيرون من الناس تهيّبوا صعود الجبال ، فبقوا أبدَ الدهر بين الحُفر ! وقليلٌ هُم الذين امتلكوا الرؤيا والإرادة والعزم ، فراحوا تصعيدًا إلى القِمم!.. والصديق علي العلي ، كما عايشته ، وكما واكبتُهُ في ثلاثة من مؤلفاتِهِ (هذا الكتاب الذي بين أيدينا / و”الأنثى .. نواةُ الفن الأولى ” / و ” سلَّ زبالة متبصِّر ” الذي انتدينا حوله في هذا الصرح ،غداة افتتاحِهِ بأشهر قليلة ) هو من أولئك الذين لم يرتضوا من القِمم بديلاً .
سِمةُ علي التميُّز ، في كل ما يُقدِمُ عليه وما يفعل ، ولا سيما في إطار تخصُّصِهِ ، وهو ذو صرامة ، شكلاً ومضمونًا . لقد اختار السبيل الصعب في مؤلَّفِهِ هذا ، الذي وإن بدا صغيرًا حجمًا ، ففعلُهُ جدُّ عظيم ، وفيه فائدة للمشتغلين بالفنون التشكيلية ، لاسيما الطلبة .
هذا الكتاب ، الذي جاء ليَسُدَّ بعضَ فراغ في مكتبنا العربية ، جديرٌ بأن يٌقتنى ويتمّ التبصُّر فيه !
***
*مداخلة ألقيت في ندوة، في كلية الفنون والعمارة(الفرع الثالث- طرابلس)- الجامعة اللبنانية، الثلاثاء(6/ 12/ 2022)، حول كتاب د.علي العلي، عنوانه:”جماليات المكان، حيّزًا وفضاءً/رؤى ومفاهيم في التشكيل الفني”، من منشورات “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية”، لبنان، 2022.