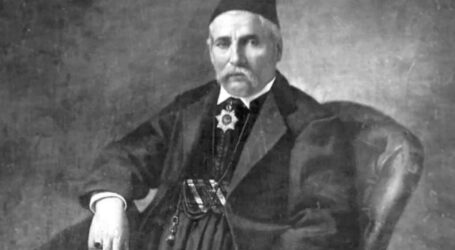عن المرجعيّة الثقافيّة لحقوق الإنسان
د. عبد الحسين شعبان*
إذا كانت فكرة حقوق الإنسان قد تبلورت على خلفيّة إسهام الحضارات والثقافات المُختلفة، فإنّ إبراز إسهام العرب والمُسلمين فيها مهمّة جدّاً لعددٍ من الأسباب: أوّلها، نظراً إلى راهنيّة المسألة من الناحيتَيْن النظريّة والعمليّة، وخصوصاً لجهة احتدام الجدل والسجال بشأنها، ودَور كلّ ثقافة في رفْدها؛ وثانيها، لأنّ العالَم العربيّ والإسلاميّ يمور بتناقضاتٍ تعتمل في داخله مسبِّبةً صراعاتٍ جديدة داخليّة ومَخاطر خارجيّة تُهدِّد وجود بعض بلدانه؛ وهذه تندرج بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالمَوقف من حقوق الإنسان.
أمّا ثالثها، فهو استشراء تيّاراتٍ متعصّبة دينيّاً وطائفيّاً وإثنيّاً في بلداننا العربيّة والإسلاميّة من دون أن ننسى ظهورها في الغرب. والتعصُّب يقود إلى التطرُّف، إذا ما انتقلت الفكرة من التنظير إلى التنفيذ، وإذا ما صار التنفيذ سلوكاً سيؤدّي إلى العنف. وإذا ضرب هذا الأخير عشوائيّاً، فإنّه سيُصبح إرهاباً. وحين يكون عابراً للحدود يتحوّل إلى إرهابٍ دوليّ بإضعافِ ثقة الدولة بنفسها وثقة المجتمع والفرد في الدولة، وخصوصاً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة أو جرائم الإبادة الجماعيّة أو جرائم الحرب، فضلاً عن جريمة العدوان.
ورابعها، حالة الإحباط والقنوط التي أعقبت حركات الاحتجاج الشعبيّ في مطلع العام 2011 وما تبعها من صعود تيّارٍ شعبوي بالانتخابات أو بغيرها، فضلاً عن مآلات ما وصلت إليه حالةُ عددٍ من البلدان التي جرت فيها محاولاتُ التغيير من تفتّتٍ وفوضى واحتراباتٍ داخليّة وتدخّلات خارجيّة.
وخامسها، ما له علاقة بالصراع الدوليّ أيضاً، والمقصود بذلك ما بعد انتهاء الصراع الأيديولوجي بصيغته السابقة والحرب الباردة بين المُعسكرَيْن الرأسماليّ والاشتراكيّ (1946 – 1989)، والذي أَخَذَ يتمظهر بتجلّياتٍ وأشكالٍ جديدة من الصراع، وخصوصاً من جانب الغرب، باستهدافه الإسلام كدينٍ أحياناً، وذلك وجه آخر لما تبنّته القوى الإرهابيّة، ولاسيّما تنظيمات القاعدة التي قسّمت العالَم إلى فسطاطَيْن لا يُمكن التعايش بينهما، ناهيك بوليدها تنظيم داعش وأخواته. وبدا الأمر وكأنّه نَوعٌ من “المصارعة على الطريقة الرومانيّة“.
الإسلاموفوبيا والإسلامولوجيا والويستفوبيا
ثمّة ظواهر جديدة أخذت تَنتشر في الساحة الدوليّة عشيّة انحلال الكتلة الاشتراكيّة وسقوط جدار برلين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 مولّدةً صراعات جديدة اتَّخذت مَساراً عنفيّاً أحياناً، في محاولةٍ لإلغاء الآخر وإقصائه أو تهميشه على أقلّ تقدير، لأنّها صراعاتٌ تناحريّة هدفها فرض الاستتباع والهَيْمَنة والتسيُّد في العلاقات الدوليّة.
في الإسلاموفوبيا “الرّهاب من الإسلام” اتّهامٌ صريح للعالَمَيْن العربيّ والإسلاميّ، باعتبارهما منبعاً للإرهاب ومصدراً للشرور واستُخدمت هذه الفزّاعة بهدف تطويعِ شعوبٍ كاملة وإخضاعها أو ترويضها لنَزْعِ آخر إمكانيّة لمُقاومَتِها من اختيار طريق التنمية المستقلّة.
ويقابلها الإسلامولوجيا، أي استخدام التعاليم الإسلاميّة بالضدّ منها في “رهاب من الغرب” بشكلٍ أعمى، وهو ما نُطلق عليه “الويستفوبيا“. فكلّ ما في الغرب، بحسب وجهة النَّظر هذه، “دليل عنصريّة واستعلاء واستعمار وهَيْمَنة”، من دون النّظر إلى ما أنجزه، وخصوصاً بكونه مستودعاً للعِلم والتكنولوجيا والعمران والأدب والفنّ والجمال.
الغرب غربان، الغرب السياسيّ الذي هدفه إملاء إرادته وتأمين مصالحه، بغضّ النّظر عن الآخر؛ والغرب الثقافيّ الذي وقف مع العديد من قضايانا العادلة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة.
أين هي الإسهامة العربيّة – الإسلاميّة؟
تُفاخِر جميع الحضارات بإسهامتها الثقافيّة في مُقارَبة الفكرة الحقوقيّة، فالصينيّون يلهجون اليوم بما جاء به كونفوشيوس ولاوتسه من أفكارٍ تصبّ في احترام حقوق الإنسان. أمّا الهنود فتعاليم بوذا هي رافدهم إلى كونيّة الحقوق. والحضارة اليونانيّة تَعتبر رافدها إلى حقوق الإنسان نابعاً من الفكر الفلسفيّ اليونانيّ. والإنكليز يباهون بالماغناكارتا “العهد العظيم” الذي تمّ إقراره العام 1215. والأميركيّون يعتبرون دستورهم 1776 هو أوّل دستور في العالَم يأتي على الفكرة الكونيّة المُعاصِرة، في حين أنّ فرنسا تَعتبر مبادئ الثورة الفرنسيّة 1789 والتي أساسها: الحريّة، الإخاء، والمُساواة هي المنطلق الرئيس، وخصوصاً وثيقة “حقوق الإنسان والمواطن”. والروس يتمسّكون بأنّهم كانوا وراء قرار حقّ تقرير المصير بعد ثورتهم الاشتراكيّة في العام 1917.
ولكن أين إسهام الثقافة العربيّة والإسلاميّة؟ وقبل ذلك أين إسهام حضارة بلاد الرافدَين ووادي النيل وبلاد الشامّ في مقاربة الفكرة الحقوقيّة، وإذا كانت شريعة حمورابي 1792 – 1750 ق.م، هي من أشهر وأوّل القوانين في الكون، فلماذا لا نأتي عليها؟
حِلف الفضول
في اختصار، ومن دون العودة إلى التاريخ البعيد، يُمكننا التوقُّف عند حلف الفضول، باعتباره أوّل رابطة لحقوق الإنسان في العالَم، وقد أُبرم في القرن السادس الميلادي (590 – 595ﻫ)، حين اجتمعَ فُضلاء مكّة في دار عبد الله بن جدعان وتعاهدوا على أن “لا يدعوا ببطن مكّة مظلوماً من أهلها أو مَن دَخلها من سائر الناس، إلّا كانوا معه على ظالمه حتّى تُردّ مظلمته”.
وبعد انتصار الدعوة الإسلاميّة، ألغى الرسول محمّد (ص) جميع أحلاف الجاهليّة، إلّا أنّه أبقى على حِلف الفضول. وكان القرآن الكريم قد جاء على أكثر من 100 آية تؤكّد حريّة التديُّن، وأقرّت صحيفة المدينة “دستور المدينة” الذي وضعه النبي محمّد (ص) لمجتمعٍ تعدّدي يتكوَّن من يهود ونصارى ووثنيّين ومُسلمين، وهو بمثابة عقْد اجتماعي جديد يُنظِّم العلاقة بين القبائل على أساس وحدة سكّان يثرب (المدينة المنورّة)، ولاسيّما المُساواة بينهم في الحقوق والكرامة الإنسانيّة. كما يُعتبر صلح الحديبيّة اعترافاً من النبي محمّد (ص) بالاتّفاق لمدّة 10 سنوات مع مُشرِكي قريش في العام السادس للهجرة.
وتشهد العهدة العمريّة التي أبرمها الخليفة عمر بن الخطّاب (رض) مع البطريرك الأورشليمي صفرونيّوس في العام 15ﻫ على روح التسامُح إزاء الأديان الأخرى وحقّ غير المُسلمين في حريّة مُمارَسة طقوسهم التعبّديّة وشعائرهم الدينيّة والحفاظ على أرواحهم ومُمتلكاتهم، بما يعني باللّغة المعاصرة: قبول الآخر والاعتراف بحقّ الاختلاف، وهو ما سار عليه المُسلمون لدى فتْح القسطنطينيّة في 22 كانون الثاني/ يناير1517.
تقصيرٌ ذاتيّ
أستطيع القول إنّ ثمّة قصوراً من جانب النّخب الفكريّة والثقافيّة العربيّة والإسلاميّة، فالبعض يُناوئ الفكرة الكونيّة لحقوق الإنسان أو لا يريد الاعتراف بها، لأنّه يعتبر حقوق الإنسان “بدعةً غربيّة” و”اختراعاً مشبوهاً” هدفه النَّيْل من قيَم الأمّة والتأثير عليها عبر قيَمٍ غربيّة لا علاقة لها بنا.
والأمر لا يتعلّق بموقف العديد من الحكومات فحسب، بل إنّ مُعارضيها أحياناً، من التيّارات الفكريّة المختلفة، الإسلاميّة والقوميّة العربيّة واليساريّة الاشتراكيّة، يتّخذ الموقف ذاته، في حين أنّ ثمّة تيّاراً تغريبيّاً لا يقلّ خطلاً عن التيّارات الإنكارّيّة الرافضة، وهو الذي يريد القطيعة مع التراث، بحجّة أنّه عائق أمام الانخراط في منظومة الحقوق الكونيّة، وبحسب وجهة نظره، فإنّه لا يُمكننا ولوج عالَم الحداثة والحقوق، إلّا بعد فكّ الارتباط بالماضي وبالدّين تحديداً.
وإذا كان هذا موقف القوى الداخليّة، فموقف القوى الخارجيّة، هو الآخر يريد النَّيل من إسهام العرب والمسلمين في رفْدِ المنظومة الكونيّة لحقوق الإنسان، فالبعض ينكر علينا مساهمتنا تاريخيّاً انطلاقاً من نظرة مسبّقة مسقطة على الحاضر، باعتبار الدّين الإسلاميّ يحضّ على العنف والحرب، وليس له من قريب أو بعيد مثل هذا التوجّه الخاصّ باحترام حقوق الإنسان، ومثل هذا الرأي بلا أدنى شكّ، لا يصدر عن خطأ فحسب، بل عن جهل، إن لم يكُن ثمّة إغراض. الهدف منه النَّيل من الحضارة العربيّة – الإسلاميّة وإسهاماتها في الفكرة الكونيّة الإنسانيّة، وذلك ناجمٌ عن قصديّة تخصّ الحاضر أيضاً.
الخصوصيّة والعالَميّة: الوَصل والفَصل
تعمّقت فكرة حقوق الإنسان المُعاصِرة تواصلاً مع تطوّر الفكر البشريّ، والإسلام جزء من هذا التطوّر المفاهيمي بدلالاته الإنسانيّة، وقد بشَّر بها في وقتٍ كانت أوروبا تغطّ بظلامٍ دامس في عهد الإقطاع والفترة المُظلمة التي دامت 1000 عام، ابتداءً من العام 400 إلى العام 1400.
فبخصوص الحريّة والكرامة، وَرَدَ في الإعلان العالَمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يُعامِل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.وحول المساواة، نصَّ الإعلان “كلّ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحقّ في التمتُّع بحمايةٍ متكافئة دونما تفرقة، كما لهم الحقّ جميعاً في حمايةٍ مُتساوية ضدّ أيّ تمييز يخلّ بهذا الإعلان وضدّ أيّ تحريضٍ على تمييزٍ كهذا”.
يُقابل ذلك، وبفارقِ 14 قرناً، ومن خلال قراءةٍ ارتجاعيّة، ما وَرَدَ في القرآن الكريم، حيث نصَّ على “يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليم خبير” (سورة الحجرات – الآية 13)، أو كما جاء في (سورة الإسراء – الآية 70) “ولقد كرّمنا بني آدم…” وفي الحديث النبوي الشريف “لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلّا بالتقوى”؛ أو كما جاء في حديث نبويّ آخر “الناس متساوون كأسنان المشط”، أو كما قال الفاروق عمر بن الخطّاب، الخليفة الثاني “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً”.
وخاطَب الإمام علي عامله في مصر مالك بن الأشتر النخعي مشدّداً على مبدأ المساواة في الحقوق بقوله “ولا تكوننّ عليهم (أي على الناس) سبعاً ضارباً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إمّا أخّ لك في الدّين (أيّ مسلم مثلك) أو نظيرٌ لك في الخَلق (أي بشر مثلك).
ولذلك فإنّ الدساتير والقوانين والمواثيق الدوليّة، بما فيها الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، هي نتاج تفاعل واستكمال للفكر الإنساني وللتقدّم الذي حصل في ميدان حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وهكذا اكتسبت صفتها الكونيّة بعدم خضوعها لإيديولوجيّة معيّنة أو دينٍ محدّد أو ثقافة واحدة، وإنّما كانت مزيجاً كونيّاً، على الرّغم من محاولة توظيفها أحياناً من جانب القوى الكبرى والمتنفّذة في العلاقات الدوليّة لمصالحها الخاصّة.
العلاقة بين الكونيّة والخصوصيّة علاقة مركّبة، فالبعض يحاول التعكّز على الخصوصيّة القوميّة أو الثقافيّة بما فيها الدينيّة كذريعةٍ للتحفُّظ على المعايير العالَميّة، وما تفرضه من التزاماتٍ دوليّة بهذا الخصوص. في حين أنّ الخصوصيّة بقدر ما تحتاج إلى مُراعاةٍ واحترام وتقدير، إلّا أنّها لا ينبغي أن تسير في اتّجاهِ تقويضِ المعايير الكونيّة، بل ينبغي أن تتوجّه لدعمها ورفدها بما يعزّزها وليس ينتقص منها.
الشموليّة والانتقائيّة
ينبغي مُعاينة فكرة حقوق الإنسان على أساسٍ كلّي ومن دون تجزئة أو انتقاء، فهي مثل السبيكة الذهبيّة لا يُمكن اقتطاعُ جزءٍ منها أو إهماله أو تأجيله، وإن كان ثمّة أولويّات تفرضها الظروف والواقع، سواء في أوقات السِّلم أم الأزمات أم النِّزاعات أم الحروب.
ولكي تتحقّق التنمية المنشودة والمُستدامة، فلا بدّ من خلْقِ نَوعٍ من التوازن بين الحقوق الجماعيّة والحقوق الفرديّة، وبين الحقوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة؛ فحقّ العمل والتعليم والتطبيب والضمان الاجتماعي وتمكين الناس من التمتُّع بمنجزات الثقافة، لا يقلّ أهميّة عن القيمة السامية للحريّة وحقّ التعبير والتنظيم والاعتقاد والمُشارَكة والشراكة، والأساس في ذلك حقّ الحياة والعَيش بسلام ومن دون خوف وعدم التعرُّض للتعذيب، مثلما أنّ الحاجة ماسّة إلى قضاءٍ نزيه وعادل، وإلى انتخاباتٍ دوريّة حرّة يختار فيها المحكومون حكّامَهم ويستبدلونهم حين يقصّرون أو يخطئون. ولعلّ هذه جميعها وغيرها حقوق أصيلة مثل حقّ تقرير المصير.
وللأسف لا تتعاطى بعض التيّارات السياسيّة الإسلاميّة أو المدنيّة في مجتمعاتنا مع هذه الحقوق كسلّةٍ كاملة، بل تحاول الانتقاء منها، بما يدعم توجّهاتها وعلى نحوٍ فيه الكثير من ازدواجيّة المعايير، ولاسيّما الكيل بمكيالَيْن، مثلما تَستخدم القوى الغربيّة ذلك أيضاً تحت عناوين “الشرعة الدوليّة”، التي أصبحت شمّاعة للتدخّل الخارجيّ بما فيه العسكريّ.
في اختصار، لا بدّ من الانسجام مع متطلّبات العصر في إطار تفاعُلٍ حيويّ مع الثقافات الأخرى باحترام الخصوصيّات والهويّات الفرعيّة من دون التحلّل من الالتزامات الدوليّة، أي من دون تابعٍ ومتبوعٍ ومن دون استعلاءٍ وخضوع، بتجسيد الفكرة الكونيّة لحقوق الإنسان في الكرامة والحريّة والمساواة والعدالة والشراكة واعتبار الإنسان أخ الإنسان.
***
* مفكّر وأكاديمي من العراق
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق