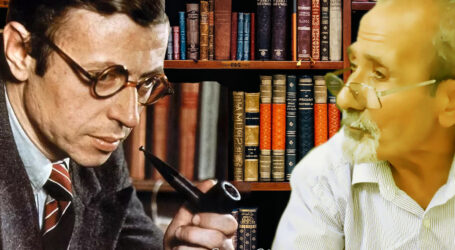شعريَّة المَسْكُوت عنه من السَّرد في نصِّ أغنية الأخوين رحباني
د. وجيه فانوس
“المسكوت عنه”، لغةً، هو ما لم يقل أو ما لم يشر إليهِ من قبل المتحدِث أو واضع النَّص. وواقع الحال، ثمَّة أمور كثيرة، أكانت من باب المقول أو من ضمن ما هو مكتوب، لا يُؤتى على أيِّ ذِكر أو حتَّى إشارة لها؛ وقد يكون السَّبب في هذا ناتج عن حالاتٍ لواضع النَّصِّ، هي ابنة سهو، أو عدم اهتمام، أو خوف، أو تشويق؛ وقد حفلت النصوص، على تعدد الحقب الزمنية وتنوع أصناف النصوص وموضوعاتهان بهذه السِّمة. وثمة ربط في الإثنولوجيا، وهي العلم الذي يهتم بمقارنة العلاقات الإنسانية المختلفة والمقارنة بينها،بين ما هو “مسكوت عنه”، من جهة، وما هو “بديهي”، من جهة أخرى. وقد بيَّنالعالم الاجتماعي الأميركي المعاصر هارولد جارفينكل (1917-2011)، ومن قبله عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم (1858-1917)، على أنه في أي موقف كان، وحتى في المواقف القانونيَّة التي ترد في ما يعرف بـ”العقد الملزم”، فإنَّ شروط الاتفاق تستند، ههنا،إلى ما تشكل نسبته حتَّى 90٪ من الافتراضات غير المعلنة التي يقوم عليها نص الاتفاق[1].ولتأكيد أهميَّة ما هو “مسكوت عنه”، في النص الأدبي، كما في النصوص الأخرى المختلفة، فإنَّ العالم الأنثروبولوجي الأميركي إدوارد ت. هول (1914-2009)، أوضح أن كثيراً مواقف من سوء الفهم بين الثقافات ينبع، أساساً، من إهمال مستقبِل هذه الثقافة أو تلك، للأنماط الثقافية الصامتة وغير المعلنةولكن المتباينة،في الثقافة التي يستقبلها، والتي اعتبرها كل مشارك أمراً مفروغاً منه[2].
أمَّا “المسكوت عنه”، في مفاهيم النقد الأدبي، فرؤية معاصرة في مجال استكشاف الفاعليَّة الأدبيَّة للنَّصِّ الأدبيِّ؛ تسعى إلى استكناه ما في النَّص لما يمكن أن يكون مسكوتاً عنه بسبب حيرة أو ارتباك في التعبير لدى واضع النَّصِّ، من جهة، أو هو، من جهة أخرى، تعمّثد من واضع النَّصِّ يفعُ فيه بمستقبِل النَّصِّ الأدبيِّ إلى إعمال لفكره أو خياله في أمرٍ ما يلمح إليه بالنَّصِّ ولكن من دون أيِّ تعبير مباشر عنه. ولعلَّ هذا التوجًّه لدى بعض أهل النقد الأدبي المعاصر، جاء مستلهماُ ما قال به سيغموند فرويد (1856-1939)، في مجالات ما يعرف في علم النَّفس بأنَّ ما يمكن أن ينظر إلى ظاهره على أنَّه هلوسات أو زلاَّت لسان أو تغييب، ليس في الواقع سوى فاعليَّة إفصاح مبطَّنة عن حقيقة هذه الهلوسات أو الزلاَّت أو حالة الصَّمت والتغييب[3].
“المسكوت عن”، من وجهة نظر بنائيَّة للفن، هو “الغائب” في العمل الفنيِّ، أيَّاً كان هذا العمل؛ بل هو ما يمكن النَّظر إليهِ على أنَّه الحاضرُ بإصرار بفاعليَّةِ غيابه. وتكمن فاعليَّة الغياب، ههنا، في وقوفها دعوة ملحاحاً للتفكُّر من قبل متلقيها في تبصُّرٍ أو تخيُّلٍ لوجودٍ ما لها. وإذا ما كان ناس القانون يسعون إلى تبصُّرِ هذا الغياب للمسكوت عنه، عبر ما يسمونه قراءة في روح القانون، أو سوى ذلك من مصطلحات قانونيَّة؛ فإنَّ فاعليَّة المسكوت عنه، في النَّصِّ الأدبي، هي قوَّةٌ تضجُّ بحيويَّة دعوة مستقبِل النَّصِّ إلى استكناهه لحقيقة وجود هذا المسكوت عنه؛ وهي، تالياً، فاعليَّة تحفيز واستنهاض لطاقات وقدرات تحقيق الشِّعريِّ عند هذا المستقبِل.
أنموذج “أنا وسهرانة”
أنا وسهرانة وحدي بالبيت
على السِّكيت ومتل الضجرانة
مشية قريبة طقِّت عالدَّرب
قلت يا قلب جايي حبيبي
قمت وضوَّيت زحت البرداية
تيشوفا الجايي وشعشعت البيت
رتَّبت المزهريِّة هييت قلوب السِّكَّر
حطَّيت الشَّال عليي
ولبست العقد الأحمر
ونطرت الباب تالباب يدق
والقلب يدق وما دق الباب
والمشية بِعْدِتْ بِعْدِتْ باللَّيل
محَّاها اللَّيل ِبِعْدِتْ وبِعْدِتْ
أنا سهرانة وطفَّيت الضَّو
وطلع الضَّو أنا وسهرانة
“الشِّعريُّ”، ههنا، في نصِّ ” أنا وسهراني”، وهو بالمحكيَّة في لبنان، فاعليَّةُ سردٍ روائيٍّ إخباريٍّ بامتياز. إنَّ النَّصُّ، في ظاهره، ليس سوى إخبار عن حدث معيَّنٍ؛ وراوي الخبرُ، هو من وقع عليهِ هذا الحدثُ. أما مكان الحدثِ، فغرفةٌ؛ وأمَّا زمانه فَلَيْلٌ يستمرُّ حتَّى طلوع الفجر.
وقائعُ الحدث سَهَرٌ ووقْعُ أقدامٍ وتَحَضُّرٌ لاستقبالٍ مُحَبَّبٍ من قِبَلِ راوي الحدثِ، الذي تقع عليه الأحداث، وانتظارٌ ومن ثَمَّ ابتعادٌ لِوَقْعِ تلكَ الأقدامِ فاستمرارٌ للسَّهرِ بعد إطفاءٍ للضَّوء حتَّى انبلاج الفجر. عقدة الرواية يمكن أن تُعْتَقدُ في موقع حركة وقع الأقدام، وصولاً وإياباً، وأمَّا ذروة الحكي فيمكن أن تُظَنَّ في استمرار السَّهرِ حتَّى موعدِ الفجر.
إنَّه مجردُ خبرٍ روائيٍّ، لا يفضحُ ظاهر الإخبار المباشر عنه، كما وضعه مُرْسِلُهُ، وهو هنا “الأخوان رحباني”، أيَّ موضوعٍ آخر، ولا يشي التَّعبير اللَّفظيّ فيه عن أيِّ أمرٍ آخر سوى حصول ما حدث. ومع هذا، فإنَّ تلقِّي النَّصَّ من قِبل المُرْسَلِ إليه يمكن أن يكون مصدر توليد لكثيرٍ من الحالات الشُّعوريَّة والانفعاليَّة التي يمكن أن تبرز، وفي هذه المرحلة وحدها ومن دون سواها، على سطح هذا السَّردِ الإخباريِّ الرِّوائيِّ. قد تتشكَّلُ، ههنا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حالٌ من الألم الحزين، نتيجة خيبة الانتظار؛ وقد يكون من ثَمَّ الإنفعالُ المتعاطف مع الصَّبر على غربةٍ ما وحالٍ صعبٍ من الوحدة الصَّامتة؛ كما قد يكون الغضبُ من هذا الذي يُنْتَظَرُ ولا يأتي؛ وسوى ذلك من الأحوال، التي قد لاتنتهي، طالما ثمَّة نصٌّ يَحْبَلُ بطاقات “الشِّعريِّ”، وثمَّة متلقٍّ قادرٍ على تفجير هذه الطَّاقات.
ثمَّة نماذج عديدة، أخرى، من نصوص أغاني “الأخوين رحباني”، يمكن أن تقف شاهداً على فاعليَّات لـ”الشِّعريِّ”، عبر ما يمكن وسمه بـ”المسكوت عنه من السَّرد”، منها نصُّ أغنية “ياستِّي الختيارة”، وهو بالمحكيَّة في لبنان؛ وإن لم يحمل قوَّة الشِّعريِّ في أٌنموذج ” أنا وسهرانة”؛ نظراً لما حواه، هذا الأخير، من تلميحات إيحائيَّة لبعض مجالات تفاعل المُتَلَقِّي:
بيتك يا ستي الختيارة بيذكِّرني ببيت ستِّي
تبقى ترندحلي اشعارها والدنيي عم بتشتِّي
يوق وفرشات وديوان عتق الباب وهالحيطان
دارِك مثل دارها يا ستِّي الختيارة
تبقى تقعِّدني وتحكيلي حكايات الجن الحلوة
وزبيب وجَوْز تخبِّيلي واعملا ركوة قهوة
ستِّي اليوم بعيدة وبشوِّحلا بإيدي
مشتاقة لاخبارها يا ستِّي الختيارة
يمكن عم تسقي جنينتها عتلال الشَّمس وتحكي
لصبيِّة غيري حكايتها وعم تِتذكَّرني وتبكي
ولمن حاكيتيني بْكيتِ وذكَّرتيني
بستِّي والدُّوَّارة يا ستِّي الختيارة
****
[1] – Harold Garfinkel, Ethnomethodology’s Program: Working Out Durkeim’s Aphorism, (Anne Warfield Rawls ed.), Rowman& Littlefield Publishers, INC, London, 2002, pp. 102-105.
[2]– Edward Twitchell Hall, Beyond Culture, USA, Anchor Books, 1989,
[3]– Philippe Julien – Jacques Lacan’s Return to Freud: The Real, the Symbolic, and the Imaginary, Translated from French by Devra Beck Simiu, New York University Press, New York & London, 1994, pp. 28-35