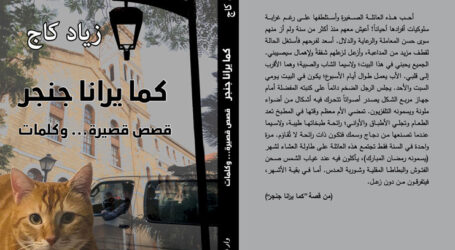رواية “المُتَمْثَلون” للمبدع إسماعيل بهاء الدين… سَفَرٌ في مجتمع التغريب والاغتراب
د. خالد بريش(*)
بعبارات مُتهكِّمة، وابتسامة مُرَّة حَبَا الله بها المصريين منذ أنْ وُلدوا فكانت بَصْمةَ كيانِهِم و”مَعَدِّيَّتَهم” نحو الأمل والغد ومَحْمَلَ نِسْيان مُعاناتهم، يفتح لنا الكاتب المبدع إسماعيل بهاء الدين سليمان أبواب روايته «المُتَمْثَلون»، التي يصفها بـ «فانْتازيا واقعية» والصادرة عن دار الأدْهم للنشر والتوزيع في القاهرة. أهْداها إلى «الذين يُضَحُّون بأعْمارهم وسعادتهم خوفًا علينا أن نَضِيع، أو نُضَيِّع البلاد بَعدَهم…»، مؤكدًا أن أحداثها «حقيقية، وقع بعضُها في الماضي، ويجري بعضُها حاليًا، وسيقع بعضُها مستقبلًا»، واعدًا القراء بأنه لن يُخْفي عنهم شيئًا. وغالبًا ما تكون هذه النوعية من البِدايات، تحضيرًا نفسيًا وذِهنيًا للقادم، الذي غالبًا ما يكون دَسِمًا وصادِمًا في آنٍ معًا…
يتداخل الخاص في العام مع السطور الأولى للرواية. فمَن يعرف المبدع إسماعيل بهاء الدين يدرك أنه دخل معه عالمَه الخاص، عندما فتح باب مكتبه الذي امتلأ بالكتب، وآلات التصوير القديمة، وعلب الأفلام السينمائية «بوبينات»، ليبدأ بذلك رحلة بين الماضي والحاضر، والواقع الذي فاتَنا كثيرٌ من تفاصيله المهمة، ونشعر أحيانًا أننا لا نعرفه مع أننا لاعبون على حلبته، وذلك من خلال عرضٍ لأحد الأفلام بحِرَفية، كمَدخلٍ لعالم روايته. فيُبعِدنا بذلك عن عوالمنا الخاصة، وعالم الرواية التقليدي. كل الوسائل مباحة، طالما أن هناك سفرًا في عالم الخيال الخصب، على خيول أصيلة قد افتقدناها واستعضنا عنها بالحمير، التي كثرت وتكاثرت بيننا.
ينتمي الكاتب إسماعيل بهاء الدين إلى جيلٍ أصبح اليوم غريبًا، وعالَمٍ تربَّعت مكارمُ الأخلاق، والمُثل، والتقاليد الجميلة، في تفاصيل تكوينه. جيلٌ لم يعرف كلمة «هاتْ»، لأنه تَرَبّى على العطاء بكل معانيه، فكان جزءًا لا يَتجزأ من كينونته، ووهَبَ أبناؤه الوطنَ أرواحَهم، وعمَّدوا ترابه بدمائهم في مدرسة بحر البقر، ومصنع أبو زعبل، ومدن القناة، وسيناء… جيلٌ عاصَرَ أحداث هزيمةٍ تحوَّلت إلى نصرٍ، عبر حرب استِنزاف، ورأى قائدَ جيشِه يموت مُسْتشهدًا على الجبهة، وليس في سريره، أو وراء مكتبه مُنْتحِرًا بعدة رصاصات. تقرأ حروفَه، فتغرق فيها، وفي عباب ذلك الماضي. بل تُحِسُّ وكأنك تسمع صوتَه الآسر المنبعث من ميكروفون إذاعة الشباب، في سبعينيَّات القرن الماضي وثمانينيَّاته. فيتداخل الزمن، والحروف، والصوت، في أقنوم سطور الرواية، التي جعلت من الإنسان المُغَرَّب في أوطاننا، مِحْوَر قضيتها، فكانت مُحاميه بجدارة.

يضع الكاتب مجتمعاتنا بين يديه، كأنها خارطة دقيقة التفاصيل، أو مُخَطط هندسي. فيشير إلى أدقِّ خباياها، بعنايةٍ ورَويَّة وإتقان، واصفًا إياها وَصْفَ الطبيب العارف بحالة مريضه، وبالأمراض التي يعاني منها. ولا يطيل على القارئ الانتظار، حتى يبدأ بطرح أسئلته التي تتكرر في صفحات الرواية، وعلى الألسن.
- ربيِّ ماذا يحدث في هذا العالم…؟!
- هذا شيء غير معقول، ولا مقبول…!
- إلى أين وصلنا… وماذا أصبحنا…؟
- أين ذهبت رحمةُ السماء…؟
تتألف الرواية من 68 مشهدًا، أو فصلًا مسرحيًا. تحمل فصولها حيوية، إنْ من حيث البناء أو من حيث اللغة، التي قام بوضع علامات الإعْراب على كثيرٍ من مُفْرداتِها، لكي لا يتفلَّت القارئُ منه، ويُشْغل نفسه بين الفاعل والمفعول، طالما أنَّ مُجتمعاتنا ليست بفاعلة، ومُنْفعلة، بل تائهة في عوالم المفعول به، والعبث الفجّ…! حيوية في المشاهد المُتتالية، وديناميكية في أسلوب السرد، الأقرب إلى عوالم كافكا، ولكن بنكهةٍ مصرية، وآفاق عربية، إن من حيث كثافة الرموز والترْميز، أو من حيث تداعيات النص على مرآة الفكر، وهو ما لم نأْلَفْهُ كثيرًا في رواياتنا العربية. وهذا يفرضُ على القارئ حالةً من التنبُّه المُستمر، لكي يستطيع قطفَ الثمار من بُسْتان النص. أقصد حتى يُفكّك رموز وطلاسم سُطوره ويَدخُل في حالةٍ من الوعي والتذكُّر ومُراجعة دفاتر الماضي ومُشاهدة صفحات أحداثه بهدوءٍ، بعيدًا عن العواطف وكل المُؤَثِّرات.
يكتب إسماعيل بهاء الدين لنا جميعًا، وبالنيابة عنّا جميعًا. فهو أسْكَنَنا في فواصل حروفه وطيَّاتها. وما على القارئ إلا أن يُحَلّق عاليًا، كنوارسِ البحر، لكي يرى ذلك بطريقة أفضل، فيضع النقاط في مكانها ويرسم تفاصيل الأحداث وهي تتوالى أمام ناظريه. أحداثٌ تمرُّ بنا، وتعاني منها كل أوطاننا، فنكاد نسمعُ ونحن نُطالع سَرديَّتَه أنين الفقراء، والعمّال، والفلاحين، والعاطلين عن العمل، وفحيح السَّاسة، والمُقاوِلين، وتُجَّار الأوطان، وقهْقهات المُثقَّفين المُتَحَذْلِقين. فيرسم بحروفه نبضات قلوبنا خُطوطًا مُتعرِّجة، عَمودية صاعدة هابطة، على وقع الأحداث المُثيرة للقيْءِ أحيانًا، مُحاولًا قدْرَ إمكانه، أنْ لا يقول إنَّه يتحدث عن وطنه، وحُبِّه لمصر. فتفاصيل الرواية وأحداثها، قد تَصْدُقُ على أيِّ بلد من بُلداننا. ولكنْ من يعرف تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر الستينيّات، وما تلاها، يستطيع الْتقاط الذبْذَبات التي تبثُّها سُطور الكاتب. وباستطاعته أيضًا استعادة شريط الذكريات، التي استَودَعَها عُلَبَ عقْله الصَّدِئَة.
يُناقِش الكاتب بهاء الدين بهدوء، موضوعَ الثورات الشابَّة، التي تحلم بالتغيير، ولا تضع خطةً لِما بعد التغيير، فتقع الطامَّةُ الكبرى، والسقوط في فِخاخ السَّاسة المُخَضْرمين، أبناءِ أجهزة الدولة العميقة. فعند وقوع الثورات «تَنْقَضُّ الديدان المتوحِّشة على التماثيل المُنْهارة وبقاياها، فتَطحَنُها، ثم تلتهِمُها بيُسْرٍ وسُهولة، كأنها قِطعٌ صغيرةٌ من السُّكَّر…» (ص 308)، لتعود التماثيل فجأة إلى سابقِ عهْدها مرة أخرى. ولهذا، يقومُ الكاتبُ بعملية دفعٍ في اتجاهِ وضعِ القواعد لِما بعد الثورة، لأن هذا هو الأهَمُّ، والأخطر في نظره، لكي لا يعودَ الساسةُ المُتوحِّشون من الشبابيك، ولا تغدو الثورة غولًا يأكل الثائرين. وحتى لا تكون الثورة أيضًا ناقصة، فتتحول إلى انتصار لأعداء الثورة، الذين طالما شكَّلوا كابوسًا للشعب.

يطالع القارئُ سُطورَ هذا العمل الإبْداعي بحُرْقة، وعيناه تتنقَّلان بين قضايا ومُعْضِلات مُجْتمعاتنا، التي ينخرُ السُّوسُ في جذورها، والكل يرى بأم عينيه ولكنه لا يريد أن يرى ولا أن يتحمَّل المسؤولية واضعًا رأسه في التراب كالنعامة، حتى غدونا شعوبًا دَيْدَنُها اللامبالاة تعيشُ على الصُّدْفة، وترى فيها حلًا لكل مشاكلها وبؤْسها. وتُطالع القارئَ في سطورِ وعِباراتِ هذا العمل إسقاطاتٌ واضحة وأصابعُ تَضغط على الجراح والدَّمامِل، بروحٍ حُرَّة ناقدة. وهل تتطوَّر الأوطان، وتتقدَّم المجتمعات دون النقد وفتح أبواب هذا النقد على مِصراعَيْها وإعطاء الفُرص للرأي الآخر للتعبير…؟
ولا ينسى الكاتب، في زحْمَةِ سُطوره، المُثقَّفين، الذين لا يَجِدون أحيانًا قُوتَ يومهم ويَبيعون أثمن ما يملكون لشراء الكتب، ثم يبيعونها قبل موتهم، حتى لا يحرقها الوَرَثة أو يرْمُوها في الزبالة…! ولا ينسى أيضًا أطفال الشوارع، الذين أصبحوا جزءًا من حياتنا، دون أن ترتعِش من أجل بؤْسهم شعرةٌ في جِسمنا. ويَنْكأ جُرحًا عندما يتناول هَدْمَ الواجهات الحضارية لبلادنا، وكل ما يُشكِّل عنصرًا من عناصر الثقافة والتاريخ، وذلك لبيع الأرض بثمنٍ بخسٍ، لا يُساوي ثمن مِرْحاض في المبنى الأساس…! حتى غَدَتْ مُدُنُنا عبارة عن خوازيق إسْمِنتية، لا طعمَ لها، ولا تاريخ. وكم هو مظلومٌ هذا التاريخ، الذي تتغيَّر كتبُه باستمرار، ويتم كتابتُها وِفْق مِزاج السَّاسة ومُدَّعي المَعْرفة. إننا جميعًا نستريح في عوالم سُطوره، بشجاراتنا الزوجية، وعيوبنا وعاداتنا السَّيئة، «إنّ أخطر ما في شعوبكم من عيوب، وهي كثيرة، هو أنكم لا تُجيدون فنَّ الإصْغاء، قدْرَ إجادتِكم فنَّ الثرْثرَة» (ص 282).
إنه سَرْدٌ بحَبْكةٍ مُتماسكة، وخلفية سينمائية تضع بين يديّ القارئ كل التفاصيل: الديكور، والإضاءة، والملابس، وكل شيء… حتى ليخال نفسه أمام شاشة عرض، يُشاهد ما يقرأ عَيَانًا. إنه أسلوب الكتابة الذي يعطي العين دورًا مهمًا، وهو نمطٌ يعتمد على الكتابة داخل الكتابة، والسرد المتعدِّد التفسيرات والوُجُهات، داخل النصِّ المُحْكَم المُزدحِم بمجموعة من القصص القصيرة جدًا التي من المُمْكن قراءَتُها مُنْفصلة، مثل: «نشرت الابنة على الفِراش مجموعةً من قِطع الملابس الداخلية، التي يحملُ بعضُها شعارًا صغيرَ الحجم، تَظهرُ فيه نجْمةُ داوود وقد ابتلعَتْ هلالًا وصليبًا، فأصبحا جزءًا من التكوين الأصلي للنجمة…» (ص 159).
يَترك المبدع إسماعيل بهاء الدين باب روايته مفتوحًا دون خاتِمةٍ كلاسيكية. وكأني به سوف يُطالِعنا قريبًا بـ «بوبينة» جديدة قد يكون نَسِيَها في أحدِ الأدراج كما ينسى البعضُ أهمَّ الوثائق التي تتعلق بمصير الوطن، وأرضه، وحدوده. فيتابع عندها عُروضَهُ، ويُحدِّثنا عن الدِّيدان التي انتشرت في طول البلاد وعَرْضِها وعن جيوش المُثقَّفين، والإعْلاميين، والمُصَفِّقين القِرَدة. وربما يكون الإنسان المهزوم، المتآكِلة روحُهُ في أوطاننا، قد حَسَّنَ من وَضْعِيته على طاولة شطرنج الكبار، وأصبح في وضعية هُجوم، بدل التراجع المُسْتمر، الذي أصبح بلا حدود أمام الفِيَلة. ويكون في ذلك إجابة على سؤاله: «ألا تلاحظان أن الصمت قد طال وتَمدَّد…؟» (ص 129).
_______
(*) خالد بريش، كاتب وباحث لبناني مقيم في باريس. تخرَّج من كلية التربية في جامعة عين شمس، القاهرة، ثم حاز على الدكتوراه في الفلسفة وتاريخ الفكر من جامعة السوربون (باريس الأولى). له سبعة أعمال أدبية منشورة في الرواية والقصة القصيرة، بالإضافة إلى مقالات سياسية وثقافية منشورة في صحف ورقية وإلكترونية.