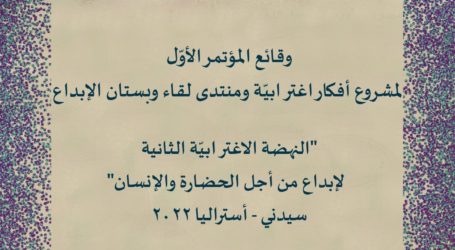بيروت مَدينةُ الشَّوك والوَرْدِ
د. رفيف رضا صيداوي
يقيناً إنّ بيروت هي المدينة الأكثر إثارةً للجدل من بين مُدن عربيّة عدّة. والسبب الأساس ربّما يكون عائداً إلى العلاقة الإشكاليّة والمُلتَبِسة التي تربط هذه المدينة بناسها؛ بيروت “المدينة الإلهة” بحسب الفينيقيّين، و”أمّ الشرائع” بحسب الرومان، و”ستّ الدنيا” بحسب الشاعر نزار قبّاني.. وغيرها وغيرها الكثير من الألقاب التي أُطلقت عليها تخليداً وتمجيداً، لطالما تمثَّلت لدى أبنائها كأنموذجِ تناقُضات.
انفجار مرفأ بيروت في الرّابع من شهر آب (أغسطس) الفائت، الذي صنَّفه الخُبراء والعارِفون بوصفه أحد أكبر الانفجارات التي أصابت مُدناً أخرى في العالَم في التاريخ الحديث، الانفجار الـ “هيروشيميّ” على حدّ تعبيرهم، جاء “كالقشّة التي قصمت ظهر البعير”. ما يُناهِز إلى الآن الـ 200 قتيل، ونحو سبعة آلاف جريح، وأكثر من 300 ألف مشرَّد بسبب العدد الهائل من الأبنية السكنيّة المتضرّرة، بدرجاتٍ مُتفاوِتة تصل حدّ الدمار الشامل، فضلاً عن أبنية غير سكنيّة عائدة لمؤسّسات اقتصاديّة وسياحيّة على أنواعها…إلخ، ذلك كلّه جاء في ظروف يُعاني منها لبنان من أزمة اقتصاديّة حادّة تكاد تهدِّد وجودَه، وأزمات اجتماعيّة حوَّلت حياة المُواطنين فيه إلى جحيم غير مسبوق يتجاوز طاقة الناس على الاحتمال، وطبقة سياسيّة صمَّت آذانها عن شعار “الشعب يريد إسقاط النظام!” الذي صدحت به حناجر مئات ألوف المُتظاهرين والثائِرين والمُحتجّين اللّبنانيّين من طول البلاد وعرضها، منذ انطلاق حراكهم المُهيب يوم السابع عشر من تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت.
بعيداً من السياقات الجيوستراتيجيّة أو السياسيّة أو الأمنيّة أو القانونيّة لانفجار المرفأ، أو عن أسبابه التي قد تكون ناجمة عن عملٍ إرهابيّ مقصود ومدبَّر أو مُوجَّه من العدوّ الإسرائيلي، نتوقّف عند حقيقة أو واقع لا لبْس فيه هو إهمال القيّمين على المرفأ الذي يفضي بنا البحث فيه إلى فتْح صندوق بندورا، الذي تحرق شراراته قلوب اللّبنانيّين لما تنطوي عليه من مؤشّرات على فساد مُستشرٍ ومُتغلغلٍ في بنيان المُجتمع والدولة. فساد أفضت إليه دولة التعايُش والتوازُنات، وإذا به يكاد يطيح بها مُهدِّداً وجودها نفسه. إذ لطالما أَفرَز نمط الدولة هذا مُفارقاتٍ على الصُّعد كافّة باتت سمة مميِّزة للحالة اللّبنانيّة، والاجتماع اللّبناني، الأشبه بكونه حالة فانتازيّة أو حتّى سوريّاليّة بامتياز. فصيغة العام 1943 التي هدفت إلى إقرار التعايُش بين الطوائف من جهة، والتوفيق بين خصوصيّة لبنان ووجهه العربي من جهة أخرى، فشلت في صهْر الولاءات القبليّة والطائفيّة والعائليّة في بوتقة الولاء الوطني، على الرّغم من أنّ لبنان وبحسب دستوره، هو جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، يستند نظامه السياسي إلى الديمقراطيّة التمثيليّة، والنظام البرلماني، والانتخاب العامّ والمباشر، والفصل بين السلطات، أي أنّه يُمثّل نِظاماً فريداً في المنطقة لجهة تبنّيه طبيعة الحُكم الديمقراطي على الطراز الغربي الحديث. لكنّ الفَرق كان شاسعاً بين مبادئه الدستوريّة وواقع الحال، أو بين النظريّة والمُمارَسة، ولاسيّما مع تحوُّل البرلمان إلى ساحة صراعٍ وتقاسُم مَصالح بين الكتل الطائفيّة والاقطاعيّة بدايةً، ثمّ الطائفيّة والإقطاعيّة والميليشياويّة لاحقاً، وذلك بعد الحرب الأهليّة التي دامت ستّة عشر عاماً؛ وإذ فشل الميثاق الوطنيّ، ميثاق العام 1943، في تعزيز الاندماج الوطنيّ الحقيقيّ، فإنّ اتّفاق الطائف (1989) في تعديله نِظام فصْل السلطات بين الرئاسات الثلاث لم يكُن يتّجه حقيقةً إلّا إلى تسويةٍ تُعيد تثبيت توازنات النّظام الطائفيّ القائِم على العصبيّات الدينيّة والعشائريّة، أي هذا النظام الذي لم يتوقّف منذ ما يربو على أكثر من مائة وخمسين عاماً “عن توليد التوتّرات والمُشاحنات والصراعات، الكامنة غالباً والمتفجّرة أحياناً، مع كلّ تبدّل في التوازنات الداخليّة والخارجيّة” (كمال حمدان، الأزمة اللّبنانيّة، ترجمة رياض صوما، بيروت، 1998).
لقد نجح إرساء النظام الطائفي قبل حرب العام 1975 وبعدها إذن، في أن يكون الضمانة الأكيدة للحفاظ على مصالح الفئات والطبقات الحاكِمة وديمومتها، لا ضمانةً لديمومة الدولة والأمن والأمان المُجتمعيَّين. فشهدَ لبنان سلسلة أزمات وحروب صغيرة وكبيرة، تعود إلى الأعوام 1958 و1967 (مع قدوم الفلسطينيّين إلى لبنان وانطلاق حركة المُقاومة الفلسطينيّة بعد اتفاقيّة القاهرة)، وحرب العام 1975 التي انتهت بحرب التحرير (آذار 1989)، ثمّ حرب الإلغاء (كانون الثاني / يناير 1990)، فضلاً عن الاجتياحات الإسرائيليّة للبنان (اجتياح آذار / مارس 1978 وحزيران / يونيو عام 1982، وعدوان تمّوز / يوليو 2006..إلخ)، ناهيك بسلاسل الاغتيالات التي كان اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005 أكثرها فداحةً لجهة تداعياته الأمنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المُستمرّة حتّى الآن.
في أزمة مدينة
انفجار مرفأ بيروت كان بمثابة الإعلان الرمزيّ عن تصدُّع صيغة التعايُش والتوازُنات وتهافُتها على الرّغم من كلّ محاولات السلطة السياسيّة لإنعاشها. وكأنّنا بشعبٍ لم تعُد شريحة واسعة منه ومن نُخبه الثقافيّة تَثِق بإمكانيّة “التسويات”، أيّاً كانت، وسواء أكانت تسويات بين أطراف السلطة الطائفيّة والمذهبيّة والعائليّة، أم بين السلطة وشريحة واسعة من القاعدة الشعبيّة. هذه الشريحة التي بدت، ومن خلال انتفاضتها التي بدأت في السابع عشر من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2019 ولم تنطفئ، وكأنّها ناطقةٌ بلسان الغراب (في حكاية الثعلب والغراب من ألف ليلة وليلة) حين واجَه الثعلب قائلاً: “وأنْتَ أيّها الثعلبُ ذو مكْرٍ وخِداعٍ ومن شيمتك المكر والخديعة لا تُؤْمَن على عَهْدٍ، ومَنْ لا يُؤمَن على عهْدٍ لا أمانَ لَهُ”.
هذه باختصار أزمة مدينة/ وطن جعلت علاقة ناسها بها علاقة مُلتبِسة ومُتناقِضة ومُنهِكة. مدينة مُغايرة تماماً للصورة التي أرادها لها مثقّفوها ومُواطنوها الصالحون. فلم تُجسِّد البتّة حُلمهم ولا حلم الفقراء وأبناء الأرياف المُهمَلة وسائر المُهمَّشين الذين لطالما لفظتهم الدولة من رَحَمِها، لتقذف بأعدادٍ منهم في رَحَم الجماعات الميليشياويّة والطائفيّة والعشائريّة والمناطقيّة والعائليّة؛ حيث أفضى المكوِّن العصبيّ الطائفيّ القبليّ العشائريّ والعائليّ هذا، بوصفه أساس البنية الطائفيّة للدولة، إلى احتكام “العقْد الاجتماعيّ”، المُستند إلى منطق التعايُش، لمُعادَلة اللّاغالِب والّلامغلوب، والتي تشكِّل بدَورها تهديداً دائماً للدولة وللسِّلم الأهلي فيها، وعنصراً مولِّداً للعنف والاقتتال والسيطرة، من دون أن يكون القانون ضمانةً دون تحوُّل هذه الكيانات ما قبل القانونيّة إلى كياناتٍ مهدِّدة للأمن الاجتماعيّ. ذلك أنّ هذه الكيانات التقليديّة تُحرِّكها في الدولة اللّبنانيّة العصبيّةُ بوصفها نظام التوجّهات والسلوكيّات وآليّات التفكير التي تتحكَّم بالأفراد والجماعات وبنظرتهم إلى الماضي والحاضر والمستقبل، بما يسمح لها – أي للعصبيّة هذه – بالتحكّم بالحاضر وبالتعايُش معه في ضوء نظامٍ ماضويّ لم يتخطّاه الزّمن، أي بوصفه حالة راهنة متجدّدة وحيّة، في إطار علاقة مشروطة بضُعف دولة القانون. وبالتالي، وعند كلّ تهديد كان ولا يزال يُطاوِل أطراف السلطة المتحكّمة بالدولة، ولضروراتٍ يقتضيها الحفاظ على نِظام المُحاصَصة الطائفيّة وتكريس “الإجماع” بين الطوائف وسائر كيانات ما قبل الدولة، كانت هذه الكيانات تتّجه للبحث عن “ضحيّة طقوسيّة” لحماية نفسها من عنفها المُتبادَل بواسطة ضحيّة بديلة بحسب نظريّة رينيه جيرار René Gérard حول العنف المقدَّس.
لكنّ هذه الصورة السوداويّة للاجتماع اللّبناني قابلتها صورةٌ مُشرقة جسَّدتها بيروت كعاصمة للثقافة والفنّ وحُبّ الحياة والإيمان بها، وكحاضنة لأفضل الجامعات والمَدارس والمؤسّسات الثقافيّة والفكريّة والمَتاحف…إلخ، وكقلبٍ مفتوح على العالَم، قلب تحتضن مقاهيه ومَسارِحه ودُور سينماته وسائر فنونه نبضَ الحداثة المتغيّر على قاعدةٍ لبنانيّة عربيّة أصيلة.
نعم لطالما عاشت بيروت بوجهَين. درّة الشرقَين التي اشتهرت بجمالها، من دون أن يُخفي جمالُها بشاعاتِها، واشتهرت بانفتاحها من دون أن تكون مُتحرِّرةً من جميع قيودِها، لم تكُن بمستوى أحلام ناسها. لفظتهم وأَخفت كلّ بشاعاتها خلف وجهها البرّاق. لبنان البلد الذي قُدِّر لاقتصاده أنّ يكون حرّاً طليقاً إلى أقصى الحدود بحجّة افتقاره إلى الموادّ الأوّليّة والصناعة، وضرورة ارتكازه بالتالي على التجارة بشكلٍ رئيس تماهياً مع فينيقيّي الأمس في فكر الصيغة اللّبنانيّة وفلسفتها الممثَّلة بميشال شيحا، حوَّل عاصمته إلى مدينة “تغري العرب باسمها – على حدّ تعبير غادة السمّان في روايتها “بيروت 75” (1974) – وكأنّها راقصة في كباريه.
بيروت الحُلم بيروت الجميلة بناها ناسها وفنّانونها ومثقّفوها ومفكّروها وعُلماؤها. فبَرَعَ روائيّوها وروائيّاتها مثلاً، وبما أُتيح لهم من قدرة على الإبداع وتشكيل عوالِمهم المرجوَّة، في إعادة خلْقها. فاغتنت الرواية اللّبنانيّة بنصوصٍ إبداعيّة كاشفة عن ازدواجيّة وجه بيروت، إذ ليس في وسع الأدب تفادي هذا الإغواء في كشْف المستور.
بيروت الجميلة بناها ناسها الذين أحبّوها وأحبّوا عراقتها ونسيجها الاجتماعي الذي اكتسى جماله من تعدّديّتها واختلاط طوائفها ومَذاهبها، وأحبّوا بَحرها ومَرفأها وشوارعها وأرصفتها وبيوتها وكلّ ركن فيها حيث تتجذَّر الذاكرة وتحيا، فلم يبرحوا أماكن الطفولة والصبا على الرّغم من مُعاناتهم من حالة انعدام تكيُّف معها، وعلى الرّغم من خذلانها لهم لأنّها ما كانت يوماً على مستوى الحُلم، فبقوا على حدّ تعبير الروائي اللّبناني يوسف حبشي الأشقر في روايته “أربعة أفراس حمر” (1962) “قلّة من المُفتّشين عن عالَم لم يُخترع بعد، يحاول كلّ منهم اختراعه كما يشاء فلا يجد له سكّاناً ولا أشكالاً ولا محتويات، فيبقى عدماً في العدم”.
لم تكفّ مدينةُ بيروت إذاً عن أن تكون مدينةَ شَوْكٍ ووَرْدٍ، تحكم الازدواجيّةُ علاقةَ الناس بها، وذلك بمقدار ما يحمله النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبنان / الوطن من ازدواجيّة: علاقات مُلتبِسة يمتزج فيها التقارُب والتنافُر، الجذْب والطّرد، الجمال والقبح، الماضي والحاضر، التقليدي والحديث… لكنْ يبقى حُبّ بيروت بحجْم حُبّ الوطن، على الرّغم من كلّ مساوئه.
صخرة بحر بيروت التي وصفها الشاعر جوزيف حرب “كأنّها وجه بحّارٍ قديم”، وجعَلَها سعيد عقل معلّقةً بالنجم تشهد على مجْد لبنان، أصبحت بعد انفجار المرفأ مشهداً من ميثولوجيا إغريقيّة يروي كيف شوَّه الشرُّ والفسادُ وجه مدينة عريقة وابتلعَ النّظام حُلم أبنائها بعَيشٍ كريم في وطنٍ يحتضن أبناءه من دون تمييز. فهل يكون هذا الانفجار إيذاناً بتسوية جديدة كأخواتها السابقات أو سبباً يا ترى لتغييرٍ حقيقيّ يؤسِّس للبنان جديد، فتنبعث هذه المرّة أسطورة نهوضه من أرضٍ صلبة؟
***
(*) مؤسّسة الفكر العربيّ
(*) نشرة أفق