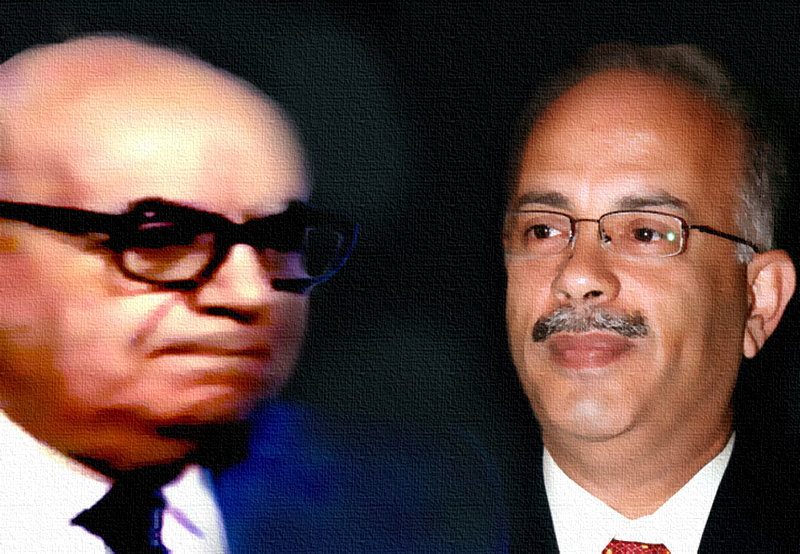الدكتور فؤاد إفرام البستاني…طوبى لمَن رافقَه
الدكتور جورج شبلي
( في ذكرى رحيلِه )
عندما انصرفَ أهلُ الحاضر عن استفتاء أصحاب الحكمة والأَلباب في ما يحزُّ بهم من أزمات المعرفة والضمائر، وصارَ أكثرُ النّاس لا يُبالي ما حرَّمت الشَّرائع والسُّنَن وما حلَّلَت من مختلف الشؤون، قُطِعَت أربعةُ القِيَم، وضُرِبَ عنقُ الثقافة السَويّ، ولم يكن فيهما من صياحٍ أو تأَوُّه.
من أفذاذ رجال الفكر، عندنا، فؤاد إفرام البستاني، السُّقراطيّ الهوى، والطَّليقُ العقل، والمُشرِقُ الذّكاء، على بَساطةٍ وطِيبة، هذا الذي أُولى صِفاته أنّه غُصنٌ بِفَواكِه كثيرة، لكنّ أوَّلَ إدهاشاته أنّ التِّسعين الذي بُلِّغَها لم تُحوِجْه الى ترجمان، لأنّ “أناهُ ” المُفَكِّرَة لم تكن مُنهَكَةً أو على رُكود. فهو رَجلٌ يُطلُّ على لُطفِ المَعشَر، وطُهرِ الخُلق، إطلالةَ الثَّغر على الإبتسام، والطّهرُ واللُّطفُ لَزماهُ لُزومَ الظلّ. وكان يجمعُ، الى سِعَة العِلم، أدبَ النّفس، وحُلوَ الحديث، فإذا نشطَ الى كلامٍ، وكلامُه نظامٌ من الياقوت، يُسمَعُ منه ما لا يوجدُ عندَ غيره، مع عِبارةٍ فصيحة، وألفاظٍ مُتَخَيَّرة، ومعانٍ دقيقة. كلُّ ذلك يُسوِّغ أن نقول إنّ هذا “البستانيّ” هو صِنوُ نفسه، أو هو مَمَرٌّ حتميٌّ لمَنْ لم يَستوفِ، بعدُ، زيارةَ مَعابد المعرفة للتَبَرُّك من أعتابها.
لم يعرف الفِكرُ فؤاد فرام البستاني شقِيّاً محروماً لينصرفَ عنه، بل إنّه لمّا سمعَ بأخباره وبما كان يَجري بين يديه من أسباب الفَهم والمعرفة وفيضِ الغلّة فيهما، تَحَوَّل الى فَنائه فاستَظَلَّه ليُطفئ صَداه. فالبستاني سوقٌ أدبيّ ومَعرِفيّ، أو هو “دائرة معارف” مُتجَوِّلة، لذا، فإفطارُ الفِكر معه لم يكن أبداً على الخبزِ البائِت. لقد برع البستاني، المُفَكِّرُ المُهَذَّب، مَنْ تَقدَّمَه من الكاتِبين في أساليب البَيان، ودقّة البحث، فأَطلعَ صُوَر المعاني في أجملِ هيئاتها، وأروَقِ لباسها. وكان يميل الى الإستقصاء والتعمّق، بحيث يَستدركُ على قاصديه من أهلِ الأدب والرواية، ما يقعُ في كلامهم من نقصٍ، أو حذفٍ، أو تصحيف. من هنا، كانت عنايتُه بالبحث عمّا عجزَ عنه أئمّةُ اللغة، واضحةَ الدّلالة في البَيان الذي شُغِفَ بأسراره. إنّ فؤاد إفرام المُتَحَلّي بذكاءِ القريحة، وسرعة الخاطر/ وخصوبة الذّهن، قد أَتحفَ الأدب بفصولٍ جَزِلةٍ مُمتِعة، ما جعل تآليفه مُمَيَّزةً، وفي غاية الأهمية، لانفرادِها في بابها. حتى قيل: لو أُلقِيَتْ جملةٌ من كلامه في أكداسٍ من الأوراق، لميَّزناها لأوّلِ نظرة.
إنّ القوة في التآليف، وفي أيّة لُغة، ترجعُ، أساساً، الى صاحبها ذي الموهبة التي تُشبهُ قرارةَ الماء، وليسَ الى اللفظِ أو الأسلوبِ، فقط. لكنَّ عشقَ الّلغة، كما الحالُ بين البستانيّ والعربية، جعلَه يُنفِقُ فيها حبَّه، ويَفضحُ سرّها، ويَتطوَّعُ للقَول بأنّ جَمالَها يرجعُ الى دقّة الفكرة وطرافتها، والى تَخَيُّرِ الألفاظ تَخَيُّراً يجعلُها تتمثّلُ مع المعنى كتلةً واحدة. من هنا، لم يعزل البستانيّ الكلمة التي كانت معه حِسّاً يحملُ أَعباءَ القلب والعقل، أو إيماءةً خاطِفةً كالنّور، تُفتَحُ العَينُ به على مسافاتٍ من الرُّؤى. لذلك، ارتاحَت كتاباته الى اهتزازٍ وارتعاش، في تَوقِها الى غاياتها، لأنها لم تكن صَمتاً يَعلُّ، بل كنزاً ينتقلُ الى الأجيال على مَتنِ التّماهي بين الأنا والفكرةِ واللَّفظة، حامِلاً المُتعةَ وطُيوفَ المعرفة.
هو الجاحظ الثالثُ بعد أبي الفضل بن العميد، لتوسُّعِه في العلوم والمعارف، ولاطّلاعِه على ما دَوَّنَ الأقدمون في الأدب والفلسفة واللغة والتاريخ، ولإجادتِه في أسرار الكلام، ولا يَحسبنَّ أحدٌ أنّ من الكثير أن يتَّصف رجلٌ واحدٌ بكلّ هذه المزايا. هذه الطَّوابع ” البستانيّة ” لا تنقاد لرسائل سواه، بعد أن حَفظَت ما كان يرمي إليه الرَّجلُ من دقائق الأغراض. لذلك، فإننا نقرأ كتبَه برغبةٍ ولذّةٍ وشوق، لِما لها من عميق الأثر في ما عُرِفَ لعهدِه من أنواع الثقافة. من هنا، فتآليفُ البستانيّ المتنوِّعةُ الموضوعات، والتي تَرجَمَت تجربتَه المعرفيّة، لم تتقوقع في مكانٍ وزمانٍ، لانفلاشِها على المدى الإنساني، وقد عبرَت الحدود لتُنشِئَ حالةً علائقيّة تتَّصفُ بالعالميّة. وكأنّ البستانيّ اللّيبيراليَّ التَوَجُّه، جارى “غوته” في اعتباره أنّ المجتمع البشريّ بدأ يَدخلُ، فِعلاً، الى عصر هذا المَفهوم.
فؤاد فرام لم يفترش اللَّيثُ صدرَه، ولم يَعقِل الرُّعبُ يدَيه، عندما تعاطى الشؤون الوطنية والسياسية، فهو كان على معرفةٍ وبَصَرٍ فيها. إنّ الوطنيّة مع البستانيّ تراثٌ روحيّ، وهي لغةٌ لا رموزَ فيها، فبينها وبين قلبه نَهدات، وهو لم يهبط أرضَها كالبَرق العارِض، بل عُرِفَ عنه ثَباتُ الجأش، وحُضورُ الرأي، لأنه كان يُحلّل ويُعلّل وينقدُ، بتَعمُّقٍ واستقصاء، ويَبلغُ السُموُّ بالنَّقدِ، معه، الى أبعد مِمّا كان يتطلَّعُ إليه النّاقدون. وإذا كانت السياسة مع مُمارِسيها صحراءَ عوراءَ، قليلةَ العيونِ فليس فيها ماء، قارَبَ البستاني حقيقتها بوِقارٍ وسكينةٍ واتّزان، فتربَّعَت في رُكن مِحرابه وأَقبلَت بوجهها عليه، إذ لا حِرمةَ أَولى بالرّعايةِ من حِرمةِ الحقيقة. وإذا ابتُلِي الناس بِرجّالةٍ أتَوا الكبائرَ في العمل السياسي والوطنيّ، ولم يبذلوا جُهداً لتكريمِ وفادةِ ضيفِهم الأَعزّ: لبنان، وفَجّوا بِقِيلِهم وقالِهم آذانَ المَقهورين، فإنّ المَقهورينَ استطابوا الإصغاءَ للبستاني الرَّجلِ التَقيّ، وأطالوا الإطراقَ إليه لِما في كلامه من نُسكٍ وطنيّ، وتَرَفُّعٍ عن الإنحلالِ في تَعاطي السياسة، وتَجاوزٍ لانكماشِها الى بناءِ وطن.
التاريخ مع البستاني يَرفع بالسَّلام له عَقيرتَه، لأنه الأَبصَرُ بجِواره الحقيقة، وملامستِه عافيتَها، ولأنّ فوارقَ الأصالة تبقى بينه وبين غيره. والتاريخُ، معه، لا يُلقي بنا في غُربة، فهو فِقراتٌ تُعَدّ من آيات الوصفِ، والمَناظرِ الحَرِكَةِ التي تتوارد في حياةٍ وانسجام، وليس مجرَّدَ إخبارٍ مُتنسِّكٍ في بُطون الحروب والممالك. فالبستاني يَزينُ له أن يحوطَ التاريخ بالعدل والإنصاف، وألاّ يميلَ عن القصد في مُراعاةِ ذلك، الى ما تَوَرَّطَ فيه المؤرِّخون من قَهرٍ للحِجَج، وإسرافٍ في تشويه الوقائع، واستسلامٍ للميول، واستعطافٍ لِذَوي السّلطان. وكان هؤلاء، لكثرة مغالطهم وعيوبهم النَّاجمةِ عن الطِّباعِ والأمكنة، بحاجةٍ الى وساطةٍ بينهم وبين الحقيقة التي لابَسَها، معهم، الغموض. ولو أراد البستانيّ أن يَجمع كُتُباً، على طِراز قُصَص المواقِد، بما فيها من مفاجآت وغرائب، لَوَصلَ الى ما يُريد من دون مَشَقّة، فطبقاتُ البشر تَنقلُ وتَبتكرُ ما شاءت لها الحياةُ بمُندرجاتِها من أصنافِ الروايات الخلاّبة، والتي تُمثِّل ما تَرجو، وما تَخشى. وهو لم يكن يرتابُ من أن تغدرَ به الحقيقة، لأنّه “سَمّيعٌ” عَروفٌ بمَصنوع الأحاديث، ومِن أَحرَصِ المُقبِلين الرَّصينين على التلَقّي، حتى نُسِبَ له في ذلك فَضلُ السَّبق. لكنّ المؤرّخ العلاّمة لم يكن يرمي الى تدوين الأوصاف عن طريق النَّوادر والفكاهات، مِمّا يُشوّقُ القلوب والأذواق، ولم يكن مِمَّن يَستنبطون الأَخبار من ينابيع صدورهم، بل قصدَ الى تغليف التاريخ بالتِقنيّة العِلمية، وذلك عندما رَكَدَت ريحُها، وخَبَت مصابيحُها، فأصبح التاريخُ، خارجَها، مُجَرَّدَ حكايات.
فؤاد إفرام البستانيّ الخَجولُ على كِبَر، تظَلَّلَ قلبُه بِكَومِ القِيَم، لأنه نَسَجَ على منوال شكيب إرسلان في ” أنّ أيَّ إنسانٍ لا يمكنُ أن يَشعرَ بوجوده أو يُحقِّقَ أهدافَه، إلاّ إذا كان يَخزنُ في ذاته مبادئ الأخلاق”. وهو لا يُكَدَّرُ ماؤُه في ما افترشَه على بساط العرب في الفصاحة، وأجادَه في مُحاكاةِ فلاسفة الغَرب. فإنْ كان للنّجاح علامة، فعندما ارتحل فؤاد إفرام فكأنما غاصَ في سَمعِ الأرض وبَصَرِها، فطوبى لِمَنْ رافقَه.
وبعد، فعندما يُستَشهَدُ بفؤاد إفرام البستانيّ، في أيِّ محفل، يُكتَبُ الكلامُ بِخَطٍ عريض.