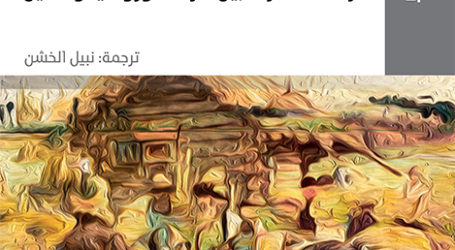رواية “الروائيّ” والأسئلة الصعبة
د. رفيف رضا صيداوي*
في روايتها “الروائيّ” (2019)، تحتفي الروائيّة اللّيبيّة وفاء البوعيسي بالطبيعة من منطلق فلسفيّ وجوديّ يُعيد الاعتبار للفطرة الإنسانيّة، من ضمن قالبٍ رمزيّ مُحكم البناء ينحاز إلى الفطرة الطبيعيّة كنقيضٍ لثقافةٍ زائفة تُصادِر عقل الإنسان بدلاً من الارتقاء به، فلا تعدو أن تكون والحال كذلك سوى ثقافة قاتِلة ومدمِّرة.
في نصّها الروائي هذا، مارست وفاء البوعيسي لعبةً مزدوجة ومُتقاطعة تلعب على وَترَيْن فنّيَّيْن، يتمثَّل أحدهما في التجسيد المُمَسرَح لماهيّة النصّ الروائي ولعمليّة الخلْق والإبداع الروائيّيْن، ويتمثّل ثانيهما في العمل على مفاصل عالَمٍ يوتوبيٍّ يعود بنا إلى فطرتنا الأولى؛ بحيث إنّها من خلال تقاطُع هذَيْن الوترَيْن شيَّدت عالَماً روائيّاً موازياً لعالَمنا المرجعيّ المُثقل بالمآسي والحروب والقتل والعنف واللّامساواة والقهر وغيرها من أشكال الخراب الذي قادت إليه حضارتنا المعاصرة بعقلانيّتها الفجّة ووثوقيّتها التي جسّدها “الروائي”/ العليم، خلافاً لمقولة الشاعر أبي نوّاس: “حَفظتَ شيئاً وغابت عنكَ أشياءُ”.
المكان هو جزيرة واقعة في اللّامكان واللّازمان، حدودها الإنسان والحيوان والأرض والتراب والشجر والبحر والسماء والهواء والألوان. أمّا ناسُها، فهُم شخوص الرواية الذين خلقهم “الروائيّ” – وهو شخصيّة رئيسيّة في الرواية، أو لربّما أحد أبطالها الرئيسيّين – ليكونوا من لحم ودمٍ، راسِماً أدوارهم ومصائرهم، مُشترطاً انضباطهم والتزامهم بالدور الذي رسمه لهم، وإيمانهم به، لاعباً على وَتَرِ توق الإنسان الفطري إلى الخلود، وكاشفاً في الوقت عَينه عن غطرسة الروائي العليم، وما يرمز إليه من زهو الإنسان الحديث بعِلمه وبإنجازات حضارته العلميّة والتكنولوجيّة التي سوَّلت له أنّه قادر على التحكّم بكلّ شيء، حتّى بالموت.
لكنْ سرعان ما تتمرّد هذه الشخوص على “الروائي” وتنتفض في وجهه مُعلنةً عصيانها ورفضها الأدوار والمصائر التي رسمها لها، وذلك في سياقٍ سرديّ زاخر بحواراتٍ تعكس التجاذُبات القائمة بينها وبينه:
“لم تكُن هناك أكاذيب، ولا هويّات مُتعادية لشخصٍ مؤمن وآخر ضالّ، وإنسانٌ عاقلٌ وحيوانٌ غريزي، لم تكُن ثمّة حِيَلٌ للسيطرة على سكّان الجزيرة وضربهم في بعضهم البعض، لم يكُن غير حياة فطريّة طبيعيّة ودودة، حيث الكلّ مشغولٌ فقط بالعيش، وحيث اعتادت جميع الكائنات على التعايُش في توازن، ترتبط ببعضها بصلة قربى خفيّة، حتّى دَخَلَ ذلك الروائي على الخطّ، مُلغِياً ذلك التوازن الطبيعي في المكان، ومحطِّماً ذلك الرابط الخفيّ من القرابة، ليَضَعَ الحواجز والقوانين والشروط على من سلكه في روايته، ليعيش معه ضمن واقعٍ نأى به من محض العيش إلى وَهْم الخلود”.
بين هذا التجاذُب والرفض يتشظّى العالَم الروائي، لتحلّ الكتابة الروائيّة وكأنّها لعنة على صاحبها، وتتناسل الأسئلة الخاصّة بالجنس الروائي نفسه: أين الحدود بين الكاتب والمكتوب؟ ما هو الحدّ الفاصل بين الشخوص والروائي؟ ومَن يكتب الآخر، الروائي أم شخوصه؟
مَن هو هذا “الروائيّ”؟
سؤال الكتابة هذا مضى يفجِّر أسئلة أخرى، لعلّ أبرزها السؤال حول مَن هو هذا “الروائي”؟ ولماذا انتفضت عليه شخوصه؟ فيما الجواب يحمله الخطاب الروائي المَبنيّ على تعارضٍ بين “الروائي” ورؤيته للحياة والكون من جهة، ورؤية الشخوص من جهة ثانية. إنّه الخطاب المناهِض للمبادئ والأُسس الثقافيّة والحضاريّة التي تستند إليها التصوُّرات االرّاهنة عن الكَون والمُجتمع والإنسان، كما يُشكِّلها المُجتمع المُعاصر ومادّيّته؛ إذ ينحاز هذا الخطاب إلى رؤية الكاتبة وفاء البوعيسي وعالَمها اليوتوبيّ، عالَم الفطرة الذي تجسّده الجزيرة (المكان الروائي) الذي تُعرّفه إحدى شخصيّات الرواية قائلة: “تتناقل جدّاتنا منذ زمنٍ بعيد، أنّ ثمّة شراكة نَمت ببطء بين الأهالي، وبين بعض الكائنات التي جرّبت الاقتراب منهم، وحين كانت تُبدي مُسالمة حيالهم، كانوا يكافئونها ببعض الطعام، ومع مرور الزمن صار هذا الاقتراب الحذر ألفةً، وصارت الألفةُ ميثاقَ تعايُشٍ طيّب بين بعضهم البعض، وكلّما وُلِدت منّا أجيالٌ جديدة، كلّما تداولنا هذا الميثاق وحملناه محمل الجدّ، ولا مرّة خرقناه نحن أو هُم، حتّى صار إرثاً نحرص عليه”. إنّه المكان/ الفضاء المسكون بالجمال والتناسُق والانتظام والعدالة والفرادة والإبداع والرحمة. إنّه الفضاء المسكون بالتوازُن بين كائناتٍ حرّة طليقة، حيث الإنسانُ خاضعٌ لقوانين الطبيعة لا لقوانين العقل وحواجزه، وحيث تتساوى الكائنات كلّها، وتتساوى كذلك الذكورة والأنوثة وتتناغمان، ويتواصل النبات مع الحيوان والأرض والبحر والشمس والقمر، ما “جَعَلَ الطحالبَ تنمو على ظهور السلاحف والقواقع، وأَدخل العصفورَ إلى أفواه التماسيح ليتلقط بقايا الطعام من بين أسنانها، ويَخرج ناجياً في كلّ مرّة، وأَنبت حشائشَ صغيرة على قرون الأيائل، وأعطى سلطةً للقمرِ على البحار والمحيطات فكان المدّ والجزر”، وذلك في تناصّ واضح مع النصّ الديني المسيحي المتمثّل في كلام النبي إشعيا: “يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معاً وصبيّ صغير يسوقها. والبقرة والدبّة ترعيان. تربض أولادهما معاً والأسد كالبقر يأكل تبناً. ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمدّ الفطيم يده على حجر الأفعوان (سفر إشعيا 11 : 6 – 10)”.
انتفاضةُ الشخصيّات على “الروائيّ”، بما ترمز إليه تلك الشخصيّات من عالَمٍ فطريّ وعَيشٍ مُنتظم، وبما يرمز إليه هذا “الروائي” من استبدادٍ ونرجسيّة لا تعدو كونها نرجسيّة الفرد المتحضّر وغطرسته ورغبة الأنا البشريّة في أن تُمارس سطوتها الذاتيّة على الحياة والموت والطبيعة والزمن والوجود برمّته، أي باختصار التسيُّد على الكون، انتفاضة الشخصيّات تلك ما هي إذاً إلّا انتفاضة ضدّ كلّ ما يعيق عالَم الطبيعة الفطري والعيش بانسجام في إطارٍ من الشراكة والأخوّة والوحدة وتقبُّل الآخر، من دون تلك القواعد الصارمة التي تُجبر الناس على مُمارسة ما لا يرغبون به.
“كنان”، ولأنّه وريث المعرفة الفطريّة، وابن العجوز حكيمة الجزيرة، جَعَلَتْه المؤلّفة منذ البداية الخصم الأساسي (L’antagoniste) لـ “الروائي”. فهو – أي “كنان” -، ولكونه الحريص على معارفه ومبادئه الفطريّة هذه، لم يخضع لـ “الروائي” ولمحاولات خداعه واستلابه كما حَصَلَ مع سواه من أبناء الجزيرة، الذين غُرِّر بهم بحجّة الوعد بالخلود. فقاوَمَ “كنان” تسلُّط “الروائيّ” و”ديكتاتوريّته”، والوعي الآخر الزائف النقيض الذي حاول هذا الأخير خلقه بين جماعة الجزيرة، والذي هو، بحسب منطق الرواية، وعي ثقافي إيديولوجي يبثّ الفرقة والخراب بين الجماعة. لذا، ألفيناه يواجهه قائلاً: “لمْ يخلّصنا منك إلّا تقبُّلنا لبعضنا، واستعادة الشعور بأنّنا أخوة رغم اختلافنا”..
في حين أنّ “جودي” التي كادت تسترسل في أن تكون أداة “الروائي” سرعان ما تراجعت عن هذا الدور، وواجهته قائلة: “ومن الرائع أن نكون بهذه الحريّة في نهاية الأمر، وسأضحك دائماً لأنّ تقبُّلنا لبعضنا هو الذي أنقذنا وأنقذ عالَمنا.(…) أردتَ مسْخنا جميعاً لتجعل منّا واحداً (..) وحين عجزتَ فرَّقتَ بيننا بالكراهيّة”.
في التخييل المركَّب
هكذا عمدتْ وفاء البوعيسي عبر لعبة التخييل المُستنِدة بشكل أساسي إلى شخصيّة “الروائي” كعنصرٍ من عناصر المشكّلات السرديّة الأخرى، إلى السموّ بالخيال الروائي عن الواقع الآني، مُعيدةً اختراعه ليكون محمَّلاً بالأسئلة التي يُثيرها هذا الواقع نفسه براهنيّته؛ وكأنّنا بها تحول دون التبدّد في العدم الذي تقود إليه حضارتُنا بمحدوديّة خياراتها العقلانيّة؛ فإذا بها بنصّها التخييليّ تُعيد جدليّة الطبيعة من جهة، والثقافة والتمدُّن من جهة أخرى، عبر امتداداتها الدلاليّة المختلفة في النصّ، وتدرّجاتها الصراعيّة، مُعلنةً انحيازها إلى الإنسان الحرّ، ابن الطبيعة الخلّاقة. تلك الطبيعة التي اكتست في نصّ البوعيسي علامةً سيميائيّة أساسيّة في تدليلها على عوالِم الحريّة والاستقرار، بعيداً عن عالَم الإكراه والضغوط ومفارقات الضمير المُصطنع بلغة نيتشة، والوجود الزائف بلغة هايدغر، والعقل المنغلق بلغة ماركوز، المتحكِّم بطاقة الحياة بلغة فرويد. إنّه انحياز للطبيعة والعقول الخامّ والذكيّة العصيّة على التشكيل، التي لا يُمكنها أن تكون على ما هي عليه إلّا إذا تمتّعت بالحريّة.
بهذا التخييل المركَّب ساءلت الرواية الزّمن الآني وأسئلته وقضاياه، ولاسيّما التمدّن والحداثة والعقل.
إنّها لعبة تخييلٍ أرادتها المؤلِّفة صوتاً واقعيّاً في مجتمعٍ حديث يتداعى، بسبب زيف العقل وزيف الحداثة وزيف الحريّة وزيف العدالة… وزيف القيَم التي ينادي بها، فقارعته الروائيّة بعملها الروائيّ الزاخر بالقيَم الإنسانيّة، وشيَّدت عالَماً موازياً لا لتلتجئ إليه بل لتتمرّد عليه: “حين نتعب، يجب أن نكتب رواية، حين توشك الحريّة أن تؤخذ منّا يجب أن نكتب رواية؛ الرواية هي اختراع الذكاء الإنساني المعاصر، من أجل التمرُّد على المتُاح والجاهز، والسواد، والقواعد الرتيبة، الرواية هي الإقامة في الأسئلة الصعبة، والممنوعة”.
لم تقبع رواية “الروائيّ” ضمن حدود عالَمها اليوتوبي بوصفه العالَم المثالي والعَود الأبدي فحسب، بل ولَّدت خطاباً ذا رؤية فلسفيّة اجتماعيّة في النّظر إلى العالَم، يُعرّي اتّجاهات الحداثة والإيديولوجيا، بأشكالها كافّة، وحتّى الدينيّة منها، نحو خلْخَلة الثنائيّات المُتكامِلة. تلك الثنائيّات التي، بتكاملها وليس بتضادّها، تُشبك حيوات الناس الفطريّة وعلاقاتهم وروابطهم بعضهم ببعض من جهة وبالمُجتمع والكون والحياة والموت والداخل والخارج من جهة ثانية. لعلّه خطاب يدافع عن حقّ الإنسان “الأصيل” في الحياة وفي تملكّه لوعيه وإرادته وتفكيره. وما التجسيد الفنّي لتجربة الكتابة الروائيّة إلّا استكمالٌ لهذا الخطاب الروائي، المبنيّ على موازاةٍ وتناظُرٍ روائيَّيْن بين العالَم اليوتوبي وأثقالِ الحياة الرّاهنة بقضاياها وأفكارها، وذلك بتشديده على أنّ الفنّ، بأجناسه وألوانه المُختلفة، وبخاصّة الفنّ الروائي، المُرتكز على بناءٍ حرٍّ ذي الأصوات المُتعدّدة والرؤى المختلفة والرحابة الزمكانيّة، لا يولِّد رؤيةً حرّة تعي أمراضَ مُجتمعِها فحسب، بل يكون بحقّ أداةً للاسترسال وإطلاق العنان.. وربّما طريقنا إلى الحريّة.
***
*مؤسّسة الفكر العربي
* نشرة أفق