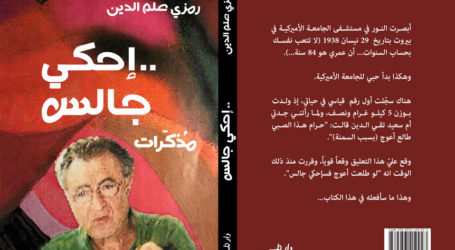“مونداي مورنينغ” لزياد كاج…تأريخ وتوثيق لمرحلة دقيقة من تاريخ البلد
صدرت عن دار نلسن في بيروت رواية “مونداي مورنينغ” للروائي زياد كاج، يروي فيها “سردية الصحافة اللبنانية من خلال تجربته المهنية محررًا وشاهدًا وعابرًا في مجلة المونداي مورنينغ”، كما جاء في كلمة الناشر سليمان بختي على الغلاف الخلفي للكتاب وتابع: “هي تجربة امتدت منذ أواخر الثمانينات حتى منتصف التسعينات-أي زمن نهاية الحرب وتكوين السلطة بعد اتفاق الطائف- وجعلته يعاين بوادر انهيار المهنة ومصائر وخيبات أبطالها الذين حلموا بمستقبل أفضل من خلال انضمامهم إلى عالم الصحافة. وأن يرى أيضًا بيروت في عز انقسامها بين شرقية وغربية، وأثر الحرب على النفوس والمواقف والممارسات.
رواية واقعية تؤرخ وتوثق لمرحلة دقيقة من تاريخ البلد بأسلوب ساخر وجذاب، ولكنها ترثي لأحوال وآمال شخصيات قلقة وحالمة بالجميل في مهنة جاحدة وبلد ممزق وعلاقات مضطربة”.
زياد كاج شاعر وروائي لبناني. يعمل في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت. جميع مؤلفاته صادرة عن دار نلسن.
له في الشعر: “كان عليك أن تقلب السلم” (2003)، “أحبك أميركا، أنا لا أحبك” (2006).
له في الرواية: “أولاد الناطور السابق” (2008)، “الحياة كما قدمت لهم” (2011)، “ليالي دير القمر حرب الجبل” (2014)، “رأس بيروت صندوق في بحر، نار على تلة” (2015)، “محمود المكاري يتذكر حلونجي بيروتي، قصة الكلاج اللبناني” (2017)، “سحلب” (2018)، “أمر فظيع يحصل رواية واقعية عن مجزرة صيرا وشاتيلا” (2021).
في ما يلي مقطع من الرواية:
عالم مكتب الوردية
بناءً على نصيحة الدكتورة أحلام، خريجة جامعات نيويورك، قررت العمل بدوام جزئي في مجلة “مونداي مورنينغ” كي أخطو أولى خطواتي في مهنة الصحافة بعد تخرجي من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، وأتمكن من نشر أولى قصائدي بالإنكليزية.
“Publish or perish”، قالت لي د. أحلام، جارتنا المثقفة، ونحن نقف على الرصيف وسط الشارع؛ بمعنى “إن كل ما يُكتب ولا يُنشر، مصيره الزوال والنسيان”.
لا أذكر متى بدأت كتابة الشعر، ولماذا باللغة الإنكليزية تحديداً؟ ربما لأن التحدث والكتابة بالإنكليزية منحني إحساساً وهمياً بالتفوق والإنتماء المؤقت إلى حضارة متقدمة عنا بقرون، شعور بضرورة الإنجاز والتفوق، لا بدّ منه، لكل من يعيش في هذا الشرق. كل منّا تسكنه جذوة الشعر بنسب متفاوتة. كنت شاباً حالماً مرهف الإحساس يضج في داخلي خليط من الأفكار والصور.. وشعور ما كان يدفعني إلى البوح على الورق كتابةً ورسماً. بدايات جدّ متواضعة، لا تخلو من الركاكة والسطحية. كانت سيمفونية الإبداع والشغف تناديني من بعيد بصوت خافت يكاد لا يسمع. وأنا غير مصدق لها.
شعر وصحافة على سطح واحد!
في مكاتب المجلة الأسبوعية في منطقة الوردية كانت الانطلاقة. صاحبها نقيب المحررين آنذاك ملحم كرم. كان يديرها من “المنطقة الشرقية” حيث المكاتب الرئيسية لدار”ألف ليلة وليلة”، التي تُصدر أيضاً: مجلة “الحوادث” وجريدة “البيرق” بالعربية، بالإضافة إلى Revue du Liban”” بالفرنسية. نجح أبن بلدة دير القمر في مسايرة وإرضاء كل الأحزاب والأطراف المتصارعة خلال الحرب، فبقي متربعاً على عرش نقابة المحررين لمدة 44 سنة. لذلك ترك أبواب مكتب “الغربية” مفتوحة. فكل ماروني هو “مشروع” رئيس جمهورية في لبنان. ومن يدري؟ ربما تُفتح له أبواب قصر بعبدا يوماً كمقيم وليس كزائر وحامل لرسائل “خليجية”.
في صباح يوم أثنين عادي، وقفت أتصفح العدد الجديد المليء بالأخطاء المطبعية وسط القاعة الرئيسية المتواضعة والمهملة. الأثاث قديم، أدوات العمل اليومي لا تنتمي لهذا الزمن، الحيطان لم تعرف الطلاء منذ زمن. كل شيء دلّ على أيام عزّ من العمل الصحافي مرّت على هذا المكان. عبد الكريم المؤمن والكت ومكان يعبر بدراجته النارية بين بيروت الغربية والشرقية لجلب المواد الإخبارية ونشرات الوكالات، وشيكات المعاشات في العاشر من كل شهر. كنت ألعن المخرج أكرم في سري أثناء قراءة قصيدتي المنشورة، والى جانبها رسمتي المستلهمة من أجواء القصيدة.
“قصيدة من عشرة أسطر لا تحتمل كل هذه الأخطاء! حتى الرسمة المرفقة مطبوعة بشكل ملتوي”.
كريس الأميركي الوحيد بيننا والمسؤول الأول عن تحرير ومراجعة المواد الإخبارية المترجمة وحامل القلم الأحمر المخيف لم يخف لعناته وهو يراجع العدد الجديد. فالمخرج المهووس بمواضيع الجنس ومغامراته المفترضة مع نساء فاتنات (كنّ من بنات مخيلته المكبوتة) كان يسهب في حديثه عنهن خلال تحضيره لماكيتات المجلة مساء كل يوم جمعة. كاد كريس، الواقف قربي بثيابه الرثّة، أن يمزق العدد وهو يردد بغضب مكتوم rabbak….rabbak””.
المكتب يقع كان خلف المصرف المركزي القريب من كنيسة الوردية والسفارة الإيطالية سابقاً (مقر جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت اليوم). الكل كان منشغلاً بواجباته اليومية التي لم ترنو إلى العمل الصحافي الجدي والمحترف. فالمهام كانت عبارة عن ترجمة الأخبار من العربية إلى الإنكليزية تحت إشراف “شبه ديكتاتوري” ملطّف من جانب كريس ومراجعاته اللغوية التقليدية والمزاجية. فهو كان يحمل تفويضاً غير معلن من النقيب كرم.
كان البلد لا يزال منقسماً في أواخر الثمانينات، رغم تعب المدفع و”أهل البارودة”، وبداية ظهور بوادر نهاية للحرب وسط حال من الإنهيار الأمني والإقتصادي والحياتي، خاصة في بيروت. لطالما منعتنا المعارك “الأخوية” بين الميليشيات والقصف العشوائي المتبادل بين “الغربية” و”الشرقية” من الحضور إلى المكتب. لم يكن الإنترنت متوفراً، ولا الهاتف الجوّال؛ فقط المقاتلون وقادتهم كانوا يحملون أجهزة إتصال عسكرية بحجم “بطاطا بقاعية كبيرة”. حتى الهاتف الثابت الأسود في مكتبنا كان صامتاً معظم الوقت. وإذا حدث وبُعثت الحياة فيه وأطلق رنينه فجأة وهذا نادراً ما كان يحصل؛ كُنّا نجفل، ثم تتسابق الصبايا لرفع السماعة ولفظ الكلمة السحرية بغنج وشعور بالتفوّق “ألو” على طريقة الممثلة هند أبي اللمع في مسلسل “ألو.. حياتي” (أصاب المسلسل نجاحاً جماهيرياً واسعاً خلال الحرب الأهلية في أواسط السبعينات وتمحورت حلقاته حول قصة حب نادرة بين محامي ناجح ومحامية كسيحة. بطولة عبد المجيد مجذوب، ومشاركة فيليب عقيقي، الياس رزق، ليلى كرم، يوسف شامل وغيرهم. تأليف وجيه رضوان وإخراج أنطوان ريمي).
تموضعت نوال خلف آلة الطباعة القديمة تعمل على ترجمة مقابلة للنقيب مع أحد أمراء الخليج وقد ارتسمت على وجهها علامات التذمّر والضيق. سيدة مُحبّة محتشمة، من أصول جنوبية، مرتاحة مادياً، يدعمها أخوتها في الاغتراب الإفريقي. يأتي سائقها الخاص ظهراً ليقلها إلى منزلها القريب في قريطم لتناول الغداء، ثم تعود في فترة بعد الظهر.
O my God, Chris.What’s this?”” تأففت دون أن ترفع رأسها عن الأوراق السمراء المبعثرة على الطاولة أمامها. كُتبت المقابلة المطلوب ترجمتها بخط غير واضح يُقال له عندنا “خط دكتور”. تمتلك أمال لكنة إنكليزية تقليدية إكتسبتها خلال فترة دراستها في لندن قبل الحرب الأهلية. بقي كريس، ذو القامة الطويلة والنحيفة، غارقاً في مراجعة العدد الجديد، جالساً على كرسي في إحدى زوايا المكتب، ورجله اليمنى ملتفّةٌ فوق اليسرى وتهتز بعصبية. نظارتاه سميكتان مثل قعر زجاجة مشروبات غازية. كان ممسكاً بالمجلة على مسافة قريبة جداً من عينيه.
المكتب المُهمل، الذي كان يقع في الطابق الأول ويشرف مباشرة على الطريق، هو عبارة عن قاعة كبيرة كنا نستعملها للقيام بمهامنا (ممكن تسميتها غرفة التحرير أو الترجمة)، ومكتب الشيخ المدير الإداري المحنك والمخضّرم، رغم عدم إلمامه باللغة الإنكليزية، مما جعله سجين لحالة دائمة من الشك والتوجس. لطالما اعتبرته “مخّبراً” لدى النقيب.
في الجهة المقابلة، ثمة مكتب صغير حيث عملت مهى على الآلة الطابعة الكهربائية الوحيدة. والى يسار المدخل كان المطبخ – أي غرفة الإخراج – وُضعت في وسطه طاولة خشبية غطت سطحها أنواع المواد اللاصقة والمساطر وبقايا قصاصات الورق والماكيت. أرضية هذه الغرفة لبثت وسخة معظم الأوقات. أما الطابق الثاني، فكان مخصصاً لكريس وحده. فوق كان يستريح، يغيب لساعات ثم يظهر وسطنا من جديد. فوق كان يُعد الطعام، يغسل ثيابه، يستحم، يعمل، ينام ويتحدث مع نفسه. أميركي غريب بثياب نادراً ما كان يبدّلها. لا يوحي هندامه بأنه ليس من أهل البلد إلا عندما يتكلم. يعرف الشاردة والواردة في عالم المجلة. قلمه الأحمر لا يرحم فيبدو كبدري أبو كلبشة في مسلسل “صح النوم” (مسلسل كوميدي سوري حول حارة كل من إيدو ألو وصح النوم هو أسم الأوتيل في حارة دمشقية شعبية. بطولة دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح). كان عندما يعيد لنا ترجماتنا وتحقيقاتنا المكتوبة بلغة غير محترفة، نشعر بالدوّنية.. وأحياناً، بالذنب والغضب. تماماً مثل حصة مدرسية بعد توزيع العلامات على التلاميذ. لكن معلمنا لم يكن لديه الوقت ولا الرغبة في تعليمنا.
فجأة أطلّت شابة شقراء بملابس مثيرة وسط المكتب. قالت بغنج ملفت ومصطنع: “Bonne Jour.. الشيخ موجود؟”
قفزت مهى، الصبية المعروفة بحشريتها وغيرتها ونشاطها الملفت، من مكان ما، وسألتها مع ابتسامة صفراوية: “مين منقلو؟” (بلهجة سكان طريق الجديدة البيروتية الثقيلة).
“الفنانة..”.
خرج المدير بسرعة من مكتبه مرحباً، سيجارته في يده وقميصه الأبيض مفتوح لتظهر شعيرات صدره الرحب. أغلق الباب خلفهما. توقفت نوال عن الطباعة، هزّت برأسها ثم تابعت عملها بوتيرة أخف. ساد سكون مختلف في المكتب.كُنا بأمس حاجة لهكذا حدث يكسر الروتين اليومي. سحبت مهى كرسي على عجل والتصقت بصديقتها الحميمة، نوال، وأخذت تهمس في أذنها واضعة يدها اليمنى لتخفى حركة حنكيها المتسارعة في هكذا مواقف. ثرثارة وصاحبة قلب طيب.
استمرت وتيرة العمل في المكتب شبه طبيعية في ظل طيف ملحم كرم “الغائب- الحاضر” وصوت النقرات المتقطعة على آلة الطباعة اليدوية يقرقع في أجواء المكتب. الجلوس خلف آلة الطباعة اليدوية كان يمنح المستخدم شيئاً من الثقة بدل الكتابة بقلم “البيك” الأزرق على الورق الرخيص. هكذا شعرت عندما بدأت أطبع أولى قصائدي في المجلة. نوال تطبع بإصبع واحد، وتكره أن تسأل كريس؛ لأنه إذا كان في مزاج متعكر، قد يأخذ الأوراق إلى “وكّره” في الطابق الثاني ويغيب غيبة “غراب نوح”. مهى كانت الأسرع لأنها اعتادت الطباعة على الآلة الكهربائية التي تتطلب مهارة وخبرة.
ربيع يمقت هذا النوع من العمل المكتبي. إنضم إلى المجلة فقط لحرق الوقت وإسكات أخته الكبرى التي كانت تمطره بالانتقادات لدرجة الإحراج. وقف قرب حافة الشباك، يدخن، ويتأمل المارة وزحمة السيارات تحت. يهوى عالم السيارات السريعة ويحلم (نهاراً) بصفقات كبيرة في عالم المال والتجارة تضعه بسرعة سيارات الفورميولا 1 مع “جماعة فوق”.
التفت ببرودته المعهودة إلى داخل القاعة: “يا جماعة، تأخّر عبد الكريم”.
نحن في العاشر من الشهر وهو يوم “قبر الفقر”؛ أي اليوم الذي يجلب معه درّاج المجلة شيكات المعاشات ومواد الشغل من الأشرفية.
أنهينا للتو، أنا وربيع، عملية proof reading”” للأخبار الجاهزة للطبع في مكاتب الشرقية؛ وتقطيع “لفافة” أخبار الوكالة وتصنيفها بين أخبار سياسية وإقتصادية ورياضية وبيئية وأخبار منوعات أطلق عليها كريس أسم: “Miscellaneous”. وهي تسمية كنت أعترضت عليها كثيراً لغموضها وانتمائها للقاموس التقليدي في فن الكتابة الصحافية الحديثة التي تتطلب الأسلوب البسيط قدر الإمكان.
حضر هادي ومعه صديقه الأسمر القصير القامة. كعادتهما كانا يتجادلان. كانت مهمة هادي حسب توجيهات الشيخ متابعة أخبار السوق وارتفاع سعر الدولار الجنوني بالنسبة للعملة الوطنية. وصل إلى حافة 3500 ليرة لبنانية للدولار وأكثر. من مقابلة إلى أخرى، كان هادي يطيع الشيخ دون تذمر. كان يشتغل على طريقة “الريمونت كونترول”. صار لقبه Mr. Dollar””. نادراً ما يتواجد في المكتب، يكره الثبات والروتين المكتبي. يهتم بهندامه بشكل ملفت.
كان الشيخ عندما يتلفظ بكلمة: business”” يكزّ على اسنانه، فيلفظ حرف s”” بصوت حرف z””، وتنتفخ أوردة رقبته كأنه في نوبة سعال. مدخّن من العيار الثقيل. همه كبير ولديه عائلة عليه إعالتها واللقمة الحلال في زمن الحرب الأهلية مرة ومكلفة.
زميلنا يركض وراء الدولار المتقلب صعوداً ونزولاً، وصديقه يركض وراءه. قصته مع صديقه الغريب الأطوار والعابر للمعابر بين الشرقية والغربية تحولت للثرثرة حول ميوله الجنسية بين الموظفين. كان هادي صاحب طبع دال على اسمه: شاب طيب لا يؤذي أحداً، ميال لعمل الخير ومساعدة الآخرين.
وسط الجدال بينه وصديقه، أتى صوت السكرتيرة فاطمة من جهة مدخل المكتب: “نوال، وصل الموظف الجديد”.
“أهلاً وسهلاً”.
“شكراً”.
بالكاد سمعنا صوته.
“ما تواخذنا المكتب مكركب. تفضل أجلس. الاسم الكريم؟”.
“عبد الرحمن”.
“Most welcome”. وين دارس إستاذ عبد وكيف خبرتك؟”.
“أنا خريج الجامعة الأميركية في بيروت، علوم الحياة وتربية. عندي خبرة في التعليم والترجمة”.
أجاب وهو يتأمل القاعة والحيطان دون أن يثبت نظره على أحد منا. متوسط القامة، هندامه بين السبور والكلاسيك، يتحدث على موجة منخفضة جداً، ويدخن “للفزلكة”.
خاض للمقابلة بنجاح، خاصة بعد مراجعة كريس لخبر ترجمه ولم يستلّ “قلمه الأحمر”. كان شاباً بالغ التهذيب والهدوء ويمتلك مستوى ثقافياً جيداً. كلاسيكي. بيروتي اللّكنة؛ رمادي، يتحدث ببطء كأنه يدرس كلماته بعناية فائقة. وجهه لا يعطي أي إنطباع. كأنه مرآة.
دخلت مهى كالفراشة وخرجت كي تلفت إنتباهه خلال المقابلة. عادت خالية الوفاض.
“وصل عبد الكريم”، قال ربيع بصوت مرتفع وهو لا يزال واقفاً أمام الشباك. الدراجة النارية المميزة كانت مركونة تحت على الرصيف. لحظات وكان عبد الكريم وسط المكتب ومعه الشيكات ومواد الأخبار والترجمات المطبوعة على ورق الماكيت. الكل يحبه ويحترمه لدماثة أخلاقه ودفء لسانه. رسول محبة وصلة وصل بين البيروتتين المنقسمتين مرغمتين. يعرف ناس “هناك” وناس “هنا”. هو الوحيد الذي يرى النقيب كل يوم ويعرف الموظفين والزملاء هنا وهناك؛ في حين بقيت “الشرقية” بالنسبة لنا مجرد “مفهوم غامض.. كلمة ضبابية.. وربما مخيفة”.
“الحمد الله عالسلامة”، قالت نوال. عبارة يستوجب قولها لكل عابر لخطوط التماس الخطرة بين “الغربية” و”الشرقية”.
“الله يسلمك. وين الشيخ؟”، بدأ بتوزيع الشيكات حسب الأسماء.
“بكرا واصل مدير جديد”.
“مدير جديد”.. تردّدت العبارة في أرجاء المكتب مثل أسم “راجح” في مسرحية “بياع الخواتم” للأخوين رحباني. تجمهر الجميع حوله بشكل دائري. كثرت الوشوشات والتمتمات من حوله.
أطلّ الشيخ من مكتبه: “شو قلت.. مدير جديد! مين قلك، النقيب؟”.
“نعم”، أكد عبد الكريم، “وهو عراقي”.
وضع يده على كتف عبد الكريم كأب عطوف يحتضن أبنه وأدخله إلى مكتبه. فيما غرقت نوال في مخيلتها وارتسمت على وجهها إبتسامة غامضة.
بقي عبد الرحمن جالساً على كرسيه يتابع المشهد المستجد. كان يتأمل الوجوه ليفهم لماذا تغيرت ملامحها؟ جذبه المشهد في الفضاء الخارجي عبر النافذة العريضة حيث بانت له الواجهة الخلفية للمصرف المركزي. شرد وأطال.
حسبته يسأل نفسه “ما الذي جلبه إلى هذا المكتب؟”.