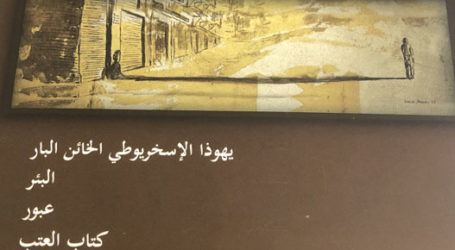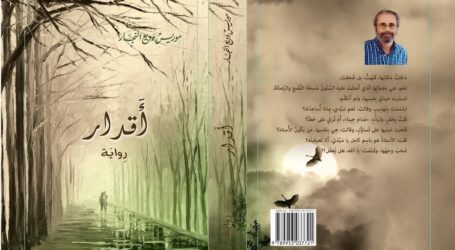عَبْرَ الكِتاب/ السِفر “من كل وادٍ صدى”* سابا زريق يشهدُ لزمنِ لبنان القلِق ويُسفر عن نزوع أكاديمي وعن مُتأدِّب مُبدع!
د. مصطفى الحلوة
(رئيس الاتحاد الفلسفي العربي)
مدخل / كتابٌ عميقةٌ موضوعاتُهُ عُمقَ الوديان وضاجَّةٌ تردُّداتُ أصدائه:
في الهزيع الأخير من العام المنصرم ، ومن على منبر “مركز الصفدي الثقافي” ، جاءنا الكاتب والحقوقي د. سابا قيصر زريق بمؤلَّف جامع ، راقٍ مضمونًا وأنيقٌ أسلوبًا وشكلاً . هو حصيلةُ رُبع قرن من العصف الفكري والخوض في مجال علم اجتماع السياسة ، مُترجِّحًا بين الكتابةِ السرديّة والكتابة الأدبية الإبداعية .
الثامن والعشرون من كانون أوّل 2022 ، كان يومًا مشهودًا إذْ احتشد ، احتفاءً بهذا الكتاب ، جمهورٌ كثيفٌ ، أتى من طرابلس والشمال ، ومن مناطق لبنانية شتّى . ولقد تخيَّر الكاتب : “من كلِّ وادٍ صدى” عنوانًا لمؤلَّفِهِ ، بما يؤشِّرُ على عمق موضوعاته ، كما عمق الوديان ، وعلى ما تُحدثُ هذه الموضوعات من تردُّداتِ ، كما الأصداء في منعرجات الأودية!
ومن موقع الأصالة والوفاء للفيحاء، بل من موقع عشق الكاتب لمدينتِهِ، كان له أن يُعلن، على رؤوس الأشهاد، أنَّ طرابلس “كانت وما زالت لي ملاذًا، على بؤسها، وحضنًا لا يرتاحُ قلبي إلى سواه ، أجدُ فيه الطمأنينة والأمان. فكان لها، كما لمعالمها وعلمائها وأعلامها، حيِّزٌ واسعٌ في مؤلَّفي”( من كلمة الكاتب في حفل توقيع كتابه/ 28 كانون أول 2022).
وإلى هذا الوفاء لمسقطه، كان للجَدّ، شاعر الفيحاء سابا زريق، كبيرُ أثَرٍ في تشكيل كاتبنا، فطفق يتخذه نبراسًا، وراحت تضجّ في مسامعه وصيَّةُ ذلك الجدّ العظيم:”ولاءٌ للوطن، وحُبٌّ للدين بنبذِ الطائفية البغيضة، وعشقٌ للعربية الفصحى”. هكذا راح سابا الحفيد يلتزمُ هذه الفضائل الثلاث، وسعى جاهدًا إلى تجسيدها، كما لو أنها انتقلت إليه بحكم الوراثة الجينيّة، “فاستوطنتني- والقولُ له- وسيطرت على مشاعري ووجَّهت خطواتي” ( من كلمته في حفل توقيع الكتاب). ولقد أعلن الكاتب أنّ جدّه ملهمُهُ إلى الرمق الأخير”، وليُضيف: “.. فهو مثلي الأعلى في الحياة، في كل ما أقدمتُ وما أُقدمُ عليه (..) كانت تربطني به صداقةٌ، قلَّ نظيرها بين جدٍّ وحفيد (..) فكان يتعاطى معي صغيرًا، وكأنِّي بلغت (..) وكان يصقلُ شخصيتي دون أن أشعر، منمِّيًا عندي روحَ التجلِّي والتحدّي وصدق القول والتسامح والتفاني وحب الغير والخدمة العامة والإقدام والغفران” (ص ص: 151- 152).
هكذا كان لسابا قيصر زريق أن “يحفظ الدرس”، درسَ جدِّه، وغدا على صورتِهِ، يتمثّلُهُ دائمًا نُصبَ عينيه، ويترسَّمُ خُطاه في الشهادة لزمنه، وشهادة المرء لزمنِهِ هي أعظمُ الشهادات، ويجهرُ بالكلمة الحُرَّة، وينحازُ إلى الحقيقة، بكلِّ عُريها ” وكما خلقها ربُّها”! وعلى غرار الشعار، الذي أطلقتهُ يومًا جريدة “السفير”، فكانت “صوتَ الذين لا صوتَ لهم”، أرادَ سابا الحفيد “أن تكون مقالاتُهُ ألسنة الأحوال، أحوالَ مَن لا حولَ لهم!” (من التمهيد، ص 9).
كيف لا يكون سابا، على ما هو، وقد رأى مواطنيه “يتخبّطون في فقرهم، والساسةُ يتربّعون على عروش فارغة، ويتبارزون في عُهرهم وجهلهم (..) يغتالون الوطن، وينهشون في جسدِه النحيل، بعد أن جرّدوه من ماهِيّتِهِ” (من التمهيد، ص 9).

“من كل وادٍ صدى”/ لونًا معرفيًّا وأبوابًا ومنهج بحث
لقد أصاب المحامي الأديب شوقي ساسين كبدَ الحقيقة، حين نصحَ لسابا قيصر زريق أن “يُنقذَ مقالاته، على خلافها، من استهلاك الجريدة اليومية، ويجمعها في كتاب”. كما كان له أن يُثيرَ حميَّة كاتبنا ومخاوفه في آن، حين توجّه إليه بالقول:”ليس من العدل ترك هذه المهمة لحفيدٍ له، يُؤدّيها عنه، نظيرَ ما صنع هو مع جدّه”(من مقدمة الكتاب، ص 8). ونُضيف من جانبنا أن جمع مادة الكتاب جاء في موضعه زمانيًّا، كون المقالات السياسية “الساباوية” لا زالت تحتفظ بألقِها وبراهنيّتها، على رُغم مرور ربع قرن على كتابة بعضها. ولعلّنا، في هذا الصدد، نرى أنّ التاريخ لا يُعيدُ نفسَهُ إلاّ في هذه المنطقة التعِسة من العالم – ونحن اللبنانيين في عِدادِها- فالماضي يبقى ساكنَنَا ولا نتعظ من تجاربه، ولا نُفيدُ من دروسِهِ والعِبَر!
أ- في اللون الأدبي/ المعرفي للكتاب:
ينتمي هذا الكتاب إلى فنّ المقالة السياسية والأدبية. وهذا الفن – أي فن المقالة- كما هو معلومٌ عرفه الغرب، منذ بضع مئاتٍ من السنين، حيث يعكف الكاتب على مقاربة قضية محدّدة، في صفحات معدودات، فيُضيء عليها إضاءة مكثّفة. وقد انتقل هذا اللون الأدبي إلى الغرب، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وعرف انطلاقته لدينا، في عصر النهضة، مع انتشار الصحافة، في مصر ولبنان. وتكمن أهمية هذا الفن، أن المقالة نصٌّ تسهُلُ قراءتُهُ. وهو غالبًا ما يُوضع بلغة سهلة، وبأسلوب يترجّح بين العلمي والأدبي، وفق طبيعة الموضوع الذي يتوفَّرُ عليه الكاتب.
ب- ” من كل وادٍ صدى”/ أبوابًا وعناوين
إلى التمهيد بقلم الكاتب سابا قيصر زريق ، ومُقدمة ، بعنوان ” سياحة بين الأصداء ” ، أبدعها قلم الأديب المحامي شوقي ساسين ، تتوزّع نصوص الكتاب (عددها 99 ) على خمسة أبواب ، جاء أوّلها ، بعنوان : “مقالات في الصحف”.
هذه المقالات ، تتموقع زمانيًّا بين عامي 1999 و 2021 . وقد بلغ عددها خمسًا وثلاثين مقالة ، نُشرت في الصحف والمجلات اللبنانية وفي مواقع الكترونية. علمًا أن ثماني منها أُعدّت للنشر ولكنها لم تُنشر ، لأسباب لم يذكرها الكاتب. إنّ نصوص هذا الباب تمتدُّ على مائة وثلاثين صفحة (من الصفحة 17 إلى الصفحة 147 ) . أما الباب الثاني ، فهو يضمُّ خمس عشرة مُقدِّمة ، وضعها الكاتب لخمسة عشر كتابًا ، جميعُها من منشورات “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية ” . وهي تشغل ستًّا وسبعين صفحةً (من الصفحة 149 إلى الصفحة 224) . وقد أُدرجت تحت عنوان “مقدّمات كُتُب”.
عن الباب الثالث ، وعنوانه ” مقابلات مع وسائل الإعلام ” ، فقد تضمَّن خمس مقابلات مع الكاتب ، اثنتان منها إذاعيتان والثلاث الباقيات هي مقابلات صحفية . وتدور هذه المقابلات حول الثقافة والسياسة والانتخابات النيابية ، وحول “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية ” والدور الذي تؤدّيه في الفضاء الثقافي الشمالي واللبناني . وهذا الباب هو أصغر الأبواب الخمسة ، يمتدُّ على خمس وأربعين صفحة (من الصفحة 225 إلى الصفحة 269 ) . أما الباب الرابع ، وهو أكبر الأبواب حجمًا ، إذْ تشغل نصوصه مائة وثلاث وثمانين صفحةً (من الصفحة 271 إلى الصفحة 453 ) ، فهو ذو طابع “كشكولي” – إذا جاز القول- يضمُّ كلماتٍ للكاتب ومحاضرات ورسائل مختارة ، بلغ عددها ثلاثًا وأربعين.
هذه النصوص تُغطِّي المرحلة ، التي أطلَّ فيها سابا زريق على طرابلس الثقافة والحَراك الفكري النشِط ، وكان أحد كبار عرّابيها ومحتضنيها . وقد امتدت الفعاليات الطرابلسية بين عامي 2013 و 2021 . أما الباب الخامس ، فهو يضمّ دراسة مُسهبة من ست وثمانين صفحة ، تدور حول شاعر الفيحاء سابا زريق ، وقد أدرجت تحت عنوان : ” شاعر الفيحاء سابا زريق (1886 – 1974) في صفحات ” . أعدَّها سابا الحفيد في العام 2014 ، مُتوجِّهًا بها إلى المعنيين بالشأن الثقافي والأدبي ، وتمّ توزيعها ، ضمن كرّاس على طلبة المدارس والجامعات . هذه الدراسة تستعرض أبرز المفاصل والمحطّات في سيرة شاعر الفيحاء وفي مسيرته الأدبية ، والفنون التي نظم فيها . وقد وُضعت بلغة سهلة . وعلى رُغم إحاطتها إحاطة “بانورامية ” بشاعر الفيحاء ، فهي لا تُغني عن العودة إلى الآثار الكاملة” لهذا الشاعر الفذّ.
لا بدّ أن نشير، بعد هذا الاستعراض المقتصد لمحتويات الكتاب، إلى أن الأبواب الخمسة، على رُغم التباين بين موادها، فهي محكومة بنَفَسٍ واحد، واقتناعات واحدة، وثوابت راسخة لدى الكاتب. فهو لم يتزحزح، قيد أنملة، عمّا باح به قلمُهُ، ولم تتبدّل اقتناعاته، منذ أن باشر إطلالاته الكتابية، طوال ربع قرن. وقد أشار إلى ذلك في “التمهيد”، إذْ يقول:”.. إن قناعاتي لم تتبدّل، بإزاء الأحوال المتبدِّلة والمتلبّدة، في بلدٍ تائهٍ في محيطه، وحائرٍ في انتمائهِ، ما ينفك يفتّش عن هُويّة، في كومة من هُويّات تتنازعُهُ”( من التمهيد، ص 11).
لا بُدَّ من لفت النظر إلى أنّ الباب الأول يصلح أن يكون كتابًا مستقلاً، قائمًا بذاتِهِ، كونه ينتمي، بنصوصه جميعها، إلى الأدب السياسي، بل إلى علم اجتماع السياسة. ومما يُعزِّز عزوَنا هذا الباب إلى علم اجتماع السياسة، ذهاب الباحث زريق إلى ملاقاتنا، عند هذا الرأي، إذْ يقول:” كتبتُ في السياسة، وذهني مشغولٌ في الاجتماع” (التمهيد، ص 9).
كما أن الباب الخامس هو، بطبيعتِهِ، مستقلٌّ بذاتِهِ أيضًا، فقد صدر في إطار كرّاس Brochure ، وتمَّ توزيعه، كما أسلفنا، على مهتمين، لا سيما على طلبة المدارس والجامعات، تعريفًا بشاعر الفيحاء سابا زريق.

ج- في المنهج البحثي المتّبع والجنوح إلى الأكاديميا
تبعًا لموضوعات الكتاب، التي حوتها أبوابُهُ الخمسة، فقد كان للمؤلِّف أن يتوسَّل عدة مناهج، في رأسِها المنهج العلمي التحليلي، بشَقَّيهِ الاستقرائي (induction) والاستنتاجي الاستنباطي (Déduction)، لا سيما في الباب الأول، وهو الأكثر “دسامةً” بين سائر الأبواب. إضافة إلى الباب الثاني (مقدّمات كتب). فقد عمد الباحث زريق إلى تفكيك الظاهرة أو الأطروحة، التي يتصدّى لها بالمعالجة، فيغوص عليها تحليلاً، ويُقلِّبُها على جميع وجوهها، حتى يستنفد ما فيها من عناصر، وما تشي به من دلالات. وهو لم يلجأ إلى تدوير الزوايا، بل قال الأشياء كما هي، إلى حد الفجاجة أحيانًا. ولا عجب، فهو، من خلفيّتِهِ القانونية، كان يرى أنْ لا اجتهاد بإزاء الحقائق العارية، ولا تأويل لإيجاد مخارج معيّّنة، ولا التماس أعذارٍ لمن أجرموا بحق شعبهم، وساموهم سوءَ العذاب، فراح يُصْليهم بشواظٍ ناره! وكثيرةٌ هي الشواهد، التي يُمكن التمثّل بها. وقد مرّ معنا، في موضع سابق من هذه الدراسة، رمي الطبقة الحاكمة بالعُهر، وبما يُماثل هذه الصفة!
استكمالاً، على صعيد المنهج، فقد استخدم الباحث زريق المنهج السردي الوصفي، لا سيما في الدراسة، التي أعدّها، حول جدِّه شاعر الفيحاء سابا زريق (الباب الخامس)، حيث استقى معطيات الدراسة من “الآثار الكاملة”، ووشّحها بكلمات، في شاعر الفيحاء، من لدُن كوكبةٍ من المشتغلين بالفكر والنقد الأدبي، كما كان للمنهج المقارن حضورٌ، في بعض النصوص المنتمية إلى مختلف أبواب الكتاب، لا سيما الباب الثاني. وقد تبدّى ذلك جليًّا، عبر إشارة الباحث إلى التّناص، بين كتّابٍ لدينا وكتّاب أجانب (غربيين)، مما يدلُّ على ثقافتِهِ الواسعة، وإطلاله على الآداب الأجنبية.
ولقد كان للمؤلِّف زريق أن يتوسَّل الأسلوب العلمي في صوغ نصوصه السياسية، وقد عزا المحامي والأديب شوقي ساسين ذلك إلى “.. شدّة مراسِهِ في أداء الكتابة القانونية (التي) وسمت أسلوب سابا بدقة أداء المعنى ، والبُعد عن المحسّنات اللفظية والبديعية، والسعي إلى تمكين القارئ من إدراك المقاصد دون عناء”، ناهيك- والقول لساسين- ” استشراء المنطق في خلايا الحروف”. ( من التمهيد ص 8، سندًا إلى كلمة الأديب ساسين في تكريم المؤلّف، في مؤتمر أدباء طرابلس الخامس ، ص 152 ).
– وفي عودة إلى المنهج العلمي التحليلي، عبر محطة ثانية، فقد توسَّلَهُ الكاتب في الباب الثاني (مقدّمات كُتُب). ولنا أن نتوقّف عند نموذجين إثنين، أولهما في مقاربة كتاب المهندس لامع ميقاتي ” من ساحة التل إلى الحيّ اللاتيني”، وثانيهما في مقاربة كتاب العالم د. محمد الحجيري “بين الحنين وصادق القول كان أبي”.
عبر النموذج الأول، فقد وضع المؤلِّف مقدّمةً مُسهبةً (13 صفحة)، اعتمد فيها التبويب والتبنيد” (من بَند)، وتقسيم موضوعه إلى مسائل/ قضايا (Thèmes)، تتفرّع من كل واحدةٍ عدة نقاط. وهذا يدل على نهج علمي منطقي صارم.
هكذا كان له أن يتوقف عند نقاط أربع: شخصية المؤلف، وقد اندرج تحتها: بوهيمي ونوستالجي بامتياز/ شهيّتُهُ وشهوتُهُ/ نزعة أصولية/ فيلسوف.
وفي مسألة أخرى، عنوانها :” الأبواب التي طرقها في مقالاته”، أدرج تحتها البنود الآتية: الحفاظ على التراث والإرث/ العروبة وتراجع العرب/ الغرب ودوره في محيطنا/ الطائفية والمذهبية والدين/ أهمية المجتمع المدني. وفي مسألة أخرى، حول أسلوب الكاتب ميقاتي، أورد نقطتين: النقد الساخر/ أبواب أخرى. ثم كانت الخاتمة، خلص فيها إلى الآتي:” وأخيرًا شبّهتُ هذا الكتاب بسوبر ماركت، حيث يمكنك أن تبتاع معجون أسنان أو أرزًّا، أو صحيفة أو مواد تنظيف، فهذا التنوّع يجعل من السوبر ماركت مقصِدًا، كما تجعل مقالات لامع، من كتابه، مرجعًا لمواضيع عديدة ومتنوّعة (..) فهنيئًا لنا هذه الموسوعة المصغّرة” (راجع، ص ص : 190- 202). كأننا بالباحث سابا، يقول في لامع ما قاله أبو عثمان الجاحظ في الأديب الموسوعي “الملمّ من كل علم بطرف”، أي بجزء!
أما بما خصّ د. الحجيري، فقد نهج الباحث زريق النهج عينَهُ، وترسّم الخطى التي سارها مع المهندس لامع ميقاتي، فكان هذا السيناريو: المقدّمة/ محمد الحُجيري الإنسان، وتضمّنت هذه النقطة العناوين الفرعية الآتية: الوالدان- مساعدة الغير- نبذ الطائفية- التواضع – الأدب- عزة النفس- الحنين. وفي نقطة ثانية، عنوانها : محمد الحجيري العصامي، ولتتبعها نقطة ثالثة: محمد الحجيري العالم، ومن ثمَّ العبور إلى نقطة رابعة: محمد الحجيري الفيلسوف، وأخيرًا الخاتمة.
وعلى نهج النقّاد “المحترفين”، يقول الكاتب زريق تعليلاً لهذا التقسيم: “لو أردتُ تبويب هذا الكتاب، من وجهة نظر ناقد،لأعطيتُ لمضمونه من العناوين أربعة، هي بمثابة صفات وسِمات للكاتب، تَرشحُ من قلمه: محمد الحجيري الإنسان، محمد الحجيري العصامي ومحمد الحجيري العالم، وأخيرًا محمد الحجيري الفيلسوف (ص 209).
وإذْ نروحُ إلى الباب الرابع، تستوقفنا محاضرتان، ترسَّم الباحث زريق فيهما نفس النهج، الذي اتبعه في مُقدِّمات الكتب التي ألمعنا إليها. فمن منطلق منهجي حرص على وضع تصميم، أي خريطة طريق لكل من هاتين المحاضرتين.
ففي محاضرة، عنوانها :” الدين والدنيا في شعر شاعر الفيحاء سابا زريق” (24 صفحة)، ألقاها في “صالون فضيلة فتال الأدبي” (طرابلس)، أسفَرَ عن باحث متمرِّس في ميدان الفكر. فقد مهّد لأطروحته بمقدمة، هي بمنزلة مدخل إلى موضوعه، وأتبع هذه المقدمة بقسمين. في القسم الأول، عنوانه: ” واقع الدين في الدنيا”. استعرض العلاقة الجدلية بين هذين المعطيين (الدين والدنيا) بشكل عام. وقد جاء هذا القسم ليُشرِّع السبيل أمام القسم الثاني “مُرتجى الدين من الدنيا”، وهو الذي ينكبُّ تخصيصًا على شاعر الفيحاء، في تعاطيه الدين والدنيا. وقد أسند الكاتب زريق بحثه بعددٍ وافٍ من القصائد، وأفلح في تحليلها والإفادة منها. ثم كانت الخاتمة، التي أوجز فيها ما خلصت إليه الدراسة (راجع الباب الرابع، ص ص : 384- 407).
وأما عن المحاضرة الثانية، عنوانها :”الموضوعية في حياتنا، ميزان ذهب” فهي على غرار سابقتها، من حيث التزام المنهج العلمي التحليلي. وقد نمّت عن امتلاك الباحث ثقافة عميقة وذات مروحة واسعة. إشارةٌ إلى أن أطروحة الموضوعية تُعلنُ عن نفسها في تضاعيف “من كل وادٍ صدى”، وبذا، فإن سابا زريق، محاضرًا فيها، يغدو شاهدًا عَدْلاً، ويصحُّ القول فيه “وشهد شاهدٌ من أهلها!” . وقد كان مقرّرًا إلقاء هذه المحاضرة في “رابطة الجامعيين في الشمال”، بتاريخ 9 آذار 2020، ولكن بسبب الظروف القاهرة آنذاك، لم يتم الإدلاء بها (الكتاب) ص ص: 384- 407). وحسنًا فعل الباحث زريق بإيرادها في هذا المؤلَّف، فهي على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية.
استكمالاً، وبما يخصُّ التزام الكاتب زريق الموضوعية، وهي من ركائز البحث العلمي، فقد كانت رائده، وكان لها أن تسِمَ جميع كتاباتِهِ، فلم يصدر عن هوى، فجاءت آراؤه مُترعةً بصُدقيةٍ عالية. ولعلّ جنوحه إلى العلمانية، لا سيما العلمانية السياسية، جعله بمنأى عن الأهواء الطائفية والمذهبية، والنزوعات السياسية الضيقة، القائمة على الأدلجة والدوغماتية. هكذا كان يأتمُّ بالعقل، مُستهديًا، في هذا المقام، قول أبي العلاء المعري: ” كذِبَ الظنُّ لا إمامَ سوى العقل/ مُشيرًا في صبحِهِ والمساء”.
علمًا أن كاتبنا قد قارب مفهوم الموضوعية، في إحدى مقالاته السياسية، فرأى أن “.. للموضوعية أحكامًا، وأبرز سماتها الإنصاف والعدل ووزن الأمور بعينٍ مجرّدة” (مقالة: الأكثرية الصامتة والخط الثالث، ص 40).
وفي موضوع آخر، حول الحقيقة، وهي ربيبة الموضوعية، يذهب إلى القول: ” فالاعتدال يقضي أوّلا ً بأوّل بألاّ يكون الإنسان مُنحازًا، بشكل أعمى، إلى ما يعتقد أنه الحقيقة الوحيدة، أو متمسّكًا بعنادٍ غير مبرّر، بما هو يعرف تمامًا أنه مُغاير لحقائق ثابتة، بحجة أن حقائق الغير أوهام (..) إذْ انه ليس هناك من حقيقة مطلقة إلاّ حقيقة واحدة، ألا وهي أنّ الله واحدٌ أحد”(مقالة: الموضوعية والحقيقة المطلقة”، ص 81).

ح – في العقل “الساباوي” المنفتح والرؤيوي
قضايا كثيرة، بل شؤونٌ وشجون “لبنانية”، شغلت فكر سابا زريق وأقلقتهُ، ولمّا تزلْ شاغلته. فهذه القضايا مُقيمةٌ لدينا، على مدار الأيام والسنين، هي هي ، لا تخضع لسُنّةِ التغيير، بل هي، إذا جاز التعبير، كما الحسابات المالية في الشركات، التي لم تُصرفْ، فتخضع للتدوير من عام إلى عام! أجل! هي قضايا، بل مُعضلاتٍ إشكالية، خلافية بين المشتغلين بالشأن العام، كما بين الناس العاديين، وإن بنسبة أقلّ!
وإذْ نستعرض بعض هذه القضايا / المعضلات ، نجد أن الباحث زريق ، لم يُغادر أيّ عنوان من العناوين التي استحكمت بالعقل اللبناني ، منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمن.
– فمن مقال ، بعنوان : العلمنة وعُقدة الانتماء ” ( كتب هذه المقالة في العام 1996) ، يذهب باحثنا ، عبر رؤيا ثاقبة ، إلى جدل العلمنة / الطائفية، فيخلص إلى ” أنّ الطائفية عبدٌ لمن يُجيدُ استمالتها والتغرير بها ، كلما نادته المطامع ، للعب دور ما ، فتُستلُّ السيوف وتُقطعُ الرؤوس وينتصر المؤمنون ” (ص 19) . وأما عن العلمنة ، التي يدعو إليها الكاتب ، فهي ” علمنة تكتب تربيتنا المدنية الجديدة / علمنة تُساعدُنا على مواكبة ركب التطوّر / علمنة تُتيح الفُرص للجميع / علمنة تحرّر السياسة والمجتمع من الجمود القاتل / علمنة تُسيِّج الوطن من الأهواء والخطب / علمنة تُعلّمنا أنّ الطائفية عدوّة الدين اللدودة / علمنة تصونُ حرّياتنا العامة والشخصية / علمنة تعطي الجواب الشافي عن تساؤلات ، عمرها عمر الزمن / علمنة تفكّك عُقدنا وتعلّمنا كيف ننتمي إلى وطن ” (ص ص : 21 – 22 ).
يتحصّل مما سبق أن العلمنة ، التي يدعو إليها الكاتب ، تُفضي ، نهاية المطاف ، إلى قيام الدولة الحديثة ، دولة المواطن ، دولة القانون والمؤسسات، دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفُرص . بل هي تُسدلُ الستار على المشكلات / المعضلات التي يتخبّط فيها اللبنانيون، منذ عقودٍ مديدة . استزادة من المسألة ، وفي طمأنة للمتخوّفين من العلمنة ، يُوضح الكاتب بأن “العلمنة السياسية لا تمسّ بحقوق الطوائف الدينية ، ولا بحُريّة ممارسة شعائرها ، ولا بأحوالها الشخصية (..) إنّ المطروح ، وبكل بساطة ، هو عدم تحكّم الطوائف بالمناصب السياسية في البلد ، على حساب المؤهّلات والكفاءة ، والأخلاق والنزاهة ” . وعن تكريس العلمنة وتأصيلها : “يكون جاهلاً من يعتقد أنه يمكن إرساء العلمنة السياسية في لبنان عن طريق تعديل النصوص فقط . فالطائفية مُتأصّلة في العقول و متجذَّرة في النفوس ، ينبغي تحييدها في مرحلة أولى، تمهيدًا لإلغائها كليًّا مع تقادم الزمن الشافي ” ( من مقالة :” العلمنة السياسية خطرٌ وهمي” – كتبها 1999 ، ص 32 ).
كأننا بالباحث زريق يرى إلى الطائفية مرضًا عُضالاً ! أجل؟، هي كذلك ، بل وصفها يومًا الأديب الراحل مارون عبود على أنها “جَرَبٌ روحي!”.
وفي هذا المجال ، يضيف الكاتب زريق : ” لا يتصوّرنَ أحدٌ أنّه يجب إِنتظار تنقية النفوس من مفاهيم الطائفية السياسية ليُباشَرَ بترسيخ العلمنة السياسية في النصوص. فإذا لم تستهدف المحاولة العقل والنص في آن معًا ، قد تفوتُ فُرصة إنجاحها ” (ص 32 ) . هكذا ينبغي العمل على خطين متوازيين ، وفي آن واحد : إلغاء الطائفية المتجذّرة في العقول والمتمكّنة من النفوس ، وتكريس العلمنة في نصوص مكتوبة.
– في الدعوة إلى مجتمع جديد ، تسودُه دولة القانون والمؤسّسات ، و يُشكِّل قطيعةً باتَّةً مع مجتمعنا الراهن ، يرى باحثنا ، من خلال مقالة، عنوانها “مزالق الانتماء في السياسة اللبنانية والقاسم المشترك ” (كتبها في العام 1999 ) : ” أن استخراج قواسم مشتركة أمرٌ يسير ، لا يُقتصر مخاضُهُ على فردٍ منّا ، بل على مجتمع جديد ، يشترك في نظرة موحّدة وواحدة إلى دولة قانون ومؤسسات ، وإلى وطن عصري ، يتطلّع إلى مستقبل تعِدُ به طاقاتٌ ولا أكبر وثروات ولا أغنى” (ص 25) . ولا شك أن مجتمعًا ، كالذي يدعو إليه ، بحاجةٍ إلى جهد جمعي ، كون معضلاتنا هي بحجم وطن!
– وأما عن الحوار ، بل معزوفة الحوار ، التي يشهدُ لبنان فصولها ، منذ ما يزيد على ستة عقود ، والتي انطلقت خمسينيات القرن الماضي ، مع أفرقاء ، غالبيتهم رجال دين من مختلف الطوائف ، فقد كان ذلك الحوار يخفت حينًا ثم يستفيقُ على إيقاع خلافات وإشكالات مُتعدِّدة . وقد قارب باحثنا أطروحة الحوار، عبر مقالة عنوانها : “حوار الوقت الضائع وفُرصة استدراكه ” (كُتبت في العام 1999) . فهذا الحوار ، بحسب الكاتب، والذي خاض غماره اللبنانيون ، حول معظم قضاياهم ، وكانت جولات إِثر جولات ، لم يفْضِ إلى أية نتائج ملموسة . وفي مواجهة الفشل الذي مُني به المتحاورون ، فهو يدعو “إلى حوار مدني ، إذا صحّ التعبير ، ينطلق من قواعد أهلية ، تأكل العصيّ يوميًّا . وهو ينبغي أن يكون حوارًا موضوعيًّا ، لا يُستثنى منه أو يُستبعد عنه أيّة شريحة من شرائح المجتمع اللبناني ، إلى أية طائفة أو منطقة انتمت. حوار يدورُ حول جدول أعمال واضح وشفّاف ، يتطرّق إلى كافة المواضيع الخلافية ، التي تُزعج اللبنانيين ، من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية وتنموية” (ص 28 ).
استكمالاً حول الحوار ، من خلال مقالة عنوانها : “مفاهيم الحوار وعثراته”(كتبها في العام 2006 ) ، يخلص الكاتب إلى ” أنّ حواراتنا حوارات طرشان ، همُّها أن تخلق جدلاً بيزنطيًّا مقصودًا ، بغرض الإعاقة . فالكل على استعداد للحوار، من موقعه ، دون أن يخطو خطوة على الأرض لملاقاة مُحاوره ” (ص 70). ويُضيف ، عبر المقالة عينها : “إن الحوار عملية إرادية ، فلا نجعل تعثّره في الماضي سببًا لعدم الخوض به مجدّدًا ، بصدقٍ وصراحة وانفتاح ” (ص 71 ) . بيد أن أهمّ ما في هذه المقالة أطروحة التربية على الحوار والمواطنة،لا سيما للناشئة . ولن يكون ذلك إلاّ عبر المؤسسة التربوية التعليمية:”المطلوب أن تُلقَّنَ مبادئ الحوار الصحيح والجريء والصادق والأمين، كما تُلقِّن الأبجدية، على مقاعد الدراسة ، وأن تُضمَّن هذه المبادئ مفهوم المواطنة ، كتربية مدنيّة ، بحيث ينمو هذا المفهوم في ذهن التلميذ ويُسلّحه ، ليأتي انخراطه في المحيط الأوسع ، وهو طالب ، مُبرمجًا على اتخاذه بنفسه القرارات والمواقف، التي يرى أنها لمصلحة بلده ، بتجرّد ودون وصاية وصي ” (ص 72).
– التحذير من عدوّ الخارج الطامع في بلادنا ، والذي يلعبُ على التناقضات لتحقيق أغراضِهِ الخبيثة ، فكانت دعوة ، أطلقها سابا زريق ، من خلال مقالة (كتبها في العام 1999 ) ، بعنوان ” عندما يكون الماضي عبئًا على المستقبل . وقد جاء فيها : “إِيّاكم ، أيّها السادة ، من بابل جديدة. إِذْ أنّه إذا لم تُنبذ لغات الأمس، ولم نُباشر التكلّم باللغة نفسها ، جاء من يُتقن لغاتنا ، على اختلافها ، للإجهاز علينا ” (ص 30 ).
– حول “وثيقة الوفاق الوطني اللبناني ، أو ” اتفاق الطائف” ، كانت مُطالعةٌ وافيةٌ (13 صفحة) من لدُن الكاتب ، عنوانُها : ” الطائف سقفٌ وطني أم غطاءٌ للحكّام ؟ ” (كتبها في العام 2005 ). وقد خلص إلى الآتي : “إِستعمل الجميع الطائف مطيَّةً ، وأكثر من ذلك ، ليُمعنوا في ممارساتهم الشائنة ، فهم لو أرادوا حقًا بناء بلد ، على أساس المبادئ التي أطلقوها في وثيقة الطائف ، لكانوا بادروا، على سبيل المثال وليس الحصر، إلى تأليف هيئة لإلغاء الطائفية السياسية – والطائفية علّة عللنا – وإلى إجراء الإصلاحات الأخرى ، التي نادى بها الطائف” (ص66). علمًا أن هذه الإصلاحات تشمل تكريس اللا مركزية الإدارية ، وإلغاء القيد الطائفي في الانتخابات النيابية ، بعد استحداث مجلس الشيوخ، ووضع قانون عصري للانتخابات النيابية ، على أساس النسبيّة والدوائر الموسّعة.
– عن الديمقراطية التوافقيّة ، تلك البدعة ، بل الهرطقة الدستورية ، فقد كان للباحث فيها قولٌ فصلٌ ، عبر مقالة ، عنوانها : “الديمقراطية التوافقية وسلاح المقاومة” (كتبها في العام 2006 ) ، ومما جاء فيها : “إن تسمية الديمقراطية التوافقية تناقضٌ في الأساس والمفهوم” ( ص 73 ).
وبعد مُضيّ خمس عشرة سنة على هذه المقالة ، كان للكاتب زريق أن يُعاود الحديث عن هذه الديمقراطية الهجينة، في مقالة له، عنوانها: “دربُ المثالثة .. جُلجُلةُ لبنان ” (كتبها في العام 2021 ) ، فيقول : ” كُرِّست ، منذ ذلك اليوم (أي مع وثيقة الطائف) ديمقراطية توافقية. كلمتان متناقضتان، تكره كلُّ منهما الأخرى . ديمقراطية هجينة ، عزّزتها محاصصة ، نتيجة توافقات ، منها ما تمَّ علانية ، مثل اتفاقية الدوحة (2008) ، ومنها ما حُبِكَ وما زال يُحبَكُ تحت الطاولة ، كلما تواءَمَ ظرفٌ مصلحيّ مع ذلك ” ( ص 112 ).
– وبما يخصّ “الهُويّة الحائرة ” (كتبها في العام 2009) ، فهي تُضاد الهُويّة الوطنية الجامعة . وفي مواجهة الهويات الدينية ، الطائفية والمذهبية . يدعوها المفكر أمين معلوف هويّات قاتلة – وهي موضع تجييش واستغلال ، من قِبل السياسيين ، مُستغلّي نقاط الضعف ، لدى الجمهور، ويعزفون على أوتار الطائفية، ومن خلال التواطؤ بين هؤلاء السياسيين وغالبية المرجعيات الدينية ، بحيث يكون تسييسٌ للدين وتديينٌ للسياسة ، يُطلق الباحث زريق دعوة خالصة لوجه مواطنة جامعة : “فليكن ديننا لبنان ، ومذهبنا لبنان ، وهوّيتنا لبنان . ولنخرج من حيرتنا ، من أيَّ موقع أتينا ، ولأيّ دين أو مذهب انتمينا . ومهما كانت ميولنا الحزبية أو السياسية ، فلنمارس شعائرنا باسم لبنان ، ونختلف باسم لبنان، ونتخاصم سياسيًا ، لمصلحة هويّة وطنية لبنانية مشتركة ” (ص 89 ).
– عن الطائفية، كانت مقالة ، عنوانها : ” زوبعة طائفية في وعاء ديمقراطي” (كتبها في العام 2016 ) ، في معرض مقاربتِهِ نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس ، للعام 2016 ، والتي لم تُسفر نتائجها عن فوز أي عضو مسيحي ولا علوي في هذه الانتخابات . وقد كان الفوز لأربعة وعشرين عضوًّا من الطائفة السُنيّة . وقد رفض الباحث المنطق الطائفي التسووي ، حيث راجت أخبارٌ عن استقالة عضوين من المجلس البلدي، إفساحًا في المجال لعضوٍ من الطائفة المسيحية وعضوٍ من الطائفة العلوية . وفي رأي الكاتب أننا يجب أن نتقبّل النتيجة، طالما أننا احتكمنا إلى العملية الديمقراطية . وقد تساءل ، هل وجود عضو بلدي مسيحي ضروري كي يمثل مصالحي كمسيحي ؟ وعليه ، كان له أن يستنكر ما وصلنا إليه جرّاء المرض الطائفي المستفحل : “إِلاَمَ تستبدُّ الطائفية والمذهبية في نفوسنا ، والعالم أجمع يتقدّم ، ونحن على تراجع بسببهما؟”(ص101).
وفي مقالة أخرى حول الطائفية ” تعالوا نتكلّم المسيحية بلكنة مشرقية ” (كتبها في العام 2013 )، رأى ” أن عدم معالجتنا لدائنا الأكبر ، المتملّك منّا، أي الطائفية ووليدتها المذهبية ، كفيل بالإتيان على صيغتنا المميّزة في هذا الشرق” (ص 96 ).
– في مقالة ، عنوانها ” درب المثالثة جُلجُلة لبنان ” (كتبها في العام 2021)، وقد سبق التمثّل بهذه المقالة ، أبدى الكاتب معارضة شديدة لعقد “مؤتمر تأسيسي” بهدف تكريس المثالثة بين المسيحيين والسُنّة الشيعة ، وجَهَرَ بالقول : “.. لا يصحّ أن نلجأ إلى أي مؤتمر تأسيسي جديد لإعادة تأسيس ما هو مؤسّس أصلاً (..) هل حان الوقت يا تُرى لتعديل دستور الطائف لإرساء المثالثة ؟”(ص 113).
– عن الميثاقية ، صنيعة الطائفية ، كان له في مقالة ، عنوانها “الميثاقية المزعومة ” (كتبها في العام 2021 ) ، يرى إليها العدوّ الأول للمواطنة : “لا تعدو كونها شعارًا فضفاضًا ، يُوظّفُ سياسيًّا . أوَلَيست الميثاقية صنيعة الطائفية اللقيطة، تضرب المساواة بين المواطنين ؟ أوَلَيست هي العائق الأكبر أمام ترسيخ العلمنة السياسية والنظام المدني ؟ أوَلَيست هي العدو الأوّل للمواطنة الصحيحة ؟ هل أجهَزَ يومًا عاملٌ سيّئٌ على النموذج اللبناني أكثر مما فعلتها الميثاقية المزعومة ؟” (ص 119).
– في مقاربة باحثنا أطروحة العيش المشترك ، فإن الأكثر إلحاحًا ، في عُرفه ، تكريسُهُ بين المسلمين أنفسهم ، سُنّة وشيعة ، وليس بين المسلمين والمسيحيين: “بمجرّد التلفّظ بهذا التعبير ، يشرد الذهن في عالم التعايش المسيحي الإسلامي ، بينما الكلّ يُدرك ، تمام الإدراك، أن مفهوم العيش المشترك، في أيامنا هذه ، ينطبق تمامًا على التعايش ، ليس بين المسيحيين والمسلمين ، بل وربّما ، على نحو ملحّ أكثر ، بين السُنَّة والشيعة (الميثاقية المزعومة ، ص 117).
– عن التعددية في الاجتماع اللبناني ، ومن خلال مقالته ” التعدّدية واقعٌ لا محالة ” (كتبها في العام 2016 ) ، يرى إليها نعمة وليست نقمة : “التعدّدية واقع ، أنعمت السماء على اللبنانيين بها (..) ينبغي أن تكون إكسيرًا ديمقراطيًّا ، لو نحن فقهنا معناها ” ( ص 133 ).
– وأما عن الأمن بالتراضي ، وهو يدعوه الأمن بالتفاهم ، فهو يرذلُهُ ويرفضه ، لأنه يجعل المجرم أو العابث بالأمن شريكًا مع السلطة: “الأمن بالتفاهم يجعل من العابثين بالأمن شركاء في حلولٍ لمشاكل هم تسبّبوا بها ، مما يُجرِّد الدولة من قوة البطش ، التي لا غنى عنها ، بهدف حماية المواطنين فيها وتعزيز هيبتها المفقودة ” ( من مقالة ، عنوانها : نزع السلاح ” ، كتبها في العام 2019، ص ص : 143 – 144 ).
الكتابة الإبداعية الوجه الآخر المضيء للكتاب!
لعلَّهُ من قبيل تواضُع كاتبنا ، أو من قبيل الإحتراس ، أو التماسًا مُسبقًا لعُذر، إذا ما اقترف خطأ ، في مجال الكتابة بلغة الضاد ، فقد كان له أن يُعلنَ : “لم أمتهن الحرف يومًا ، ولم أُتقنهُ ، كما كانت تشتهي نفسي” (التمهيد ، ص 7 ).
وإذْ أعملنا النقد في الأسلوب التعبيري ، الذي توسَّلَهُ الباحث زريق ، فقد تحصَّل لنا خلافَ ما ذهب إليه ، وأتانا الخبرُ اليقين ، حين أكببنا على العديد من نصوص الكتاب ، لا سيما العائدة للباب الثاني ، وهي عبارة عن مقدِّمات كُتُب ، أصدرتها “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية”.
ولا شكَّ أن اللون الكتابي / التعبيري ، الذي اعتمده كاتبنا ، في العديد من هذه المقدّمات ، يكتنز الكثير من عناصر الإبداع الأدبي. هكذا ، أسفر عن مُنشئ، له في ميدان الكتابة كعبٌ عالٍ ! بل إنه ، في هذا المجال ، تفوّق أحيانًا كثيرة على ممتهني الكتابة . فهو ، بقدر ما يُعطي موضوع الدراسة حقَّه ، تحليلاً وتفكيكًا ، يحرصُ على تجويد أسلوبه.
ولكي لا يبقى كلامنا في الإطار التنظيري العام ، نضعُ بين يديَّ القارئ مقتطفًا من قطعةٍ أدبية ، عنوانها ” فيحائي .. هويّتي”. وهي محطاتٌ من سيرة ذاتية ومسيرة عمر . فهو إذْ يبوحُ بعشقه فيحاءهُ ، وهو عشقٌ متوارثٌ عن الجدّ – أعشقِ عاشقي طرابلس – يذهب إلى أنَّه أُرضِعَ عشق مدينتِهِ ، منذ عهد الفطام .. وهاكُم ما أبدَعَ قلمُهُ: ” أبت سنة 1952 ( هي سنة ولادة المؤلِّف ) ، وهي تحشرجُ ، بضعة أسابيع قبل أن تلفظَ آخر أنفاسها، في ذاك السادس من تشرين الثاني ، أن ترحل قبل أن تهبَ الفيحاء إبنًا جديدًا ، أو عشيقًا جديدًا ، كما سوف تُبيِّنُ الأيام لاحقًا ، وإن كانت مُتيقِّنةً أن الحضن ، الذي سوف يترعرع ذلك المولود فيه ، يفطمه لا محالة على حُبِّها ، ليتحوّل ذلك الحبُّ إلى وَلَهٍ ، يرُسِّخُ انتماءه إليها ، في لبِّهِ وبدنِهِ ، وتعلُّقِهُ بها ، كما شروش السنديانة الألفيَّة ، تتمسَّك بأرضَهَا تمسُّكَها بروحها ” (وردت هذه المقالة في كتاب : “طرابلس الفيحاء – مدينة العلم والفنون ، لماذا ؟ ” ، من إِعداد د. نيللي الحسيني ، ص 163).
فإلى جمال التعبير وحميميّته، واتّسامِهِ بطابع أدبي راقٍ، فإنَّ لسلامة اللغة واختيار المفردات الملائمة ما يشي بامتلاك الكاتب ناصية اللغة العربية الفُصحى.
وإذْ نستزيدُ ، فنستلُّ مقتطفًا آخر من هذا النص ، يرتكسُ فيه الكاتب إلى عهد التلمذة الأولى ، فيستذكر مدرسته ” مدرسة الفرير”، وهي من أقدم الصروح التعليمية التربوية في طرابلس، إذْ ترقى إلى القرن التاسع عشر ، فهو يأسى لما حلَّ بها ، إذْ دُبِّر في ليل إلغاؤها من الخارطة الطرابلسية. فقد هُدمت ، وارتفعت في المكان عمارات إسمنتية ، لا معنى لها ولا لونٌ ولا طعم ! بإزاء ذلك طفق الكاتب يبثُّنا لواعجه وجميل الذكريات:”.. وضرب الجهلُ وطننا الدامي ، وزعزعت الحرب أركانه ، وهجر المدينة كُثرٌ من أبنائها . كما هجرتها مدرستي، وهُجّرت أشجار الليمون منها ، وقضت رائحة البارود على ما تُفرزه أزهارها . غير أن ذلك كلّه لم يُغيِّر ما في قلبي شيئًا . فأنا ، لو نظرتُ إلى المباني التي اغتصبت أرضَ مدرستي ، لا أنفكُّ أرى فيها صفوفًا وملعبًا ووجوه أساتذة مُحبّبة. ولو تنشّقتُ رائحة البارود ، لا أزال أشتمُّ فيه عبق الليمون الآفل ! ” (ص 166 ).
وفي رجعةٍ إلى المقدّمة ، التي وضعها الكاتب “للآثار الكاملة لشاعر الفيحاء”، حيث يصف علاقته بجدِّه ، في أخريات أيّامِهِ ، لنا أن نتملَّى من هذه العبارة: “.. وشببتُ برفقتِهِ ، حتى أنّه بعد أن نالت السنونُ من عزيمتِهِ وجهورية صوتِهِ ، دون أن تستطيع النيل من عقله النيِّر وقريحتِهِ الفيّاضة ، كان ينتدبني لإلقاء قصائده في الحفلات والمناسبات الرسمية والخاصة ، فكنتُ أُخرجُها من فمي بصوتِه ، مقلِّدًا نبرته لتدخل آذان المستمعين ، وكأنها صلاةُ الفُصحى ترفضُ المغيب ” (ص 152).
لم نُورد هذا المقطع ، بقصد التملِّي منه فحسب ، بل كي ندرك أن سابا الحفيد خضع “لدورات تدريبية “، إذا جاز التعبير ، بإشراف الجدّ . وبامتلاكه تلك الوقفات الخطابية ، التي أشار إليها ، فلا بُدَّ أن يكون لوقفاتِهِ كبيرُ أثر في تجويد لغته العربية ، ذلك أن الشكل لا يتكامل فصولاً من دون المضمون!
… قضيةٌ تستحقُّ أن نُعيرها أهمية ، بما يخصّ تجويد الكاتب لغته التعبيرية، فحواها أنه خلال الفترة، التي تمتدّ من العام 2013 وحتى اليوم ، حيث خاض كاتبنا غمار الحراك الثقافي ، بوتيرة عالية ، كان “مضطرًا ” إلى تحبير الكثير من النصوص، في مناسبات وإطلالات مختلفة (مقدمات كتب، ندوات ، محاضرات، رسائل وكلمات إلخ .. ). هكذا كانت “تمارين” كتابية ، راكمت لديه خبرةً نوعيةً في مجال الكتابة ، على خلاف أغراضها وألوانها … كل أولئك جعله لاعبًا أساسيًّا في معمعة الكتابة بالعربية الفصحى.
ولما كان سابا زريق، صاحب الشخصية الأنيقة ، لا يرتضي إلا الإتقان في أي عمل يقوم به ، فمن الطبيعي – وهو حفيد عاشق العربية والمنافح عنها – أن لا يقصّر في هذا المجال . ومصداقًا لهذا التوجُّه ، لنا أن نتوقّف عند توصيف شوقي ساسين لكاتبنا ، إذْ يقول : “سابا قلمٌ يسكنُ الوجعَ ، من أوّل السطر حتى تنشف المحبرة . كأنّ ريشته بُريت بمبضع ، أو كأنها كِسرةُ ضلع ، إذا حزّت الورق هراقت عليه الأفراح مواجع” (من المقدمة ، ص 13 ).
ولنا في ختام هذه النقطة ، وبما يُعزِّز ما خلصنا إليه ، أن نتساءل : كيف لا تكون لسابا الحفيد نفحاتٌ والتماعاتٌ أدبية ، وهو القائل: “.. أنا المُشبعُ أدبًا دون أن اكونَ أديبًا ! ” (كلمة بمناسبة حفل عشاء ، في مؤتمر أدباء طرابلس الخامس 2015 ، ص 291 ).
هذا الاعتراف المفارقة ينمّ عن تواضع العلماء ، “ومن اتضع ارتفع”!

خاتمة: سابا قيصر زريق صاحب مشروع فكري ثقافي نهضوي!
في لغتنا الفلسفية ونحن نتكلّم على جدل الوجود ، ثمة وجودان إثنان ، أولهما وجودٌ “هُيولي” ، أي وجودٌ لم يتحقّق ولكن لديه قابليةُ التحقُّق ، وتحقُّقُهُ مشروطٌ بظروف معينة ، وهذا ما ندعوه بالفرنسية (En puissance) أي وجود بالقوة . في حين أن النوع الثاني ، يتجسَّد في الانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل (En fait ) ، أي الوجود الناجز.
هذه المقولة / المعادلة تنطبق “حفرًا وتنزيلاً ” على الكاتب سابا قيصر زريق. ذلك أنه ، منذ رحيل جدّه ، شاعر الفيحاء ، مثلِهِ الأعلى ، في العام 1974، راح يهجسُ في تحقيق أمنية ذلك الجدّ ، الذي أوصاه ، عشيّة خضوعه لعملية جراحية ، بأن يتدبَّر أمر ديوانه الشعري ، الذي يضم عشرين ألف بيت ، في مختلف الفنون الشعرية إضافة إلى كتابات نثرية، فقد استشعر أنه لن يخرج سالمًا من تلك العملية . وقد صدق حدسُهُ، وغادر هذه الدُنيا!
ثمانٌ وثلاثون سنة (بين عامي 1974 و 2012 ) ، وسابا الحفيد يعيش حالة وجود ” هيولي” ، وجود بالقوة ، إذا جاز التعبير، كان مخاضٌ، وكان إِثره انتقالٌ أي وجود بالفعل ، وكانت ” الآثار الكاملة لشاعر الفيحاء سابا زريق ” ، التي أبصرت النور في العام 2012 . وقد كان لهذا الوجود بالفعل أن يتكرّس ، عبر محطة مفصلية ، تمثّلت بالندوة التي عُقدت في “بيت الفن، الميناء” ، في 20 نيسان 2013 ، حول “الآثار الكاملة “. وقد كان لنا شرف المشاركة فيها ، إلى جانب د. زهيدة درويش جبور ، ومربِّي الأجيال الأستاذ شفيق حيدر ، وبإدارة د. جان توما. هذه المحطة أرّخت لانخراط سابا زريق في النشاط الفكري والثقافي ، الطربلسي والشمالي ، من باب واسع . وفي هذا الصدد يقول : “.. في تلك الندوة، التي وصفها كُثُر بأنها كانت مميّزة ، عاهدتُ نفسي مُذّاك على مواكبة الحراك الثقافي النشِط ، الذي تنعم به فيحاؤنا ” ( ص 308 ).
وقد تبع ذلك ، أي غداة هذه الندوة ، إنشاء “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية ” . وقد كنتُ في مداخلتي ، قد قدّمت عدة اقتراحات ، في عِدادها إقامة هذه “المؤسسة “. هكذا تقاطع هذا الاقتراح مع رغبة د. سابا قيصر زريق ، الذي كما مصمِّمًا على إنجاز ذلك الحلم ، الذي يُراوده!
وعن أهداف هذه “المؤسسة الزاهرة ، فهي تنصبُّ على الآتي : نشر الثقافة الأدبية العربية / تشجيع الكُتّاب والباحثين على نشر نتاجهم باللغة العربية / تنظيم اللقاءات والمحاضرات والندوات الأدبية والثقافية حول مواضيع تتعلّق باللغة العربية وثقافتها / المساعدة على استحداث مكتبات أو دعم مكتبات قائمة ، تضمُّ مراجع باللغة العربية.
.. ثم تأتي محطة كبرى ، تُشكِّل ذروة تحقُّق الحضور ” الساباوي” بالفعل، من خلال الكتاب / المرجع ، الذي وضعناه حول شاعر الفيحاء سابا زريق، بعنوان: ” مُقابسات زريقية بين شاعر الفيحاء سابا زريق وسابا الحفيد”.
وقد تم إطلاقه، عبر ندوة مشهودة ، في مركز الصفدي ، العام 2016.
هذه المحطات الثلاث شكَّلت عامل ” توريط ” محمود لسابا الحفيد في الحراك الفكري والثقافي ، ليس على مستوى طرابلس فحسب، بل على المستوى اللبناني أيضًا ، وباتت “المؤسسة” ، بإنجازاتها ، في صدارة المنتديات الأدبية لبنانيًّا. فقد أصدرت حتى تاريخه مائة كتاب، لأدباء وشعراء ومفكرين ، جُلُّهم من طرابلس والشمال ، إلى إقامة عشرات الندوات والمحاضرات والمشاركة في دعم مؤتمرات وتظاهرات ثقافية، وإمداد المدارس وبعض الجامعات بمكتبات وأجهزة كومبيوتر، وسوى ذلك من أعمال.
.. ويأتي هذا الكتاب ” من كلّ وادٍ صدى ” ليعكس جوانب واسعة ومضيئة من هذه المرحلة ، الممتدة من العام 2013 وحتى اليوم. ناهيك عن مرحلة، ما قبل “الآثار الكاملة ” ، وهي مرحلة مطبوعةٌ بطابع سياسي واجتماعي ، امتدت من العام 1996 ( حسبما يتبيّن من تاريخ المقالات ) وحتى العام 2013 ، ولم يتوقف هذا اللون من المقالات ، التي درج عليها كاتبنا . أي أن الحراك “الساباوي”، في مجال الكتابة السياسية والفكرية والأدبية بكلّيتهِ، يرقى إلى حوالي ثلاثة عقودٍ من الزمن.
تأسيسًا على ما تقدّم ، وهنا بيت القصيد ، نرى أن سابا قيصر زريق ، شاء أم أبى ، هو صاحب مشروع نهضوي، دشّنه من خلال كتاباته في قضايا الشأن العام ، ويستكمله بوتيرة عالية في الميدان الثقافي والأدبي ، ولم يتخلَّ حتى اليوم عن الكتابات ، في علم اجتماع السياسة.
ولا شك أن سابا زريق لم يدخل ميدان الكتابة السياسية ليكتب ، على طريقة الفن للفن . بل كان صاحب رسالة والتزام بقضايا مجتمعه وهموم شعبه. إنها كتابةٌ ملتزمة بامتياز ، ذات بُعد وظيفي ، بُغية التأسيس لوطن علماني (العلمانية السياسية ) ، يُجاهر بإدانة الطائفية، مرض لبنان العُضال، ويقف ضد “الديمقراطية التوافقية “، وهي هرطقة دستورية ، ويدين “الميثاقية ” التي تعوقُ مسار لبنان نحو الإصلاح الناجز .. وإلى قضايا أخرى، سبق أن فصّلنا القول فيها .
هذا التوجُّه نحو لبنان جديد، لا يتكامل فصولاً من دون إِعارة المسألة الثقافية ما تستحق من اهتمام . هكذا كان لسابا أن يعيش جدل السياسة/الثقافة، من موقع وطني ، ومن موقع إنساني ، تتوجّهما القيم السامية.
ويبقى السؤال، المعلّق على مشجب الانتظار: إلامَ سيُفضي هذا المانيفستو (Manifeste) ، الذي يضمّه الكتاب بين دفّتيه؟ هل سيبقى حبيس الكتاب، أم ستتم ترجمتُهُ على أرض الواقع عملانيًّا ؟ إنّه التحدي الذي ينتظر سابا عند مفترقات مُتعدِّدة!
***
* – تمَّ إطلاق الكتاب في “مركز الصفدي الثقافي” في 28/ 12/ 2022، وهو من منشورات “مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية” ، 2022. وقد أُقيمت ندوة حوله، شاركَ فيها مُداخِلاً الوزير محمد الصفدي، ونقيبة المحامين في الشمال الأستاذة ماري تريز القوال، والمحامي الأديب شوقي ساسين، ومديرة “مركز الصفدي الثقافي” د. نادين العلي عمران.