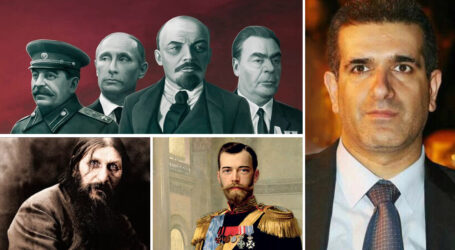لهجة الساحل السوري… ألسن متفرعة من لغة واحدة
سنا الشامي
(صحافية وكاتبة سورية)
*الدراما السورية تتجه إلى إنتاج أعمال بلهجات محلية أبرزها أوغاريت ورأس الشمرة*
لوحظ في السنوات الأخيرة توجه الدراما السورية لإنتاج أعمال بلهجات محلية، بعد أن انتشرت اللهجة الشامية المتأثرة في العمق باللغة الآرامية، فمن مسلسل “ضيعة ضايعة” الذي صور ببيئة محددة في مدينة اللاذقية، إلى مسلسل “الخربة” الخاص بلهجة أهل السويداء، وليس أخيراً مسلسل “عاصي الزند” بلهجة محلية في طرطوس.
ولكن الغريب في الأمر وغير العلمي أن هذه اللهجات وصمت بمرجعيات طائفية بطريقة سطحية لا دليل لها سوى الصفة الاجتماعية الشائعة عن المنطقة، ومن دون الأخذ في الاعتبار تاريخ هذه المدن والحضارات المتعاقبة عليها واختلاطها وامتزاجها بحضارات متعددة كانت اللغة واللهجة أول المتأثرين بها.
فما تاريخ هذه اللهجات والألسن وأصلها، وهل هي نتيجة عوامل الجغرافيا فقط أم أن هناك عوامل أخرى أثرت وتأثرت بها فكانت بشكلها الحالي؟

أول أبجدية
بمجرد البحث عن تاريخ المدن السورية سيلحظ الباحث مدى توغلها في القدم، فدمشق وحلب واللاذقية من أقدم مدن العالم، إذ تعتبر الأولى مأهولة منذ أقدم العصور، أي منذ العصر المعروف باسم العصر الحجري القديم “الباليوليتي” الكائن بين 12500 و10000 سنة قبل الميلاد، فقد عثر في أماكن مختلفة منها على أحجار من الصوان يعود تاريخها إلى ذلك العصر البعيد حيث كان الإنسان يستعمل تلك الأحجار كأدوات في عمله.
وقد عثر في موقع رأس الشمرة على أقدم آثار لمساكن البشر في هذه المنطقة على شكل قرية كبيرة كانت قائمة في الألف السادسة أو الخامسة قبل الميلاد، أما ساكنوها فيرجح أنهم انحدروا من المنطقة الشمالية للهلال الخصيب، كما توجد آثار للبشر تعود للعصر “الاينيوليتي” الذي يحتضن الألف الرابعة حتى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، إذ وجد في رأس الشمر آثار سكان وكمية كبيرة من الفخار تدل على أنه كان هناك اتصال بين هذا الساحل وبين بلاد ما بين النهرين وسورية الشمالية وقبرص.
وفي موقعة رأس الشمرة اكتشفت عام 1929 مدينة “أوغاريت”، التي تعتبر من أعظم أمجادها ما خلفته من أقدم أبجدية في العالم عرفت حتى الآن، وما يهم هذا البحث النتيجة التي وصل إليها، بأن لغة أوغاريت تشبه من وجوه عدة اللغة العربية، وقد ظهرت حتى الآن 660 كلمة تقريباً من لغة رأس الشمرة مماثلة لكلمات عربية.

ندرة أبحاث اللهجات
هناك ندرة وقلة في الدراسات والأبحاث العربية الخاصة باللهجات أو الألسن عامة والسورية من بينها. يقول الباحث عمر الخولي لـ”اندبندنت عربية”، “الأكيد أن اللهجة الساحلية السورية عربية متأثرة بعدد من اللغات القديمة والمعاصرة، ومنها على سبيل المثال الأوغاريتية والكنعانية والآرامية والتركية والفارسية، إضافة إلى كلمات مستعارة من اللغات الأوروبية”.
ونوه إلى أن “الدراسات الأكاديمية الرصينة في هذا الشأن نادرة، وأغلب الباحثين اللذين تناولوا موضوع لهجات بلاد الشام هم إما سوريون أو لبنانيون ولكن بطريقة غير موضوعية نسبياً”.
وأوضح أن “للهجات العربية أهمية علمية لا تقاس بالعناية القليلة التي يتعهدها رجال العلم والبحث، فمنذ عهد غير بعيد لم يكن أحد يعتبر درس اللهجات العامية جديراً باهتمامه، وقلة من تفرغ لدراستها والبحث فيها”.
ولكن تعتبر اللهجة الشامية لبلاد الشام عموماً من أكثر اللهجات العربية دراسة بين الغربيين، وهي وإن كانت دراستها اللغوية قليلة بالعربية لكن الكتب اللغوية الفرنسية والألمانية والإنجليزية التي تدرسها لا بأس بها مقارنة بأغلب اللهجات.

تسيد اللغة الآرامية 11 قرناً
يقول جورجي كنعان في كتابه “تاريخ الله”، “كان الآراميون على صلة وثيقة بالكنعانيين في سوريا الغربية، وكانت قوافلهم تنقل من صور وصيدون وجبيل وأوغاريت إلى الداخل السوري ما كان يجلبه البحارة الكنعانيون من مدن حوض المتوسط أو ما تنتجه الحواضر الكنعانية.
وحوالى القرن العاشر قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل تبنى الآراميون أبجدية الكنعانيين في كتاباتهم ورسائلهم التجارية، فانكفأت أمام هذا الأسلوب الكتابي الجديد أساليب الكتابة المسمارية القديمة جميعها، وكان من الطبيعي أن يتغلب الخط الآرامي بسهولته ووضوحه على الخط المسماري البالغ الصعوبة والتعقيد، وأن يتغلب اللسان الآرامي على الألسن المحلية التي كانت منتشرة في بلاد النهرين وفي الشمال السوري.
وهكذا امتد مجال الآرامية شمالاً إلى جبال الأمانوس وشرقاً إلى جبال زاغروس وغرباً إلى وادي النيل، وظلت لغة التجارة والإدارة في العالم القديم، ولم يؤثر سقوط دول آرام في سوريا على انتشار حضارتهم ولغتهم في أرجاء الشرق المتوسطي جميعها وفي ما وراء حدود هذه الأرض”.
يقول كنعان “لقد طمست الآرامية في القرن السادس قبل الميلاد كل اللغات التي سبقتها، وأصبحت اللغة الأولى خلال 11 قرناً، كما يرى آخرون أنها ظلت لغة العالم المتمدن منذ القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد.
وقد وجدت نقوش تدمرية آرامية اللسان في أفريقيا وروما والمجر ورومانيا وإنجلترا، وهي من كتابة التجار التدمريين.
وفي الجنوب الشرقي من سوريا ازدهرت مملكة الأنباط في القرن الرابع قبل الميلاد وكان نبط البتراء (العاصمة) صلة بين بلاد العرب وبين سوريا الشمالية والغربية والنقوش النبطية لسان أرامي.
وفي القرن الأول الميلادي امتدت اللغة الآرامية إلى العربية الشمالية، يقول المسعودي بعد ذكره أقسام بلاد العرب، “أن هذه الجزيرة كلها لسانها واحد سرياني”. وكان يعقوب السروجي (452- 522م) يراسل عرب نجران المسيحيين في شرق بلاد العرب باللغة السريانية، فالسريانية هي نفسها الآرامية وأطلق عليهم اليونانيون هذا الاسم بعد أن دخل الآراميون المسيحية.

أصل مشترك
إن الشعوب التي ظهرت مع بداية التاريخ المدون (الألف الثالث قبل الميلاد) مستقرة في أقاليم سوريا الطبيعية على اختلافها، تتشابه في ما بينها إلى حد يكفي لتبرير الفرض القائل إنها انتشرت من موطن مشترك قديم إلى البلاد التي استوطنتها في العصور التاريخية. وهي تؤلف كتلة واحدة، ليس باجتماعها في صعيد جغرافي واحد، والتحدث بألسن لغة واحدة فحسب، ولكن باشتراكها أيضاً في أصل حضاري تاريخي واحد.
والواقع بحسب كنعان، أن بين ألسن هذه الشعوب من التشابه في الأصوات والصيغ والتراكيب والمفردات ما لا يمكن معه أن تنسب تقاربها إلى حدوث اقتباسات في ما بينها في العصور التاريخية، ولا سبيل إلى تفسير هذا التقارب إلا بافتراض أصل مشترك لها، وأن المقارنة بين الألسن (الأكادي “البابلي – الآشوري” والكنعاني والآرامي والعربي)، تقدم دليلاً قاطعاً على أن هذه الألسن تفرعت عن لغة واحدة تكلم بها شعب واحد قبل أن يتفرق في مناطق مختلفة.
وقد أدرك الخليل بن أحمد هذه الحقيقة في وقت مبكر من العهد الإسلامي، فقال في كتابه العين “وكان الكنعانيون يتكلمون بلغة تضارع العربية”. وأدركها ابن حزم الأندلسي أيضاً قال في كتابه الأحكام في أصول الأحكام، “إن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيناً أن السريانية (الآرامية) والعبرانية (الكنعانية) والعربية لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها، فمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبدلاً لا يخفى على من تأمله”، يضيف “من تدبر العربية والكنعانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم، وإنها لغة واحدة في الأصل”.

الأهم التقارب والاختلاف
فإذا كان هناك من اختلاف بين هذه الألسن فمرده إلى تصرف المتكلمين بها تصرفاً يختلف باختلاف البلدان والقبائل والبيئات والأهوية بحسب كنعان، فلكل زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال أو صيغة معناه أو غاية أو فكرة، ثم جاء الاستعمال فأقرها مع الزمن على ما أوحته لهم الطبيعة أو ساقهم إليه الاستقراء.
والواقع أن أوجه المشابهة بين البابلية – الأشورية والكنعانية والآرامية والعربية واضحة جداً، وأشد وضوحاً التشابه بين الكنعانية والعربية والآرامية، فقد تتفق معاني الألفاظ كل الاتفاق وقد تبتعد قليلاً، وهذا لا بد منه بعد نزوح الدار واختلاف العادات والتقاليد وتغير الأهواء والأجواء إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر في المرء تأثيراً لا يمكن إنكاره.
أما الألفاظ العامة المشتركة بين الكنعانية وبين العربية فهي كثيرة جداً إلى درجة حدت بعضو المجمع العلمي الفرنسي المؤرخ كلود شايفر إلى القول عن الأوغاريتية، “إنها تؤلف أقدم مصدر للغة العربية”، ويعلق جورجي كنعان على هذا الكلام بالقول، “إن إطلاق الأحكام القاطعة بأقدمية لغة أو لفظة فيه كثير من ضحالة الوعي وقلة التبصر”.
فمثلاً اسم الشمال في العربية من شمأل عاصمة (مملكة يادي الآرامية) الواقعة في شمال غربي سوريا (لواء اسكندرون اليوم) وهي مدلول على الاتجاه.
لذلك المهم بالنسبة إلى كنعان هو ملاحظة مواطن التقارب والاختلاف لا مواطن الأخذ والاقتباس، لأن ما يدعونه لغات هو ألسن متفرعة من لغة واحدة لم يأخذ أو يقتبس لسان عن آخر، وإنما هناك تقارب واختلاف بحسب عوامل البيئة، إضافة إلى أن هذه الألسن وصلت مكتوبة في رموز كتابية غابت منطوقاتها مع الزمن، وتعددت بتعدد المجموعات الناطقة بها الذين تباعدت بهم هجراتهم عن مواطن اللغة الأم، وما طرأ عليه من تبدل الألفاظ على ألسنة الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم.