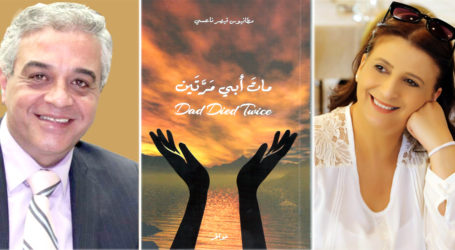سؤال الهويّة في “إفرح يا قلبي”
د. رفيف رضا صيداوي*
ما الهويّة؟ وهل يُمكن تغييرها بالانتقال بها من انتماءاتنا الطبيعيّة إلى انتماءاتنا الاختياريّة؟ أي تبعاً لإرادتنا، وليس تبعاً لارتباطاتنا التي تشكّلت منها الهويّة أساساً، كالأرض، واللّغة، والتاريخ، والحضارة، والثقافة، والعرق، والقوميّة وغيرها؟
لطالما شكَّل سؤال الهويّة هذا موضوعاً رئيساً للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، سواء في بُعده السلوكيّ والذّاتيّ أم في بُعده الجمعيّ، بالنّظر إلى تقاطُعات الهويّة الذاتيّة، هويّة “الأنا”، مع الهويّة الاجتماعيّة، هويّة “النحن”. وانتقل هذا السؤال إلى المخيال الاجتماعيّ، ولاسيّما إلى المخيال الروائيّ، بوصفه من المجالات الفضلى لتعبير الإنسان عن نفسه عبر الكلام، أي كمُنتجٍ للنصوص، وكمُبدعٍ لها بحسب ميخائيل باختين. فحضرت إشكاليّة الهويّة هاجِساً وسؤالاً في التاريخ الإبداعيّ الروائيّ العربيّ مع الانخراط في حداثةٍ أَعلت من فكرة الإنسان وهويّته الفرديّة.
لقد ألحّ علينا نصّ الروائيّة اللّبنانيّة علويّة صبح الصادر حديثاً عن “دار الآداب” اللّبنانيّة، بعنوان: “افرح يا قلبي“، لاستكمال سؤال الهويّة الذي لم ينقطع يوماً البحث حوله، والذي كان، ولا يزال، من أكثر الأسئلة إثارةً للجدل بسبب مفصليّة الهويّة ودَورها في حياة الأفراد والجماعات والمُجتمعات من جهة، وبسبب عدم ثبات معناها في المرحلة الرّاهنة من جهة ثانية، المُتزامنة مع ثورة تكنولوجيّة غير مسبوقة بوتيرتها وسرعتها، أعادت تشكيلَ العالَم على مستوى الواقع الاجتماعي بأبعاده الشاملة والكلّيّة، بما في ذلك تمثّلاته ورموزه التي تحتلّ الفنون والآداب حيّزاً غير بسيط فيها.
لطالما تجلّت مسألة الهويّة في الرواية العربيّة في بحث الشخصيّات الروائيّة الأساسيّة عن هويّاتها وشعورها بأنّها مغتربة عن الآخر عموماً، سواء أكان هذا الآخر هو المجتمع عَينه أم الطبقة الاجتماعيّة التي تنتمي إليه هذه الشخصيّات، أم الأسرة أم الأصدقاء والمحيط المباشر بشكلٍ عامّ، أم مجتمعاً مُختلفاً كالمجتمع الغربي مثلاً؛ وشَغَلَ جَدَلُ الهويّة هذا في تقاطعاته مع الغرب المتفوِّق و”الحضاري” حيّزاً غير عابر في المخيال الروائي العربي، حيث تشكِّلُ كلٌّ من الروايتَيْن المبكّرتَيْن “الحيّ اللّاتيني” (1953) للأديب اللّبناني سهيل إدريس، و”موسم الهجرة إلى الشمال” (1966) للأديب السوداني الطيّب صالح، أنموذجَيْن روائيَّيْن عربيَّيْن رائدَيْن في ترجمة هذا الجَدَل الهويّاتي فنّيّاً، ووفق معايير روائيّة حديثة، كان من أبرزها التحرُّر من نمطيّة البطل الإيجابيّ الخارق القدرات، إلى آخر إشكالي يعاني تمزُّقاً بين قيَمه وتطلّعاته من جهة، والقيَم الاجتماعيّة السائدة في محيطه من جهة أخرى، فيعتري الشكّ حياته عوضاً عن اليقين المُطلَق، ويعيش أبداً على أمل التغيير، ما يعكس التعارُضَ الجذريّ بينه وبين العالَم بحسب جورج لوكاتش.
في روايتها “افرح يا قلبي“، تدير الروائيّة اللّبنانيّة علويّة صبح نصَّها حول “ثنائيّة الشرق والغرب” و”صراع الهويّات” وفق رؤية مختلفة عن تلك التي عبَّرت عنها نصوص روائيّة عربيّة في إدارتها مثل هذه الثيمات، والمتمثّلة بإخضاع الرجل الشرقي المرأة الغربيّة في الفراش، في تناصّ مع رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيّب صالح مثلاً، وبطلها “مصطفى سعيد”. فقد أدارت علويّة صبح نصَّها عبر نمط بنائها الشخصيّة الرئيسة لروايتها، أي “غسّان”، الأستاذ المُختصّ بالموسيقى والعازف المُحترف على آلة العود، ومنْحه خصائص إنسانيّة وأنثويّة، بحسب الخصائص المُتعارف عليها للأنوثة: فهو “الرجل الصغير المنمنمة تفاصيل وجهه” (ص20)، الذي يعشق النغم، الرومانسي، السلس، الصادق منذ طفولته (راجع ص113). فجعلتْ صبح منه شخصيّة فائضة الحواسّ في تعبيرها عن رأيها أو في توصيفها مشهداً ما، بحيث تتفلّت الحواسّ من أَسرها، مُطلقةً تلاحُمها مع هذا المشهد، وتغلْغلها فيه تغلْغُل الموسيقى في الأعماق. أمّا أزمته، فتكمن في كونه مُطارَداً بمشكلاته الأسريّة غير المنفصلة عن بيئته المُغلقة، التي تَقاطعَ معها عنفُ الحرب اللّبنانيّة وتحوّلاتها المُجتمعيّة، والتطرُّف الديني، وقتل الأخ لأخيه، وخطاب الكراهيّة والتعصُّب والنّبذ…إلخ، فعانى، هو الفنّان المرهف المأزوم بعلاقته ببلده، من أزمةِ وجودٍ دفعت به إلى هجرة بلدته “دار العزّ” الشماليّة التي غَدَتْ في النصّ رمزاً للهويّة وإشكاليّاتها، قاصداً نيويورك كمنفىً اختياريّ، قاطعاً عهداً على نفسه بعدم العودة إليها، حتّى وعلى عدم دفنه فيها، وإلغاء ذاكرته، حاملاً عوده الذي كان جدّه المعتاد على إحياء سهرات الطرب المصري القديم في بيته أوّل من علّمه العزف عليه. حَمَلَ عوده من دون أن يدري لماذا حمله، هو الذي قرّر عدم العزف على العود في الغربة والاكتفاء بالعزف على الآلات الموسيقيّة الغربيّة: أحلامه وأحلام العود معاً “لم تعُد واحدة. ليحلم العود بماضيه، فهذا من شأنه. لقد هجرته أصابعه للأبد، أمّا حلمه الآن فبات المستقبل” (ص18)؛ فكان العود كآلة رئيسيّة في التخت الموسيقي الشرقي وأغنية “أمّ كلثوم” “افرح يا قلبي” رمزَيْن أساسيَّيْن من رموز موسيقى الشرق وهويّته المحفورة في كيان “غسّان” حتّى ولو حاولَ إنكار ذلك والتنكُّر له.
حضور الموسيقى الشرقيّة والأغنية العربيّة، والعود، وشخصيّة الجدّ، وعبد النّاصر، والقاهرة وغيرها الكثير من رموز الماضي القريب، تشير كلّها إلى فترة كانت فيها المنطقة، بما في ذلك بلدة غسّان، تتمتّع بحريّة تتناقض مع مجريات الواقع الحالي بكلّ ما يكتنفه من انكفاءٍ عروبي ويساري وتشدُّدٍ دينيّ.
أمّا عن تنازُع مواقع نساء ثلاث في حياة “غسّان” (“كيرستن” الأميركيّة التي “أمدّته بإحساسٍ عميق بإنسانيّته وبمعنىً آخر للرجولة، تلك المتكافئة مع الأنوثة؛ و”نور” حبّه العذريّ الأوّل في بلدته تعبيراً عن البراءة الأولى للمكان الأوّل؛ وزوجته اللّبنانيّة “رُلى”، التي تربطه بها علاقة قربى، المرأة التي تختزن قيَم الشرق وتُرضي “غرور” ابن هذه الثقافة بخضوعها وامتثالها للمعايير الجندريّة المفروضة مجتمعيّاً)، فجاء توظيفاً للإيحاء بالمرايا المتكسّرة للهويّة، وميلها أكثر فأكثر إلى التشظّي والتجزئة لدى الأفراد والجماعات. لكنّ ذلك جاء في سياقٍ روائي يُلملم شظايا هذه الهويّة، ويقول بإمكانيّة التواصُل والتصالُح والتناغُم والاندماج، على مستوى الهويّات الجندريّة المتعالقة مع المستويات الثقافيّة والاجتماعيّة العامّة. هذا التواصُل الذي يصعب رسم معالمه من دون الإشارة إلى الدَور المركزيّ والحاسم لـ “الموسيقى” و”الغناء” على المستوى الدلالي لخطاب “افرح يا قلبي“، سواء عبر توظيف الحقل المعجمي للموسيقى، وتكثيف حقلها الدلالي المحيل على الحبّ والوئام القادرَيْن على تخطّي الصراعات من أيّ نوع: “الحبّ ليس أقلّ من عزف الموسيقى درساً للعالَم” (ص11)، أم عبر تحميل المُصالَحة المجازيّة لـ “غسّان” بين موسيقى الشرق والغرب قولاً روائيّاً يفيد بإمكانيّة تعدُّد الهويّات من دون التنكّر لإحداها، أو جَعْلها قيداً لنا، وكأنّ ذلك لا يتحقّق في إطارٍ من التعصّب والكراهيّة والشعور بالدونيّة.
من التصالُح الجندريّ إلى التصالُح الهويّاتيّ
تصالُح الذكورة والأنوثة لدى علويّة صبح جاء كعلامة نصّيّة فارقة اخترقت البنيان الروائي المتعدّد الطبقات والتّمفصلات المولِّدة للمعنى؛ بحيث أعطى هذا التصالُح دلالاته في سياق تصالُح الشرق والغرب في تمثّلات الهويّة الذاتيّة للشخصيّة الرئيسة، أي “غسّان”، الذي أيقظت محطّاتٌ كثيرة في حياته ذاك الماضي الذي حاول دفنه ونسيانه، ظنّاً منه أنّه تبرّأ منه، ومن الهويّة التي منحه إيّاها. لذا حضرت هذه المحطّات بالقوّة عبر تمثّلات مرتبطة بالمكان الأوّل، وبالأحداث التي خبرها وعاشها “غسّان” فيه لتُنبئه بخيبة مسعاه في التنكّر الهويّاتي. بدا هذا المكان الأوّل، المعادل للوطن والهويّة، الجيّاش بالعاطفة، المُكتسي ملامح ناسه وطبيعته، محفوراً في الطبقات العميقة من كيان “غسّان” من دون حاجةٍ إلى كبير جهدٍ كي يطفو على السطح في رحلة الصراع العاطفي لهذا الأخير مع ماضيه.
توظيف البُعد النوستالجي الذي تستعيد الأشياء من خلاله طبيعتها الأولى، بقصد الشحن العاطفي والوجداني الشارح لـ “جماليّات المكان” الأوّل وأثره في كيان “غسّان” الفائض الحواسّ، جاءَ إغناءً لفكرةٍ مركزيّة في خطاب علويّة صبح، المتمثِّل في استحالة التخلّي عن الهويّة بشكلٍ كامل. ففي استذكاره الجبال التي كان يقصدها مع أبيه وإخوته في بلدته، تذكَّر “غسّان” سعادته حين كان “يرى الجلول والوهاد والتلال والشلّالات والثّلوج. كانت تبدو له أنّها مفاتيح الدخول إلى حفلِ التلاقي بين الأرض والسماء، تديره وتعزفه أوركسترا رومنسيّة تذكّره بوجه نور تماماً (…) يشمّ رائحة القمح العسليّ ورائحة أقمار الصاج المرقوقة على زندَيّ جدّته” (ص321).
لم تكتفِ علويّة صبح بالاشتغال على الشحن العاطفي والوجداني باستخدام قوّة الحواسّ في تبيان أهميّة حضور المكان الأوّل في كيان الشخصيّة الرئيسة، بل لجأت إلى ترجمةِ جدليّة حضور هذا المكان وصدّه وإبعاده ترجمةً فنّيّة. من ذلك مثلاً حين ذكّرته أغنية فيروز “بعتّ لك يا حبيب الروح” بحبّه الأوّل “نور”، ففارت أحاسيسه وقرّر ألّا يستمع إلّا لأغانٍ أميركيّة أو أجنبيّة (راجع ص127).
حضور المكان الأوّل جاء مدعوماً بصرامة نقديّة، فرضها خطاب علويّة صبح الكاشف عن الانقسامات التي يُمكن لعناصر الهويّة أن تولِّدها، لكونه خطاباً يتأمّل حيثيّات هذه العناصر وتداعياتها. ولكأنّ الموقف المُعاصر من الهويّة، المرتبط بوجودنا وخياراتنا، وليس الهارب والمتخلّي عنها، بل المتصالح مع التقدُّم والحضارة، لكأنّ هذا الموقف هو إثباتٌ وتأكيدٌ لهذه الهويّة، وليس العكس. وتجربة جبرا إبراهيم جبرا الذي لم يمحُ رحيله عن القدس ذكريات الطفولة والشباب، وبقيَ مسكوناً بالمكان الأوّل، لهي خير تعبيرٍ عن جدليّة المكان الأوّل والهويّة. جبرا إبراهيم جبرا القائل إنّه يذكر “القدس الجديدة، القدس السليبة، كآدم يذكر الجنّة. فالصبيّ إذ ينمو، تنمو المدينة في كلّ زاويةٍ من زوايا نفسه…” (جبرا إبراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، ص119)، يذهب في مجازٍ لغويّ رائع إلى التعبير بعُمق عن التجربة الحسّيّة التي بقيت لأمدٍ طويل تحمل له دلالاتها النفسيّة، بالإضافة إلى دلالاتها الحضاريّة، كما وإلى التعبير عن الدّفع الزماني لمعنى تجربته المكانيّة. فحين رأى البحر لأوّل مرّة، وهو في العاشرة من عمره، وكان ذلك في يافا، وأذهلته زرقته، غدا البحر مع الأيّام والتجارب والأسفار متداخلاً لديه مع “تجربة الحَجَر وترامي الجبال والوديان. وتداخَلَ التراب الفلسطيني الأحمر بالبحر الفلسطيني الأزرق في خيالاتي، أو ربّما في اللّاوعي منّي – أسكنهما ويسكناني كيفما فكّرت، وأينما أقمت..” (تأمّلات في بنيانٍ مرمريّ، ص91). لكنّ الأهمّ في كلام جبرا هو تعبيره عن احتلال المكان الأوّل جزءاً من اللّوحة النفسيّة، أو طبقةً منها، فيما الجزء الآخر من هذه اللّوحة أو طبقة منها، يحتلّها المبنى العامّ الذي هو “بنيان تاريخي كبير، يسكننا هو أيضاً بقدر ما استوعبنا من دواخله وخوارجه، فتتداخل التجربتان في الصورة النفسيّة بشكلٍ “يمثّل التداخُل بين الزمن الشخصي والزمن التاريخي – بين المكان المطلق والزمان المطلق” (المرجع السابق، ص92)؛ حتّى إذا ما مرّ في أسفاره ورحلاته في مُدن الشرق والغرب الغنيّة بصروحها ومساجدها وهياكلها القديمة وقصورها التي تعطي لهذه المُدن معناها المكاني الأعمق، عاشها بدرجة من الحسّ الداخلي، “فأغنت حسّي القديم للتجربة المكانيّة التي عرفتها في فترة الطفولة والمراهقة، وأكَّدتْ عليها، بحيث غدوت، فيما أحسب، أعمق إدراكاً لأماكن الطفولة في بيت لحم وأماكن المُراهقة في القدس، وغدوتُ أكثر فهماً للمدينة”؛ حتّى إذا ما وقف على قمّة الصخور التي تعلو أبعد ميناء في غرب البحر المتوسّط، ناظراً إلى امتداد المحيط الأطلسي، وذلك في رأس سان فنسنت”، قرب مدينة سارقِس، في أقصى منطقة “الغرب” من جنوب البرتغال، “رنَّ في أذنيّ وقْعُ سنابك الخيول العربيّة، وقد بلغت تلك الحافّة الرائعة، وصوت عقبة بن نافع وعبد الرّحمن الغافقي يتحدّى هدير الأمواج بالخَيل التي لو كان لها أن تسبح في الماء، لقطعَ العرب بها بحر الظلمات. وعاد إليّ من جديد حسّي الغامض بأنّ البحار كلّها تبدأ من الساحل الفلسطيني، وتتصايح بلسانٍ عربيّ” (المرجع السابق، ص93-94).
فإذا كانت العناصر المكوِّنة للهويّة، بما فيها المكان الأوّل، موسومة بسمات النسق السياسي والاقتصادي والروحي السائد في مجتمعٍ ما، ومن التفاعلات الواعية وغير الواعية للفرد مع الجماعة التي ينخرط فيها، فإنّ التخلّي عن الهويّة بشكلٍ كاملٍ صعب إذاً من منظور الخطاب الروائي لعلويّة صبح، وإن كانت الهويّة تحشرنا في قوالب موروثة ومُغلقة ومحدَّدة سلفاً، وإن كنّا على دراية بأنّ الهويّات الاجتماعيّة “توجد وتُكتسب وتُصنَّف طبقاً لعلاقات القوى، و(أنّها) شيء ما يدور حوله الصراع وتتبلور فيه الخطوط نحو الأمام” (هارلمبس وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهويّة، 2010، ص106).
في مطالع تسعينيّات القرن الماضي، خصَّص الروائي اللّبناني إلياس خوري رواية كاملة “مملكة الغرباء” (1993) لشخصيّات هامشيّة، مختلفة الانتماءات الجغرافيّة والدينيّة والإثنيّة..، ورثتْ غربتَها وتزعزُعَ هويّاتها بفعل التغييرات الجيو – سياسيّة التي عرفها الشرق منذ مطلع القرن العشرين، والتي كانت، ولا تزال، تميل لمصلحة القوى الاقتصاديّة – السياسيّة العالميّة، أي القوى الاستعماريّة آنذاك. وواصلت الكتابة الروائيّة تفاعلَها مع التحوّلات المُجتمعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة العميقة الحاصلة منذ تسعينيّات القرن الماضي، التي طاولت تغييراتها مفاهيم المكان والزمان، وذلك في تقاطعاتها مع مفهوم الوطن والتاريخ والقوميّة وغيرها من العناصر المكوِّنة للهويّة. لكن يبقى كلام “غسّان” في أنّ “هناك أشياء تدفعنا إلى التذمّر أو كرهها ونودّ الخلاص منها، ثمّ نكتشف أنّها كنزٌ ثمين فقدناه وجَعَلَنا فقراء بأرواحنا” (ص177)، الأكثر بلاغةً وتعبيراً عن التجلّيات الفنيّة الروائيّة لحركة التفكير حول الهويّة في زمننا الحالي.
***
* مؤسّسة الفكر العربي
*نشرة أفق