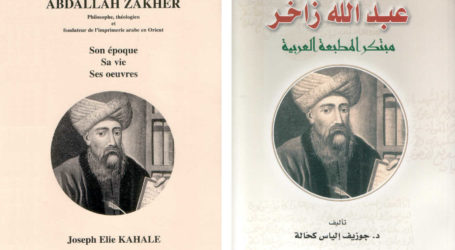وطنٌ نحلم به!
مارلين سعاده
رحيل دائم
على مقاعد الدراسة، كنّا نقرأ عن النازحين من القرى إلى المدن سعيًا وراء لقمة العيش، وعن المهاجرين من بلدٍ إلى آخر هربًا من جوعٍ أو طغيان… فارتبط في أذهاننا “النزوح” بالانتقال المحلّي الداخلي من مدينة إلى أخرى، ومن أعلى إلى أسفل أي من القرية إلى المدينة. وجاء في لسان العرب: “وقد نُزِحَ بفلان إِذا بَعُدَ عن دياره غَيبَةً بعيدة”؛ بينما ارتبطت في أذهاننا “الهجرة” بالرحيل الدائم، من دون عودة، والسفر إلى بلادٍ جديدة، “بلاد الغربة”. ويفسّر لسان العرب “الهِجْرَةُ والهُجْرَةُ: بالخروج من أَرض إِلى أَرض… وتَهَجَّرَ فلان أَي تشبّه بالمهاجرين”.
حين غادرْنا بيوتنا خلال حرب لبنان عام 1975 كنّا نُنعَت بالـ”مهجَّرين”، وكان انتقالنا داخليًّا، من المدينة إلى القرية أي معاكسًا لمفهومنا للنزوح. ولئن كان المقصود، بشكل عامّ، من النزوح والهجرة، الانتقال من مكان إلى آخر، إلّا أنّنا نرى عبارة “النزوح” أخفّ وطأة من عبارة “الهجرة”، وإن كان كلاهما (النزوح والهجرة) ينطويان فعليًّا على معنى الرحيل القسري؛ فالـ”نزوح” بلفظه وحروفه ووقْعه على السمع يبدو أخفّ وطأة، ويوحي بالهجرة المؤقّتة ضمن إطار الوطن، لأسباب قاهرة، والتي تنتهي بانتهاء هذه الأسباب، كما يوحي بإمكانيّة العودة؛ بينما تعبير “الهجرة” يوحي باللّاعودة والرحيل الدائم.
مرّ زمن الدراسة وزمن الحرب والتهجير… ولم أكن أتصوّر يومًا أننّي سأصبح مجدّدًا من النازحين المهجّرين! فقد كنت أظنّ أنّ من هُجّر مرّة ثمّ عاد سالمًا غير غانمٍ بعدَ حرب طويلة، لا يمكن أن يهجَّر من جديد ويعود به التاريخ القهقرى!
خلال حرب الآخرين على أرض لبنان (1975-1990) التي أُطلقَ عليها تسمية “الحرب الأهليّة”، هجرنا بيوتنا قسرًا، ذلك أنّ جغرافيتها، كجغرافية هذا الوطن السعيد الذكر التعيس الطالع، جعلت من العقار الذي أَنشأ عليه جدّي مسكنه ومسكننا، خطَّ تماس يفصل بين المنطقتين اللتين وُسِمتا منذ ذلك الوقت بالتعريف المبتكر: بيروت الشرقيّة وبيروت الغربية… فكيف يمكن أن تتكرّر الحرب التي أعلنوا – مخطئين – أنّها انتهت بعد خمس عشرة سنة؟! ألا يعني إعلان انتهاء الحرب انتهاء أسبابها؟! إلّا أنّ حرب لبنان – كما بيّن لنا الواقع – لم تنتهِ، بل بقي الجمر تحت الرماد ثمّ تأجّج مجدّدًا بعدما أُعيد إيقاده، فاستمرّينا في دفع ضريبة حروب الآخرين على أرضنا! فهل يوجد شعبٌ بهذا “السخاء” غير شعب لبنان؟!

نزوحٌ قسريّ
وبعيدًا عمّا سبق، وعن واقعنا السياسيّ المريع، أعود إلى يوميّات نزوحي القسريّ، لأدخل من خلاله إلى يوميّات العامّة من الناس، الذين يستمرّون بالعيش في ظلّ الظروف القاسية التي جعلتنا ضحايا رغم أنوفنا، أدخل عالمهم من بابه الواسع، فحين تفقد الاستقرار، وتصبح ملزمًا بالسفر اليوميّ على الطرقات تمضي أقلّه ساعتين ونصف ذهابًا لتصل إلى مقرّ عملك في بيروت، ومثلها إيابًا لتعود إلى مقرّ إقامتك الجديد في الجبل، تدخل عالمًا جديدًا لم تكن تعرفه، وتتعرّف بأفراد مِن مجتمعك لم تكن على صلة بهم من قبل، منهم من يعلّمك دروسًا في الحياة، ومنهم من يقدّم لك الدليل على فشل المجتمع أو تخلّفه…
إنّ رحلة النازحين عن بيوتهم وأعمالهم، صباح كلّ يوم، في طقسٍ دافئ لم تقيّدهم فيه بعد سياط الزمهرير، تبدو – ولو في جزء منها – سياحيّة بامتياز، تقدّم إلى ذهنك المهجّر والمربَك و”المشنطل” على الطرقات، الشعور بالاستقرار والرفاهية! فصوت فيروز يرافقك خلال الطريق، وهل أجمل منه رفيقًا عند الصباح؟! والركّاب يتوافدون تباعًا وبهدوء، راكب أو راكبين في كلّ محطة، وإن عظم العدد لا يتخطّى الخمسة، والمقاعد نظيفة ومريحة، بحيث يجلس كلّ راكب على مقعده بارتياح، من دون أن يتجاوز عدد الركّاب عدد المقاعد؛ وقد تصل إلى المحطة التي تقصدها قبل أن تمتلئ كلّ المقاعد. ويزداد هذا السفر متعةً إذا ما اتّخذت لك رفيقًا اخترته من بين مجموعة الكتب لديك، فتشعر أنّك تقوم برحلتين (رحلة الجسد ورحلة الروح) في وقت واحد.
مجتمع هجين
إنّ الأمان الذي تعيشه خلال رحلتك الصباحيّة هذه، يمكن أن تخسره بالكامل إن أوقعك حظّك السيئ في حافلة لدى سائقها شهيّة جامحة على الكلام بصوت مرتفع مع عدد من الركاب الذين ألفوا مرافقته، وحلّ شيء من الودّ بينه وبينهم، فعبّروا عن فرحهم به وبهذه الصبحيّة بالمزيد من الأحاديث التافهة التي تستثير ضحكاتهم، فيختلط الحابل بالنابل كحال حديث “نسوان الفرن”، ويتحوّل ضجيجهم في رأسك إلى بركان، فتدرك أنّه قُضي على نهارك من أوّله، ولا بدّ لك من المسكّنات لتتمَّه بسلام…
وعندها تدرك هول المسافة بين السائق المتحضّر والسائق الهمجي، والراكب الراقي والآخر العشوائي، وتعلم سريعًا أنّك في مجتمع هجين، جزء منه يفتقر لآداب التصرّف والتواصل، ويلزمه الوعي لمعرفة الحدود بين حرّيّته وحرّيّة جاره المرافق له.
كما قد تحظى خلال الطريق برفيق(ـة) خلوق يجلس بجوارك، يعيش الغربة نفسها التي تعيشها، فيدخل معك في حديث يبدأ خجولًا ويستمرّ على وتيرة ناعمة، ثمّ يزدهر فيشعرك بنوع من الألفة، ويؤكّد لك أنّ الطيبين ما زالوا قيد الوجود، ويفاجئك هذا الودّ وهذا اللطف المتناميَين من دون غرض أو غاية، فتشعر بصلة القربى والمودّة الصافية، وتغادره محمّلًا بمشاعر الرضا والسلام مقتنعًا أنّ الدنيا لم تخلُ من الطيّبين أمثال رفيقك في سفرك القصير، الذي يتمتّع برهافة الحس والخلق الرفيع.

تواطُؤ ومروءة
وبين السائقين تتعرّف بذاك المحترف النزيه المتقِن لعمله والذي يلفت انتباهك بردود فعله، فمن تصرّفاته ما يذكّرك بالقول المأثور: “عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة”، إذ يضنّ بخسارة راكب لمّح بالنزول إثر إعلام السائق الركّابَ بأنّه ينوي العودة القهقرى لأخذ زبُنٍ آخرين طارئين… كما يستهويك أسلوبه في ترصّد الطريق والمفارق بحثًا عن زبون، وإشارات يديه الدقيقة والمعبّرة أكثر من أيّ كلام، فمتى وقع على ركّاب منتظرين يناديهم بإلحاح بإشارة من يده، ويخبرهم عن وجهته بإشارة ثانية محدَّدة وصريحة، يقصد بها أنّه يسير في اتّجاه مستقيم حتى نهاية مسار الرحلات. ولا يغادرهم قبل أن يتأكّد من وجهتهم، وإن وجدهم متلكّئين، وأخذوا يساومونه، يسايرهم، لكن، بشروطه وليس بشروطهم! ولا يمكنك إلّا أن تثمّن مروءته حين يصعد راكب ويهمس إليه وهو يدسّ في يده ورقة نقديّة لا تساوي الأجرة المتعارَف عليها، فيتواطأ معه على ستر قلّة ذات يده!
وأكثر ما يفاجئك، وربّما يمتاز به كثير من سائقي الحافلات كونهم يجتازون مسافات طويلة من العاصمة إلى الأطراف النائية، أنّهم يتحوّلون إلى ساعي بريد، فيقومون بتسليم الرسائل وحتى الطرود الموضوعة في أكياس شفّافة يُظهر معظمها ما تحتوي عليه من علب أدوية وما شابه. وبذلك، كان السائق يتوقّف تباعًا حيث ينتظره أناس، تواصل معهم عبر هاتفه الخلوي، لاستلام البريد.
هكذا يتكرّر نزوحنا كلّ يوم، وتتكرّر معه مشاهداتنا ومعاناتنا، وتزداد قناعتنا بأنّ سفَرًا طويلًا يفصلنا عن الوطن الذي نحلم به… ولا يُنعش أملنا فيه سوى هذه القلّة من عامّة الناس التي تؤكّد لنا بطيبتها وجمال خلقها أن لا شيء مستحيل!