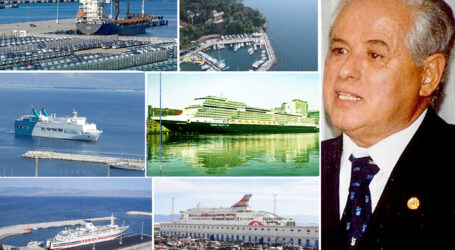عبّاس محمود العقّاد… أديب موسوعي المعرفة
وفيق غريزي
علمان من عالم الأدب والفكر بعثا حركة نشيطة في حياتنا الآسنة في القرن العشرين الماضي، هما: عميد الأدب العربي طه حسين، ابن البيئة الثقافية المصرية وجامعة السوربون والحياة الفرنسية، وعبّاس محمود العقّاد الذي ما عرف الا البيئة المصرية، ولكنه بذكائه ومواهبه وقدراته الذهنية الفائقة، حقق في عالم الفكر والأدب ما لم يحققه معاصروه من الاساتذة الكبار. إنه العصامي الذي استوعب ما في الفكر الغربي من فلسفات معقدة، وهضم واستوعب، واضاف اليه، وعدّل فيه، ثم قدّمه لنا معرفة سائغة، فأنار افكارنا، وعقد بيننا وبين هذا الفكر الجديد صلة طوّرت من معارفنا. والعقاد موسوعي المعرفة، لا ندري كيف استطاع أن يتمثل كل هذا الكم من المعرفة، وان يقرأ كل هذا العدد الضخم من الكتب التي من العسير فهمها، فكيف بتصويب ارائها، وتقديم اراء جديدة فيها.
الناقد الاردني الدكتور محمود السمرة تناول العقّاد ومسيرته الادبية الفكرية والشعرية في كتابه “العقاد”.
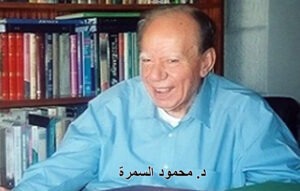
نظرية العقّاد الجمالية
بدا العقّاد حياته الأدبية في العقد الاول من القرن العشرين، مؤمنا بأن افكاره ستفتح باب التجديد في الأدب العربي، وكان دافعه الى ذلك ايمانه بأن الأدب العربي يشوهه مفهوم المعاصرة للأدب، مما جعل الحاجة ماسة الى التجديد، وحسب رأي المؤلف السمرة فان الأدب عند العقّاد ليس شكلا من اشكال التسلية، ولكنه تفسير صادق، للحياة، وما دامت الحياة والأدب، خاضعين للمؤثرات نفسها، فانهما يخضعان ايضا للمفاهيم النقدية نفسها، فالأدب مزاج الأمة، واعتبار الأدب ملهاة وتسلية، هو الذي يصرفه عن عظائم الأمور، ويوكله بعواطف البطالة والفراغ، لأن هذه العواطف اشبه بالتلهي، واقرب الى الأشياء التي لا خطر لها، ولا مبالاة لها. واعتبار الأدب ملهاة وتسلية هو علة ما يطرأ على الكتابة والشعر من التزويق والبهرج الكاذب، والولع بالمحسنات اللفظية، والمطالعات الوهمية كما يقول العقّاد نفسه. ونستطيع القول إن العقّاد كان من اوائل النقاد المصريين المحدثين، إن لم يكن اوّلهم، في أنه كرّس نفسه لمناقشة القضايا الجمالية، وقدّم مفهوما جديدا للنص والأدب لم يحد عنه، وكان متأثرا في آرائه بالفيلسوف الالماني عمانويل كانط، وليسينغ، وهيغل، وشوبنهاور، وفرويد. ويشير المؤلف الى أن العقّاد لم يكن ناقلا لآراء هؤلاء فقط، بل شارحا لها ، ومضيفا اليها، ومعدلا فيها، وهو يقول: “في سبيل الحق والجمال والقوة أحيا، وفي سبيل الحق والجمال والقوة اكتب، وعلى مذبح الحق والجمال والقوة اضع هذه الاوراق المخضلة بدم فكر، ومهجة قلب، قربانا الى تلك الاقانيم العلوية، وهدية من السحاب الى العباب”.
عند العقّاد ادراك الجمال ينبغي له تهذيب في النفس، ودقة في الذوق، لا تكتسبان إلا مع العلم ومعاينة ثمرات الفنون، وذلك الى استقامة الفطرة، وسلامة الطبع، وليس كذلك الجلال، فانه لقوته الضاغطة على الحواس يضطر النفس الى الشعور قسرا”. ووجد في رأى ليسينغ في التفرقة بين الفنون، بين الشعر من ناحية، والرسم والنحت من ناحية اخرى، ما يعينه على تكوين رأى جديد في الشعر العربي، وفي هذا الصدد يقول العقّاد: “فالنحت أو الرسم، النحات أو الرسام يصور لحظة حركية أو اثرها في الجسم، وعلى النحات أو الرسام أن يختار هذه اللحظة بحيث تكون لحظة الذروة. بينما على الشاعر أن يختار جزءا أو حالة من الجسم ليصوّر الحركة المستمرة فيه، وعلى هذا الجزء المختار أن يكون اكثر الاجزاء تأثرا بالحركة”. ويؤكد المؤلف محمود السمرة أن العقّاد تأثر في نظريته الجمالية النقدية بهيغل في كتابه “علم الجمال”، حيث يرى هيغل أن محتوى الفن أو مضمونه هو الفكرة، بينما يتمثل شكله في عملية الصياغة، وعلى الفنان أن يقوم بإحداث التناغم أو الانسجام بين هذين المكونين، لتكوين مركب جديد، يتسم بالحرية، وقد انطلق العقّاد من هذا ليقول إن الجمال هو الحرية، وهما معنيان لا ينفصلان، فلا يكون الجمال ابدا في معناه بعيدا من الحرية، ولا تكون الحرية ابدا في معناها بعيدة عن الجمال”. والحرية المقصودة هنا هي نقيض الفوضى، كما أن الجمال نقيض الاضطراب والاختلاط، فالحرية تستلزم الاختيار والمشيئة، ولا غاية… وهذا يرجع بنا الى التوحيد بين الجمال والحرية “.
اما شوبنهاور فيرى أن الجمال مطهر للعقل، فهو يسمو بنا الى لحظة تعلو عن قيود الرغبة. ويقسم شوبنهاور العالم الى فكرة وارادة ويقول: “إن العالم في الفكرة هو العالم المكنون قبل أن يظهر في حيز الأسباب والقوانين، وعلاقات الاشياء بعضها ببعض، وإن العالم في الارادة هو هذا العالم الذي نكابد اوصابه، ولا نذوق السرور فيه إلا لسبب من الاسباب، ولما كان سرورنا بالجمال سرورا بلا سبب أو منفعة ، فهو من قبيل الفكرة المجردة التي تحسها النفس المجردة”. وهنا يخالفه العقّاد في أن الجمال حرية وليس فكرة، وكلما زاد نصيب الفنون الجميلة من الحرية كانت أرقى في سلم الجمال. إن الحرية هي العنصر الذي لا يخلو من الجمال.
نظرية العقّاد الشعرية
يقول المؤلف محمود السمرة: “اذا كان حسين المرصفي قد احدث نوعا من التجديدي في كتابه “الوسيلة الادبية في العلوم العربية” بان نظرية الأدب على أنها تنمي الذوق الأدبي، فان التجديد الحق انما بدا على يدي مدرسة “الديوان”: العقّاد والمازني وعبد الرحمن شكري، وكان هؤلاء قد بدأوا حياتهم النقدية ينشرون في صحيفة عكاز في العام 1912. فالشعر عند مدرسة الديوان ليس تزجية فراغ، وانما هو عمل جاد ينفذ فيه الشاعر الى بواطن الأمور، والنهضة الأدبية الصادقة لا بد من أن تحفز الأمة الى نهضة قومية، فمزية الشعر، لا تنحصر في الفكاهة العاجلة، والترفيه عن الخواطر، لا، بل في تهذيب الاخلاق وتلطيف الاحساسات. ولكنه يعين الامة ايضا في حياتها المادية والسياسية. وإن لم ترد فيه كلمة عن الاقتصاد والاجتماع، فإنما هو كيف ما كانت موضوعاته وابوابه، مظهر من مظاهر الشعور النفساني، وان تذهب حركة النفس بغير اثر ظاهر في العالم الخارجي”. ولقد كان العقّاد هو الممثل الحقيقي لمدرسة الديوان في النقد، وقد اقتصر نقده على الشعر الغنائي لأنه في رأيه، قمة الفنون، وقد عرّف النقد بقوله: “النقد هو التمييز، والتمييز لا يكون إلا بمزية”، أما المؤلف فيشير الى أن من المنطلقات الرئيسية في نقد العقّاد أن يصعب أن يكون هناك نقد موضوعي خالص، لأن الذوق، ذوق الناقد، لا بد له من أن يجد طريقه اليه، والمهم ألا يكون هذا النقد ذاتيا مزاجيا، غير معلل، كما تأثر العقّاد بنظرية كولريدج في الخيال، وتمييزه بين الخيال الأولي والخيال الثانوي، وبتميزه ايضا بين الخيال والوهم، فالخيال الأولي هو الذي يجعل الادراك الانساني ممكنا، والخيال الثانوي، يذيب ويحطم لكي يخلق من جديد، والوهم ليس الا ضربا من الذاكرة تحرر من قيود الزمان والمكان. وكولردج شاعر عظيم، وناقد عظيم، ووفق وجهة نظر المؤلف فان القصيدة الجيدة هي التي تعبر بصدق عن نفس الشاعر وشخصيته، حتى ولو كانت تتحدث عن الآخرين. وقسّم العقّاد الشعراء الى قسمين: شعراء مطبوعين وهم الذين يعبرون عن احاسيسهم، وشعراء مقلدين، هم نسخة مكررة عن سابقيهم، والشاعر لا يكون الناطق بلسان الجماعة الا عند القبائل غير المتحضرة.
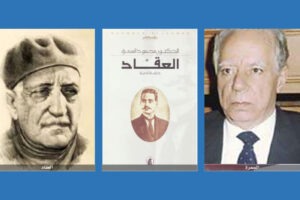
عباس محمود العقّاد والمرأة
ثمة نقطة مركزية في حياة العقّاد هي موقفه من المرأة، اهو كاره للمرأة، ام محب لها؟
يشير المؤلف الى أن صلة العقّاد بالمرأة تعود الى عام 1912، عندما لخص في كتابه “الانسان المثالي، مقال الفيلسوف الالماني آرثر شوبنهاور عن النساء”، فتأثر به، يقول العقاد: “وقفت على اراء في المرأة للفيلسوف شوبنهاور، فأعجبني حذق الرجل، وجرأته عل المجاهرة بأقوال يعد قائلها في اوروبا خلوا من التهذيب وسلامة الذوق.
وقرا العقّاد ميتافيزيقا الحب الجنسي لشوبنهاور، الذي كان متفقا معه في كثير من آرائه حول المرأة، وعرض لآراء ماكس نورداو في الجمال والزواج، وبإيجاز يقول المؤلف: “إن آراء العقّاد حول المرأة كانت نتاج قراءاته الكثيرة لما كتبه المؤلفون الغربيون عنها، ونتيجة خبرته في الحياة.
ولعل موقف العقّاد من المرأة نتيجة لتكوينه النفسي، فقد كان شديد الحساسية، منطويا على نفسه، يقيم الحواجز بينه وبين الآخرين، لا يعرف التوسط في حياته، فأنت اما صديق أو عدو، ولا شيء غير هذا. ويرى المؤلف محمود السمرا أنه بسبب علاقاته الفاشلة مع المرأة، حمل لها الكراهية، وبسبب خيانتها له لم يعد يثق بها. (wmpg.org) وهذا ما حدث له مع سارة، التي أحبها حبا ملك عليه كل مشاعره، واسمها الحقيقي “اليس داغر”، وهي سيدة لبنانية كانت في الخامسة والعشرين من عمرها عندما عرفها، تجيد كثيرا من اللغات، تزوجت وهي في العشرين من رجل في الخمسين، بسبب ثرائه، ولم تجد عنده الحب الذي كانت تسعى اليه، فكان قلبها فارغا، متطلعا الى من يملأه. ولا يرتاح العقّاد لفكرة الزواج، ولا يتصور الحياة تحت سقف واحد مع امرأة واحدة طوال الوقت. وأحب العقّاد الأديبة اللبنانية مي زيادة وكان حبهما قائما على الإعجاب والعاطفة البريئة. كما أحب فتاة في عنفوان شبابها، تسكن في ضاحية عين شمس، وقد فشل في حبه لها ولم تمكّنه من نفسها. وكان قد تجاوز الخمسين من عمره، وكبرت هذه الفتاة لتصبح ممثلة معروفة، فهذا الحب اعصار هب عليه وهو يدلف الى الشيخوخة، ويؤكد الملف أن من هذه التجارب كلها انتهى العقّاد الى رأي ثابت في المرأة.
ويروي العقّاد عن شوبنهاور قوله إن: “النساء كالصغار، صبيانيات الميول، ضعيفات الاحلام، قصيرات النظر، وانهن لا يفتاًن لاهيات، فما تزال المرأة طفلا في كل ادوار حياتها”. وأعرب العقّاد عن ايمانه بقول كولردج: “إن الرجل يريد المرأة، وأما المرأة في غالب امرها، فان الذي تريده هو أن يريدها الرجل”.
ويعتقد عباس محمود العقّاد أن الحب ليس غريزة جنسية، ولا شهوة، ولا صداقة، وليس انتقاء أو اختيارا، أو رحمة، بل فيه شيء من العبادة، والخداع، والأنانية، والغرور، والاهتمام، ولهذا فان في الحب شيئا من البغض، والايذاء، والخيانة. وفي الحب شيء من القضاء والقدر، وخلاصة القول في الحب: “إنك لا تحب حين تختار، ولا تختار حين تحب، وإننا مع القضاء والقدر حين نولد، وحين نحب، وحين نموت”…