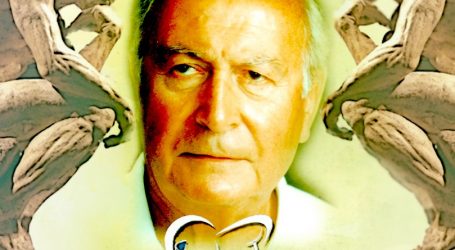قصة قصيرة/ عائدٌ إليكِ… إنتظريني
ديانا جورج حنّون
“لقد وصلْتَ سيّدي”.
لمْ يحرّكِ الشّاب الجالس في المقعد الخلفيّ ساكناً، فالتفتَ إليهِ، ورآه فاغر الفم، يحملقُ ببيوت مهدّمة، وأراض مقفرة. فسألَهُ: “سيّدي، أهذه المرّة الأولى التي تأتي فيها إلى هذه القرية؟ حتى الأمس القريب كانتْ محتلّة. الحمد لله لقد تخلّصنا من الكابوس”.
فتنبَّهَ الشّاب إلى السّائق، ورمقهُ بنظرات تائهة، ومن دون أنْ يردَّ نزلَ من السّيارة، وسار في طريق فرعيّة محفّرة حاملاً حقيبة جلديّة. وخطرَتْ بباله وصيّة أمّه وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة: “يا ولدي، لقد عادَتْ إلينا الأرض بعد أنِ اندحرَ العدوّ، آن الأوان لأنْ تعودَ إلى قريتك وتُرمّمَ بيت أبيك. أتعدُني؟” وأجابَ بلهجة مطمئنة واثقة: “أعدكِ”. فارتاحتِ الأمُّ وأسلمَتْ روحها إلى خالقها.
منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، أخذتْهُ أمّه ورحلَتْ، بعدما استشهد والده وهو يزرع أرضه، وسكنا في غرفة متواضعة، وعملَتْ خادمة في البيوت، لتحملَ إليه آخر النّهار لقمة طريّة تسدّ بها رمقه. تعالَتْ على قلقها وتعبها ويأسها، ورعتْهُ وأغدقَتْ عليه حبّاً وعاطفة لا مثيل لهما…

وانطوتِ السّنون، وكبر الصّبيّ.
كبر، وقلبه يضجُّ حنيناً وشوقاً لأب فقدهُ ويفتقدهُ.. وقرية هُجِّرَ منها ويتوقُ إليها.. وأُمّ تعلّق بها ولم يُفارقها لحظة. ففي صقيع تلك السّنوات، كان ينفطر قلبها حزناً عندما كان ينظرُ في عينيها الذّابلتين وقد ماتتِ البسمة على شفتيها، وهي عائدة من عملها مرهقة لتُلقي بجسدها النّحيل على شبه أريكة، تحضنُ رأسها بين يديها، وتبكي بصمت…
وإذ أتعبَتْهُ الذّكرى وأرهقه المسير، جلس على صخرة في ظلّ شجرة، وجال بعينيه المتعبتين في أرجاء القرية، وراح يحدّثُ نفسه: “أأنا حقاً في قريتي؟ أين ملاعب الطفولة؟ أين أهل تلك البيوت؟ ما زلتُ أسمع وطء أقدامهم على حصى الطّرقات، أين أنتم؟ أجيبوني…”. فأرجع الصدى كلماته وأنّاته، وتاهت كملامح ناس تلك القرية. فقام عن الصّخرة، وسار في طرقات قريته، يبحث عن بيت أبيه.
…في برودة ليالي تلك الأيّام، وعلى ضوء شمعة يتيمة تُصارع العتمة، وترسم خيالات على الجدران، كان يجلسُ إلى أمّه، ولا يملّ من الاستماع إلى ذكرياتها المحبّبة عن والده يوسف: “لقد شيّد والدكَ بيته حجراً حجراً بيديه.. رفض أن يغادر أرضه يوم احتلّ العدوّ القرية.. فنقموا عليه وقتلوه..”
كان حنينها، وألمها الدّفين، يغذّيان مخيّلته الصّغيرة، ويوقدان في قلبه شعلة لا تنطفىء، لحبّ والد شهيد، ووطن سليب…
فيما كان يسير بين البيوت المهدّمة، باحثاً عن بيته، التقى رجلاً كبيراً في السّن، يتوكّأ على عصا، فألقى عليه التّحيّة، وسأله:
– أيّها الجليل، أين أجد بيت يوسف(…)، منذ سنوات بعيدة صرعته رصاصة عدوّ حاقد، فاستشهد وهو يزرع حقله؟
أمعن الشّيخ النّظر مليّاً في وجه الشّاب وسألَهُ بحشرية:
– لماذا تسألُ؟ أتربطكَ به علاقة ما؟
– إنّني ابنه…رفيق.
– ابنه؟!
– لقد غادرْتُ وأمّي البيت إثر استشهاد والدي، ولمْ أعدْ أذكر موقعه…أين هو؟
– وأين أمضيتَ هذه السّنوات؟
– في المدينة.
– ولماذا عدتَ؟
حدق رفيق بمحدّثه، وأجابَهُ بثقة وعزم:
– أريدُ أنْ أرمّم بيت أبي وأعيش فيه.
– وأمُّك؟
– توفّاها الله.
– رحمها الله.
– أرجوك، دلّني على موقعه؟
– لمَ لا تنسَ ما جئتَ من أجله، وتعود من حيث أتيتَ؟
– لماذا؟
– لأنك لنْ تجدَ أبداً أثراً لبيت أبيك.
– لا أفهمك…
– لأنّك… تقف على أنقاض البيت.
(وتابع الرجل مسيره متأسّفاً).

نزل الخبر على رفيق نزول الصّاعقة. فغشيتْ عيناه بالدّمع، وركع على الأرض، وكمش ترابها، وراح يمرّغها على وجهه، وجبينه، وينثرها على شعره وهو يناجي روح أبيه الهائمة:
“لقد هدّموا بيتك بعد أن استمتعوا بقتلك وتشريدنا… حُرِمتُ كلماتك، وضحكاتك، ومداعباتك… أينَ سأدفن أمّي، وقبرك مُحيت معالمه؟”.
الآن ، وقد اندحر العدوّ، أعدك، كما وعدتُ أمي، أنّني لن أترك بيتي وإنْ مُدّمراً، سأعيد بناءه. وأرضي وإن محروقة، سأقوم على فلاحتها وغرسها. لنْ أغادر قرية ارتوى ترابها بدمائك الزّكية… أتسمعني؟”.
ومسح دمعه وقام، ومشى بخطوات واثقة على الطّريق التي سلكها، ثمّ التفتَ خلفه، وابتسم للبيوت القليلة المتناثرة، وقال:
“عائدٌ غداً…افتحي لي، يا قريتي، ذراعيك واقبليني ابناً لا يلهج لسانه إلاّ باسمك، ولا تُغريه إلاّ رائحة ترابك… إنتظريني”.