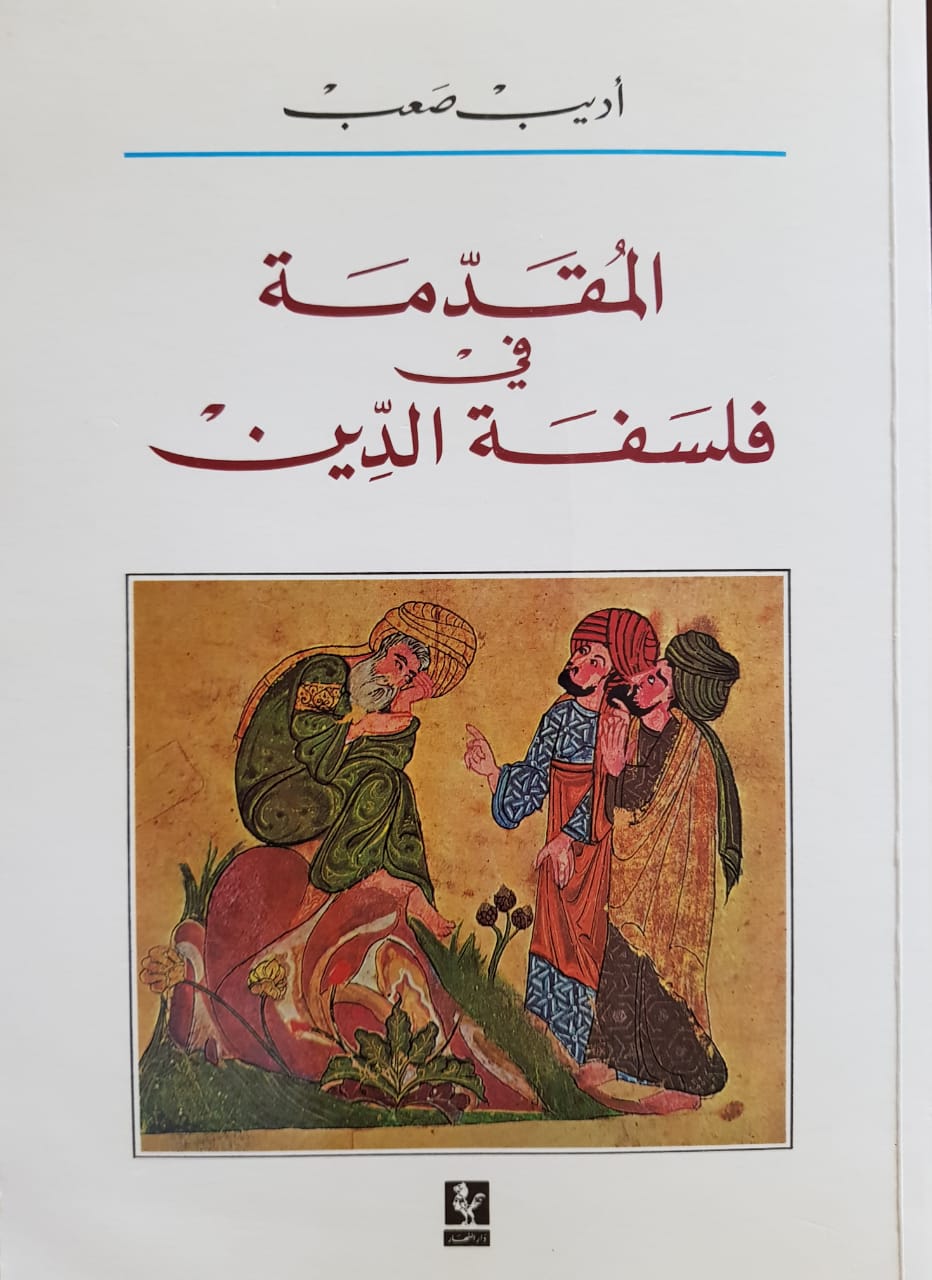الدولة الدينية الاسمية والدولة الدينية الفعلية
د. أديب صعب
عبارة “الدين والدولة” من أكثر العبارات تكرراً في الأدبيات الفلسفية والدينية والاجتماعية والسياسية. ما طبيعة هذه الواو القارنة، وكيف نتلمس طريقنا وسطها؟ ما هي طبيعة الدولة؟ ما هي طبيعة الدين؟ كيف نتصور العلاقة السليمة بين الدين والدولة وبين الدولة والدين؟
ثمة أبواب كثيرة لوُلوج هذا الموضوع. لكني ارتأيتُ دخوله من الباب الآتي: كلّ دين، بمعنى عميق جداً، هو “دين ودولة” إنْ جاز التعبير. هذا ينطبق على المسيحية كما على الاسلام. وينطبق على كل أديان العالم الذي بلغ عدد سكّانه أخيراً سبعة مليارات وسبعمئة مليون نسمة، بما فيه من ديانات، مسيحية وإسلامية وبوذيّة وهندوسية وكونفوشيوسية وطاويّة وشينتويّة ويهودية وزردشتية وسواها. لكن بما أنّ بلادنا، في حاضرها وماضيها، معنية بالاسلام والمسيحية على وجه الخصوص، فلسوف أَقصر كلامي عليهما.
من الأخطاء الشائعة في بعض الفكر الديني والاجتماعي والسياسي أنّ المسيحية ليست ديناً ودولة كما الاسلام دينٌ ودولة، استناداً إلى احتواء القرآن على سُوَر مدنية زاخرة بالتشريع مع السوَر المكّية الزاخرة بالأبعاد الروحية، وإلى خلوّ الانجيل من التشريع مع آيات من نوع “مملكتي ليست من هذا العالم” و”أَعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله”. إلّا أنّ هذا التفسير مثَل على فصل الأقوال عن سياقها وأخْذ النصوص الدينية لا في مجملها بل جملةً من هنا وجملةً من هناك، كما يتّفِق للمفسر وكما يوافِق أغراضه ومصالحه.
إنّ المسيحية لا تختلف عن الاسلام من حيث كون الاثنين “ديناً” و”دولة”. والحقّ أنّ كل دين هو هكذا بطبيعته، إذ يتناول كل شيء في حياة الانسان، واضعاً إياه في ضوء مثاليّ إزاء الحقيقة المطلقة أو الأُلوهة. ومن هذه الأشياء ما يسمَّى المجتمع والدولة والسياسة. فالمؤمن المسيحي والمسلم واليهودي والهندوسي والبوذي، المؤمن من أيّ دين، إمّا أن يبني كل نظرته إلى الحياة، بما فيها نظرته الاجتماعية والسياسية، على إيمانه الديني، وإما أن يتحمل تبعات الانفصام الذهني والنفسي والروحي المترتبة على هذا الفصل.

معنى “مملكتي ليست من هذا العالم”
حين أَطلق المسيح عبارته الشهيرة: “مملكتي ليست من هذا العالم” (يوحنّا 18: 36)، فهو لم يقصد البتّة أنّ الدين ليس معنياً بهذا العالم، وأنّ رسالته مقصورة على “الحياة الأُخرى”، أي تلك التي تعقب الموت. إنّ الرسالات الدينية كلها تدور على تحسين حياة الانسان على هذه الأرض ورفع شأنها، مع الايمان بأنّ الكمال لا يتحقق إلّا في الدهر الآتي. لذلك تشدِّد المسيحية على أنه “ليس لنا هنا مدينةٌ باقية” (عبرانيّين 13: 14)، فيما يشدّد الاسلام على أنّ “الآخرة خَيرٌ وأَبقى”: “بل تؤْثرون الحياة الدنيا، والآخرةُ خيرٌ وأَبقى” (سورة الأعلى [87]: 16-17).
المعنى الطبيعي لقول المسيح بأنّ مملكته “ليست من هذا العالم”، في إطار رسالته ككل، هو: (1) التمييز بين “العالم” و”الملكوت”، أي بين نظرتين إلى العالم: واحدة تجده كوناً قائماً في ذاته ومكتفياً بذاته، وواحدة تراه من حيث هو مخلوق، لا كيان له ولا معنى إلا في ضوء الخالق. (2) النظرة الثانية إلى العالم تعطي الدين سِمَتَه الخاصة بالتمييز بينه وبين النشاطات الأُخرى، خصوصاً الأخلاق والاصلاح الاجتماعي. فالدين يتميز بنظرته الإلهيّة إلى العالم قبل أيّ شيء آخر، وعلى هذه النظرة تُرسى الأخلاقيات والاجتماعيات الدينية. (3) في حين أنّ الأخلاق والاصلاح الاجتماعي ممكنان بانفصال عن الدين، إلّا أنّ المؤمن يستمد نظرته الخُلقية والاجتماعية من دينه. (4) كَوْن “مملكة الدين” من غير هذا العالم لا يعني البتّة أنها ليست له. والأحرى أنّ السعيَ الديني هو إلى تحويل هذا العالم ملكوتاً لله.
هذا يعني أنّ قول المسيح “مملكتي ليست من هذا العالم” لا يختص بالدين المسيحي وحده، بل يعبّر عن ماهية الدين، أيّ دين، بقبْضه على العنصر الذي يمنح الدين استقلاليته ويجعله مختلفاً عن سواه، ولا سيّما عمّا يشبهه، مثل الأنظمة الخُلقية والاجتماعية. في غياب هذه النظرة إلى الدين، من الطبيعي جداً أن يُخفَض الدين إلى أخلاق، وألّا يكون هناك أيّ فرق بين يسوع المسيح وسقراط، أو بين النبي محمّد وكارل ماركس.
لكن إذا كانت المسيحية ديناً ودولة، والاسلام ديناً ودولة، واليهودية ديناً ودولة، والهندوسية ديناً ودولة، وكان كل دين بلا استثناء ديناً ودولة، فعلى أساس أيّ دين يُقام نظام الحكم في بلدٍ ما؟ هناك مسألتان كبيرتان يجب التصدّي لهما من أجل تلمُّس الطريق نحو إجابة عن هذا السؤال. المسألة الأُولى تتناول المجتمعات لجهة تعدديتها أو لجهة وحدتها الدينية. والمسألة الثانية تتناول الدين من حيث هو مصدر للتشريع. نبدأ بالمسألة الأُولى. في مجتمع متعدد الأديان، أيّ دين يجوز أن تكون له اليد الطولى في الحكم؟ في لبنان، مثلاً، أتَكون الدولة إسلامية أم مسيحية؟ لا شكّ أنّ دولةً مسيحية لن تُرضي المسلمين، وأنّ دولةً إسلامية لن ترضي المسيحيين، مهما كان محتوى هذه أو تلك، ومهما بلغ التسامح الاسمي أو الفعلي على يد هذه أو تلك. فلا أحد يرتضي أن يكون “في ذمّة” أحد، أو تحت راية أحد، وإنْ إسميّاً. وما يصحّ على المجتمعات ذات الأغلبية الدينية الضعيفة يصحّ على المجتمعات ذات الأغلبية الدينية القوية. فهذه المجتمعات متعددة الأديان. وأيّ نظام حكم يتكنّى باسم دين الأغلبية فيها لا بدّ من أن يشكّل ظلماً للأقلّيات.
لكن ماذا عن المجتمعات ذات الدين الواحد؟ حتى في مجتمعات كهذه، يواجِه الحكم باسم الدين مآزق. من هذه المآزق أنّ الشرائع، حيثما وردت وكما وردت في النصوص المقدسة، غير كاملة وغير مفصلة، وأنها تحتاج إلى سدّ ثغرات كثيرة وإلى تفصيل وتفسير واجتهاد. وقد نشأ هذا التفسير والاجتهاد فعلاً، لكنه كان سبيلاً إلى الخلاف والانشقاق أحياناً كثيرة، وإلى نشوء مذاهب مختلفة في الدين الواحد. حتى في الحكم المذهبي الواحد حيث يقوم اليوم، نجد ما يسمَّى خطاً منفتحاً أو متحرراً وخطاً متشدداً أو منغلقاً، مع ما بينهما من خطوط تَميل ذات اليمين أو ذات اليَسار.

التعددية واقع كل مجتمع
من هنا، يبدو أنّ تسمية المجتمع المتعدد أو التعددي تصحّ على أيّ مجتمع، حتى ذاك الذي يندرج أفراده تحت دين واحد أو مذهب واحد. فتنوُّع التفسيرات والاجتهادات في الدين الواحد أو المذهب الواحد، وحرّية المرء للتفسير والفهم وكذلك للايمان وعدم الايمان، أُمورٌ كفيلةٌ بِجَعْلِ أيّ مجتمع في العالم تعدُّدياً بمعنى واحد على الأقل لا يمكن خَفْضَه إلى معنى آخر، هو المعنى العددي. وبما أنّ كل مجتمع “عددي”، أي مكوَّن من أفراد، فهو بالضرورة تعددي.
وإذا أمكن أن يكون نظام حكم قائم على الدين ظالماً للبشر، فهو ظالم لله أيضاً. فالحاكم في نظام ديني، كما في أيّ نظام، هو البشر. غير أنّ بناء الحكم على الدين يَمنح الحاكم نوعاً من الاطلاقية يظنّ معه أنه ظل الله على الأرض وأنه يفعل إرادة الله في كل ما يفعل. لكن إذا كان هذا صحيحاً، فكيف يمكن تفسير الانقلابات والاغتيالات التي نُفِّذَت في الحكّام الدينيين، باسم الدين والتصحيح الديني، ثم ما لبث “المصحِّحون” أن تعرّضوا للمعاملة ذاتها في حركات تصحيح مضادّة؟ ولْنتذكّر قول المفكر الألماني لودفيغ فويرباخ: “حيثما أُقيمَ الحقّ على السلطة الإلهية، يمكن تبرير أشدّ الأُمور سوءاً وظلماً”. ما سبق هو بعضٌ من الصعوبات التي يمكن أن يواجهها نظام حكم ديني في مجتمع متعدد أو غير متعدد دينياً.
أما المسألة الثانية في تصدّينا لهذا الموضوع فمتعلقة بالدين من حيث هو مصدر للتشريع: هل في الأديان شرائع مفصلة تَصلح لكل مكان وزمان؟ هل يمكن استمداد شرائع مفصلة من الدين تَصلح لكل زمان ومكان؟ الواقع أنه ليس من شرائع مفصلة في الأديان، وإنْ كان الجانب التشريعي في بعض الأديان، كالمسيحية، أقل كثيراً منه في بعضها الآخر، كاليهودية والاسلام. إلّا أنّ الشريعة الاسلامية لم تأتِ مفصَّلة في القرآن، الأمرُ الذي أدّى إلى بروز أربع مدارس فقهية أساسية في الاسلام السنّي، هي الحنَفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ناهيك بالاجتهادات والفتاوَى في الشيعة، وإناطة شؤونها بالأئمّة. واعتُمِدَت أربعة أُسس في التشريع التقليدي، هي: القرآن، الحديث، القياس، الإجماع. وقد رَكّزَت المدارس المختلفة على بعضها أو عليها كلها. وأدّى اختلاف التفسير إلى خلافات واسعة أحياناً. وهذا جَعل أبا العلاء المعرّي يقول:
أَجازَ الشافعيُّ فعالَ شيءٍ وقال أبو حَنيفةَ لا يَجوزُ
فضَلَّ الشِّيبُ والشبّانُ منّا وما ٱهتدَتِ الفَتاةُ ولا العجوزُ
والحقّ أنّ في الدين، كما في الأخلاق، نوعين من الأحكام: المطلق والنسبي. المطلق يدور على القيم والمثُل العليا العامة التي لا يطرأ عليها تبدُّل، مثل الحرية والعدالة واحترام كرامة الانسان. وهذا متعلق بالغايات أو الأهداف. أما النسبي فيَدور على الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. والوسائل تتبدل بتبدُّل الأزمنة والأمكنة وتتعدل في ضوء الظروف، بشرط ألّا تنحرف عما يخون الأهداف التي وُجدت من أجلها. فليس من العدالة في شيء أن تُحقَّق عدالة أحدهم بظلم سواه. ولا يبقى معنى لاحترام كرامة أحد الناس إذا أُهينت كرامة آخر في هذا السبيل.
إنّ هدف الحياة الاجتماعية هو إتاحة أفضل الظروف أمام جميع الأفراد الذين يتكوّن منهم النسيج الاجتماعي لكي يحققوا ذواتهم، ولكي يعيشوا ويتعايشوا بسعادة وطمأنينة وسلام. وقد تبيَّن خلال التاريخ، وفي سعي الأفراد والشعوب لتحقيق هذه المطالب، أنّ أفضل الأنظمة المدنية أو الاجتماعية أو السياسية الكفيلة بتحقيق هذه المطالب هي تلك القائمة على تأمين الحرية والعدالة والمساواة. وهذا ما دعت إليه بعض التشريعات المحلية والشرائع العالمية لحقوق الانسان. وهذا ما يدعو إليه لا دينٌ بعينه، بل الأديان كلها، التي تتلاقى على جوهر واحد، في رأسه هذا المبدأ بالذات: وهو أنّ كرامة الانسان آتية من أعلى ما فيه.
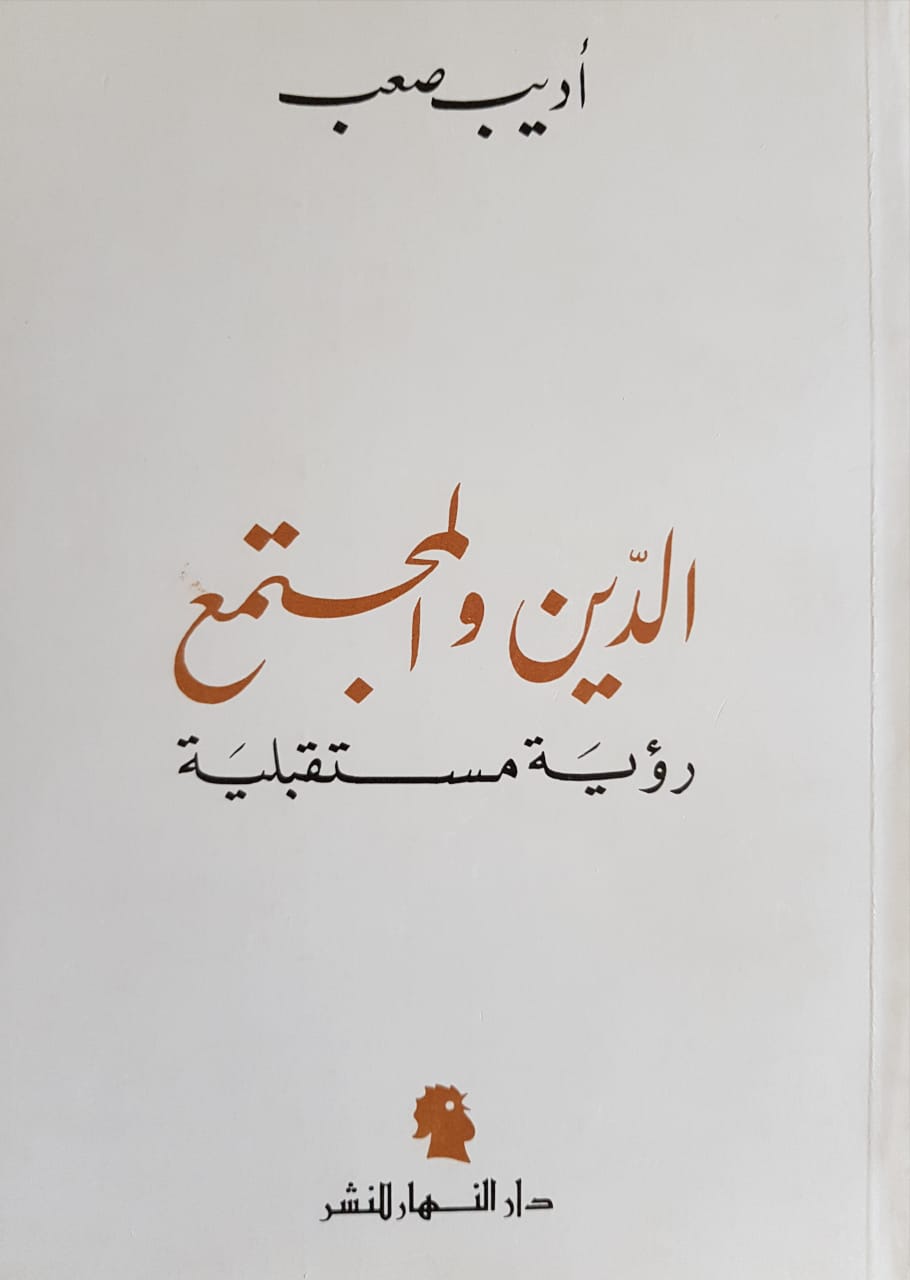
الدولة الدينية الفعلية
إنّ الدولة التي تنتهج قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان وإتاحة أفضل الظروف له لتحقيق أعلى إمكاناته هي، إذاً، دولة تقيم نظام الحكم على جوهر الدين. والدين، قبل أيّ شيء آخر، جوهر: إنه جوهر قبل أن يكون اسماً. وإذا كان لا بدّ من ربط الدولة بالدين، فما نقوله يعني أنّ هناك دولة دينية “إسميّة” ودولة دينية “فعلية”. الدولة الدينية الاسمية تتكنّى باسم دين معيَّن، فتجعل من ذوي الأديان الأُخرى أو ممن هم خارج نطاق الايمان أعداء لها. والايمان مسألة حرّية، لا مسألة قَسْر. ولا ضمان لهذه الحرية إلّا بتصحيح مفهوم التعددية حسب ما اقترحنا، أي التعددية بالمعنى العددي.
أما الدولة الدينية الفعلية فتنطلق من روح الدين وجوهره ولا تتبنّى أيّ عقيدة، مفسحةً المجال أمام مواطنيها لكي يتبنّوا العقائد التي يريدون. وما دمنا في نطاق الدولة، أي في نطاق الوطن والمواطنين والمواطَنة، فلا مكان للعقائد ضمن هذا النطاق، إذ ما يرجوه المواطن من الدولة ومن المواطنين الآخرين هو المواطَنة لا العقيدة، أي احترام حقوقه كمواطن. أما اعتناق العقائد وممارستها فيحصلان في نطاق آخر غير نطاق الدولة. الدولة الدينية الاسمية تنتهج سبيل الإكراه والعنف والحرب لإنقاذ أسماء. الدولة الدينية الفعلية تنتهج السلام، وتفعل كل ما يمكن لإبقاء الجوهر أو المعنى أو الروح حيّاً. وبما أنّ المطلوب هو الجوهر لا الاسم، والحرّية لا القَسر، والرفق لا العنف، والنظام لا الفوضى، والإخاء لا العداء، والسلام – وهو من أسماء الله تعالى – لا الحرب، فلا شكّ أنّ المطلوب هو الدولة الدينية الفعلية، لا الدولة الدينية الاسمية. هذا هو النظام الوحيد الذي يستطيع أن يرفع شأن الانسان وشأن الدين.
وأختم بما جاء في مقدمة كتابي “الدين والمجتمع” (1983): “الهدف دولة عصرية تكون تجسيداً لمثال الوحدة في التعدد على الصعيد السياسي. فالتعدد، بالمعنى العددي على الأقل، هو واقع كل مجتمع. لكنّ الدولة، من حيث طبيعتها، أداة وحدة وتوحيد. وهذا التوحيد ينبغي أن يتمّ ليس على حساب التعدد، بل ضمن التعدد. لذلك يجب أن تقتصر الدولة على كونها آلة إدارية، لا داعية عقيدة، كيما يُتاح للأفراد اعتناق العقائد التي يريدون بحرّية، ولكي يكون لهم ولاء قومي واحترام لكرامة الانسان مهما كانت عقائده”.