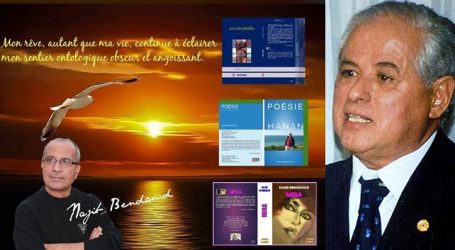بين تعددية المجتمع ووحدة الدولة… نحو عقد اجتماعي جديد
د. أديب صعب
في حين يحصر المفكرون الاجتماعيّون والكتّاب السياسيّون مفهوم التعددية بالمعنى الديني أو العرقي أو الطبقي أو السياسي عموماً، فالكاتب يقدّم معنىً جديداً للتعددية هو المعنى العددي، الذي يغدو معه كل مجتمع تحت الشمس تعددياً بالضرورة. هذا هو المعنى الوحيد للتعددية الذي يصون القيم الاجتماعية، وفي رأسها الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان. وقد طرح أديب صعب هذا المفهوم الجديد للتعددية في خماسيّته الفلسفية، بدءاً من “الدين والمجتمع” (1983) حتى “دراسات نقدية في فلسفة الدين” (2015)، وركّز عليه في الفصل الأول من كتابه “هموم حضارية” (2006). وفي هذه الدراسة يطرح فلسفته الاجتماعية والسياسية اعتماداً على كتابيه “وحدة في التنوّع” (2003) و”هموم حضارية”.
__________________________________________
“Wandering between two worlds, one dead
The other powerless to be born”
(Matthew Arnold)
التعدُّد والوحدة
لا بدّ لأيّ فلسفة اجتماعية أو سياسية، بل لكل فلسفة، سواء أكانت في الدين أم في العلم أم في الأخلاق أم في غير ذلك، من مفهومين جوهريَّين هما التعدد والوحدة. وما دمنا في صدد الفلسفة الاجتماعية، فلنتناول مفهوم التعدد أولاً ثم مفهوم الوحدة بالنسبة إلى المجتمع.
في كل مجتمع أنواع من التعدد أو التنوع. هناك، مثلاً، تنوع في العلم والمستوى التربوي، وتنوع في الطبقات الاجتماعية، وتنوع عرقي، وتنوع ديني ومذهبي، وتنوع سياسي. لكن هَبْ أنّ بعض أنواع التعددية، مع ما يرافقها من مشاكل وصراعات، كانت عديمة الوجود في مجتمع أو آخر؛ هَبْ أنّ أبناء مجتمع معين كانوا كلهم من عرق واحد، وهذا شبه مستحيل عملياً إلا إذا انحرفنا بمفهوم المجتمع عن معناه المقبول؛ أو هَبْ أنهم كانوا كلهم من دين واحد أو مذهب واحد، وهذا ممكن إذا أخذنا الانتماء بمدلوله الاسمي، فلا يتوهَّمنّ أحد أنّ التعددية تزول إذ ذاك من المجتمع. لأنه مع هذا كله، يبقى للتعددية معنى راسخ لا يمكن أن يزيله شيء، هو المعنى العددي(1). هكذا، كل مجتمع تعددي شاء أم أبى، وسوف يبقى على الدوام وتحت كل الظروف تعددياً شاء أم أبى، بمعنى تكوُّنه من أفراد، أي من عدد. قد يكون هذا المجتمع عربياً خالصاً أو كردياً خالصاً، مسيحياً خالصاً أو مسلماً خالصاً، سنّياً خالصاً أو شيعياً خالصاً، لكنّ هذا “النقاء” العرقي أو الديني لن يزيل عنه البتّة سمة التعددية.

التعددية بالمعنى العددي، إذاً، هي واقع كل مجتمع. وهذا هو المعنى الأصيل والأقوى لمفهوم التعددية الاجتماعية، حيث تبقى التعددية قائمة تحت كل الظروف، ويتعذر مَحْوُها أو تبديلها أو تعديلها. ويجدر بكل المنظِّرين في الاجتماع والسياسة والفلسفة والدين إدراك هذه الحقيقة البديهية. وهذا الادراك يَستتبع أخذ الحقيقة المذكورة في الاعتبار من جانب المخططين والمنفذين وكل العاملين في إدارة شؤون المجتمع.
لكنّ التعدد لا يمكن ولا يجوز أن يبقى منفلتاً من كل تنظيم أو توحيد. إذ لو كان واقع الأشياء واقع تعدد مطلق، لأدّى هذا إلى التهافت وانغلاق أبواب الفهم والتفاهم بين الناس. ثمة حاجة، إذاً، إلى اكتشاف مبادئ نظام أو وحدة في مختلف ظواهر الوجود، وأحياناً إلى افتراض مبادئ من هذا النوع أو حتى فرضها على بعض الظواهر. وأكتفي بمثلين عن هذه الوحدة، هما الشخصية على الصعيد الفردي والدولة على الصعيد الاجتماعي(2).
في تجربة كل فرد تعددية هائلة، تتعاقب فيها تيارات الزمان والمكان والأشخاص والظروف والحالات. في غياب عملية تنظيمية تضبط هذا التعدد في وحدات معينة، من الطبيعي جداً أن يصاب الفرد الذي تحصل له التجارب بالتهافُت النفسي. والكثير من الأزمات النفسية التي يعانيها بعض الأفراد ترتبط بالعجز عن تبنّيهم أو ابتكارهم قوانين توحيدية من شأنها حفظ خبراتهم المتنوعة ضمن مبادئ تنظِّمها أو توحِّدها.
إنّ الذين يطلقون العنان لتجارب الحياة تتقاذفهم من غير أن يتوقفوا بين الحين والآخر للتأمل فيها والبحث عن معناها يشبهون قوماً قال فيهم الشاعر تي إس إليوت: “كانت لنا التجربة لكن فاتَنا المعنى”(3). هذا المعنى هو بالذات ما نقصده بالوحدة أو بالمبدأ التوحيدي. وهو، بالنسبة إلى الأفراد، ذو مصادر متنوعة: فبعضهم يستمدّه من انتمائه الديني، وبعضهم من انتمائه السياسي، وبعضهم من انتمائه الفكري، فيما يستمده آخرون من تأملاتهم ومواقفهم الشخصية. حتى الذين ينادون بالعَبَث يرون في هذه العبثية أو اللامعنى نوعاً من المعنى. وبعضهم ممّن يجد معاني عظيمة للحياة مستمَدّة من مصدر ديني أو اجتماعي أو إنساني قد يَفقد المعنى على أثر خبرات معينة مثل الموت أو خيبة الأمل. وإذ يجد الفرد نفسه متروكاً وسط تعددية هائلة من التجارب لا ينظّمها أو يربطها أيّ رابط معنوي، فهو قد يلجأ إلى أُمور مثل الانتحار هرباً من مأزق لا قدرة له على احتماله. وفي العلوم السلوكية دراسات كثيرة لظاهرة الانتحار، حَدَّدت أحياناً دوافع هذه الظاهرة في فَقْد المعنى أكثر من تحديدها في اللامعنى.
وإذا كانت الشخصية مبدأ الوحدة على الصعيد الفردي، فالدولة هي مبدأ الوحدة على الصعيد الاجتماعي. لكن كما في حال النفس البشرية، لا بدّ من أن يؤدي التعدد المطلق، أي ذاك الذي لا توحّده مبادئ معينة، إلى فوضى أو تهافت على الصعيد الاجتماعي. وهذا واقع بعض المجتمعات، حيث الأعراق المختلفة أو الأديان المختلفة أو المذاهب المختلفة أو الأحزاب والتكتلات السياسية المختلفة أقوى من الدولة. وطالما حاولت إحدى هذه الفئات أن تكون “دولة في قلب الدولة”، أحياناً بهدف فرض المبدأ التوحيدي الذي يلائمها. وطالما حصل، باسم الديمقراطية أو مفهوم الأكثرية، تغليب عرق على بقية الأعراق أو دين على بقية الأديان أو مذهب على بقية المذاهب، بهدف بثّ الوحدة في مجتمع معين. وليس من النادر تحقيق التوحيد السياسي عبر اعتماد نظام الحزب الواحد، أي حزب السلطة، وحظْر كل حزب آخر، مع ما يستتبعه ذلك من هيمنة “رسمية” على الإعلام والتعليم والجمعيات الأهلية وكل المرافق الاجتماعية. لكن في أنظمة سياسية أُخرى يتمّ التوحيد على أُسس تأمين الحرية والعدالة والمساواة للجميع، من غير إقصاء أيّ فئة، عرقية أو دينية أو مذهبية أو سياسية أو سواها، عن جسم الدولة.
يمكن أن تتحقق الوحدة الاجتماعية، إذاً، وفق نمطين رئيسيين: أحدهما يقوم على اقتطاع عنصر معين من عناصر التعددية الاجتماعية وبناء قاعدة الحكم عليه. وغالباً ما يحصل هذا الاقتطاع على أساس أغلبيّة ما: عرقية أو دينية أو مذهبية أو سياسية. لكنّ إحدى الأقلّيات قد تتولى السلطة أحياناً وتفرض إرادتها على الأكثرية. ولئن كان هذا النوع من التوحيد، خصوصاً ذاك الذي تبادِر إليه إحدى تعدديات المجتمع بحكم تفوقها العددي عرقياً أو دينياً أو سياسياً، أبسطَ الأنواع وأكثرها مباشَرةً، إلا أنه ليس أفضل أنواع التوحيد على الاطلاق. فهو يبقى بعيداً عن هدف تحقيق العدالة، مهما حاولت الفئة “الغالبة” وضع الفئات الأُخرى “في ذمّتها” وادّعت “التسامح” في معاملتها. فالتسامح، في مفهوم كهذا، ناقص جداً بل مشوَّه، إذ يرتكز إلى أنّ صاحب القوة أو الغلبة أو السلطة وحده في الحق أو في الحق الكامل، وأنه يتساهل مع سواه ممّن هم في بعض الحق أو حتى في انحراف عنه، لأنّ مبادئه، الدينية أو سواها، تملي عليه الشهامة تجاه الآخرين أو أخْذَهم بمبدأ “العفو عند المقدرة”(4).

النمط الآخر من التوحيد هو ذاك الذي تتحقق فيه الوحدة الاجتماعية لا على حساب التنوع أو عبر طمس التنوع أو إضعافه، بل وسط التنوع أو ضمن التنوع. هذا يَستبعد أن تكون أداة التوحيد واحداً من عناصر التنوع. وما دمنا نتكلم عن الوحدة الاجتماعية التي تجسّدها الدولة، فهذا النمط التوحيدي يقضي بأن تكون الدولة، من حيث هي مسؤولة عن تسيير شؤون الناس، آلة إدارية لا داعية عقيدة(5). لأنها إذا تبنّت عقيدة دينية معينة، مسيحية مثلاً، فَقدت ولاء غير المسيحيين، وإذا تبنّت عقيدة إسلامية فَقدت ولاء غير المسلمين. وهكذا إذا تبنّت عقيدة سياسية، شيوعية مثلاً أو قومية من فئة معينة. وظيفة الدولة أن تستوعب تعددية المجتمع من غير أن تطمسها أو أن تُبرز فئة، مهما غلبت عددياً، على سواها. حتى في حال انتماء كل أفراد المجتمع اسمياً إلى مذهب ديني واحد، يجب أن تحقق الدولة وحدة المجتمع على أساس تعدديته بالمعنى العددي الذي هو، كما قلنا، المعنى الأصلي للتعدد. فالإكراه لا يجوز، إنْ في الايمان وإنْ في تفسير الايمان والنصوص الدينية.
دَعوَتُنا إلى أن تكون الدولة كياناً إدارياً لا كياناً عقائدياً لا يلغي أبداً الأبعاد الوطنية للدولة. لا تقوم أيّ دولة بدون أبعاد وطنية تُكسِبُها هويّةً يشارك فيها مواطنوها جميعاً. وإذا وُجِدَ في بلد معيَّن فئات لا تشارك في النظرة الوطنية الواحدة، فهي تشكّل حركات انفصالية تقوم، عادةً، على أُسس عرقية أو لغوية أو دينية. لكن لكي تبقى الدولة وحدة وسط التنوع، لا بدّ من قيام عقد اجتماعي بين مواطنيها. ولا يمكن أن يقوم عقد من هذا النوع إلا إذا أعادت كل مجموعة النظر في خصوصياتها التي لا يمكن أن تشاركها فيها المجموعات الأُخرى، وضَحَّت بهذه الخصوصيات في سبيل الانسجام والسلام والوحدة.
هذا النمط من الوحدة الاجتماعية أو من النظام السياسي الذي نزكّيه، إذاً، وهو الوحدة في التنوع، يهدف إلى بثّ النظام والانسجام في الجسم الاجتماعي. وفي غيابه تتنافر تعدديات المجتمع وتتصارع، ويغيب السلام والأمن الاجتماعيّان لتَبرز الفوضى والحروب الأهلية، الدينية والعرقية وسواها. ولعل من الصعوبة القبض على هذا النوع من الوحدة ومحاولة تحديده وتسميته. فهو نوع من وحدة الجوهر أو الروح وسط تنوع المظاهر واختلاف الأسماء.

بَيتٌ من زجاج
رأينا أنّ أيّ تعدد بدون وحدة هو اختلال في طبيعة الأشياء، وأنّ أيّ وحدة بدون تعدد هي هكذا أيضاً. كما رأينا أنّ الوحدة التي تحصل على حساب التعدد هي وحدة تعسفية تُجافي، على صعيد الاجتماع البشري، المبادئ والقيم الأساسية لهذا الاجتماع، وهي الحرية والعدالة والمساواة. أما الوحدة المنشودة فهي الوحدة في التعدد. وهذا أشبه بوحدة الجوهر أو الروح أو المعنى وسط تعدد المظاهر والأسماء. وإذا كان التوصل إلى هذا النوع من الوحدة أشبه بتحقيق “المدينة الفاضلة” أو الدولة المثالية، فلا شك أنّ رقيّ الأنظمة السياسية يقاس باقترابها من هذا المثال.
الآن، إذا نظرنا إلى المجتمع اللبناني عشيّة الحرب الأهلية (1975)، لوَجَدنا، في لبنان ومحيطه العربي، نموذجَين لاختلال نظام الحكم ونأْيه عما سميناه رقيّاً سياسياً. النموذج العربي خارج لبنان كان يجسِّد، إلى حد أو آخر، الوحدة التعسفية المفروضة قسراً على حساب التنوع. الأنظمة العربية اتَّسمت عموماً بالسعي إلى الوحدة على حساب التعدد السياسي و/أو العرقي و/أو الديني و/أو المذهبي. وهذا أدّى، وما يزال، إلى حالات كثيرة من القمع والقهر والاضطهاد والسجن والاقامة الجبرية والنفي والاغتيال وأحكام الاعدام الجائرة وغير ذلك من انتهاك حقوق الانسان. وفي عقود الخمسينات والستينات وبعض السبعينات، أدّى إلى انقلابات عسكرية لم يكن فيها المنتصر أفضل من المنكسر بالنسبة إلى الهيمنة التعسفية. كما حمل بعض الأفراد والفئات على الانكفاء أو الهجرة أو اللجوء السياسي، مع تأسيس معارضة في الخارج أحياناً. وقد لا تكون برامج بعض الفئات المعارِضة أفضل حالاً من الفئة الحاكمة حيال اعتماد مبدأ الوحدة في التنوع.
أما في لبنان فكان الاختلال آتياً من الجهة المضادة، أي من التعددية الهائلة التي لا يربطها رابط أو يوحّدها مبدأ معين. كل شيء في لبنان كانت تسيّره الطوائف، وما برحت تسيّره الطوائف إلى حد بعيد، هو حد انعدام الولاء الوطني العامّ وإعلاء الولاء المذهبي فوق كل ما عداه. وبلغت الطائفية اللبنانية ذروتها في الإطباق على كل المرافق والوظائف. وراح معظم مَن يُسمّون “رؤساء طوائف” يدافعون عما يعتبرونه حقوقاً أصيلة أو مكتسَبة لمن انتمى اسمياً إلى طوائفهم، أو بالأحرى عشائرهم، في الحصول على هذه الوظيفة أو تلك. ومع الوقت قويت التجمعات الطائفية حتى كسفت المجتمع الواحد وكوَّنت كل منها مجتمعاً. وراجت في الحرب الأهلية وفي أعقابها مقولات من نوع “المجتمع المسيحي” و”المجتمع الاسلامي” و”المقاومة المسيحية” أو “الاسلامية”. وإذ راحت بعض الفئات المسيحية، انطلاقاً من شعورها بالتقلص العددي، تعزز مفهوم التعددية، وَجدت بعض الفئات الأُخرى، المتفوقة عدداً، في هذا المفهوم ما يعارض مصالحها. ولعلها كانت تتوق إلى فرض نموذج الوحدة التعسفية التوتاليتارية على لبنان، أُسوةً بالأنظمة التي تُلهِمها وتُمِدّها بالعَون. ومع خمود نار الحروب الأهلية، غدا مصطلح التعددية أكثر مدعاةً إلى القبول من فئات رفضته سابقاً. لكن في غياب دراسات علمية رصينة، فلسفية وسلوكية وسياسية ودينية وغيرها، لهذا المصطلح ومعانيه التي قد تكون مختلفة كثيراً في ما بينها تبعاً للمجموعة المذهبية أو السياسية التي تستعمله وللدوافع إلى قبوله بعد رفض طويل، لا يجوز البتّة الاطمئنان إلى أنّ كل هذه الفئات باتت تتبنى مفهوم الوحدة في التنوع.
بالعودة إلى عشيّة 1975، نجد أن الدولة كانت مرآة للتعدد الاجتماعي، خصوصاً المذهبي، بدلاً من أن تكون منارة للوحدة. وبما أنّ التعدد من غير وحدة يؤدي إلى التهافت، فقد حصل هذا فعلاً، وكانت أقسى نتائجه الحرب الأهلية. من هنا لا أُوافق الذين يكتفون بتسمية هذه الحرب “حرب الآخرين على أرض لبنان”. صحيحٌ أنّ هؤلاء “الآخرين”، من أنظمة عربية وغير عربية وقوى كبرى، موَّلوا وسلَّحوا ودرَّبوا وحرَّضوا، لكنهم فعلوا هذا كله مع فئات لبنانية، مستغلّين هذه التعددية المطلقة بالذات، وهي التعددية التي لا يربط بين عناصرها رابط قوي، لتأجيج التناقض والتنافر والصدام، والسعي أحياناً إلى الهيمنة، أي إلى تحقيق وحدة تعسفية عبر فرض أحد عناصر التعدد على المجتمع بأسره.
إنّ مثَل المكتفين بمقولة “حرب الآخرين على أرض لبنان” يشبه مثَل القائلين بأنّ لوحاً من الزجاج كُسر لأنّ حجراً أصابه. بديهي أن هذا التفسير جزئي وخاطئ. فانكسار الزجاج لا يفسره العامل الخارجي فقط، وهو الحجر، بل تفسره أيضاً، وعلى وجه الخصوص، طبيعة الزجاج، أي زجاجيّته أو قابليته للانكسار. لقد كان لبنان عشيّة الحرب الأهلية، وما يزال إلى حد بعيد جداً، أشبه ببيت من زجاج. لو كان هذا البيت من حجر أو من حديد لما كُسر بهذه السهولة أو لما كُسر أبداً. وأحسنَ بعض علماء الاجتماع عندما وصفوا المجتمع اللبناني بأنه “فسيفسائي” أكثر منه تعددياً(6)، لأن الفسيفسائية تشير إلى تعددية مطلقة، في حين أنّ التعددية السليمة تنطوي على مفاهيم النظام والانسجام والوحدة.

الدين والقومية
اليوم يجد اللبنانيون أنفسهم معلَّقين بين عالمين، أحدهما مات والآخر لم يولد بعد. التحدي هو الآتي: كيف تتحقق الوحدة ويبقى التعدد؟ كيف نصون التعدديات ونجعل منها عامل استقرار بدل أن تكون عامل فوضى وصدام؟ ما هو نموذج الحكم المنشود، الذي تكون فيه الدولة وحدة وسط التنوع؟
لنأخذ نقطة انطلاقنا من العامل الطائفي بما أنّ له اليد الطولى على صعيد السياسة والوظيفة والشأن العام في لبنان. ما هو شكل الحكم اللبناني الكفيل بتحقيق الوحدة وسط تنوع الأديان والمذاهب؟ طبعاً، كلامنا عن وحدة في التنوع يستثني أن تتولّى طائفة معينة عملية التوحيد باسم تفوقها العددي وبما يخدم مصالحها الشكلية. ومن الخطأ الفادح أن يظن بعضهم، من مسلمين معظم الأحيان ومن مسيحيين أحياناً، أنّ المسيحية لا تَرفع تحدياً حقيقياً في وجه قيام دولة إسلامية في لبنان لأنّ المسيحية، حسب ظنّهم، دين يحصر اهتمامه بالآخرة، وليس ديناً ودولة كالاسلام(7). إن المسيحية والاسلام، وكذلك اليهودية والهندوسية والبوذية والزردشتية والكونفوشيوسية وكل دين بلا استثناء، هو، بمعنى عميق جداً، “دين ودولة” في آنٍ معاً. فالدين نظرة إيمانية شاملة إلى الوجود، تتناول كل شيء في حياة الانسان، بما في ذلك المجتمع والسياسة والدولة، ولا تبقي شيئاً خارجاً.
ولئن أعلنت المسيحية تمسكها بالسماويّات في قولها: “ليس لنا هنا مدينة باقية”(8) (رسالة بولس إلى العبرانيين 13: 14)، فالاسلام يؤكّد هذا الاعلان عبر قوله: “بل تؤْثرون الحياةَ الدنيا، والآخرةُ خيرٌ وأبقى”(9) (سورة الأعلى [87]: 16-17). وهذا مصداق لقول المسيح: “مملكتي ليست من هذا العالم”(10) (يوحنّا 18: 36)، الذي يفصله بعضهم عن سياقه ويدعمونه بقول آخر للمسيح: “أعطوا ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه(11) (متّى 22: 21)، ليستنتجوا خطأً أنّ المسيحية غير معنية بهذا العالم. والأحرى أنّ المسيحية والاسلام وكل الأديان “ليست من هذا العالم”، بل هي من السماء أو من الله، لكنها وُجدت لهذا العالم أو من أجله، كي تحوّله بل تعيده، كما تستوجب النظرة الايمانية، إلى ملكوت أو ملك للّه، عبر كل الوسائل الممكنة، بما فيها سياسة المجتمع وإدارة الدولة ونظام الحكم.
لكن إذا كانت المسيحية ديناً ودولة والاسلام ديناً ودولة واليهودية ديناً ودولة والهندوسية ديناً ودولة والبوذية ديناً ودولة وكل دين، بمعنىً، ديناً ودولة، فلأيّ دين تحقّ سلطة الحكم في مجتمع ما؟ إلى حد كلامنا عن لبنان، حيث لا أكثرية غالبة مذهبياً بقوّة، من غير العدل أن يكون لمذهب معين الكلمة الفصل في الحكم. لكنْ وإنْ كان لبنان، أو غير لبنان، من غالبية مذهبية معينة، وحتى لو انتمى المواطنون إلى مذهب واحد، يبقى الحكم الديني غير مستحَبّ لتَعدُّد التفسيرات والاجتهادات والمذاهب الفقهية، ولأنّ الايمان لا يُفرَض بقوانين، ولأنّ الحكم باسم الله يتولاّه بشر لهم حدودهم وأهواؤهم ومصالحهم. وفي كل مكان عَرَف الحكمَ الديني، كائناً ما يكون اسم الدين، تزخر صفحات التاريخ بأخبار حكّام رَوَّعوا شعوبهم وشعوباً أُخرى وقمعوها واضطهدوها باسم الدين وتفسيراته القويمة، وبأخبار حركات “تصحيحيّة” انقلب فيها حاكم على آخر دموياً وحصلت كلها تحت شعار “الخط القويم”. وأتذكّر هنا قولاً للفيلسوف الألماني لودفيغ فويرباخ: “حيثما أُقيمَ الحق على السلطة الإلهيّة، يمكن تبرير أشد الأُمور سوءاً وظلماً”(12). وإذا كان الحكم باسم اللـه ظالماً للبشر، فهو بهذا يَهزم الدين وقضيته، كما يَظلم اللـه لأنه يحمّله نقائص الحكام وموبقاتهم.
هنا نطرح سؤالاً عن الدين كمصدر تشريع للنظام السياسي، فنسأل: هل في الأديان شرائع مفصلة تصلح لكل زمان ومكان؟ هل يمكن استمداد شرائع مفصلة من الدين تصلح لكل زمان ومكان؟ الواقع أنه ليس من شرائع مفصلة في الأديان، وإن كان الجانب التشريعي في بعض الأديان، كالمسيحية، أقل كثيراً منه في بعضها الآخر، كاليهودية والاسلام. ويمكن ردّ هذه الظاهرة، في جانب منها، إلى أنّ المسيحية ظهرت في بيئة غنيّة بالتنظيم المدني والشرائع، في حين أنّ الاسلام كان في حاجة إلى تعديل الشرائع السائدة وابتكار سواها لإنعاش النظام الاجتماعي. إلا أنّ الشريعة الاسلامية لم تأتِ مفصَّلة في القرآن، الأمرُ الذي أدّى إلى بروز أربع مدارس فقهية أساسية في الاسلام السنّي، هي الحنَفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ناهيك بالاجتهادات والفتاوى في الشيعة، وإناطة شؤونها بالأئمّة. واعتُمِدَت أربعة أُسس في التشريع التقليدي، هي: القرآن، الحديث، القياس، الإجماع. وقد رَكّزت المدارس المختلفة على بعضها أو على عدد منها أو عليها كلها. وأدّى اختلاف التفسير إلى خلافات واسعة أحياناً. وهذا جعل أبا العلاء المعرّي يقول(13):
أجازَ الشافعيُّ فعالَ شيءٍ وقال أبو حنيفةَ لا يجوزُ
فَضَلَّ الشِّيبُ والشبّانُ منّا وما ٱهتدت الفتاةُ ولا العجوزُ
والحقّ أنّ في الدين، كما في الأخلاق، نوعين من الأحكام: المطلق والنسبي. المطلق يدور على القيم والمثل العليا التي لا يطرأ عليها تبدل، مثل الحرية والعدالة واحترام كرامة الانسان. وهذا متعلق بالغايات أو الأهداف. أما النسبي فيدور على الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. والوسائل تتبدل بتبدل الأزمنة والأمكنة وتتعدل في ضوء الظروف، بشرط ألا تنحرف عما يخون الأهداف التي وُجدت من أجلها. فليس من العدالة في شيء أن تتحقق عدالة أحدهم بظلم سواه. ولا يبقى معنى لاحترام كرامة الانسان إذا أُهينت كرامة آخر في هذا السبيل. إنّ هدف الحياة الاجتماعية هو إتاحة أفضل الظروف أمام جميع الأفراد الذين يتكون منهم النسيج الاجتماعي لكي يحققوا ذواتهم، ولكي يعيشوا ويتعايشوا بسعادة وطمأنينة وسلام. وما يحتاجة الفرد من فرد آخر ضمن العلاقة الاجتماعية ليس دينه، بل احترامه كفرد ومواطن مساوٍ له. وقد تبين خلال التاريخ، وفي سعي الأفراد والشعوب لتحقيق هذه المطالب، أنّ أفضل الأنظمة المدنية أو الاجتماعية أو السياسية الكفيلة بتحقيق هذه المطالب هي تلك القائمة على تأمين الحرية والعدالة والمساواة. وهذا ما دعت إليه بعض التشريعات المحلية والشرائع العالمية لحقوق الانسان. وهذا ما يدعو إليه لا دينٌ بِعَينه بل الأديان كلها.
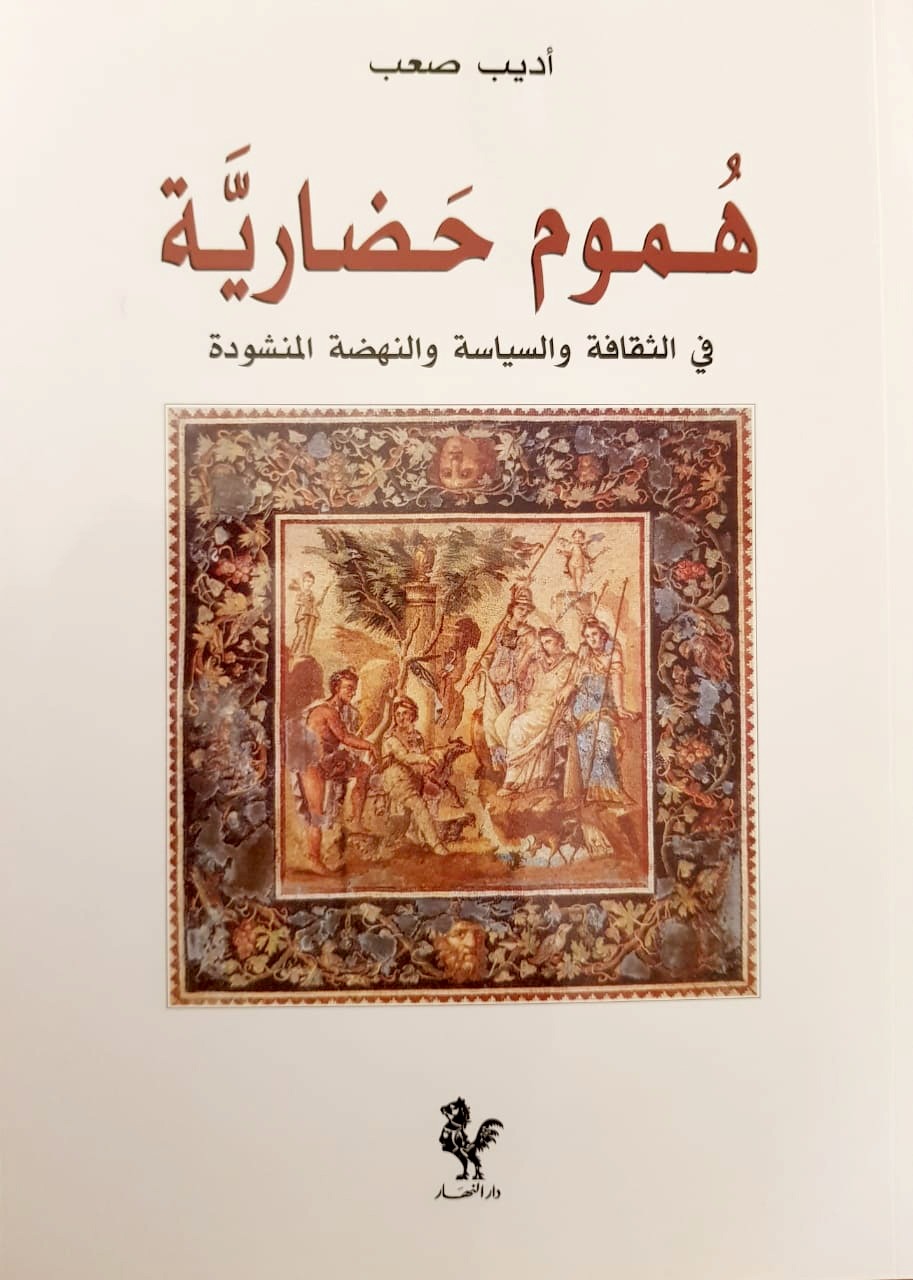
لنذكر على الدوام أنّ كل مجتمع تعددي، شاء أم أبى، بالمعنى العددي، أي معنى تكوُّنه من أفراد، وأنّ لكل من هؤلاء الأفراد – وإن انتموا إسمياً إلى مذهب واحد – موقفه من الايمان وفهمه وتفسيره للنصوص الدينية ونظرته إلى السياسة ونظام الحكم والعدالة الاجتماعية. وهدف الدولة إتاحة أفضل الظروف أمام جميع الأفراد الذين يتكون منهم النسيج الاجتماعي لكي يحققوا ذواتهم ويتعايشوا بسعادة وطمأنينة وسلام.
في سعي الأفراد والشعوب نحو هذه المطالب خلال التاريخ، تَبيَّن أنّ أفضل الأنظمة الاجتماعية أو السياسية الكفيلة بتحقيقها هي تلك القائمة على قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان. وهذا عين ما يدعو إليه لا دين بعينه بل كل الأديان، التي تتلاقى على أن أعلى ما في الانسان كرامته، وهي آتية من كونه مخلوقاً على صورة اللـه ومثاله. والدولة التي تنتهج هذه القيم من دون إعلاء دين على دين آخر أو مذهب على مذهب آخر أو موقف إيماني على موقف إيماني آخر أو تفسير على تفسير آخر هي الدولة الدينية الفعلية. وهذه أقرب إلى جوهر الدين من الدولة الدينية الاسمية، أي تلك التي تكتفي بالتفاصيل والقشور في حين تنتهك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان حفاظاً على أسماء ومظاهر مفرغة من محتواها.
وإذا كانت “العلمانية القاسية” أو “المتطرفة” هي تلك التي لا تكتفي بفصل الدين عن الدولة بل تحاول إقصاءه عن المجتمع، و”العلمانية الليّنة” أو “المعتدلة” هي تلك التي تفصل الدين عن الدولة لمصلحة الدولة والدين كليهما، فما سميناه “الدولة الدينية الفعلية” يتلاقى مع النظام السياسي العلماني بالمعنى الليّن أو المعتدل(14). وإذا استطاع نظام الحكم الانسجام مع جوهر الدين فهو إنما يساهم في تحقيق أهداف الدين بعيداً عن التحجر ضمن شكليات لم ينتج منها سوى الويل خلال التاريخ، الأمر الذي يخون قضية الدين.
ثمة مسألة رئيسية أُخرى ذات علاقة بمفهومَي التنوع والوحدة: كيف تكون الدولة في لبنان أداة توحيد وسط ثلاث دعاوى قومية مختلفة تتوزع على معظم الأحزاب السياسية وتنادي بالقومية اللبنانية والقومية السورية والقومية العربية؟ صحيح أنّ الحميّة القومية، في لبنان وحول العالم، شهدت ضعفاً أكيداً مع بداية الألفية الثالثة وسط دعوات العولمة وهيمنة القوة الأحاديّة التي تمثلها الولايات المتحدة الأميركية، وبعد الخيبات الكثيرة التي عرفتها الحركات القومية حول العالم. لكن تبقى التوجهات القومية للحركات السياسية في لبنان، خصوصاً في غياب التنظير المتفاعل مع الوضع العالمي الجديد، أسيرة أُطرها التقليدية عموماً. وإذا كان لكل من هذه الدعاوى القومية جذور تاريخية راسخة، فليس معنى هذا أن تتصارع الأحزاب القومية للسيطرة على الدولة، حيناً باسم القومية “الأقدم” في تاريخ لبنان، وهي السورية، أو باسم القومية المرتبطة بالغالبية العددية السنّية في المنطقة، وهي العربية، أو باسم قومية العصور الحديثة، وهي اللبنانية.
لكل من هذه الدعاوى القومية، كما قلنا، جذورها التاريخية. وإذا استطاعت إحداها تولّي الحكم في لبنان عن طريق حزب أو آخر من الأحزاب التي تمثلها، فالخوف من غلبة القوميين العرب، مثلاً، أو السوريين بالنسبة إلى القوميين اللبنانيين آتٍ من القضاء على الكيان اللبناني عبر تذويبه في جسم أكبر، مع ما قد يستتبعه ذلك من إخضاع للمسيحيين تحت راية إسلامية. وخوفُ القائلين بالقومية السورية من غلبة الدعوى اللبنانية الانعزالُ في الحاضر والتنكر للماضي، ومن غلبة القومية العربية إحلالُ الدولة الدينية مكان الدولة المدنية أو العلمانية. كل فئة، بدورها، تخشى أن يؤدي انتصار سواها إلى خيانة التاريخ الذي تظنه منحازاً إليها، هذا التاريخ الذي، كما في تعبير الشاعر تي إس إليوت مرة أُخرى، “قد يكون عبودية وقد يكون حرّية”(15).
إنّ هويّة شعب ما تأتي لا من ماضيه فحسب، بل من حاضره ومن مستقبله أيضاً، أي مما هو اليوم ومما يودّ أن يكون. لذلك يجدر أن تلطِّف الأحزاب “الجغرافية” في لبنان، وهي تلك التي تختلف في ما بينها حول تحديد حدوده، من غلوائها التاريخية. فالسؤال الذي طرحه أنطون سعادة يوماً، بمنهجيته العلمية الرصينة، “مَن نحن؟”، وأجاب عنه بأننا “سوريّون، والسوريّون أُمّة تامّة”(16)، يمكن أن يأتي جوابه أننا “عرب” أو “لبنانيّون”. كما لا تكفي الاجابة عما كنّاه يوماً لتقرير ما يجب أن نكون في المستقبل القريب أو البعيد.
لكن إذ لا يمكن لكل الدعاوى القومية الثلاث أن تمتلك لبنان في آنٍ معاً، كما لا يجوز لإحداها امتلاكه عنوةً وإخماد الدعويَين الأُخريَين، يبدو أنّ الحل المنسجم مع مبدأ الوحدة في التنوع هو ذاك الذي يبقي هذه الدعاوى حية لدى اللبنانيين، لكن من غير أن تكون إحداها ملغيةً للأُخرى أو مقصورة على فئة من اللبنانيين دون سواها. إنّ شرط إبقاء هذه الدعاوى حية، إذاً، هو تجريدها من إلغائيتها القومية والاحتفاظ بمحتواها الحضاري. فاللبنانيون كلهم “لبنانيون” وكلهم “سوريون” وكلهم “عرب”. ويمكن أن يظهر الوفاء لهذا الواقع التاريخي في نظام عصري متطور للحكم يعزز إنجازات لبنان في الديمقراطية والحرية والتربية والثقافة والإعلام والاقتصاد وغير ذلك، وتنتصر فيه هذه الدعاوى الحضارية، بسلام وانسجام، عبر نظام تربوي تجسّده كتب التاريخ والانسانيات على وجه الخصوص، كما تجسده سياسة الدولة العامة وأحلافها وولاءاتها.
صحيح أنّ لبنان كيان محْدَث أدّت إلى إنشائه ظروف معينة، وأنه قبل ذلك الحين كان جزءاً من كيان أكبر. غير أنّ المسيرة التي اختطَّها هذا الكيان الحديث لنفسه في المناحي المذكورة، السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية وسواها، على ما شابَ هذه المسيرة من نقائص ومساومات وعيوب واستئثار أحياناً، جعلته طليعة البلدان العربية في اعتماد قيم الحرية والعدالة والمساواة، وجعلت منه نموذجاً في مجالات كثيرة، يجدر بكل بلد عربي أن يحتذيه عندما يقرر هذا البلد أو ذاك أن يضع نفسه على خريطة العالم المتحضر. لا بل إنّ لبنان، كما قال أنطون سعادة، إذا كان نوراً، وهو حقاً هكذا، فأحرى بهذا النور أن يشعّ ويَشيع في كل ما حوله(17).
ثمة حاجة، إذاً، إلى لبنان الكيان، لا لأنه “أزَليّ” كما يَصِفُه بعضهم، بل لأنه أثبت أنه ضرورة لا يستغنى عنها في المجالات التي تحقق إنسانية الانسان عبر احترام حريته وكرامته. إنه لمن قبيل الكفر أن نزعم أنّ أي كيان غير اللـه الخالق يتمتع بالأزلية، أي أنه كان في البدء، قبل أن يكون أيّ شيء آخر. الأزلية صفة الخالق وحده… “أفَمن يَخلق كمن لا يَخلق؟”(18) (سورة النحل [16]: 17).
وكما أنّ كل شيء وُجد في الزمن يخضع لأحكام الزمن، فما ليس أزلياً يستحيل أن يكون أبدياً. لذلك كان استمراراً لمنطق الكفر نفسه نَعْتُ لبنان، وأيّ وطن آخر على وجه الأرض، بالأبدية. وحده لا نهاية له مَن لا بداية له، أي اللـه تعالى. ولئن كانت الأوطان قديمة جداً في التاريخ، فهي، على قِدَمها، تبقى حادثة في الزمن وخاضعة لأحكامه وحركته. لذلك تخيفني فكرة “الوطن النهائي” التي ابتكرها نفَر من المسيحيين وأقرّوها في مؤتمر الطائف، أو بالأحرى صلح الطائف، كي يردّوا عنهم خطراً طالما أخافهم، هو خطر إلغاء الكيان اللبناني عبر ارتهانه أو إضعافه أو تذويبه في وحدة سوريّة أو عربية من شأنها تأكيد أقليتهم العددية ووضعهم في ذمّة سواهم والقضاء عليهم شيئاً فشيئاً. وكان أن قبل هذا النفر المسيحي بعروبة لبنان إزاء قبول مواطنيهم المسلمين بكَون لبنان وطناً “نهائياً” لجميع أبنائه.
اليوم إذ تنحسر، مع الأسف، دعاوى العروبة حول العالم العربي باسم تجمعات مذهبية أو عرقية أو سواها، أرى لزاماً على المفكرين الاجتماعيين والسياسيين وعلى المثقفين عموماً العمل من أجل إعادة تحديد مفهوم العروبة، وهو وحده الكفيل بإقامة الوحدة السليمة وسط التنوع في العالم العربي وتأسيس كيان عربي قوي يَتَّخذ شكلاً أو آخر من أشكال الاتحاد الاقتصادي – الثقافي – السياسي. والمعنى المنشود للعروبة يتجاوز العرقية، بحيث يكون أكراد العراق عرباً لا أقل من سواهم، وبربر المغرب عرباً لا أقل من سواهم، والسريان والأرمن في بلاد الشام عرباً لا أقل من سواهم، ويهود فلسطين عرباً لا أقل من سواهم… كما يتجاوز الطائفية ليكون السنّة والشيعة والمسيحيون بمختلف مذاهبهم وكل الفئات الدينية فوق الأرض العربية عرباً بالتساوي.
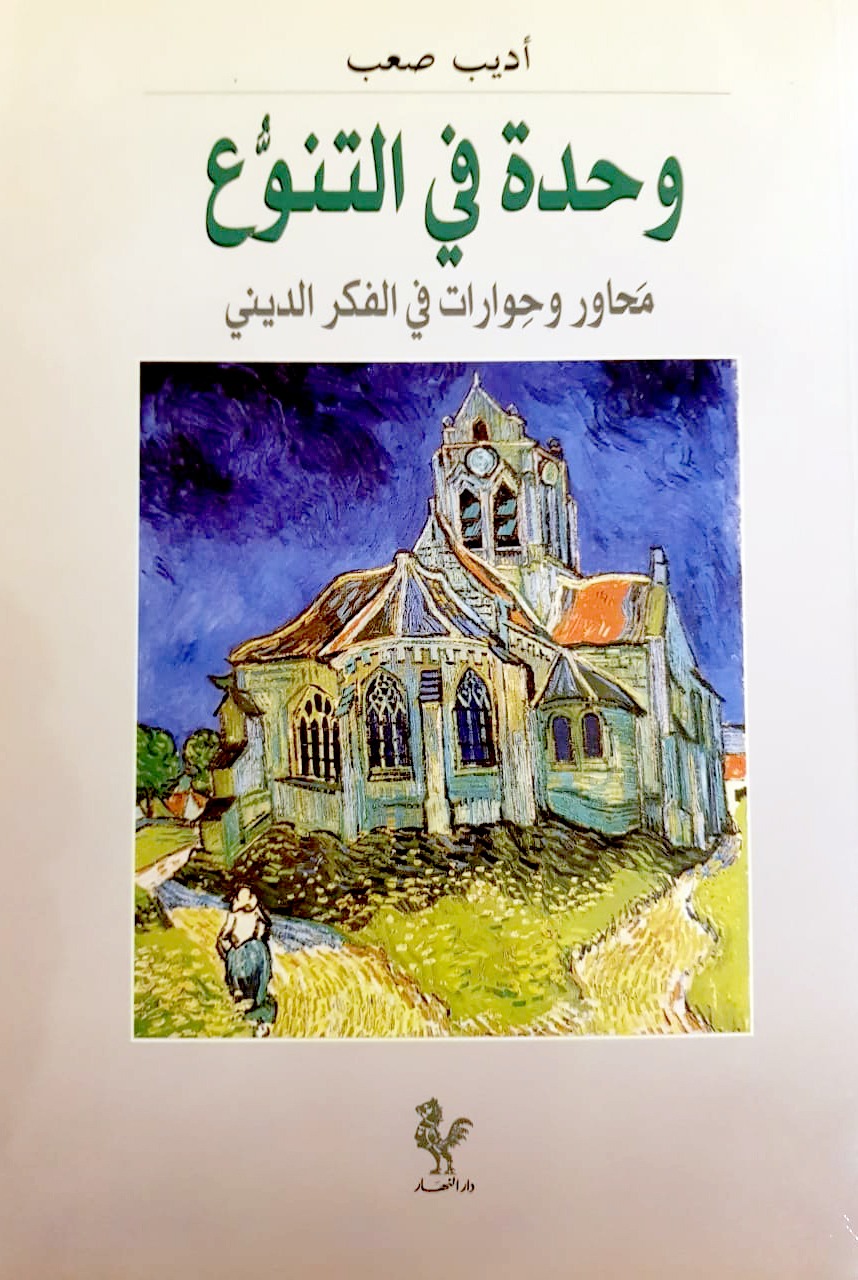
وحدة في التعدد
لا التعدد المطلق من دون وحدة، إذاً، كما رأينا في مثَل لبنان، ولا الوحدة التعسفية على حساب التعدد كما رأينا في مثَل البلدان العربية خارج لبنان: لا هذا ولا ذاك يشكِّل فلسفةً لنظام سياسي سليم. لكننا نجد هذه الفلسفة، كما رأينا، في مفهوم الوحدة في التعدد. وإذْ يبقى ضرورياً جداً أن يعالَج هذا المفهوم على أيدي المثقفين ولا سيما المشتغلين في الفلسفة الاجتماعية والسياسية، فإننا نتمسك بنموذج الوحدة الذي أعطيناه على صعيدَي الدين والقومية. ونكرر أنّ الدولة العلمانية التي دعَونا إليها هي الدولة الدينية “الفعلية” تمييزاً لها عن الدولة الدينية “الاسمية”. فهي لا تتبنى اسماً دينياً معيناً لئلا تستعدي عليها المواطنين المنتمين إلى أسماء دينية أُخرى، ولئلا تَفرض أي إيمان أو أي تفسيرات دينية خاصة على مواطنيها وإن انتموا اسميّاً إلى مذهب واحد، ولئلا تحمِّل اللـه وأنبياءه ورسله أوزار الحكام ومحدودياتهم. لكنها، في الوقت نفسه، تنتهج مبادئ الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان، “لأنّ هذا”، في أيّ حال، “هو الناموس والأنبياء”(19) (متّى 7: 12).
أما نموذج الوحدة القومية بما يخص لبنان فهو إبقاء الدعاوى الحضارية السورية والعربية واللبنانية جميعاً حية، تربوياً وثقافياً وإعلامياً وسياسياً واقتصادياً، لكن بعيداً عن رفع القومية أو الأُمّة أو الوطن إلى مقام الأُلوهة بإغداق صفات عليها من نوع “الأزلية” و”الأبدية” و”النهائية”. حقّاً لقد حَقَّق لبنان إنجازات نهضوية، ثقافية وتربوية وإعلامية واقتصادية وسياسية، جعلته طليعةً في العالم العربي ونموذجاً يُحتذى في مجالات كثيرة. إلا أنه، لاتّباعه الحرية المطلقة وإطلاقه عنان التعدديات من غير ضوابط تؤلف في ما بينها، قَوّى نزوع بعض الفئات، الدينية وسواها، إلى التملص من سلطة الدولة المركزية وقوانينها والتصرف كما لو كانت “دولة في قلب الدولة”. وهذا من شأنه أن يبقينا في التعددية الفوضوية المطلقة التي تحيل الدولة دولاً أو دويلات ويُحِلّ شريعة الغاب – مهما بدت الشرائع الخاصة جليلة في أعيُن أصحابها – مكان حكم القانون، ويضعِف مفهوم الوطن والمواطَنة.
ما يحتاج إليه لبنان لتحقيق الوحدة في التعدد على الصعيد السياسي هو دولة مركزية قويّة تجسِّد مفاهيم الوطن والمواطَنة. الايمان الديني لا يشكِّل قضية على هذا الصعيد. وهذا يفسر قول الانجيل بإعطاء ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه. وفي القرآن آيات عدّة تشير إلى هذا الأمر، منها: “فمَن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر”(20) (سورة الكهف [18]: 29)، و”لا إكراه في الدين”(21) (سورة البقرة [2[: 256). وفي إحداها يخاطِب اللـهُ تعالى نبيَّه ورسوله محمّداً بقوله: “أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين؟”(22) (سورة يونس [10]: 99). المطلوب، لحسن عمل الجسم الاجتماعي، قوانين تضمن الحرية والعدالة والمساواة وتردع تعديات الناس بعضهم على بعض، بصرف النظر تماماً عن تنوّعات إيمانهم وتجاربهم الدينية. ولئن كان لهذا الايمان آثار إيجابية في تعزيز مفهوم المواطَنة الواحدة وسط مواقف المواطنين المختلفة من الدين والايمان، فليبذل ذوو الايمان ورعاتهم كل ما في وسعهم لتربية هذا الحس الديني النبيل في ذواتهم ولدى الرعية. بكلام آخر، إذا كان الايمان الديني يعزز احترام القوانين المدنية والسلم الاجتماعي بجعله المؤمن مواطناً صالحاً يحترم القوانين ويحفظ الوعود والعهود أكثر من سواه، فهذا، في أي حال، يقع ضمن مسؤولية المؤمنين ورعاتهم. لكن يبقى أنّ ما يعني المواطن من مواطن آخر ليس دينه وإيمانه، بل احترام حريته وكرامته وعدم التعدي عليه.
إنّ مفهوم المواطَنة في لبنان لا يمكن أن يتعزز وسط تطلع بعض فئاته الطائفية خارج حدود بلدهم لاستلهام مواقف قد تعرقل سياسة الدولة المركزية، وإن باسم الدين أحياناً. كما لا يمكن أن يتعزز هذا المفهوم وسط دعاوى قومية مختلفة يشدّ كل منها في اتجاه على نحو لا يمكن أن ينتج عنه سوى تمزيق الجسم الاجتماعي. لذلك كان من أشد أُمور الاصلاح السياسي إلحاحاً إصدار قانون جديد للأحزاب، يقام على القضايا الاجتماعية الاصلاحية ويؤخَذ فيه الكيان اللبناني كأمر مفروغ منه، وتُمنَع تلك الأحزاب “الجغرافية” التي تقوم دعواها الأساسية على رسم حدود لبنان، وتلك التي تشكك في شرعية الكيان اللبناني، كما تُمنَع الأحزاب “الطائفية” التي تقتصر عضوية أفرادها على دين واحد أو مذهب واحد. والمضحك في بعض هذه الأحزاب حالياً أنّ قادتها يتشدقون بقانون انتخابي وقوانين اجتماعية أُخرى تحقق ما يسمونه “الانصهار الوطني”. لكن كيف يتحقق انصهار من هذا النوع ما لم تقدِّم أحزابهم أولاً، وهي نموذج مصغر للوطن، المثال الصالح عن هذا الانصهار؟ إنّ مثال الوطن المنشود لا يمكن أن يتحقق قبل إلغاء الأحزاب والتجمعات الفئوية والطائفية، مع كل امتيازاتها وحساباتها ومحسوبياتها.
لقد أرهَقَنا الدين وأدعياؤه، حتى كادت عبارة “الدين” تقتصر على مدلولات سلبية لكثرة ما استغلوها لمآرب خاصة. إذا سُئلتُ عن أنبل كلمة في القاموس لأجبتُ: “الدين”، وعن نقيضها لأجبتُ أيضاً: “الدين”. ذلك أنّ الدين، حسب استخدام الناس له، أي حسب تمسكهم بجوهره الصحيح أو بقشوره التي أقحمها منحرفوهم عليه لخدمة مصالحهم الإلغائية، هو مصدر خير كما هو مصدر شر. أعطِني “ديناً” – لا سمح اللـه – خالياً من الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان والمحبة والسلام، وأعطِني من ناحية أُخرى نظاماً تحت أيّ اسم، لكنْ نظاماً قائماً على هذه القيم، فلا شك أني أرفض الدين الاسمي وأختار ذاك النظام الآخر ديناً فعلياً.
التحدي الأكبر الذي يواجه اللبنانيين اليوم هو خَلق الوطن اللبناني والمواطن اللبناني. وطن يكون فيه الناس، بكل أديانهم وطوائفهم ومواقفهم من الدين والايمان والشؤون الأخيرة، وبكل أُصولهم العرقية والإثنيّة، مواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات والكرامة الانسانية. وإذا كان لبنان قطع شوطاً على هذه الطريق لكن ما تزال تعترض طريقه عراقيل، فإنّ تخطّي هذه العراقيل لن يحصل إلا بخطوة، لا بل قفزة، جريئة. وهي قفزة لا يأخذها الرافضون عادةً ولا المترددون، بل تؤخذ عنهم. والتردد حيال قفزة جريئة من هذا النوع آتٍ من خوف المترددين إن هم تحولوا إلى مواطنين أن يَفقدوا ما يظنونه امتيازات تأتيهم من وضعٍ قبَليّ يتيح لهم الانحراف عن قوانين الوطن الواحدة واتّباع نهج غامض يتولّون مَلء فراغاته، كلما دعت الحاجة، على النحو الذي يخدم مصالحهم. وهذا يعني إبقاءَ لبنان ضمن شريعة الغاب، والنأيَ به عن حكم القانون، وفقدانَ الارادة لتأسيس وطن والمشاركةِ في المجتمع المدني بصفة مواطنين.
إنّ لبنان بعد الحرب الأهلية لا يمكن ولا يجوز أن يستمر في أخطاء كانت سائدة قبل هذه الحرب، لا بل كانت من الدوافع إليها. وأقسى تلك الأخطاء ما كان يعرقل تحقيق مثُل المجتمع المدني والوطن العصري، ويمنح الطوائف كل الامتيازات التي تعطل حياة المواطنين الموحَّدة ضمن روابط المواطَنة فوق أرض الوطن. وإذا كانت بعض الفئات لا تستطيع التملص من الماضي بل تحاول التشبث بعقلية الامتيازات الطائفية وعرقلة نشوء الدولة المدنية، فالحل المطلوب ثورة “من فوق”، تُفرَض على الكل فرضاً للخروج من الظلمة إلى النور تحت قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان، هذه القيم التي تجسدها وترعاها دولة مركزية قوية تكون مثال الوحدة في التعدد على الصعيد الاجتماعي.
إنّ الدولة التي تنتهج قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام كرامة الانسان وإتاحة أفضل الظروف له لتحقيق أعلى إمكاناته هي، إذاً، دولةٌ تقيم نظام الحكم على جوهر الدين. والدين، قبل أي شيء، جوهر: إنه جوهر قبل أن يكون اسماً. وللتذكير بالتمييز الذي أقمناه بين دولة دينية اسمية ودولة دينية فعلية، نقول إنّ الدولة الدينية الاسمية تتكنّى باسم دين معيَّن، فتجعل من ذوي الأديان الأُخرى أو ممّن هم خارج حظيرة الايمان الديني أعداء لها. والايمان مسألة حرّية، لا مسألة قَسْر. أما الدولة الدينية الفعلية فتنطلق من روح الدين وجوهره ولا تتبنى أيّ عقيدة، مفسحةً المجال أمام مواطنيها كي يتبنّوا العقائد التي يريدون. الدولة الدينية الاسمية تنتهج سبيل الإكراه والعنف والحرب لإنقاذ أسماء. الدولة الدينية الفعلية تنتهج السلام، وهو من مرادفات الأُلوهة، وتفعل كل ما يمكن لإبقاء الجوهر أو المعنى أو الروح حياً. وبما أنّ المطلوب هو الجوهر لا الاسم، والحرية لا القسر، والرفق لا العنف، والنظام لا الفوضى، والإخاء لا العداء، والسلام لا الحرب، فلا شكّ أنّ المطلوب هو الدولة الدينية الفعلية، لا الدولة الدينية الاسمية. هذا هو النظام الوحيد – وهو نظامٌ قائمٌ على مفهوم التعددية التي هي واقع كل مجتمع حول العالم، أي التعددية بالمعنى العددي – الذي يستطيع أن يرفع شأن الدين وشأن الانسان.
هوامش
- أَثَرتُ مفاهيم الوحدة والتعدد والوحدة ضمن التعدد في كتابي “الدين والمجتمع” الصادر عام 1983، يومَ كانت بعض قوى “الأمر الواقع” في تلك المرحلة من الحرب الأهلية في لبنان تحظِّر عبارات من نوع “التعدد”. ويجب أن أعترف بأن المعنى الأصلي الذي أَعطَيتُه للتعدد، أي المعنى العددي، هو ثمرة تحليل وموقف شخصيَّين لا ثمرة قراءات. اُنظُر: أديب صعب، الدين والمجتمع، بيروت: دار النهار، 1983، طبعة ثانية 1995. وتجدر الاشارة إلى أن كل ما ورد في الدراسة الحالية ينطلق من مفهوم الوحدة في التعدد كما عالجتُه بدءاً من هذا الكتاب.
- أديب صعب، المرجع المذكور، ص 88-90 (ط 1) و80-82 (ط 2).
- T.S. Eliot, “The Dry Salvages” (verse 93), in Four Quartets, London: Faber, p. 39.
قارِن مع ما يقوله الفلاسفة الرواقيون، وعلى الأخص ماركوس أُوريليوس، حول فحص الذات.
- أديب صعب، وحدة في التنوع، بيروت: دار النهار، 2003، ص 27-33.
- أديب صعب، الدين والمجتمع، ص 8 (ط 1) و16 (ط 2).
- حليم بركات، “المجتمع اللبناني: فسيفسائي أن تعدُّدي؟”، مجلة مواقف، العدد 1، بيروت: تشرين الأول (أُكتوبر) – تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، ص 108-125.
- أديب صعب، وحدة في التنوّع، الفصل الرابع: “الدين والدولة”، والفصل الخامس: “الدولة الدينية الفعلية”، ص 41-54.
- رسالة بولس إلى العبرانيين 13: 14.
- سورة الأعلى (87): 16-17. قارِن مع: سورة الأعراف (7): 169، سورة يوسف (12): 57، سورة الرعد (13): 26، سورة النحل (16): 30.
- يوحنّا 18: 36.
- متّى 22: 21، مرقس 22: 17، لوقا 20: 25.
- Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, New York: Harper, 1957, p. 274.
- أبو العلاء المعرّي، اللزوميّات (لزوم ما لا يلزم)، القاهرة: مطبعة التوفيق، 1924: ز: 6. أيضاً: ديوان لزوم ما لا يلزم، بيروت: دار الجيل، 1992، المجلَّد الأول، ص 525.
- أديب صعب، الدين والمجتمع، 119-128 (ط. 1)، 106-113 (ط. 2).
- T.S. Eliot, “Little Gidding” (verses 162-163), in Four Quartets, p. 55.
- أنطون سعادة، مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي، بيروت، 1970، ص 11-17. انظر شرحاً مفصلاً لهذا المبدأ في: أنطون سعادة، المحاضرات العشر.
- جاء هذا في خطاب أنطون سعادة عند عودته إلى لبنان عام 1947 بعد اغتراب قسري دام تسع سنوات. انظر: سعادة في أول آذار، بيروت: مطابع لبنان، 1956، ص 83.
- سورة النحل (16): 17.
- متّى 7: 12.
- سورة الكهف (18): 29.
- سورة البقرة (2): 256. 22.
- سورة يونس (10): 99.