استقلال المعنى اللبنانيّ!
د. مشير باسيل عون
يحتار المرء في أمر الاستقلال اللبنانيّ. فربَّ سائل يسأل: هل يكون استقلال الأوطان الصغيرة المنعطبة خطأً سياسيًّا تاريخيًّا؟ وإذا أراد المرء أن يبالغ في الاستقصاء النظريّ، فإنّ السؤال الأخطر الذي يتبادر إلى ذهنه يتعلّق بقابليّة بعض الكيانات غير الناضجة للفوز بالاستقلال السياسيّ الحقيقيّ. فالجماعات التي لم تبلغ بعدُ سنّ الرشد السياسيّ لا يحقّ لها أن تتصرّف تصرّفًا سياديًّا، فتُقرّر وحدها مصائر الناس فيها فردًا فردًا، ومصائر الأرض التي تقطنها، والطبيعة ونتاجها الذي تقتاته، والبيئة التي تتنفّس فيها.

لا ريب في أنّ اختبار المئويّة الأولى من نشوء الكيان اللبنانيّ يجعل الإنسان يشكّ في صوابيّة مثل هذا التكوّن السياسيّ المعاصر. وإذا ما استثنى المراقبُ الفطنُ حقباتٍ وجيزة من السلم والهدوء والازدهار، فإنّ السمة الغالبة تضطرّه إلى الاعتراف بأنّ اختبار المئويّة الأولى كان جلُّه مجبولًا بالاضطراب، محقونًا بالمنازعات، محفوفًا بالمخاطر الكيانيّة، مضرّجًا بالدماء العبثيّة. أراق اللبنانيّون من الدماء ما كان في مقدوره أن يؤهّلهم للفوز باستقلال مكين، وطيد، مديد. غير أنّ دماءهم غالبًا ما سالت هدرًا وعبثًا، في نصرة الزعماء المؤلَّهين، وتأييد الأيديولوجيات الواهية، وتسويغ الانحيازات الإقليميّة والدوليّة الخائنة.
لستُ من الذين يعيبون على اللبنانيّين رغبتهم في الاستقلال، ولئن تَبيّن لي أنّ القاصرين لا يستحقّون هذه النعمة. بيد أنّ النظر في المشهد الكونيّ يجعلني أدرك أنّ نصف الأوطان المستقلّة لا تستحقّ استقلالها. ذلك أنّ الانعطاب الكيانيّ لا يُبطل إمكان الاستقلال، والمعاناة الوطنيّة لا تُلغي ضرورة المجاهدة. بيد أنّ التصوّر السليم يستوجب التبصّر في الإعاقات البنيويّة التي تمنع عن اللبنانيّين التنعّم الهنيّ باستقلال وطنهم الهشّ. ضروبٌ شتّى من التنازع البنيويّ تزجّ بالوطن اللبنانيّ في متاهات الضياع والانحلال والهلاك. وليس للّبنانيّين أن ينعتقوا من هذه التنازعات إلّا بانتهاج سبيل الإصلاح البنيويّ الجذريّ الشامل.

- التنازع البنيويّ في المعنى
من الواضح أنّ الانعطاب الأصليّ في الاستقلال اللبنانيّ ناشئٌ من التنازع البنيويّ في المعنى الكيانيّ التأسيسيّ. فاللبنانيّون ما برحوا يختلفون على صياغة مضمون الجوهر الوطنيّ الجامع. فمنذ ائتلافهم الأوّل في العام 1920، تردّدوا تردّدًا خطيرًا في إثبات هويّتهم الوطنيّة. منهم من كان يميل إلى قوميّة لبنانيّة جبليّة أضيق، ومنهم إلى قوميّة سوريّة أمتن، ومنهم إلى قوميّة عربيّة أرحب. منهم من كان يصبو إلى كيان مسيحيّ صرف، ومنهم إلى كيان إسلاميّ محض، ومنهم إلى مختبر مسيحيّ إسلاميّ واعد. تَكرَّر مثلُ هذا التنازع في كلّ منعطف من منعطفات المئويّة، سواء في عام الاستقلال (1943) أو في ثورة 1958 أو في الحرب الأهليّة (1975-1990) أو في ثورة الأرز (2005). ويعاني اللبنانيّون اليوم في ثورة كرامة الإنسان اللبنانيّ (2019) آثارَ هذا التنازع الأصليّ.
من تجلّيات هذا التنازع التباينُ الفكريّ في بناء المعيّة اللبنانيّة، واستجلاء رموزها الجامعة، وصياغة تصوّراتها الإنسانيّة الحاضنة. فاللبنانيّون فازوا فوزًا قدَريًّا بهذا الكيان الخاصّ، ولكنّهم لم يستطيعوا أن يُنشئوا له مبرِّرًا فكريًّا جامعًا. أتتهم الأرضُ قبل الوطن، وجاءهم الاستقلالُ قبل المعنى، ومُنحوا الحرّيّة قبل المسؤوليّة. فإذا باستقلالهم يئنّ أنينًا مُهلكًا من شدّة التنازع الفكريّ، والتسيّب الوطنيّ، والاستهتار الأخلاقيّ، والتهوّر التدبيريّ. في خضمّ هذه الابتلاءات كلّها، نسي اللبنانيّون أنّ الأوطان السليمة تجدّد في نظام مَعيّتها، فتنتقل من طور إلى طور، ومن دستور إلى دستور، ومن جمهوريّة إلى جمهوريّة. ولكنّها في جميع هذه التبدّلات، لا تُبيح لنفسها أن تسائل موجبات وجودها، ومبرِّرات كيانها، وأصول معيّتها. الأوطان السليمة تجتهد في النظام، ولا تجتهد في الكيان. أمّا اللبنانيّون، فيحلو لهم عند كلّ طارئ أن يشكّكوا في سبب وجود الوطن اللبنانيّ. مثل هذا التشكيك يُفضي بهم في نهاية المطاف إلى إهلاك الوطن برمّته.

ومن ثمّ، فإنّ السبيل الأقوم إلى صون الاستقلال اللبنانيّ يقتضي النظر الموضوعيّ المجرّد في الجوامع اللبنانيّة. شرطُ الشروط العزوفُ عن تساكن الأضداد الحادّة في تصوّر المعنى اللبنانيّ الضابط. ذلك بأنّ اللبنانيّين لا يحتملون بعد اليوم التنازعفي معنى الهويّة الأساسيّة. فإمّا أن يرضوا بما قسمه لهم الدهرُ من انبساط جغرافيّ، ومؤتلِف إنسانيّ، ومحيط عربيّ، وإمّا أن يفرطوا العقد، ويذوبوا في الطامع الأقدر. لا يستطيع الفكر السياسيّ اللبنانيّ أن يثابر على الاجتهاد العبثيّ في الأصول والأسباب والمسوِّغات. فلبنان نشأ على هذه النشأة، وتكوَّن على هذا التكوُّن. ولا مجال لإعادة التاريخ وتغييره. فالإنسان قد سبق أن أبحر، على ما تقول به الوجوديّة. وليس فيه طاقةٌ على مساءلة الغيب من أجل إعادة مسرى الإبحار. فإمّا القبول، وإمّا الانحلال. في حالة القبول، يجدر باللبنانيّين أن يعتصموا بالمعنى الأنبل في تصوّر معيّتهم الإنسانيّة.
أعني بذلك أن يكون الوطن اللبنانيّ هو محضن المعنى الإنسانيّ الأنسب في المحيط السامي الشرقيّ العربيّ. يمكن الاجتهاد في استخراج الدلالات الإنسانيّة الرفيعة التي تنطوي عليها شرعة حقوق الإنسان، وقد اصطبغت بالروحانيّة الشرقيّة اصطباغًا يجعل الوطن اللبنانيّ وطنَ الكرامة الإنسانيّة الشخصيّة حيث يحيا الإنسان الفرد كائنًا قائمًا بذاته، حرًّا في اختياراته الوجوديّة، منفتحًا على اختبارات الإيمان الشخصيّ الفرديّ المغنية. وعليه، يستطيع مثلُ هذا التوفيق بين قيم الشرعة الكونيّة وقيم الروحانيّة الشرقيّة أن يستلّ من الوضعيّة اللبنانيّة الوطنيّة عناصر تميّزه. فيغدو لبنان على هذا النحو موضعَ التطبيق التاريخيّ لقابليّات الإغناء الإنسانيّ التي ينطوي عليها تلاقي مثل هذه القيَم. يجب على اللبنانيّين إذًا أن يلتئموا على معنى حضاريّ للإنسان يعيد إليه كرامتَه الذاتيّة الأصليّة وحرّيّته الكيانيّة الحقّ من دون أن يجرّده من وجدانه الصوفيّ، وتذوّقاته الروحيّة، وإيثاراته الأخلاقيّة، وتضامناته الجماعيّة. لا ريب في أنّ هذا الائتلاف المتناغم بين مقتضيات الفرديّة الذاتيّة وأبعاد الانتسابات الجماعيّة يمنح الاختبار الوطنيّ اللبنانيّ أشدّ ضروب التسويغ الفكريّ عمقًا ودلالةً وأثرًا. بذلك تتحقّق مقولة الانصهار الحضاريّ في البوتقة اللبنانيّة حيث تختلط تصوّراتُ الإنسان المستلّة من شرعة حقوق الإنسان بتلك المستخرَجة من حكمة الاجتماع الشرقيّ العربيّ، فتتفاعل وتتلاقح، ويُطهّر بعضُها بعضًا ويُغني بعضها بعضًا. من جرّاء هذه الصيرورة التاريخيّة، تتّضح هيئة المعنى الإنسانيّ اللبنانيّ الذي تضمنه المباني الدستوريّة التي تليق برفعة الاختبار.
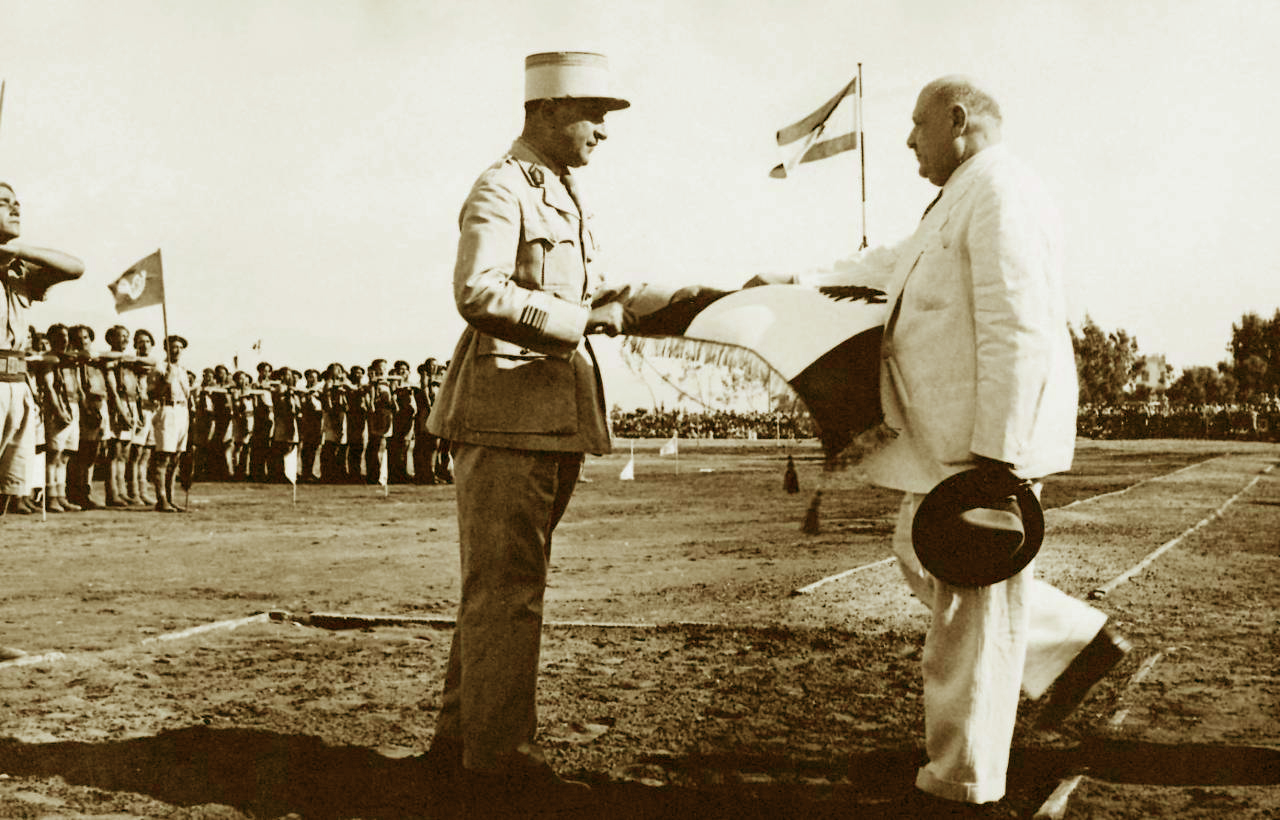
عوضًا من أن تنغلق الأنا اللبنانيّة على دائرتها الضيّقة، فتتناسل تناسلَ الشبه من الشبه، يمكنها أن تستثمر هذه المعيّة المتنوّعة، فتنقل الأنا الفرديّ والجماعيّ من الانغلاق إلى الانفتاح بحيث تغدو الأنا ذاتًا، وقد ضمّت إليها ثمار تفاعلها الحرّ البنّاء مع الآخر، على نحو ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنسيّ بول ريكور حين عاب على الأنا تصلّبها وثبوتيّتها وعقمها التناسليّ، وامتدح الذات التي تجرؤ على المغامرة والانفتاح والاقتباس والتحوّل المغني. ينبغي للمعيّة اللبنانيّة المستقلّة أن تنتقل من طور الأنا إلى طور الذات، أي من طور الأنانيّة المتشنّجة إلى طور الذاتيّة المنفتحة، فينشأ للّبنانيّين معنًى إنسانيّ راقٍ يزيّنون به استقلالهم، بحيث يغدو استقلالًا في الذات الإنسانيّة الناضجة، لا استقلالًا في الحجر والتراب والجغرافيا وحسب.أعتقد أنّ مثل هذا المعنى اللبنانيّ جديرٌ بلمّ الشمل، وصوغ الوَحدة، وترسيخ الائتلاف، وتوطيد المعيّة، وإلهام مضامين الاستقلال اللبنانيّ الحقيقيّ. أجل، مثل هذا المعنى الإنسانيّ خليقٌ بأن يجعل الوطن اللبنانيّ جديرًا بالوجود، عزيزًا بالمنعة، سليمًا بالاختبار التاريخيّ. في سبيل هذا المعنى يستحقّ اللبنانيّون أن يحيوا وأن يبذلوا الأغلى من روحهم وفكرهم وجهدهم. أمّا المعاني القوميّة الأخرى الضيّقة، والمعاني الدينيّة المتشرنقة المنعزلة المتشنّجة، والمعاني الأيديولوجيّة المكابرة المغرضة الفاسدة، فلا تستحقّ أن يتقاتل اللبنانيّون من أجلها ليفنوا ذواتهم إفناءً عبثيًّا. في هذه الحالة، أنصح الجميع بإغلاق المختبر، وفسخ العقد، وإنهاء الكيان.

- التنازع الوطنيّ في الولاء
من البديهيّ أن تتفرّع التنازعاتُ الأخرى من أصل التنازع الأساسيّ في المعنى. فحين يضطرب اجتماع اللبنانيّين على المعنى الواحد، يتفرّق شملهم وتتباين انتماءاتهم وتتعارض ولاءاتهم. لا شكّ في أنّ التنازع في الولاء يلازم الاختبار اللبنانيّ منذ أقدم العصور، إذ اتّضح أنّ الأرض اللبنانيّة، بسببٍ من توسّطها النسبيّ بين القارّات الآسيويّة والأُروبّيّة والأفريقيّة، وبسببٍ من مركزيّتها في عين البحر الأبيض المتوسّط، غالبًا ما استضافت مُكرهةً جيوش الغزاة وجحافل الفاتحين. ومن ثمّ، كان النقاش محتدمًا حتّى التكفير بين المقتنعينبالملكيّة الذاتيّة للأرض اللبنانيّة والقائلين باستحالة الملكيّة الذاتيّة ومشاعها وانتسابها إلى المحيط الأرحب. آخر هذه المباحثات كانت تنشط بين مؤيّدي لبنانيّة جبل لبنان ومناصري عثمانيّة هذا الجبل عينه. في السياق نفسه، يذهب كثيرون إلى أنّ الملكيّة عربيّة، لا لبنانيّة. ولذلك استقرّ في وعي اللبنانيّين أنّ الآخرين لهم عليهم دينٌ وحقٌّ ومَمسكٌ. في لاوعي اللبنانيّين اضطرابٌ بنيويٌّ يزيّن لهم أنّهم ليسوا أصحاب الملكيّة الأصليّة في الأرض اللبنانيّة.

من آثار هذا الاضطراب ميلُ اللبنانيّين المرَضيّ إلى ممالأة الغرباء، وحججهم في ذلك أكثرُ من أن تُحصى. الحجّة الأولى تقترن بهذا الشعور المضطرب الذي ينتابهم حين يشكّكون في لبنانيّة أرضهم، فينزعون مَنزعًا مربكًا إلىاستحضار التأييد الخارجيّ، علّهم يفوزون بقدر من الطمأنينة في ذواتهم. الحجّة الثانية قوميّةُ المصدر تُفضي بهم إلى تفضيل الآخرين على الذات حتّى لتصبح الأرضُ اللبنانيّة أرض الاستضافة في أصلها الكيانيّ، لا في قرارها التاريخيّ الحرّ. فاللبنانيّون يستطيعون أن يستقبلوا مَن يشاؤون من معذّبي الأرض يمنحونهم الدفء والتعزية والدعم. ولكنّهم لا يجوز لهم أن يجعلوا أرضهم أرضَ استقبال مفتوح، وقد أقنعوا أنفسهم بصدارة الانتماء القوميّ الأوسع على الانتماء اللبنانيّ الذاتيّ. الحجّة الثالثة دينيّةُ الطابع تدفع باللبنانيّين إلى إعلاء السلطان الدينيّ ورفعه إلى مرتبة المرجعيّة الوحيدة في جميع شؤون الأرض اللبنانيّة وشؤون الاجتماع اللبنانيّ. في هذه الحالة، يسقط الانتماء الوطنيّ اللبنانيّ في قبضة المبايعة الدينيّة التي تتجاوز حدود الأوطان، لا بل تُنكر دستوريّة هذه الحقوق على الإطلاق. الحجّة الرابعة انتهازيّة، منفعيّة، تواطئيّة، تزيّن للّبنانيّين أنّ مماشاة الغرباء تضمن لهم المساندة والغلبة على الشركاء في الوطن اللبنانيّ.
في جميع هذه الولاءات اللبنانيّة المرَضيّة نفيٌ صريحٌ للذات اللبنانيّة. والحال أنّ اللبنانيّين ينسون أو يتناسَون أنّ انتفاء ذاتهم اللبنانيّة إنّما يُبطل كلّ تفاعل حرّ مع الآخرين، ويعطّل كلّ تضامن قوميّ صادق. في جميع هذه الولاءات يستميت اللبنانيّون في الانتصار لكلّ هيجان قوميّ، أو تفوّر دينيّ مذهبيّ، أو لمعان أيديولوجيّ وهّاج. فإذا بهم يعتنقون القضايا قبل أن يصدّقها أصحابُها، فيذهبون بها مذهبًا قصيًّا،ويستطيبون الموت في سبيلها من غير أن يراعوا مقام الانعطاب الذي نشأ عليه كيانُهم. في جميع هذه الولاءات ينافس اللبنانيّون الملِك في ملَكيّته، على حدّ ما يُقال في حكمة الشعوب.

تروّعني بلاغةُ اللبنانيّين حين يحاضر خطباؤهم وفصحاؤهم في مسائل تسويغ الولاء الخارجيّ. جميع الحجج تبدو صائبة على الإطلاق، وقد فات اللبنانيّينأنّهم يؤيّدونها بقوّة الاقتناع الوجدانيّ، لا بدليل التبصّر العقليّ الموضوعيّ. في كلّ منعطف من منعطفات المئويّة الأولى تنازع اللبنانيّون في ولاء خارجيّ، فساقوا له أبلغ الأدلّة وأزهاها. في الطور الأوّل، نادى بعضُهم بالولاء للسلطان العربيّ المنبثق من تداعيات السلطنة العثمانيّة وتواطؤات الحرب العالميّة الأولى. في الطور الثاني، هبَّ بعضُهم يطالب بالاتّحاد بسوريا، فيما آثر بعضُهم الآخر سلطة الانتداب الفرنسيّ. في الطور الثالث، طَرِب بعضُهم للتألّق الناصريّ في مصر، فاهتزّ وجدانُهم وطفقوا يعاركون شركاءهم في الوطن اللبنانيّ من أجل الانضواء تحت اللواء العروبيّ الأقوى، فيما استرهب بعضُهم الآخر مخاطر هذه المغامرة وآثروا الولاء لمحور آخر. في الطور الرابع، انتشى بعضُهم بالقضيّة الفلسطينيّة وبالكفاح المسلّح والمقاومة الفدائيّة، فشرّعوا حدودهم وأبوابهم وضمائرهم لنصرة القضيّة العربيّة الأولى، وخضعوا لحاكمها المقتدر في بيروت، فيما انكفأ بعضُهم الآخر إلى ملاجئهم الجبليّة الحصينة يستجدون العون من القريب والبعيد. ونسي الجميع أنّ قوّة الحقّ في القضيّة الفلسطينيّة لا تُبطل شرعيّة الكيان في الذات اللبنانيّة. فلا يجوز أن يفنى لبنان افتداءً للقضيّة الفلسطينيّة، بل الحكمة تقوم في تعزيز منعة لبنان لكي ينصر كلّ القضايا الإنسانيّة العادلة. في الطور الخامس، اشتدّت أواصر القربى بين الشعبَين اللبنانيّ والسوريّ من جرّاء الوصاية الكاملة التي أقرّت بها القوى الدوليّة والإقليميّة إنهاءً للحرب اللبنانيّة العبثيّة. فنادى بعضُهم بالذوبان في الكيان السوريّ المنيع، وأخذوا يُقنعون العالم بتلازم المسارَين وبوحدة الشعب وثنائيّة الإدارة السياسيّة الظرفيّة المؤقّتة الزائلة، فيما لاذ بعضُهم بشرعة الجامعة العربيّة وبالقانون الدوليّ وكظموا غيظهم في تصبّر وترقّب. في الطور السادس، حين تبدّلت موازين القوى واتّضح إجماع اللبنانيّين المطلق على مقاومة العدوّ الإسرائيليّ، أيقن بعضُهم أنّ هذه المقاومة لا تستقيم إلّا بالولاء لمحور الممانعة الذي تقوده الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، فيما بعضُهم الآخر إمّا يُصرّ على المقاومة التي يضمنها الإجماعُ العربيّ، وإمّا يرتَئي الاستناد إلى شرعة حقوق الإنسان الكونيّة، وسلطان الأمم المتّحدة الرادع وقراراتها الملزمة، ومسؤوليّة الضمير الإنسانيّ وإمكانات الردع الأدبيّ عن الغيّ الفرديّ والضلال الجماعيّ.

لا ينهض وطنٌ على تنازع مزمن في الولاءات الأصليّة. فالولاء واحدٌ في الأوطان السليمة. أمّا معاهدات التعاون والمناصرة، فتُمليها المصلحة الإنسانيّة الأرقى والمصلحة الوطنيّة الأعلى. وحدهم اللبنانيّون يخلطون بين الولاء والتعاون. الولاء لا يكون إلّا للذات، فيما التعاون يصحّ مع الآخرين. لا يجوز أن يعلن اللبنانيّون ولاءهم لمن هم من خارج الوطن اللبنانيّ، مهما علا شأنهم السياسيّ، وسما قدرهم الحضاريّ، ونبَه مقامُهم الدينيّ.
الاستقلال الحقيقيّ يُسقط حجّة القائلين بأنّ الآخرين يحبّون لبنان حبًّا أشدّ من أبنائه. بذلك تَبطل أيضًا حجّة القائلين بأنّ المصلحة الوطنيّة العليا تقتضي الولاء لأمِريكا ولروسيا ولفرنسا وللسعوديّة ولسوريا ولإيران. مثل هذا المنطق إفراغٌ للاستقلال من معناه الأصليّ وتسفيهٌ للوطن اللبنانيّ. سخرية الأقدار تصعق الجميع حين تتبدّل موازين القوى، وقد تبدّلت غير مرّة على تراخي الأيّام. حينئذ يعود اللبنانيّون إلى رشدهم، ولكن من بعد أن يكفّر بعضهم بعضًا على غير هدًى، ويصارع بعضهم بعضًا في حُميّا الهيجان الانفعاليّ، ويقتل بعضهم بعضًا من دون رحمة. ومن مقتلة إلى مقتلة، تنهار دعائم السويّة الوطنيّة اللبنانيّة، فيكفر اللبنانيّون بهذا الوطن الذي انقلب مطيّةً لمطامع الآخرين. فليكفّ اللبنانيّون إذًا عن موالاة الخارج، ولينكفئوا إلى ذواتهم يستكشفون فيها من طاقات الإبداع ما يؤهّلهم للاكتفاء الذاتيّ وإغناء الآخرين. خطيئة اللبنانيّين أنّهم يمتدحون زعماءهم الذين ينهبون ثروات وطنهم، ويستجدون باسم الشعب اللبنانيّ هِبات المذلّة من الآخرين. أعجب لقومٍ يتخلّون طوعًا عن كنوزهم تبجيلًا لزعمائهم الفاسدين، ويرضون بأن يستعطواالغرباء استعطاء المتسوّلين المرذولين.

- التنازع الدستوريّ في الصيغة
لا يستقيم استقلالٌ سليمٌ بنّاءٌ مثمرٌ في اجتماع إنسانيّ يُفرَض عليه دستورٌ ملتوٍ ظالمٌ مجحفٌ، أو قلْ يَفرض على نفسه مثل هذا الدستور. منذ نشأة الكيان اللبنانيّ المعاصر، تشاحن اللبنانيّون وتعادَوا وتباغضوا بسببٍ من استحالة التوافق على نظام دستوريّ يضمن لهم المساواة في جميع وجوهها والعدالة في جميع أبعادها. معضلة لبنان الدستوريّة ناشئةٌ من صعوبة التوفيق بين مبدإ المساواة في الانتماء الوطنيّ ومبدإ العدالة في التمثيل السياسيّ. من جرّاء انعقاد الكيان اللبنانيّ على تنوّع دينيّ طائفيّ مذهبيّ، استحال التوفيق بين المبدأين، بحيث اضطرّ الجميع إلى القبول بتنازلات أثبتت الأيّام أنّها مناوراتٌ ظرفيّةٌ لا يُبنى عليها تضامنٌ وطنيٌّ سليم.
استحسنت الشريحتان الدينيّة والسياسيّة التواطؤ الموضوعيّ بينهما، فتوزّعتا الأدوار والمهمّات والوظائف. حين كانت تصيب الطبقة السياسيّة علّةٌ أو آفةٌ أو مَفسدةٌ، كانت الطبقة الدينيّة تهبّ للذود عن كرامة الطائفة وعنفوانها وعزّتها. وحين كان ينتاب الطبقة الدينيّةارتعاشٌ أو وهنٌ أو تراخٍ، كانت الطبقة السياسيّة تسارع إلى النجدة. في جميع الأحوال، تآمرت المجموعتان تآمرًا موضوعيًّا لا تآمرًا ذاتيًّا على سلامة البنيان الاجتماعيّ اللبنانيّ، وعلى مصلحة الوطن اللبنانيّ، وخصوصًا على حرّيّة الإنسان اللبنانيّ الفرديّة الذاتيّة.

بيد أنّ المجتمع اللبنانيّ اختبر صحواتٍ وطنيّة راقية وانتفاضات إنسانيّة نبيلة. في كلّ مرّة كانت الطبقتان تتآزران من أجل درءالمخاطر عن الصيغة اللبنانيّة التقاسميّة. حين شاءت قوى الإصلاح في المؤسّسة الدينيّة اللبنانيّة، على اختلاف مشاربها، أن تأتي بشيء من التغيير البنيويّ الذاتيّ، كانت الشريحة السياسيّة تحاصرها وتردع المصلحين عن الاستنهاض والتجديد. الحجّة الوحيدة في ذلك الزجر مخاطرُ إضعاف المناعة الذاتيّة في كلّ طائفة على حدة. هي مسرحيّةٌ اختبرها المجتمع اللبنانيّ حتّى اندلاع الحرب اللبنانيّة في منتصف السبعينيّات من القرن العشرين.
أمّا بعد الويلات التي أصابت لبنان، وفي إثر التحوّلات الفكريّة الكونيّة والتغيّرات السياسيّة العالميّة، فإنّ المجتمعات الإنسانيّة كلّها غدت تواجه تحدّيات التجديد في الذهنيّات وفي البنى. لا ريب في أنّ الاضطرابات السياسيّة التي ابتلي بها لبنان ناصرت وضعيّة التواطؤ المقيت بين المجموعتيَن. فأضحى التجديدُ واجبًا يقتضيه تطوّرُ الوعي السياسيّ الفرديّ والجماعيّ في الاجتماع اللبنانيّ. ومن بعد أن اختبر لبنان نظام الميثاقيّة التشاركيّة بين الطوائف، وعانى ما عاناه من اختلالات واعتورات وتواطؤات ومفاسد وتظلّمات، أدرك الجميع أنّ هذه الميثاقيّة جعلت لبنان في موضع الانعطاب الدائم. فلا هي أرضت الطوائف، وقد تبدّلت موازينُ القوى بينها، ولا هي أنصفت الإنسان اللبنانيّ في فرديّته، وقد نما وعيُه النقديّ نموًّا نسبيًّا، لاسيّما في أوساط الشبّان والشابّات، فطفق يطالب بمجتمع عَلمانيّ عصريّ منعتق من المباني الذهنيّة والاجتماعيّة والقانونيّة والسياسيّة الموروثة من القرون الوسطى.
أظنّ أنّ الوقت قد حان من أجل الشروع الحكيم في تغيير النظام اللبنانيّ برمّته. غير أنّي لستُ من القائلين بتجديد المعيّة اللبنانيّة من خلال الميثاقيّة الطوائفيّة، بل بواسطة العقد الاجتماعيّ المستند إلى مبادئ شرعة حقوق الإنسان. ذلك بأنّ ترميم الميثاقيّة سيُفضي إلى ابتداعات مشوَّهة لا تُرضي أحدًا، منها على سبيل المثال المناصفة المقنّعة أو المثالثة الصريحة. جميع هذه الصيَغ سقطت في ثورة كرامة الإنسان اللبنانيّ. ومن ثمّ، فإنّ أفضل الصيَغ الممكنة هي التي تتيحها العَلمانيّة الهنيّة، وقد انتظمت في سياق الإرث الحضاريّ والفكريّ والذهنيّ اللبنانيّ.
هي إذًا عَلمانيّةٌ هَنيّةٌ ترتكز على التصوّر الأنتروبولوجيّ الذي يعاين في الإنسان اللبنانيّ كائنًا قائمًا بذاته يحمل في وجدانه توقَ الذاتيّة الفرديّة الحرّة وتذوّقَ الانتماء الجماعيّ السليم، على ما ذهبتُ إليه في مسألة التنازع الأوّل في المعنى. لا تخالف هذه العَلمانيّة الهنيّة طبيعة الوجدان اللبنانيّ، بل جلُّ غايتها أن تعصمه من كلّ انحراف. فتعترف للإنسان الفرد بذاتيّته الأصليّة الحرّة، وتُقرّ له بحقّ الانتماء الرضيّ إلى الجماعة الدينيّة التي يطيب له أن ينتسب إليها ويُنعش بها وفيها اختبارَه الروحيّ.مثل هذه العَلمانيّة اللبنانيّة الخاصّة هي الأفق الوحيد الذي يتيح للّبنانيّين أن يحرّروا اجتماعهم من عصبيّات الطوائف والمذاهب والعشائر والقبائل والإقطاعات. بمقتضاها يميّز الناسُ في مداركهم الحقل العامّ من الحقل الخاصّ، فيتدبّرون أمور معيشهم بحسب ما تقتضيه أصولُ الإدارة القانونيّة التقنيّة العلميّة الموضوعيّة المحايدة، وينصرفون في خلواتهم الحرّة إلى تعزيز اختباراتهم الإيمانيّة الخاصّة.

شرط الشروط في تطبيق العَلمانيّة الهنيّة أن ينتسب الإنسان اللبنانيّ إلى المجتمع انتسابًا مجرّدًا من كلّ مبايعة أو انتماء، ما خلا الاعتصام بخاصّيّته الإنسانيّة الكونيّة الواحدة، وبصفته الوطنيّة اللبنانيّة الجامعة. ينجم عن ذلك الاعتصام أن تُنزَع كلُّ الهويّات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة عن الانتساب الأوّل في مسرى انضمام الفرد إلى المجتمع اللبنانيّ. فالفرد هو في أصله إنسانٌ ومواطنٌ. أمّا صفة الاختبارات الوجدانيّة الأخرى، فيحملها الفرد في نطاق انسلاكه الطوعيّ في الجماعة الإيمانيّة التي يختارها بملء إرادته. لذلك تقتضي العَلمانيّة الهنيّة أن يُشرَّع الزواج المدنيّ الشامل الملزم، وأن تُلغى المحاكم الدينيّة الطائفيّة، أو على الأقلّ أن تُلغى سلطتُها القانونيّة على الأفراد المواطنين، وأن ينشأ نظامٌ واحد في الأحوال الشخصيّة. إنّه السبيلُ الوحيد الذي يُفضي إلى بناء مجتمع لبنانيّ سليم معافًى عصريّ منفتح.
بالاستناد إلى هذا التحوّل الجذريّ في بنية الاجتماع اللبنانيّ، ينبغي أن يكبّ اللبنانيّون على صياغة النظام السياسيّ الأمثل الذي يَرتؤونه ملائمًا لمعيّتهم التاريخيّة الغنيّة. لا بدّ لهم أوّلًا من اختيار النظام الدِّموقراطيّ الصحيح الذي يقوم على مبادئ شرعة حقوق الإنسان. معنى ذلك القول أنّ الدِّموقراطيّة إمّا أن تكون ليبراليّة تعترف بكرامة الإنسان الأصليّة وبحرّيّته الذاتيّة وبمقامه الفريد، وإمّا ألّا تكون على الإطلاق. فالدِّموقراطيّة المجرّدة من الليبراليّة إنّما تُفضي إلى الفاشيّة المتعصّبة. هذا هو الشرط الأوّل في الدِّموقراطيّة الصحيحة. أمّا الشرط الثاني، فهو عَلمانيّتها الهنيّة لأنّ الدِّموقراطيّة التي انتُزعت منها العَلمانيّةُ الهنيّة إنّما تُفضي إلى حكم الأكثريّة الدينيّة المقنّعة. الشرط الثالث في الدِّموقراطيّة الصحيحة هو القدرة على الوعي الفرديّ النقديّ. فالدِّموقراطيّة التي يكتفي الناسُ منها بما يُدعى زورًا السيادة الشعبيّة لا يمكن الوثوق بها ما دام الشعبُ عاجزًا عن اكتساب وعيه النقديّ الحرّ. فالشعب الجاهل قد يختار بالدِّموقراطيّة عينها ما يخالف مبادئ شرعة حقوق الإنسان. لذلك يحذّر علماء السياسة في الأزمنة الحديثة من ديكتاتوريّة الأكثريّة الجاهلة حين تقتصر الدِّموقراطيّة على إجرائيّة اقتراعيّة جوفاء لا يعضدها تثقّفٌ ذاتيٌّ رصينٌ، وتنشئةٌ فكريّةٌ جامعةٌ، ومراسٌ معرفيٌّ راسخٌ، وتدبّرٌ نقديٌّ جريءٌ. من دون هذه الشروط الثلاثة الأساسيّة تنقلب الدِّموقراطيّة اللبنانيّة المنشودة سبيلًا إلى تسلّط الأيديولوجيات القوميّة وهيمنة الأصوليّات الدينيّة. فالإنسان في لبنان ينبغي أن تحميه الدِّموقراطيّة من ذاته الجاهلة الخطّاءة بالاستناد إلى القانون العادل المستلّ من شرعة حقوق الإنسان.

وعليه، فإنّ مثل هذه الدِّموقراطيّة الليبراليّة العَلمانيّة هي التي يمكنها أن تُلهم اللبنانيّين مسالكَ الإصلاح الدستوريّ القويم. من هذه المسالك إنشاء نظام المجلسَين، مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ. يُنتخَب مجلسُ النوّاب على قاعدة الانتماء الإنسانيّ الوطنيّ الواحد الذي أثبتته العَلمانيّة الهنيّة في الاجتماع اللبنانيّ حين فرضت الزواج المدنيّ الإلزاميّ وألغت المحاكم الدينيّة ووحّدت الأحوال الشخصيّة الفرديّة. ويُنتخب مجلسُ الشيوخ بحسب الانتماءات الروحيّة الحرّة أو العَلمانيّة الحرّة التي يعلن عنها اللبنانيّون ويستحصلون لها على بطاقة انتمائيّة فرعيّة تُمنح لهم حين يبلغون الثامنة عشرة من عمرهم، على غرار رخصة السَّوْق أو البطاقة الجامعيّة أو بطاقة الائتمان المصرفيّ. يجري انتخاب مجلس الشيوخ بحسب حجم الانتماءات الحرّة التي صرّح عنها كلُّ لبنانيّ على حدة بمقتضى البطاقة الفرعيّة. تناط بمجلس النوّاب التشريعات الإداريّة العامّة التي تقتضيها مصلحة الوطن اللبنانيّ في تدبّر جميع حقول الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية وما إلى ذلك. أمّا مجلس الشيوخ، فتُناط به القرارات الوجوديّة المصيريّة الجسيمة، وفي مقدّمتها صون الوطن والدفاع عنه، وصون الدستور أو تعديله، وصون التنوّع الروحيّ والارتقاء به إلى أشرف المراتب الحضاريّة عاملًا أساسيًّا في تهذيب الكائن الإنسانيّ، وتعزيز كرامته وحرّيّته ومسؤوليّته، وترسيخ السلام الكونيّ بين الناس.

أمّا النظام اللبنانيّ، فليكن نظامًا جمهوريًّا برلمانيًّا حكوميًّا يجعل مجلس الوزراء هو السلطة التي تضطلع بمسؤوليّة الإدارة السياسيّة، وهو السلطة التي يحاسبها الشعب بواسطة مجلس النوّاب.أمّا رئاسة الجمهوريّة، فلتكن بالتداول بين ممثّلي التيّارات الروحيّة والعَلمانيّة التي يحتضنها مجلس الشيوخ، بحسب الانتماء الحرّ الذي يصرّح به كلّ فرد لبنانيّ بمقتضى بطاقة الانتماء الفرعيّة. ولينتخب الشعبُ انتخابًا مباشرًا الرئيس بحسب منطق التداول لولاية لا تتجاوز السنتَين. ويمكن أيضًا النظر في إمكان انتخاب مجلس رئاسيّ يعبّر عن غنى التنوّع اللبنانيّ الدينيّ والعَلمانيّ، على غرار ما تنعم به سويسرا في مجلس رئاستها الجماعيّ. أمّا الأحزاب السياسيّة، فيُفرَض عليها نظامٌ في الانتساب يُلزمها مراعاة أحجام العضويّة بحسب تنوّع الأقضية اللبنانيّة. فلا يرخّص لحزب سياسيّ لا يُحصى في عديده أعضاء يأتونه بالتساوي من جميع الأقضية.
ومن ثمّ، لا بدّ من اعتماد هذا الإصلاح البنيويّ الشامل في الصيغة اللبنانيّة إذا ما أراد اللبنانيّون أن ينعموا باستقلال وطنيّ حقيقيّ. ذلك بأنّ مثل هذا الإصلاح يعزّز المنعة الوطنيّة الذاتيّة، ويرسّخ التضامن الاجتماعيّ، ويوطّد أسُس الإدارة الشفّافة النزيهة الفاعلة، ويُخضع جميع اللبنانيّين لمبدأَي المساواة والعدالة، ويحاسب كلّ مواطن ومواطنة على ما فعله بنفسه وبالآخرين وبالطبيعة وبالبيئة. حينئذ لا يستطيع اللبنانيُّ الفاسد أن يحتمي بطائفته هربًا من المحاسبة، ولا يقوى رجلُ الدِّين على حماية الفاسدين لأنّ النظام اللبنانيّ الجديد يجرّده من هذه الامتيازات البالية. حين ينعم اللبنانيّون بثمار هذا التحوّل البنيانيّ الشامل، ينصرفون إلى التفكّر السليم في جميع ألوان التحدّيات الخارجيّة والداخليّة، ويعصمون أنفسهم من الانجراف وراء المبايعات الخارجيّة والاستغلالات والاستفزازات والاصطفافات. فليتفكّر اللبنانيّون تفكّرًا حصيفًا في مصائر نظامهم السياسيّ، وليتجرّأوا على ابتكار مثل هذه التعديلات الجوهريّة التي تصون اجتماعهم الإنسانيّ من المفاسد والمهالك. الشرط الموضوعيّ الأخطر في مثل هذا الإصلاح أن يُقبل إليه اللبنانيّون بالهدوء والسكينة والتسالم، لا أن يُضطرّوا إلى الخوض فيه وهم على احتراب وتقاتل وتذابح. فلا قيمة لأيّ إصلاح يفتعله اللبنانيّون بالعنف، إذ إنّ التعانف لا يبطل قيمة الإصلاح الدستوريّ وحسب، بل يلغي الكيان اللبنانيّ المعروف برمّته.

- التنازع التدبيريّ في السلطة
أعني بالضرب الرابع هذا من التنازع استفحال الفساد بين المسؤولين اللبنانيّين الذين يستميتون في السعي إلى السلطة استغلالًا لها، وانتفاعًا منها، وتأبُّدًا بها.لا شكّ في أنّ فساد المسؤولين بات معروفًا في جميع دول العالم الثالث. بيد أنّ الجديد المذهل في لبنان هو فساد اللبنانيّين أنفسهم. فالمجتمع اللبنانيّ أضحى هو بعينه مَنبت الفساد وموئله وراعيه الأكبر. منشأ هذا الواقع الانحلالُ الأخلاقيّ الذي أصاب اللبنانيّين إبّان الحرب اللبنانيّة (1975-1990)، وإبّان زمن الاحتلالات والوصايات (1990-2005)، وإبّان زمن الانهيار الإداريّ الشامل (2005-2020). في كلّ عقد ونصف اختبر اللبنانيّون نمطًا فتّاكًا من التنشئة المنهجيّة على الفساد. في زمن الحرب عاين اللبنانيّون أهوال العنف والاقتتال، واختبروا فظائع الاقتلاع والهدم والإلغاء. فاضطربت مفاهيمُ القيَم الأخلاقيّة في وعيهم، والتبست عليهم مداركُ الحكم الموضوعيّ على الوقائع، واختلطت لديهم التصوّراتُوالاعتباراتُ والمستنداتُ والحجج والمعاييرُ.لم يكن اللبنانيّون قبل الحرب بمنأى عن كلّ انحراف أو سوء أو فساد. غير أنّ ضلالهم الأخلاقيّ كان يضبطه انتظامُ القانون اللبنانيّ على وجه العموم. حين أدرك اللبنانيّون في ويلات الحرب هشاشة الوجود، وانعطاب الحياة، وفقدان المعنى، وتحلّل البنى، وسقوط القوانين، أخذوا يبيحون لأنفسهم ما كانت تحظّره عليهم مبادئهم الإنسانيّة، وقيَمهم الأخلاقيّة، واقتناعاتهم الدينيّة.

في الزمن الثاني، زمن الاحتلالات والوصايات، عكف اللبنانيّون على تسويغ الانحلال الأخلاقيّ الذي أصابهم في زمن الحرب. وعوضًا من أن يتوبوا ويرتدّوا في مسرى أصيل نبيل رفيع من المصالحة الإنسانيّة والوطنيّة، أمعنوا في مخالفة القوانين، والتعدّي على الحُرمات، وانتهاك الأصول في المعاملات الإنسانيّة والمسؤوليّات والإدارات والقطاعات. تواطأ المسؤولون اللبنانيّون مع أصحاب السلطان، وفي مقدّمتهم السوريّون، فاستباحوا كلّ موارد الدولة ومصالح الناس ومنافع الوطن. الأنكى أنّ اللبنانيّين أصابتهم جميعًا عدوى الفساد، من أصغرهم إلى أكبرهم، وذلك لشدّة ما عاينوا من يسر في الانتفاع الماكر. تعاظمت آثار هذه العدوى الأخلاقيّة حين أدرك اللبنانيّون أنّ الدستور والقانون مطيّتان طيّعتان للتأويل المزاجيّ الاستبداديّ. كلّ انتهاك له مسوِّغه في قاموس أهل السياسة في لبنان. فإذا كان أهل المسؤوليّة السياسيّة ينتهكون كلّ شيء من دون حسيب أو رقيب، وإذا كان الناس يهلّلون للفاسد ويهنّئونه على فلاح فساده، فحريٌّ بكلّ طامح أن يصول ويجول ويعيث فسادًا في الحقل الذي ينشط فيه. في هذا الزمن الرديء انقلب الفسادُ اللبنانيّ سمة الرجولة والبأس والعنفوان والاقتدار، وتحوّل الفاسدون إلى زعماء القوم، وأسياد التاريخ،وحكماء التشريع، وأرباب القرار. من بعد أن تواطأت السلطتان اللبنانيّة والسوريّة على تسويغ الفساد، سقطت في وعي اللبنانيّين كلّ أحكام الوَزْع الذاتيّ، والردع القانونيّ، والزجر الأخلاقيّ، والنهي التأديبيّ. فتفلّتت قرائحُ الشطارة اللبنانيّة الفاسدة من عِقالها، وانغمس الجميع في وحل هذا الوباء. في هذا الزمن أيضًا انقلبت الشطارة عنوانًا للفساد، من بعد أن كانت مرادفةً للمهارة التفاوضيّة والحذاقة العمليّة والفطنة التدبيريّة. حين يستخدم اللبنانيّون هذه الصفة، فإنّهم يشيرون بها إلى إتقان التملّص من القانون اللبنانيّ، وتجويد تسويغ الارتكابات والاختلاسات والسرقات والتعدّيات والتجاوزات. وعليه، أصاب اللبنانيّين العمى الأخلاقيّ في الحكم على قيمة هذه الشطارة، وقد انحرفت عن مقاصدها الأصليّة البريئة. فإذا بمعظمهم يبجّلونها ويرفعونها مثالًا يحتذى في المواطنة الصالحة.
في الزمن الثالث، زمن الانهيار الإداريّ الشامل، كان اللبنانيّون في معظمهم قد أيقنوا أنّ بقاءهم على قيد الحياة يقتضي الانخراط الذكيّ في عمليّة النهب الشاملة، نهب الإنسان اللبنانيّ، ونهب الأرض اللبنانيّة، ونهب الحياة اللبنانيّة بأسرها. في هذا الزمن أدرك الجميع أنّ الفساد هو الصراط المستقيم من أجل الفوز بموقع مكين في معترك التاريخ الظلّام. أخطر ما في الزمن الثالث هذا أنّ أغلب اللبنانيّين، من بعد أن راكموا في لاوعيهم الباطنيّ ثلاثين عامًا من الانحطاط الأخلاقيّ، فقدوا القدرة على التمييز بين الخير والشرّ، بين الصلاح والفساد، بين الاستقامة والانحراف، بين الصدق والكذب، بين الفضيلة والرذيلة. أغلب اللبنانيّين باتوا اليوم مستعدّين لكلّ ألوان التسويات والترتيبات والتركيبات والتمريرات والتنسيقات، وهذه كلّها من مفردات الشطارة اللبنانيّة المقيتة، تحدوهم على ذلك رغبةٌ جارفةٌ في الانتفاع السريع، والكسب الآنيّ، والاغتناء اليسير.

من مفارقات الزمن الثالث هذا أنّ معظم نصوص التشريع اللبنانيّ تضاهي برقيّها نصوص الأمم الغربيّة المتقدّمة، ما خلا التشريعات الدستوريّة المقترنة بالنظام الطائفيّ اللبنانيّ. بيد أنّ العقل السياسيّ اللبنانيّ أصبح لديه القدرة على اجتراح الفظائع في تطويع القانون وليّه وتشويهه واستغلاله وتفسيره تفسيرًا يلائم مصالحه الأنانيّة. لذلك يعلم اللبنانيّون أنّ الفعل السياسيّ في لبنان مصابٌ بداء التفسير المغرض حتّى إنّ القضاء اللبنانيّ أمسى خاضعًا لعمليّة التطويع والليِّ والتشويه. فإذا كان المسؤولون يستنجدون بالقضاء المنحاز لكي يسوّغوا كلّ أصناف جرائم الفساد المرتكبة، فإنّ المستند الأخير في بتّ المسائل القانونيّة العالقة هو الاستنجاد ليس بالقضاء العاجز، بل بالمسؤول الفاسد والمفسد. وعليه، فإنّ اللبنانيّين أصبحوا يدركون اليوم أنّ الدولة هيكلٌ عظميٌّ عديمُ الفائدة والأثر، وأنّ الزعيم هو المالك على مصائر الناس ومرابط قضاياهم. فإذا أرادوا إنصافًا، كان لا بدّ لهم من الخضوع لمشيئة الزعيم الفاسد حتّى يحكم لهم بما يُمليه عليه ضميره المنحرف. على هذا المنوال، تتحوّل قضايا الناس إلى مسرح المجابهة بين الزعماء الفاسدين. والحكم في القضيّة إنّما يمتلك ناصيته الأقدرُ والأعتى والأفسدُ من الزعماء اللبنانيّين.
حين يدرك اللبنانيّون جسامة الوضعيّة الأخلاقيّة المنحلّة التي ابتُلوا بها ابتلاءً مبرمًا، يقفون حائرين تتنازعهم رغباتٌ شتّى. فإمّا أن يواطئوا المسؤولين الفاسدين، وهذا ما يفعله جلّهم عن طوع أو عن إكراه، وإمّا أن يتخلّوا عن حقوقهم الأساسيّة ويعتصموا بالصمت البليغ، وإمّا أن يكفروا بالوطن ويهاجروا إلى غير رجعة. يتهيّأ لي أنّ أغلب اللبنانيّين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في قرائن الانحراف الأخلاقيّ اللبنانيّ، وسبيلهم الوحيد ممالأة الزعيم الفاسد. من جرّاء هذه الممالأة سرت إليهم عدوى الفساد عينها، فتحوّلوا في حقولهم الصغيرة زعماءَ فساد في مقادير تناسب أحجامهم. فطفق الجميعُ يسرق الجميع في لبنان حتّى يستقيم للناس شيءٌ من العدالة السلبيّة التي ستُفضي في نهاية المطاف إلى إتلاف موارد الأرض، وتلويث الهواء، وإفساد المعاملات الإنسانيّة برمّتها.
استفضتُ في مسألة التنازع في الفساد لأنّ الطور الأخير الذي بلغه اللبنانيّون هو طور الاستماتة في انتزاع آخر موارد الوطن اللبنانيّ، وتسخيرها لخدمة الأنانيّات المستفحلة، من أعلى الهرم إلى أسفله. يقيني في هذه المسألة الخطيرة أنّ مثل هذا الفساد يبطل كلّ استقلال رمزيّ أو حقيقيّ. لا يحقّ للّبنانيّين أن ينشدوا نشيد الاستقلال وهم على هذا الانحطاط الأخلاقيّ في تدبّر حقول اجتماعهم الوطنيّ. ما من استقلال حقيقيّ يستطيع أن يصمد في مساكنته هذا المقدارَ المرعب من الفساد البنيويّ الشامل. معنى هذا القول أنّ لبنان لا يمكنه أن يغدو وطنًا مستقلًّا ما دام اللبنانيّون يواظبون على إفساد وطنهم ومجتمعهم وبيئتهم ودستورهم وإدارتهم وحياتهم كلّها. يحفّ اللبنانيّون بالفساد على نحو ما تحفّ الكواسر بالجيَف المنتنة المتحلّلة.
لا سبيل إلى الانعتاق من هذه الآفة إلّا بترميم أصول التربية في البيت والأسرة والمدرسة والشارع والنادي والجامعة والمعمل والمكتب والحزب. يفترض الترميم أن يتوب اللبنانيّون توبة كيانيّة صادقة وأن يعترفوا علنًا بما اقترفوه من جرائم في تدبّر معيّتهم الإنسانيّة، وفي إدارة موارد وطنهم المثخن بالانعطابات والأسقام والعلل. يبدو لي اليوم أنّ التوبة الكيانيّة صعبةُ المنال ما دام اللبنانيّون خرجوا من الحرب الأهليّة ومن زمن الاحتلالات والوصايات خروجًا مصطنعًا فيه الكثير من التكلّف والتصنّع والرياء. لم يصارح اللبنانيّون بعضهم بعضًا في أسباب النزاع الحقيقيّة ومبرِّرات الاقتتال الهدّام. توافقوا على طيّ صفحة الماضي من دون أن يجرؤوا على تحليل الوقائع، وتعرية الأوهام، وتعيين المسؤوليّات، ومحاسبة المحرِّضين والمندسّين والمفتعلين والمنتفعين. ما كان اللبنانيّون كلّهم أبرياء في الحرب، وما كان العرب كلّهم أصفياء فيها، وما كان الغربيّون كلّهم أطهارًا. بيد أنّ اللبنانيّين طووا الحرب من غير أن يدقّقوا تدقيقًا موضوعيًّا نزيهًا حازمًا في مسلك كلّ جهة على حدة، وفي خلفيّات كلّ طرف، وفي نيّات كلّ فريق.
لذلك نشأ بعد الحرب اللبنانيّة مجتمعٌ لبنانيٌّ مضطربٌ، منقسمٌ، متشنّجٌ، متأهّبٌ لكلّ ضروب الانحراف والجنون الممكنة. غياب الرؤية الشفائيّة الفرديّة والجماعيّة القويمة جعل اللبنانيّين بعد الحرب اللبنانيّة في حالة الضياع الكيانيّ. ومن جرّاء الخضوع المذلّ لسلطة الاحتلال والوصاية وتواطؤ السياسيّين اللبنانيّين على نهب الموارد والثروات والطاقات، تفاقمت أعراضُ الاعتلال اللبنانيّ وتضاءلت فرص النجاة والخلاص. الشعب الذي كان يجرّ أذيال الخيبة ويكتم في ذاته العقَد النفسيّة التي ابتلي بها إبّان الحرب اللبنانيّة، ما لبث أن أصابته المذلّة في خضوعه لمشيئة الآخرين. فلا عجب، والحال هذه، أن تتعاظم بلاياه تعاظمًا خطيرًا يجعلالشفاء الجماعيّ عمليّة شديدة العسر. ومن دون هذا الشفاء الجماعيّ لا سبيلَ إلى استقلالٍ وطنيّ حقيقيّ.
تبسّطتُ في تحليل ضروب التنازع الأربعة لكي أبيّن جسامة الوضعيّة التي زُجّ فيها الوطنُ اللبنانيّ في هذه الأزمنة المضطربة الكالحة. يقيني أنّ الاستقلال لا يعدو أن يكون مجرّد حلم جذّاب يركن إليه اللبنانيّون من أجل الانعتاق الرمزيّ من قيود الأسر الكيانيّ التي تكبّلهم تكبيلًا. انطباعي أنّ الاستقلال مسرًى جدليٌّ ينشط بين وعي الذات الحرّة ووعي الجماعة الناضجة. أمّا في لبنان، فإنّ الاستقلال الرسميّ الحقوقيّ الدستوريّ المعترف به عالميًّا يظلّ متأثّرًا تأثّرًا بليغًا بانعطاب الاستقلال الفرديّ الذاتيّ وبالتباسات استقلال الجماعات اللبنانيّة المتشنّجة، المتعصّبة، المؤدلجة، المستغَلّة، المسيَّرة.
تعزيةُ اللبنانيّين المعذّبين الوحيدة اقتناعُهم بأنّ الاستقلال، ولئن ظلّ مختلًّا ناقصًا منعطبًا، إنّما يُعبّر عن حصيلة التفاعل الذي أحدثته الاضطراباتُ الكيانيّة بين اللبنانيّين الساعين إلى التبصّر في حقيقة وجودهم الوطنيّ. حدثُ الاستقلال يتجاوز البعد التاريخيّ المحض ليصبح حالةً من التطوّر المؤلم في وعي اللبنانيّين الذين تنازعوا في تفسير اختبارات الاستقلال في غضون المئويَّة الأولى. إنّ معظم ما تراكم واستقرّ في الوعي اللبنانيّ مؤلم ومرعبٌومحبطٌ. بيد أنّ الألم الكيانيّ يحمل في ثناياه رجاء النضج الذاتيّ والجماعيّ. لم يختبر اللبنانيّون إلى اليوم من الاستقلال سوى تناقضاته الموجعة. فهل يأتي على اللبنانيّين زمنٌ آخر من اختبار الاستقلال يحيون فيه حياةً تليق بالقصائد البهيّة التي أنشؤوها وبالأحلام الزاهية التي سامرتهم في ظلمات حياتهم المكفهرّة؟








