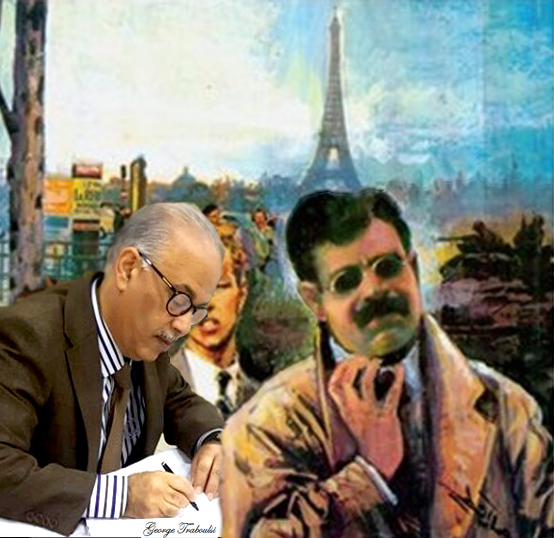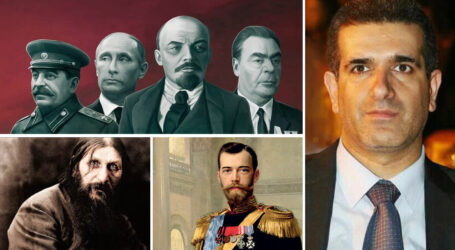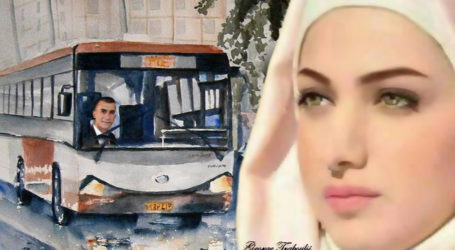طه حسين ثَوريٌّ في زَمن تقديس التقاليد
د. جورج شبلي
التُّحفةُ البهيّة هي التي إنْ جلستَ الى جانبِها وشَمَمتَ رائحةً طيّبة، ظَنَنتَ أنّك من أهل النَّعيم. فالقليلُ المُبَعثَر منها يكفي للإطمئنان الى أنّ لها يداً في ما نُسِب الى كثيرين سواها من روائع الرسائل. وعندما يَفترُ حضورُها، يخبو مَبيتُ المعرفة عند الناس.
طه حسين، هذا الذي لم يكن مُستَطيعاً بغيره، لم يأتِ من القَحط ليطلبَ الإحسان، ولم يدخل كعبةَ الفكر والأدب مُستَتِراً. فالسّقامُ على جِدّ الكتابة لم يعتَرِه، ولا النُّحول، لأنّ مَلاحظَها عنده سِحر، وهو لم يتعب من حَمل ثِقَل حُبّها، وهو الكَلِفُ حتى بمُحرَّماتها، يفتديها بتوفيقاته من دون أن يعلوَ فيها شحُّه. إنّ بُروز اسم طه حسين، وهو الصَّعيديّ التُّرعَوِيّ، قوبِل بموقفٍ ماضَويٍّ لبورجوازيّي الحواضر المصريّة يَدين، ومِن باب الطبَقيّة ونافذة الإستعلاء، مَن يسعى لمكانةٍ رفيعة وهو من طبقة الشَّعب وبِرَسم جمهور العامّة. وكأنّ الطَبَقيّين لم يصِلْهم أنّه في عزّ العهد الإمبراطوري لِروما، كان الأبطال الرياضيّون مُصَنَّفين من طبقة الوُجَهاء، فكيفَ بالمُفَكِّرين.
مع طه حسين، الذي كان له في أوائل صَبوته هوىً للأدب اشتدَّ له شَغَفُه، عندما نَقضي دَينَه علينا، نحتاج تواً الى قَرضٍ جديد. فالرَّجل الذي تَصَوَّرْنا للأدب رغبةً في اصطفائه، كان ذلك الوجهَ الوضّاح الذي تَذاكرَ مع الكلام أخبارَ الإبداع، فاحتالَ الكلامُ له في لقاءِ ما اتَّفق من صُنوف الكتابة، فأَذِنَت هذه له مَتنَها فحلَّ في أرضها، فتبارَت أنواعُها وانتظرَت الى أَيٍّ منها هو أَشوَق، وبأيٍّ منها يريدُ أن يبدأ. ففي مَشيَخَتِه العفيفة حظٌّ للأدب استعدَّ له، ولكن باعتدال المَقال وجَمال الصِّفة، وحظٌّ للفكر الإجتماعيّ الجريء، وحظٌّ للرواية والسّيرة والنَّقد.

بِقَدر ما في تآليف طه حسين زقزقاتُ عصافير، بِقَدر ما فيها نِطاحُ كِباش. فالرَّجلُ مَفطورٌ على التَّحدّي، وجرأتُه لها وجودٌ فِعليّ في عقيدتَين اثنتَين، كان من البَدَهيّة بحيث ظلَّت إحداهما تتماهى مع الأخرى، وهما التَّنوير والتَّحديث. وبالرَّغم من الحرص على إثبات بُطلانهما، وذلك باتّهامه بنزعة الأَورَبَة أو التَّغريب، لم يتراجع طه عن الدَّعوة الى المنهجيّة التجديدية في مُقاربة سيرورة الفكر، خاصةً في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، ولم يتوانَ عن المُجاهَرة بأنّ المُستنيرين “هم عِدَّةُ المستقبل وقوامُ النهضة الحديثة”. وقد شكَّل بذلك رأس رمحٍ في الحركة الأدبية والفكرية في العالَم العربيّ بأسرِه.
لقد شكا طه حسين من زمانه، وتوجَّع من حقد معاصريه وحَسدهم، بالرَّغم من مُلاحاة الكثيرين منهم، والحرص على إظهار فضلهم وتفوّقهم. فهذا الذي ودَّعته نضارةُ الأيام، وتبعته جنيّة التَجَنّي أينما حلّ وحيث ذهب، لم يُمَلّ من الطَّعن عليه، ربّما لأنه كان الشيطان الأمرَد. فالذين نابَتهم النُّوَب، وانتضى عليه لسانُهم عند السّامعين، ساعدَتهم زرافةٌ من المُتَضَرِّرين لَمّا بويِع طه عميداً للأدب العربي. وقد سخّروا نَبضَهم ومن دون تأخيرِ الإجابة، للتعريض بشخص طه الذي كان يَصبو، كما روَّجوا، الى أن يدرّ له شريان العِلم، بتقليد أبي العلاء الذي خَصَّه طه بأكثر من بحثٍ ودراسة. فبالرَّغم من التَّعاشق على المستوى الحسّي بين الرَّجُلَين في عِرق النَّظَر، وبالرَّغم من تَتابُع الحركة الأدبية بين العصور وفي المَوهوبين، غير أنّ المُتَعَرِّضين لم يكونوا مُصيبين حين افترضوا أنّ هناك تقاطُعاً جوهريّاً بينهما، أو أنّ طه قَلَّد المعرّي. ولعلّ “مُوضَةَ” السّرقات الأدبية المُتَجَنِّيَة التي راجَت في كلّ عَصر، وأشهرُها ما سُرِّب من “سَرقات المتنبّي ” عن أرسطو وعن عروة بن الوَرد وغيرهما، ما حَدا بالمُتَصَيِّدين الى خَوضِ ما يُشبِهُ حرب “طروادة” مع طه، وتوجيه السِّهام الخائِبة له. من هنا، وبعد هذا كلِّه، يَصحُّ السؤال: هل طه حسين هو عميدٌ أو شَهيد ؟
إنّ المِبضعَ النَّقدي الحادّ قصدَ الى عَرض رأس طه حسين أمام مَدْعُوّي الحِرفة الأدبية، وكأنّه تمثال من حَجَر. فموقفه المُشَكِّك في كتابه “في الأدب الجاهلي”، مُجارياً بذلك رأي المُستَشرِق الإنكليزي ” مَرغُوليوث “، كان موضِعَ انتقادٍ لدى المُحافِظين المُتَشَدِّدين الذين يعتبرون الشِّعر الجاهليّ من الأصول التي يجبُ عدم التعرّض لها، إن لم نَقُل تقديسَها. لكنَّ موقف طه المُتَنَوِّرِ وصاحبِ العقل ” الدِّيكارتي “، له ما يُبَرِّره، إذ أنّ السَّماع مَصدرٌ ضعيفُ المصداقيّة ولا يمكنُ عَدُّهُ ميزاناً للحقيقة، فما وصل إلينا من شِعر الجاهليّين كان كلَّ ما بقي منه في ذاكرة الرُّواة، والذّاكرةُ الشفويّة لا تُعَمّر طويلاً. من هنا، كان تَشَكُّك طه في محلِّه، وكان إعلانُه أكثرَ حقَّانيّة، بحيث ذهب أصحابُ العقول المَصدومة الى الإعتقاد بأنّ طه حسين شكّل بموقفه تَجديفاً إذ نفى تاريخية الشِّعر الجاهلي واعتبره مَنحولاً. وبالرَّغم من هذا الموقف الثَّوري الذي يدفع الى إعادة النَّظر موضوعيّاً في صحّة نِسبة القصائد الجاهلية الى أصحابها، كان حَريّاً بالنُقّاد، ولا سيّما أنور الجندي في كتابه “محاكمة فِكر طه حسين”، أن يعودوا الى “حديث الأربعاء” وفيه استفاضةٌ في اعتبار الشِّعر القديم من حيثُ الجَمال البَيانيّ أساساً من أُسُس الثقافة الحديثة، فيلتزموا دربَ الحَذَر والترَوّي في إدانتهم طه، لأنهم لم يَبلَوا البلاء الحَسن في معركتهم الإعتباطيّة تلك، وبالتالي لم يجنَوا سوى الضَّرَر الفادح لهم وله.
إنّ النّزاع المُستَشري بين القدماء والمُحدَثين حكايةٌ مُتَوَلِّدةٌ من الجَدَل بين التقدّم والأسطورة، وقد أمعَنَت مشكلةُ الأسطورة في التَعَقُّد، حتى أصبح من العَبَث التَّمييز بينها وبين الخُرافة. وقد أدّى ذلك بالمُحدَثين الى طرح السؤال : هل تنطوي الخُرافة على شيءٍ حقيقيّ ؟ لقد انطلق طه حسين من قاعدة التَّفاوُت القائم في درجات الصَّحيح، أو مقاييس الحقيقة، ورُوِي أنّه كان يغتاظ لدى سماعه نادرةً لا ترتكز على أي أساس عقليّ. ومع اعترافه بأنّ المَرويّات ليست عنصراً عابِراً في التاريخ، لكنّها ليست ماهيّة جوهريّة فيه، وبالتالي ليس من الضرورة أن ينخدعَ العقل بها. لذلك، كان لنصوص طه جميعاً عمقُ الواقع وتَماسُكه، لتُمنَحَ سَلَفاً التّفسيرُ الأكثرُ ذكاءً ومُعاصَرة.
إنّ ثوريّة طه حسين ” الفولتيريّة” برزَت في السّيرة، فقد وضع كتابُ “الأيام” القارئَ أمام تَحَدٍّ، وكأنّ هذا الأخير يواجِهُ قائمةً يتعيَّن عليه أن يملأها بإجابات، بَدلاً من أن يتلقّى الأجوبة من الرّاوية نفسه. إنّ كتاب ” الأيام ” قد صنّفه البعض فاتحةً تُؤذِنُ بروايةٍ بالمعنى العلميّ الحقيقيّ، لأنّ ما هو مَكتوبٌ فيه يشكّلُ جزءاً من الأمور الواجبِ معرفتُها، وليس من الغرائب المَنسوجة بعناصرَ طارِئة، لتُشبه التَّضخيمات المَلحميّة. والمؤلّفُ لم يخلط فيه بين الأحداث والتاريخ الذي لم يكن سوى مرجعٍ دُلاليّ لها فقط، من هنا، فإنّ ” الأيام ” هو تاريخٌ أدبيّ راقٍ، لا يُستَخدَم لمتابعةِ مسرحيّةِ حياة، بِقَدر ما يأخذ بالقارئ الى حُسن فَهم طه حسين الذي كان يبدو لنا أنّنا نعرفه حقَ المعرفة. ولكن، حتى لو اهتدينا في ” الأيام ” الى مواقع الرَّوعة في حياة طه، لَما أَجدانا ذلك نَفعاً، طالما أنّ هذه المَواقع لم تَعُد مأهولةً في أيّامنا !!!
طه حسين الثَّوري، لم يتَّكِئ على رمحه حين مات، ليُسأَل: أَعَجزٌ يا فتى الإنس ؟ من هنا، كان ينبغي أن تُجَدَّدَ له البَيعةُ عميداً للأدب وهو مَيت.