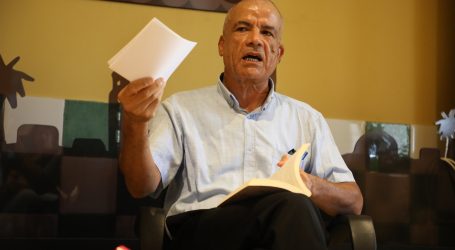نهاد الحايك وتجربتها الشعرية في استضافة ندوة الزيتون الأدبية في القاهرة: صوت مختلف يهز الأعماق
استضافت ورشة الزيتون الأدبية(1) في القاهرة الشاعرة اللبنانية نهاد الحايك يوم 3 شباط/فبراير 2020، بعقد ندوة عن نتاجها الشعري، شارك فيها وحضرها نخبة من الكتّاب والكاتبات والنقّاد والناقدات ومتذوِّقي ومتذوِّقات الأدب ومُتابِعي ومتابِعات الحركة الثقافية. أدارت الندوة الكاتبة سوسن الشريف، وقدم كل من القاصّ والناقد أسامة ريان، وأستاذ النقد الأدبي الدكتور أحمد عبد الرحيم، والشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، وأستاذة العلوم اللغوية الدكتورة فاطمة الصعيدي، مراجعات نقدية عن كل من ديوانَي الشاعرة “اعترافات جامحة” و”عناقيد الزئبق”(2). كما قدم الحاضرون والحاضرات مداخلات مختصرة عن رأيهم ورأيهن في شعر نهاد الحايك. يُذكر أن منظمي ندوات ورشة الزيتون يوزعون نصوص كل ضيف وضيفة على مجموعة من رواد الورشة الملتزمين حضوراً وقراءةً ومتابعة. كما قرأت الشاعرة مختارات من قصائدها. وفي ما يلي ملخص للمراجعات النقدية.

تحدث في بداية الندوة القاصّ والناقد أسامة ريان، الذي تناول ديوان “عناقيد الزئبق” ورأى أن فيه تفاعلاً عميقاً مع القضايا العامة، مِحن الوطن ومتاعب البشر، إلى جانب الغوص في الجانب الخاص من تأملات في الحياة والموت وتعبير عن الحب. ولمس ثقافة موسوعية عربية وعالمية، كما لاحظ أن نصوص الديوان غنية بالفكر الفلسفي وتُميِّزها نزعة صوفية واضحة جداً، ولا سيما أجواء الحلاج. وتوقف عند عدد من القصائد محللاً شكلها ومضمونها.
اعتبر ريان أن قصيدة نهاد الحايك “مَن أنا؟” التي تتحدث عن وضع المرأة العربية، هي القصيدة العمدة في ديوان “عناقيد الزئبق”. فقد خطّت فيها الشاعرةُ سِفْرَ الثورة والتمرد بالمكاشفة ومواجهة دعاة التخلُّف. وأوضح أنها وإن أعلنت أن المرأة ليست ناقصة فهي ليست من دعاة تغيير العالم من عالم ذكوري إلى عالم أنثوي، بل تدعو إلى التساوي والمشاركة في بناء عالم أفضل.

وقال إن نص “قيثارة الملائكة” يدل على البعد الفلسفي في تفكير الشاعرة وتعبيرها، فهي في حيرة أو متاهة بين المسيّر والمخيّر، القضية الأزلية، فتقول: “تلك هي أفعال مائجة، بين قعر الحياة وسطح القدر، أحاول اصطيادها بأوتار قيثارةٍ خرجت على كورس الملائكة”. ورصد في قصيدة “خزنة الوقت” غرائبية في التعامل مع الوقت وقال إن الشاعرة تصف الوقت بأوصاف رائعة وتتحدث عن “حبس الوقت”، فجعلته يواجه بين رؤيتها الأدبية الفلسفية ونظرية آينشتاين العلمية. فبينما تحدث آينشتاين عن ضغط الوقت حيث من الممكن أن تحتل الثانية مسافة أوسع أو أضيق من الزمن، تصف الشاعرة الزمن باعتباره أوقيانس، وتجعله يتدافع. تصف بدقة غير مسبوقة تَحرُّك الوقت والخشية من آثار الزمن.
وقال إن الشاعرة في قصيدة “الكفة الراجحة” تتكلم عن قيم مطلقة مثل العدل، وجعلت المنافسة هنا مع القبح، حيث تستخدم قالباً تبريرياً قائماً على تعدد الحجج.
وفي قصيدة “سحر الأبواب” تتعمق نهاد الحايك في رمزية الباب، وتقرأ في الباب المغلق كما لو في مرآة، أو تُحوِّله إلى زجاج شفاف يكشف عن عوالم كثيرة، أو تنجذب إليه كمحرك يوحي بحالات كثيرة من الدهشة.
وفي قصيدة “أرق” تصف الليل وتهويمات النفس الصاحية في سكونه وتصور حالة الأرق والتفاعل الصامت مع الظلام والخيالات والأفكار الجامحة بأسلوب جديد وصور مبتكرة. وفي خاتمةٍ رائعة للقصيدة، تضع جملة مبتكرة بفكرتها وصياغتها: “وإنْ غلبني النعاس، لا أنام عن حياتي، بل موتي أعيش”.
في “صرخة حمراء” صورت لحظات إعدام بدقة فائقة وتماهٍ مدهش مع الضحية في مواجهة الجلاد.
وختم الأستاذ ريان بالقول: “إذا كنا نطلق على الشاعر الجيد صفة “الفحل”، بماذا يمكننا أن نصف الشاعرة الجيدة؟ أقول بكل ثقة إن نهاد الحايك شاعرة “مُجيدة”.

من ناحيته تناول أستاذ النقد الأدبي الدكتور أحمد عبد الرحيم ديوان “اعترافات جامحة”، تناولًا نقديًا أكاديميًا، حيث قال إن أسلوب نهاد الحايك أسلوبٌ جديد، يتميز بالصدق الفني، حيث عكست في ديوانها رحلة من المكابدات وضروباً من المِحن والشدائد وكانت أمينة في تصوير مشاعرها وخلجات نفسها. وقد تميزت بالجودة والترابط الشديد والأصالة والاقتصاد. ألفاظها خالية من الحشو والإسهاب، وقد تناسقت مع الصور البلاغية لرسم لوحات جمالية تعبر عن اغترابها النفسي.
وتوقف الدكتور أحمد عبد الرحيم عند عدد من القصائد، وإن خصّ قصيدة “ضباب” باهتمام وتركيز خاصين، حيث أوضح أن هذه القصيدة تتضمن صرخة حنين وألم من جراء الغربة عن الوطن والأهل في الولايات المتحدة. ومع أن الشاعرة لم تستخدم ألفاظاً صارخة ولا كلمات تحتوي على جرس قوي أو حروف قاسية، فهي نجحت في إيصال المعنى إلى المُتلقّي بشكل واضح وسلس، ما يؤكد أن الشاعرة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني، تستطيع به أن تختار أدواتها الشعرية بإتقان لتصل إلى المُتلقّي بما تريد أن تقول.
وفي ختام دراسته أوضح الدكتور عبد الرحيم أن جميع قصائد نهاد الحايك تتضمن موسيقى خفية، يشعر القارئ بها في قلبه ولا يسمعها بأذنه. هذه الموسيقى ليست وليدة القافية والوزن، وقد تكون ناتجة عن انسيابية العبارات، أو عن الصور، أو عن الأفكار، أو قد تكون ناتجة عن كل عناصر النص مجتمعة، ولكنها في النهاية تهز أعماق المُتلقّي.

ثم قدم الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ مراجعته، فقال إنه قرأ الديوانين “اعترافات جامحة” و”عناقيد الزئبق” وخلص منهما إلى أن الشاعرة لها منهج فكري فلسفي وصوفي. وأوضح أن نصوص الديوانين تكتمل فيها معظم عناصر قصيدة النثر: الإيجاز، والصور، والتعبير، واستخدام غير عادي للغة اليومية، وأن للفلسفة حضوراً واضحاً في كل أشعارها، وبكثافة رهيبة خاصة في “عناقيد الزئبق”. . وقال إن قصيدة “الكفة الراجحة” مثال على ذلك، ففي كل سطر فيها فلسفة محددة، بالإضافة إلى ما فيها من أسلوب التشويق، حيث تجرجرنا بكلمات “أحبكَ” و”أفتقدكَ”، لتصل بنا في النهاية إلى الكشف بأن مَن تحبه وتفتقده هو “العدل”. وكذلك في قصيدة “سحر الأبواب”، حيث تومض نهاد الحايك لنا بلمعات فلسفية مثل: “لا يكون الباب باباً إلا عازلاً” و”لا يكون الباب باباً إلا قابلاً للخلع”…
وقال شرقاوي حافظ إن العفوية في شعر نهاد الحايك قد استوقفته، فهي تعبر عن عواطفها وشجونها دون تحفُّظ أو قيود، مثل في قصيدة “مَن يرث سفري؟”: “بيني بين الدنيا طفلٌ لم يأت، يلهو في حقول يقظتي…” وتخاطب جسدها: “هذا الجسد الذي لم يَلِدْ، رسَمْتُه شجرةً منفيّة على زجاج الصيرورة…”. وتخاطب الحبيب في “أفعال للصرف”: تَدفَّقْ، فحقلي أملٌ يخمِّرُ بذور الهناء”.
ورأى أن الشاعرة قد استخدمت تقنيات شكلية وأخرى غير شكلية. وفي قصيدة “صرخة حمراء”، وصفٌ دقيق وجوديّ لضحية تحت سيف جلاده، فتقول على لسان الضحية: “مات صوتي، وأسمعُ صراخي يخترق عصب الصخور… في صدري هدير وفي شراييني إعصار، أبكي غياب السماء لا غيابي…” وفي هذه القصيدة استدعاءات كثيرة، تستدعي يوسف وحادثة البئر وخيانة الإخوة “…أسمع وقع الحجارة في بئر يوسف…”، وتستدعي قايين وهابيل وحادثة أول شر وغدر في تاريخ البشرية “…هل قايين يقتلني أو صنفٌ من وحوش القفار؟…”.
ومن الملامح الأخرى التي رصدها حافظ في الديوانين، النسوية. ففي قصيدة “مَن أنا؟” تبرز قيمة المرأة الضائعة في الوطن العربي اجتماعياً ودينياً وبفعل موروث العادات القميئة التي انتشرت بانتشار ثقافة البدو والمجتمعات التي كانت المرأة فيها تباع وتُشترى، مع أن المرأة في أماكن كثيرة من هذه المنطقة وحقب تاريخية بعيدة وقريبة، كانت قدوة ورمزاً، مثل نفرتيتي وحتشبسوت وبلقيس وغيرهن. وفي تحليل تشريحي للقصيدة، رأى أن الشاعرة ترفض اختزال المرأة في جعلها مصدراً للمتعة: “… سِفْرُ التاريخ من أحشائي طالِعٌ، فكيف أرادوني، على ثغر التاريخ، مجرّد قبلة؟” ورأى أن الشاعرة في هذه القصيدة تريد أن تتحول من أنثى لها وضع خاص إلى أنثى شريكة، وأنها هنا تذكِّره بـ”ليليت” التي يقال إنها المرأة التي وجدت قبل حواء ولم ترض بسيطرة آدم عليها فتمردت وهربت منه. وأورَدَ مقتطفات من القصيدة ليبيِّن كيف تصرخ الشاعرة صرخة المرأة التي تريد استرداد حقوقها: “لست تمثالاً بأصابع الشهوة يُلمَس وبغَضبَةِ ذكورةٍ يُكسَر”. وأكد أن قصيدة “من أنا؟” لها مكانة بارزة في هذا الديوان، ولكن الشاعرة لا تناصر قضايا المرأة في هذه القصيدة فقط التي تتناولها مباشرة وبكل وضوح وثورة، بل نستشف مناصرة متوارية للمرأة في معظم القصائد.
وأوضح حافظ أن الشاعرة، في الفصل الذي يحمل عنوان “بوح”، تتحول من النسوية إلى الأنثوية، حيث عبّرت عن ذاتها كأنثى تصف الحبيب بأنه الفجر والغصن وبيت القصيد، الأنثى التي تحتاج إلى الرجل كما يحتاج الرجل إليها. ففي قصيدة “المحور”: “ما نفع ذراعيّ إذا عجزتا عن ضمِّك؟ عينيّ إذا لم تريا وجهك؟ … الحياة إذا لم تتمحور حولك؟”.
وأضاف الشرقاوي أن الشاعرة قد استخدمت ما يسمى oxymoron أو الترادف الخلفي، أي الجمع بين نقيضين في عبارة واحدة، ما يخلق تأثيراً درامياً. هذا الاستخدام شائع في كل القصائد بعبارات مثل: “إيقاع أخرس”، “شرقي الغارب”، “يَحكي صمتُها”… هذه التقنية تعتمد على التضاد الذي يسبغ وجهاً جديداً للمعاني والألفاظ. ويزخر الديوان بالتناسق اللفظي والجناس والصور المجازية. شعرها النثري له وزنه الخاص، ولو جاء الخليل اليوم سيعتبر أن هذا الإيقاع هو بحر جديد من البحور.
واختتم الشرقاوي دراسته قائلًا: “في رأيي أن الترجمة هي أحد مقاييس الشاعرية، وأتصور أن شِعر نهاد الحايك إذا تُرجم إلى لغات أخرى يبقى شعراً. إن نهاد الحايك تكتب بلغة عربية صافية شفافة عالية الجودة. كما أنها أضفت بإلقاء قصائدها النثرية الكثير من الموسيقى والإيقاع. إلقاؤها وجهٌ مشرق جداً لقصيدة النثر، وهو يُغْني عن الكثير من القول والتحليل. لقد أمتعتنا الشاعرة بقراءتنا لشعرها وباستماعنا إلى إلقائها”.

ومن ثم تحدثت أستاذة العلوم اللغوية الدكتورة فاطمة الصعيدي، فوصفت الندوة بما قُدم فيها من مراجعات وما أُلقي بها من قصائد، بـ”ليلة دافئة ننتصر فيها للغة العليا، لغة الشعر”. ولخصت رأيها بنتاج نهاد الحايك من خلال قراءتها لديوان “اعترافات جامحة”. وإذ تناول المتحدثون السابقون جوانب عدة من المضمون والشكل والأفكار، حصرت الدكتورة الصعيدي حديثها بالسِمات الأسلوبية والتداول اللغوي. وقالت: “إن نهاد الحايك صوت مختلف بكل ما تعني كلمة اختلاف. فأنا قرأت عشرات الدواوين ومنها الكثير من الأشعار المترجمة، وأجد أن للشاعرة صوتها المختلف وكلماتها المختلفة. في توطئة الديوان التي تحمل عنوان “الاعتراف الأول”، تطرح تساؤلات عن أهمية الشعر في حياة الإنسان، ولماذا تكتب الشعر، وتحاول أن تجد الجدوى والمبرر لتدعونا إلى القراءة: “ما الجدوى من الكتابة إذا غاب القراء؟”. “الشعر الجميل له القدرة على إضرام الدهشة في حياة قارئه”. “أيُّ تجربة مهما كانت أليمة تصبح ممتعة عندما تمر في مصفاة الشعر”. كل هذا لتبرر لماذا كتبت، رغم أننا لا نحتاج إلى ذلك، ولكن كأنها تقدم لنا مِنَحاً إضافية لقراءة الشعر. وفي نهاية الاعتراف الأول تقول الشاعرة: “كنت أبحث عن شيء يكون أبقى مني، أنا الزائلة التي سيوحِّدها الموت مع عناصر الطبيعة كأي حبة غبار، فوجدتُ الشعر”. بدأت الديوان بــ”رهبة”، حيث نفهم مما تقول، أن الكتابة تسبب الرهبة والشعر يقف بين الصمت والتعبير. ولأن ما سيبقى منها هو الشعر الذي كتبته، تنهي الديوان بـ”غبار” حيث تحسد نخلة الصحراء والشاطئ وهدير الصَدَف، لأنها باقية، أما الشاعرة فليست إلا “غبار، يحوِّم في فلك الأبد”.

وأضافت الدكتورة الصعيدي: “لن أحدد الأسلوب بأنه قصيدة النثر أو الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة أو أي توصيف. ولكن سأذكر سِماته العامة: السمة الأولى هي الحذف. لا تستخدم الشاعرة لغة مجانية وهي تقتصد كثيراً، فنجد أنها أحياناً تحذف الفعل والفاعل وتكتفي بالمفعول به، وأحياناً أخرى تحذف كل أركان الجملة وتحتفي كثيراً بمكملات الجمل كالمضاف والمضاف إليه”.
وقالت الدكتورة الصعيدي: “أنا لا أتغاضى عن سِمة الصور الشعرية التي أسهب الزملاء في الحديث عنها، وأذكر بعد سمة الحذف سمة شعرية أخرى هي التكرار. أستطيع القول إن شعر نهاد الحايك يعتمد على الهندسات الصوتية، وهي تقنية تستخدم في الشعر الإنكليزي. فعندهم مثلاً هندسة الفاتحة أي افتتاح السطور الشعرية بكلمة معيّنة رأسياً، وهندسة الخاتمة أي اختتام السطور بكلمة محددة أو بحرف معيّن، وهندسة المحيط أي أن يكون آخر حرف في السطر هو أول حرف في السطر الذي يليه. أنا وجدت أن الهندسات الصوتية عند نهاد مبنيّة على التكرار، ما يولِّد إيقاعاً معيّنا يؤخَذ القارئ به. من نماذج هذا التكرار المولِّد للإيقاع قصيدة “تَوق”، حيث تكرر عبارة “أتوق إلى… توقَ…” ست مرات، وبشكل رأسي فتعطي نوعاً من الموسيقى العالية جداً. وفي قصيدة “أنتَ وأنا”: “نحلِّق، نبحر، نمشي، نتعثر، نهبط، نطير، نقع، نسير، وراء حلم مسافر”. ثمانية أفعال متتالية من دون كلمات أخرى، كلها تبدأ بحرف النون. ونموذج آخر في قصيدة “أحبكِ” حيث تكرر كلمة “أحبكِ” في مقاطع القصيدة الخمسة، وهي الكلمة التي تحب سماعها من الحبيب.
والملمح الأسلوبي الآخر الذي شخّصته الدكتورة الصعيدي هو التقديم والتأخير. ففي قصيدة “المنفى” تقول الشاعرة “من أقاصي الشوق أناديك”، بدل “أناديك من أقاصي الشوق”. وأيضاً “وحيدةً، أعيش موتي”، بدل “أعيش موتي وحيدةً”، فتخرج من الصياغة العادية إلى أخرى شعرية.
وذكرت أيضاً ملمح الاستدراج، الذي يظهر في استخدام الشاعرة لصيغة الشرط “لو”، مما يخلق جواً من الانتظار وعدم التحقق. “لو أني أعود بعد انطفائي…”
واختتمت الدكتورة فاطمة الصعيدي دراستها بقولها: أعجبتني كثيراً قصيدة “خرز من حروف” التي تبدأ بـــ”كل يوم أخضّ وعاء الأبجدية…” الخض هو عملية يقوم بها سكان الريف في مصر، يخضّون وعاء اللبن (الحليب) لاستخلاص الزبدة أو السمن منه. هذه الحركة القوية، وليس العنيفة، هي حركة مجاهدة للحياة، تدل على الإيجابية التي اتصفت بها الشاعرة رغم كل شيء، فهي أرادت أن تستخرج من وعاء الحروف التي نستخدمها جميعاً، صياغات تتفرد بها، وتصنعها لنا قصائد، بل كما تقول “قلائد”. إنها قصائد/قلائد جميلة. باختصار، شعر نهاد الحايك فيه فكر جميل ولغة راقية، وبالإضافة إلى ذلك أتحفتنا بإلقائها المميز.
__________
- ورشة الزيتون هي ندوة أدبية انطلقت منذ 40 سنة في القاهرة، تعقد أسبوعيًا لمناقشة أعمال إبداعية وبحثية من رواية وقصة وشعر ونقد. أسسها ويشرف عليها الكاتب المصري الكبير شعبان يوسف، ويشارك فيها نخبة من الكتّاب والكاتبات.
- صدر الديوانان عن دار سائر المشرق، بيروت، 2015 و2019.