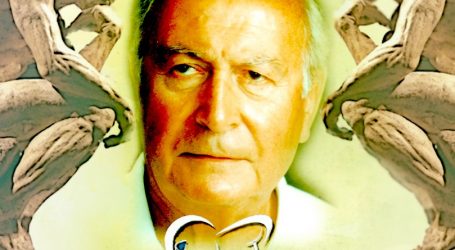مغارة الفقراء
باسم عون
في عصر العولمة هذا حيث اجتاحت التكنولوجيا المسعورة جميع نواحي الحياة ،اندثرت مهنٌ كثيرة ودالت دولة المؤسسات القائم معظمها على المعاملات الورقية والمكتبية ومنها ما راح يعاني سكرات النزع الأخير. ومن بين هذه الأخيرة كانت مكتبة “بو جورج” .
غير أن لأبي جورجِ هذا ابنًا قد علِقَ التكنولوجيا منذ نعومة أظفارهِ فغدا مأخوذاً بكل ما له صلة بالأجهزة الذكية على أنواعها، وبات على غرار أبناء جيله من ملازِمي “المحمول” حتّى لَيُخَيَّل إليك أن انتزاع هذا الشيطان من أياديهم لأصعب بما لا يقاس من انتزاع عظمة من فم كلب.
وهكذا وبإرادة” تكنولوجية” تحولت المكتبة العجوز إلى قسمين إثنين. قسم يعجّ بأجهزة الكومبيوتر لهواة الألعاب الإلكترونية والتواصل والمحادثة، وقسمٌ آخر قد تحوَّل إلى مقهىً صغير تعلوه سقيفة شاء أبو جورج أن يحتفظ على رفوفها – على الرغم من تحفّظ الوريث – بما تبقى له من كتب قديمة طالت عنوستها بانتظار العريس الموعود. وقد جعل فيها طاولتين للقراءة تطلان من عَلُ عبر واجهة زجاجية ، على حركة الشارع. ولقد وجدتُني بطبيعة الحال من روّاد القسم الثاني .
عند العصر، عشيّة الليلة التي سيُولد فيها يسوع، وبعدما فرغت من ابتياع ما تيسر من هدايا العيد، عرَّجْتُ على المقهى. وهناك، وبينا أنا أرتشف القهوة وقد سلب منّي “زوربا اليوناني” كل الحواس، فقطع عني أي “كونِّكشِن” مع العالم الخارجي كما يقول أبناء جيل اليوم ، إذا بي قد استفقت على وقع صراخٍ مستغيثٍ ما لبث أن تحَّول إلى بكاء متقطّع. هبطت الدرج بقفزتين اثنتين فوجدتُني في الخارج وقد التأم روّاد المكان مستطلعين مستفسرين…
أمام واجهة زجاجية تعجّ بالألعاب كان جورج قد استحدثها لمناسبة الأعياد المجيدة ،انطوى طفلٌ على نفسه جاعلاً يديه بين ساقيه كمن يحتفظ بشيء يخشى خسارته.
– ” وحياتك يا ماما ما فينا… كتير غالي… ما معي مصاري”.
راحت الأم تهمس في أذن صغيرها راجية متوسّلة ،غير أنّ الصغير كان قد تشبّث بالحمار الدّمية بيديه الاثنتين رافضاً التخلّي عنه.
وتابعت الأم :
– “بكرا بجبلك غيرو أحسن منّو، اعطيني ياه.”
فانتحب الصغير نابحًا:
-” ما بدي غيرو… الليلي جايي يسوع . كيف بدو يدفا وما عندو حمار ينفّخلو ؟”
– “يا ماما ، يا حبيبي ، في عنا بقرا بتدفّيه.”
فعوى الصغير مجدّداً وهو ممسك بحماره:
– “البقرا اللي عنا مكسورة ما فيها تنفِّخ. بدي الحمار.”
واستمرت المفاوضات الشاقة ولكن دون جدوى . فذكرتُ بالخير المفاوضات والمشاورات فيما بين المسؤولين عندنا عشية تشكيل الحكومة…
إزاء هذا الوضع المتأزّم ودرءًا للفتنة العائلية – وجلُّ الفتن مُسبِّبُها حمار – رأيتُني وقد انتحَيت بجورج “التكنولوجي” على حدة. وبعد مشاورات لا تقلُّ صعوبة عن الأولى ارتضى جورج، وإكراماً لصاحب العيد أن يتقاضى مني أربعين ألفاً من الليرات ثمناً لحماره الـ “كلاس” عوضاً عن الخمسين التي طلبها من الوالدة المنكودة الحظّ قبل اشتداد أزمة الصغير. وهكذا غدا الحمار هديّةً للصغير الذي مسح دموعه ولملم بعضه ولاذ بأمه رافضاً أن يسلّم حماره ليتم تغليفه بورق الهدايا خوفاً من تواطؤٍ مشبوه قد يُطيح بالغنيمة.
وبينما رحت أراقبه يتقافز على الرصيف ذاهباً خلف أمّه، عادت إليَّ صُوَرٌ قديمة عزيزة، خلتُ أن النِّسيان قد طواها الى غير رجعة. بَيْدَ أنَّ هذا الصّبي وحماره قد بعثاها من غياهب الماضي …فإذا بي قد رجعت هناك،هناك حيث نشأت، منذ أكثر من خمسة عقود . وها هي أطياف الذكرى الميلادية الأولى لطفلٍ لمّا يبلغ السابعة من عمره قد بُعِثَت من جديد:
…كانت الساعة قد قاربت الخامسة مساءً عندما أنزلني باص المدرسة مع اثنين من أترابي في ساحة القرية. كانت المدرسة على بعد بضعة عشر كيلومتراً ليس أكثر غير أن العاصفة التي أطبقت على الأرض منذ ما قبل الظهر قد جعلت الطريق في حالة يُرثى لها ، فكان ما كان من التّأخير في موعد الوصول .
وكعادته كان أبي بالانتظار. ولكنّ انتظاره ذلك اليوم كان مشوباً بالقلق ولا سيّما أن الأجهزة الخلويّة لم تكن يومئذٍ سوى حلمٍ بعيدٍ أو مجرّد نُطفةٍ في مخيّلة العلماء ممّن رفدوا العالم بما عهدناه من اختراعات علميّة بغية تحسين ظروف الحياة على سطح الكوكب الصّغير…ولكَم سألت والدي لماذا لم يرسلني الى مدرسة القرية طالما هو من صلب جهازها التعليمي كونه استاذًاً للرياضيات ،غير أن الإجابة لم تكن ذات جدوى.. فتارة يقول إنَّ المستوى التعليمي في مدرسة الراهبات أعلى شأنًا وطورًا يخشى من الدّالّة التي قد يمارسها التلميذ على أساتذته –وهم زملاء والده بطبيعة الحال- مما قد يهدِّد تحصيله العلمي الرّصين…وكان هذا الرأي الأخير سلاح الوالد يرفعه في وجه من يعيب عليه تسجيل ابنه في مدرسة خاصة ما قد يبدو انعدام ثقة بما يعلّمه هو نفسه لتلامذته في مدرسته الرسميّة.
كان بيتنا مرابطاً عند أسفل الرابية التي تتربع عليها القرية، لكأنّه برجُ حراسة أزليّ ابتناه أحد أسلافي المباركين هَهنا على تخوم الوادي السّحيقة. أمّا الدّرب الصّاعد الذي يربطه بساحة القرية فكان أشبه بالزّقاق منه بالطّريق . فإذا ما التهبَ الصيف ،بدا زقاقُنا مُتْرَباً ، مُجللاً بالغبار وقد نتأت حجارة أرضه الترابية فبدت كالعظام في صدر الجائع. أما في الّشتاء فيستحيل إلى سيولٍ زاخرة معربدة من الأوحالِ والحصى. والويل كل الويل لمن زلّت به القدم وسط هذا الخِضَمّ، فإن معموديّة ثانية_وبحسب الطّقس البيزنطيّ _ سوف تكون بانتظاره.
في هذا الجّو العاصف من أواخر أيام كانون ، كان أبي لائذاً بجدارٍ قريب ، ملتفعاً بمعطفٍ سميك من الصّوف وقد انتعل جزمة جلدية عالية تَقيه المياه والوحول. ونظرة سريعة إلى المظلّة فوق رأسه ،أو قُلْ ما تبقّى من مظلّة كانت كافية لإدراك ما كانت عليه العاصفة من الشدّة والجنون .
المطر يتساقط بغزارة ، والغيوم السّوداء المتزاحمة تعلن بأن لا هدنة قريبة ما بين السماء والأرض وعليه فقد بات من العبث الانتظار… وأقدم والدي فحملني إلى صدره ، دافناً إيّاي تحت معطفه السّميك، وراح يهبط في طريق ضاعت معالِمُه فاستحال نهراً صاخباً مولولًا يلتطم بجدران المنازل الحجرية القائمة على ضفتيه.
… ووَصلنا . عندما ولَجْنا الدّار، بدَوْنا كناجِيَيْن من حطام سفينة غدرت بها الأنْواء. وبينما انشغل والدي بإصلاح شأنه ونزع ثيابه المبللة قرب الموقد، هرعتُ إلى الرّكنِ المقابل حيث كانت جدّتي تضع لمساتها الأخيرة على “تحفتها” الميلاديّة.
كانت شجرة جدتي تلك عبارة عن غصن كبير اقتطعه جدّي على مضض من صنوبرة الدّار الكبيرة . وهناك على دَكّةٍ عالية، تعالى الغصن فكاد يلامس جذوع السقف الترابي .وهنا، وهناك على الفروع الخضراء تناثرت نتفٌ صغيرة من القطن الأبيض الناعم تحاكي بياض ثلج “كوانين”. أما الزّينة فقد اقتصرت على بضع صور ملونّة لشيوخٍ قد بلغوا من العمر عتيّاً ، وقد اعتمروا قبعاتٍ بيضاءَ صغيرة من مثل أثوابهم ، فيما تتدلى من رقابهم سلاسل ذهبية تنتهي بصلبان لامعة. ألعلّها مجموعة من “البابا نويل” هذا الكائن المحبوب جالب الهدايا الذي أخبرتنا عنه الراهبة اليوم في المدرسة؟
ولكن والدي قد أردى لي الحلم في مهده عندما أخبرني أنَّ هذه الشخصيات هي صُوَر لباباوات رومية، الجدد منهم والقدماء، وقد اقتطعتها جدتي من بقايا روزنامات رعويّة خلال عقود من الزمن. وإلى جانب الباباوات تسلل بعض صوَر لقدّيسين وقدّيسات عرفت منهم القديسة تريزيا ومار يوسف شفيع قريتنا.
وهكذا بدت شجرة جدتي كَ “السنكسار” الماروني مجسّداً، أو قُلْ كمعرضٍ لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية بأحبارها القديسين من “بولس السادس” ورجوعاً في الزمن حتى لتَكاد اللائحة تلامس “أوربان الثاني “، ذاك الذي – كما قد عرفنا لاحقًا – قد أعلن الحرب الصليبية “المقدسة”.
أما المغارة فكانت عبارة عن حفرة بين أرومتين دهريّتين من حطب السِّنديان قد نُثرتْ بينهما طبقة رقيقة من التِبن ، حيث أُقيمت صورة ملوّنة تمثّل مريم ويوسف والطفل بينهما وخلفهما بضعة خراف. وعلى مقربة، وضعت جدّتي حماراً نحاسياً صغيراً زاعمةً أنّه من سلالة ذاك الذي حمل على ظهره العذراء الحامل بالمخلّص من الناصرة إلى بيت لحم.
ووقفتُ أمام “ملحمة” جدتي الإنجيلية تلك مشدوهاً كما كان يقف فلّاحو القرون الوسطى أمام كنيسة قوطيّة، فيما كانت أمي تسترِقُ النّظر إلى شجرة حماتها محاولةً إخفاء ابتساماتٍ مكتومة. فهي لم تشارك في هذا الإنجاز المبارك ولا سيّما أنّها ما زالت تشعر أنها دخيلة على مملكة الجدّة. ذاك أن والدي بعد أن اختطف عروسه الصغيرة شاء أن يدَّخِرَ بعض المال كي يبني بيته الخاص فآثر السّكنى عند ذويه ريثما يتيسّر له ما أراد . وهكذا أبصرتُ النور في كنف الجدّين الحنونين.
لَسْتُ أعرف ماذا دهاني تلك الليلة… فلئِن كانت الشجرة الميلادية قد خطفت بعض إعجابي فإن الحمار الصغير قد حبس أنفاسي كلّها وطغى على كياني برُمَّتِهِ. كيف لا وهو الذي حمل العذراء وطفلها إلى الملاذ الآمن! حمارٌ معدنيٌّ مجسّم ، يقف على أربع قوائم ، إنها لَبدعة كبرى !
وعندما قَصّت ليَ جدّتي قصّة الميلاد على طريقتها ، ابتداءً بالحبل الإلهيّ مروراً بالنجم الساطع إلى مذود القش، فالمجوس، فمكر هيرودس، فالهروب إلى مصر بعد مذبحة بيت لحم، ازدادت محبتي لحمار الجدّة وأكبَرْتُ فيه مروءَته وتفانيه في خدمة المخلّص . وعندما وضعت أمي مائدة الميلاد تناولت طعامي على عجل رغبة في الجلوس على مقربة من صاحب المروءة.
وعند العاشرة ، بسطت جدّتي فراشها على الأرض قرب الشجرة ونامت. وبعد أن آنستُ منها غطيطاً منتظماً، تسلّلت من حضن أمي -النائمة هي الأخرى – إلى حمار الجدّة فأخفيته في جيبي وطفقت راجعاً إلى فراشي فوضعت صاحبي تحت المخدّة. وكان “الدَّلفُ” يتحلّب من السقف الترابيّ وينساب على “النايلون” فوق سريري فيشكّل خيوطاً صغيرة من المياه ما تلبث أن تنساب على الأرض.
لست أذكرُ متى غفوتُ تلك الليلة أو تفاصيل هذا الكَم الهائل من الأحلام في ربوع بيت لحم ، إنّما ما زلت أذكر جيداً قهقهات جدّي في الصباح حين أخبرتني الجدة بأن يسوع كاد ليموت من البرد ليلة البارحة محرومًا من أنفاس حماره. ثمّ دنا منّي فأعطاني بضع دريهمات وحفنة من الزبيب هامسًا في أذُني :
– “قوم يا جدّي جيب الحمار لسِتّك، قوم. نَقْمِتلي راسي من الصبح . هيدا الحمار جاي معها بجهاز العروس .هيدا أهم من الحمار اللي أخَدِتو”.
وضحك عاليًا، فضحكتُ بدَوري مع أنّني لم أفهم شيئاً. ولكنّني أطَعْتُ خوفاً على طفل المغارة من ليلةِ بردٍ ثانية…
وها آنذا اليوم أتساءل، وبعد مرور كل تلك السنوات: علامَ يُسارع الفقراء لاصطناع مغاور مزيّفة، فيما كانت أكواخهم لتفي بالغرض على أكمل وجه. وهل ثمة من مكانٍ أفضل ليُولدَ فيه ذاك الذي لم يكن له حجرٌ يسند اليه رأسه!
في 25- 12- 2020