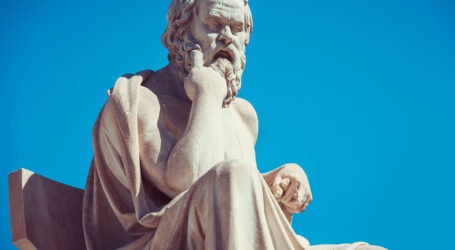بورخيس العدميّ المُستنير.. عن طه حسين وكازنتزاكيس
أحمد فرحات*
هذه هي الحلقة الثانية من حواري المُطوَّل مع الشاعر والقاصّ والأديب المَوسوعيّ الأرجنتينيّ الكبير خورخي لويس بورخيس. وكنتُ قد التقيته في العام 1978 في العاصمة الفرنسيّة باريس، وتحديداً في منزل الصديقة الأرجنتينيّة ليونور غونزاليس الكائن في شارع رينوار في حيّ باريس 16 الأنيق للغاية. وكانت هذه السيّدة المُثقّفة ثقافةً رفيعةً للغاية، قد حوَّلت منزلها الباريسيّ إلى صالونٍ أدبيّ تجتمع فيه نخبةُ نُخَبِ الشعراء والأدباء النّاطقين بالإسبانيّة، سواء أكانوا مُقيمين في باريس أم كانوا على سَفَرٍ محدودٍ إليها.
ولقد نشرتُ الجزء الأوّل من هذا الحوار في دوريّتنا “أُفق” – العدد 69 – حزيران/ يونيو 2017، وفي ما يلي الجزء الثاني من هذا الحوار مع العملاق بورخيس على أن يعقبه أكثر من جزء لاحقاً.
سألتُ بورخيس: أتسمح لي، سيّدي الكبير بالتحدُّث عن العمى، عمى البصر الذي أَطفأ عَينَيْكَ في العام 1955، وهل تراني وقِحاً إذا ما فتحتُ معكَ مثل هذا الموضوع؟
أجابني من فوره، وهو يبتسم ابتسامةً واثقة: أبداً.. أبداً، الأمر لا يُغيِّر شَيئاً من واقع ما أنا فيه، فأنا عشتُ نَهارَ هذا العالَم فترةً من حياتي، وها أنا أعيشُ لَيلَهُ في ما تبقّى لي من حياة (وُلد بورخيس في العام 1899 ومات في العام 1986). هذه هي مُعادَلةُ الطبيعة مع سائر الكائنات، لكنْ صدِّقْني، أَعانني العمى على أن أصير أكثر كشْفاً للإنسان والكائنات والطبيعة من حواليّ. بتُّ أُفكِّر في أسرارها وغموضها المُتغيِّر أكثر ممّا ينبغي؛ وأُفسِّره أو أشرحه بأجلى ممّا ينبغي. كما بتُّ أَستنزِفُ الأيّام أكثر ممّا تَستنزفُني…
قاطَعتُه قائلاً: ثمّة أديبان عربيّان كبيران: الأوّل مصريّ فاقِد البصر، اسمه طه حسين، والثاني لبنانيّ اسمه رئيف خوري، وقد تَناظَرا معاً حول الالتزام في الأدب من عدمه، في الجامعة الأميركيّة في بيروت عام 1958، وقد خَرجا من المُناظَرة، كلّ واحدٍ منهما أكثر إعجاباً بالآخر. ويُروى عن رئيف خوري أنّه قال بُعيد المُناظَرة إنّ صاحب “الأيّام” لم يفقد بصره، بل كلّ ما ماحدثَ معه أنّه تطلَّع إلى الشمس، فأحدثَ ببصرِه حفرةً فيها مزّقتها تمزيقاً…
هنا انتفض بورخيس مُحرِّكاً عصاه، ومُعدِّلاً من جلسته، وصارِخاً بملء الفم: هذا أعظم ما سمعته في حياتي من كلامٍ أدبيّ يَتناول مَوضوعةَ فقدان البصر. نعم، سمعتُ بطه حسين من أصدقاء فرنسيّين مُشترَكين أثقُ بآرائهم وأحكامهم الأدبيّة، لكنّني لم أسمع برئيف خوري، صاحب هذا القول الرائع، فمَن هو يا ترى؟ أجبته:
إنّه واحد من أهمّ مؤسِّسي فنّ القصّة والحكاية عند اللّبنانيّين والعرب جميعاً في الزمن النيو/ كلاسيكي، وهو أيضاً ناقدٌ كبير، ومُفكِّر كبيرٌ، فضلاً عن أنّه أحد أعمق مَن تحدَّث وألَّف عن العرب في التاريخ والأسطورة.
هزّ بورخيس رأسه مُستأنِفاً التعليق على ما قاله رئيف خوري في عمى طه حسين: إنّه قَولٌ لن يغرب عن بالي البتّة ما حييت. لقد شددته إلى أقصى ركنٍ من سِعة الحضور في ذاكرتي. باختصار إنّه قَولٌ سيُلهِب دماغي إلى ما لانهاية.
ثمّ سألتُ بورخيس: مَن يقرأ لك نصوص الأدب والسرديّات على اختلافها الآن؟ فأجاب: أمّي التي عاشت 99 عاماً تولَّت الأمرَ لمدّة طويلة، وكانت مُثقَّفة، وتُجيد اللّغة الإنكليزيّة، ثمّ أختي نورى مع آخرين من مُحيطي القريب والبعيد، وكانوا جميعاً التجسيدَ الحيّ الآخر لفعْل القراءة لديّ.
أختكَ تدعى نورى؟!. أتدري أنّ هذا الاسم هو اسمٌ عربيٌّ بامتياز؟.. أَطرق بورخيس بعض الشيء ثمّ قال: نعم.. نعم أدري ذلك، وكانت أمّي تُناديها أحياناً بتوصيفٍ رائع آخر: “تعالي يا سحابتي البيضاء”؛ ومرّة علَّقت أختي أمامي على هذا التوصيف/ المُناداة بالقول: “ليتني كنتُ بالفعل سحابةً بيضاء تنتقلُ من فضاءٍ إلى فضاء”.. وكان قصدها أن تقول (من وجهة نظري طبعاً): “ليتني كنتُ لمسةَ خُرافةٍ ساحِرة”… وأَردف بورخيس: هكذا، يا صاحبي، كانت تجري الأشياء في عائلتنا وكأنّها آتيةٌ من صباح الآلهة.
أيّ نصوص كنتَ تُحبّ أن تقرأها أكثر من غيرها يا سيّد بورخيس: نصوص الشعر أم نصوص القصّة أم الرواية، عِلماً أنّني مِن الذين لا يؤمنون بالفواصل بين الأشكال الكتابيّة الإبداعيّة على اختلافها؟
أجابني بورخيس: أنا من الذين كرَّسوا وقتهم وحياتهم للقراءة أكثر بكثير من الكتابة، التي كنتُ أملّ منها أحياناً. لَستُ مُبرمَجاً على قراءة قطاعٍ واحدٍ من الأجناس الأدبيّة. تراني أميل أحياناً إلى قراءة اللّاهوتيّات على اختلافها، من قديمة وأَقْدم، وأَجدُ فيها شعريّاتٍ مُكثَّفة ومُحبَّبة لي أكثر بكثير من أيّ نصوصٍ أخرى محسوبة على الشعر. ثمّ إنّ العالَم بأسره عندي هو نصٌّ واحد، ومَن لا يَقرأ الأمور الإبداعيّة على هذه الشاكلة الشاملة يظلّ، من وجهة نظري، شاعراً أو كاتِباً صغيراً، مُقصِّراً إلى ما لا نهاية.
على غرار كثيرين، هل تَدمج يا سيّد بورخيس بين الشعر والفلسفة في كِتاباتك، فالشعر صار سفراً في عتمة الأشياء واستبطاناً فلسفيّاً أو شبه فلسفي للوجود، ولا بدّ، وفاقاً لذلك، من تفسيرٍ أورفيوسيّ للعالَم على حدّ تعبير “مالارميه”..
أجاب: لا أريد، في كلّ كِتاباتي، أن أتشبّه بأحد، لا من قبل ولا من بعد، أطمح في كلّ ما أكتب أن أشبه نفسي.. ونفسي فقط. لكنّني أُحبّ الفلسفة، نعم، وأسعد بها، وتراني أكتب بغير وعي منّي شعراً أو سرديّات أخرى تتضمّن تساؤلاتٍ وأخلاطاً فلسفيّة شتّى، أكتشفها لاحقاً مثلي مثل أيّ قارىء حاذِق لنصوصي.
ثمّ خاطَبتُ بورخيس بصيغةٍ مُتسائِلة: قالت لي صديقتنا الأرجنتينيّة المُشترَكة ليونور غونزاليس إنّك مُقِلٌّ في قراءة الرواية عموماً، فكيف يحدث ذلك، وأنتَ على حدّ قولك (قبل قليل) تَعشق القراءة أكثر ممّا تعشق الكتابة؟
– نعم، هذا صحيح؛ فأنا على مَدار حياتي لم أقرأ إلّا رواياتٍ معدودات. لكنْ، مع شيءٍ من حُسن الاختيار والتقدير العالي لقراءات أخرى لا تحصى مَدياتها النصيّة الإبداعيّة غير الروائيّة، جعلتُ وأجعلُ العالَمَ كلّه من مُمتلكاتي الخاصّة.. والخاصّة جدّاً. وبقدر ما يكون الكاتِب أو الشاعر رشيقاً رفيعاً في قراءاته وكِتاباته، يكون مُشعّاً بتأثيره وضرباته، فهذا العالَم يستحقّ منّا أن نعرفه، ولكنْ دائماً بعُمقٍ خاطِف ونافِذٍ لكلّ مرئيّاته.
هل أفهم، سيّدي، أنّك تُمعن في تكسير الزمن إلى وحداتٍ سرديّة مُتعدِّدة الأحجام والزوايا حتّى يسهل عليك أمر “القبض الإبداعي” على أكبر قدر من مُحرّضاتها وعُمق تحدّياتها؟
أجاب بورخيس: الكِتابة عندي هي دائماً الحرب المُستحيلة على الأرض المُستحيلة. نعم، لي حُريّة الكتابة بلا شروط، ولكَ أنتَ، أو لأيّ قارىء غيرك، التأويل والحلّ والرّبط. نعم، الزمن عندي هو تحوُّلٌ لا يعرف التوقّف أو الثبات، كما قد يُعرف أحياناً، وبحسب ما أُريد، الحدود والانضغاط القصووي، ومثله الكتابة أيضاً، هي شيء أشبه بالحواس الحرّة والمُنضغِطة في آن.
ومَن هو كاتِبكَ الأدبيّ المُفضَّل في الرواية والقصّة، يا سيّد بورخيس؟
هنا أخذَ الرجلُ ذو الطلعة الكاريزميّة الأسطوريّة المُجلَّلة بالعمى رشفةً من فنجان الشاي الساخن بيدَيْن اثنتَيْن مُرتجفتَيْن، ثمّ قال: في طليعة الروائيّين عندي هو جوزيف كونراد، هذا البحّار الغرائبي الذي مَنحه البحر الشيّق والشاقّ قدر ما يتحمّل أُفقه من مُغامرات ومُفاجآت، فسجَّل أغلب رواياته بوحيٍ من تجربته المهنيّة كبحّار عاديّ، ثم كقبطان يقود السفنَ بخِبرة مَن يَمتلك شدّ الأمواج والتحكُّم فيها من جهة، ومهارة الصراع على امتلاك الهواء المُحيط به من جهة أخرى. وأكثر الأمكنة البحريّة التي كانت تشغف لبّ كونراد، وأقام فيها لسنواتٍ طويلة كانت مدينة مرسيليا، ثمّ جزيرة كورسيكا التي وَصَفها “بالخضراء التي تلمع في العَينَيْن وفي القلب دفعة واحدة”.
ومن بين روايات كونراد الأحبّ عندي رواية: “تحت عَيْنٍ غريبة”، ورواية: “قلب الظلام”. كما أنّ قصص كونراد القصيرة، هي مثل رواياته عابقة بالشعريّة التي تفرض عليك طغيانها الحيوي المُمتع الجذّاب.
كازنتزاكيس بين شمسَيْن
كما أحبّ أن أجول في العالَم الإبداعي لنيكوس كازانتزاكيس، هذا “القدّيس الزنديق” الذي قرأتُ على هامش رواياته، نصوصاً رائعة تنتمي إلى أدب الرحلات، سجَّلها في أثناء رحلة تاريخيّة له إلى البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، عرفَ خلالها كيف يَمتلك الفرح الصوفي للصحراء العربيّة، وعبر طموحٍ نَجَحَ خلاله في إقامة ذلكم التناغُم الخصوصي العالي بين كيانه وكيان الصحراء المُقدَّس والفسيح.
كما نجح كازنتزاكيس في تأهيل رواياته بالشعريّة المؤكِّدة على استعادة أرض اليونان المنشودة، وشعبها المنشود، مُضافاً إليهم شعوب الرومان والنورمان وقبلهما العرب وبعدهم جميعاً، الترك العثمانيّون على أرض وطنه جزيرة كريت اليونانيّة التي رفع من مَكانتها التاريخيّة والحضاريّة حين قال في روايته “الحريّة أو الموت” إنّ كريت لا تحتاج إلى أرباب عوائل وبيوت، بل تحتاج إلى مجانين يُخلِّدون ذكراها على الدوام. وكم لفتَ انتباهي في رحلته إلى اليابان حين قال لأحد الصحافيّين ردّاً عن سؤالٍ يتعلّق بزيارته الأولى لتلك البلاد: “جئتُ اليابان لأتفقّد أحوال شمسكم العظيمة، وأُقارِن بينها وبين شمس اليونان العظيمة أيضاً؛ وكان أن وجدتُ أنّ شمسكم تُقدِّم لكلِّ مَن يَجتمع تحتها دروساً مُوجِبة للتواضُع، بينما شمسنا تؤجِّج إيقاعاتٍ داخليّة تتلاقى وتتفرَّق، في ذاتها، وفينا أيضاً، من دون أن تعطينا أيّ درس يذكر”.
وأيّ الدروس، يا ترى، كان يَنتظرها كازنتزاكيس من شمس اليونان بحسب رأيك؟
لو كان كازانتزاكيس لا يزال حيّاً لكنتُ ضممتُ سؤالكَ إلى سؤالٍ لي مُشابِه وطرحتهما في سؤال واحد مركّب عليه.. أجابني بورخيس وأردف: على أنّني سأضع نفسي محلّ أندراوس، أحد أبطال روايته “الإخوة الأعداء” وأجيب باسمه بأنّ شمس اليونان الحضاريّة مُعطَّلة اليوم، أو هي في أحسن الأحوال تجترّ نفسها وتُراوِح مَكانَها بلا طائل، وهذا بدَوره يدفع إلى ضرورة التحرُّك بهدف التحرُّر من مَباذل هذا الواقع الفكريّ والفلسفيّ المُتدهور في يونان اليوم.
وعلى أندراوس أن يَعلم بعد، أنّ العالَم يُخلق ويتجدّد كلّ يوم، وأنّ شمس اليونان كي تقوم وتنجلي ثانية، فعلى المنصّة الأرضيّة أن تنشدّ هيَ إليها، وتُحرِّكها لتتكامل معها في الإشراق.
كما على أندراوس أن يتذكّر أيضاً أنّ الإسكندر العظيم قال لليونانيّين القدامى إنّه يُفضِّل أن ينتصر بالعِلم والمَعرِفة والفلسفة على الانتصار في الحرب.
تَعرف سيّد بورخيس أنّ كازنتزاكيس تعرَّض للاضطّهاد الشديد من سلطة السياسة وسلطة الدّين في مُجتمعه. لقد رفضَ الطرفان حتّى دفنه في أثينا، فكان أن دُفن في مسقط رأسه جزيرة كريت، وبالقرب من عاصمتها التاريخيّة “كانديا” أو “الخندق”، المدينة التي بناها عرب الأندلس الذين حكموا كريت 140 عاماً (غيَّر اسمها يونانيّو اليوم إلى هيراكليون)، وبالتالي هو كان حانقاً على يونان الحاضر التي رآها مُتخلّفة جدّاً عن يونان الأمس البعيد، الذي تغنّى فيه كازنزاكيس شِعراً، وكَتَبَ مَلحمةً شعريّة تألَّفت من 33.333 ألف بيت، بدأها من حيث انتهت أوديسة هوميروس، فلُقّب بعدها بـ”هوميروس الجديد” ..
وقبل أن أستطرد أكثر بالكلام، قاطَعني بورخيس قائلاً: كلامك صحيح.. نعم صحيح، ثمّة سلطة سياسيّة – كَنسيّة واحدة اتّفقت على كازنتزاكيس، هذا اليوناني العظيم، الذي يُذكّرني بسَلفِه القديم، الشاعر اليوناني الكبير بنداروس، الذي كان الإسكندر الأكبر يحترمه ويَخضع لسلطته الرمزيّة والإبداعيّة، مع الفريق الديني المقرَّب منه. وقد أوصى الإسكندر المقدوني جنوده أن يبتعدوا عن مَنزل الشاعر بندار تقديراً واحتراماً، لأنّ مَنازل الشعراء والفلاسفة هي عنده من أكرم المنازل. وقيل إنّه أوصى بضرورة حراسة بَيت بنداروس من عَبَثِ العابثين.
كان كازنتزاكيس، وعلى طريقته الخاصّة، يتدثّر بالأسرار، ويسعى في الوقت عَينه إلى فضْح ما يَستتر وراء المَرئي، طَمَعاً في سَفَرٍ جديد وغير محدود. وأَثبت أكثر من مرّة، وخصوصاً في قصائده الإنشاديّة على طريقة هوميروس، أنّ الشعر يستطيع، وبكلّ جدارة، أن يحلّ محلّ الحقيقة الغائبة. وبالمُناسَبة قرأتُ “إلياذة” كازنتزاكيس وخلصتُ منها بهذه العبارة/ الدرْس: ما أشدّ انتصار الموت على الحياة، وما أضعف الموت أمام حالة اليأس به، فاليأس هو الحقيقة.
وهل قرأتَ “الأوديسة” الأولى، ملحمة هوميروس الخالِدة؟
ينتفض هنا بورخيس كمَن أصابه مسٌّ بإهانة كبرى نتيجة سماعه سؤالاً كهذا، ويصرخ بغضب: ما هذا؟!! أوَ يُعقل أن تسألني مثل هذا السؤال؟!!.. أوَ يُعقل؟!! ما هذا؟!!.. نعم قرأتها وأكثر من مرّة.. كيف لا وهي التي أسّستْ للأدب العالَمي برمّته، وجعَلت الكِبارَ يحذون حذوها في كِتابة المَلاحِم: فرجيل، دانتي، ميلتون. كما أنّ قصّة حرب طروادة التي دارت على ألسنة الكثيرين من سائر شعوب الأرض، ومنذ قرون طويلة إلى اليوم، كانت بسبب “الإلياذة”. إنّها مَلحمة فلسفة القوّة، وتحالُف أهل القوّة من كلّ المُدن الإغريقيّة على طروادة المدينة التي صدّت وبقوّة، وعلى مدى عشر سنوات مُتوالية، هجمات “الإخوة الأعداء” وانتهت بهزيمتها وإحراق كلّ مَعالمها.
وأهمّ ما في هوميروس، شاعر الإلياذة، هو أنّه شاعر مشكوك في وجوده، وأنا أرغب، بل أطمح أن يكون مشكوكاً بوجودي، غداً أو بعد قرون، سواء بسواء.
***
(*) مؤسّسة الفكر العربي
(*) نشرة أفق