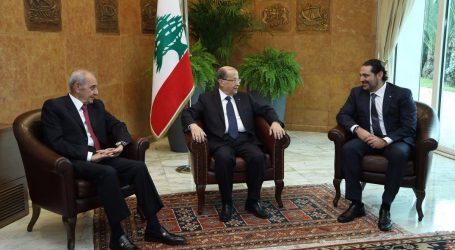جائحة “كورونا” ومُستقبل النّظام الدّوليّ
د. إدريس لكريني*
على امتداد التاريخ الحديث للعلاقات الدوليّة، اقترنت الكثير من التحوّلات الهامّة والإنجازات الكبرى التي شهدها العالَم، بأزماتٍ وحروبٍ وأوبئة وكوارث خَطِرة، مثّلت حافزاً لاستخلاص الدروس من الأخطاء والهفوات، ولإعادة النَّظر في السياسات والأولويّات، وإحداث مجموعة من المؤسّسات والقواعد التي كان لها أثرٌ مُهمّ على تطوّر النِّظام الدوليّ برمّته..
فقد تلا نهاية الحرب العالَميّة الأولى إنشاء عصبة الأُمم التي أَعطت دفعةً حقيقيّةً للتنظيم الدولي، فيما أَعقبَ، في نهاية الحرب العالَميّة الثانية التي خلَّفت خسائر عظمى في الأرواح والمُمتلكات والبيئة..، تأسيسُ هَيئة الأُمم المُتّحدة، التي أَرست مجموعةً من المَبادئ المهمّة كمنْع التدخُّل، والتأكيد على المُساواة في السيادة بين الدول، وعلى السُّبل الوديّة في تسوية المُنازعات، وجَعلت من حفْظ السِّلم والأمن الدوليَّيْن ونبْذ الحروب أحد أهمّ أولويّاتها.
وفي بداية التسعينيّات من القرن الماضي، انهار الاتّحاد السوفييتي، وانتهت مرحلة الحرب الباردة بصراعاتها المُكلِفة، ما مهّد لأحداثٍ وتطوّراتٍ كبرى، بدأت بحرب الخليج الثانية، وتمدُّد العَوْلَمة، وتنامي البُعد الاقتصادي في العلاقات الدوليّة، وبروز مَعالِم “نظام دوليّ جديد” قادته الولاياتُ المُتّحدة الأميركيّة.
منذ تفجُّر الأزمة التي أَحدثَها انتشار فيروس كوفيد 19، على امتداد مناطق مُختلفة من العالَم، وتفاقُم تداعياته وتسارُعها على المستويات الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، تناسلت الكثير من الأسئلة بصدد الإشكالات الاستراتيجيّة التي سيُخلِّفها، وحول مُستقبل النِّظام الدولي، بعدما ظهرت القوى الدوليّة الكبرى كالولايات المُتّحدة الأميركيّة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.. مُرتبِكةً بشكل واضح، في تعاطيها مع تطوّرات الفيروس، ما خلَّف خسائر جسيمة في الأرواح والمَصالِح الاقتصاديّة.
فتحَ الوباءُ البابَ لإعادة تشكيل مفهوم السِّلم والأمن الدوليَّين، بعدما ظلَّ لعقودٍ طويلة مُقترناً بغياب التهديدات العسكريّة، لينفتح بذلك على مَخاطر جديدة عابِرة للحدود، تَفرض تغيير الأسلحة، وإعادة النَّظر في أدوات المُواجَهة، وباتّجاه تبنّي آليّاتٍ استراتيجيّة، مع إعادة النَّظر في النُّظم التقليديّة لإدارة الأزمات..
أظهرت الجائحةُ وجودَ حسٍّ ضعيف من التضامُن الدوليّ، بعدما طغت المُقاربات السياديّة على حساب التنسيق الدولي للسيطرة على الوضع، على الرّغم من أنّ الأمرَ يتعلَّق بخطرٍ لا يعترف بالحدود السياسيّة، ولا يُمكن لأيّ إجراءٍ داخلي كيفما كان نوعه، أن يَكسب رهان مُحاصرَته، إذا لم يكُن مقروناً بتدابير مُوازية في إطارٍ من التعاوُن والتنسيق العالميَّين.
كَشفت الجائحةُ أيضاً أنّ العالَم بمؤسّساته وضوابطه القانونيّة والاتّفاقيّة، لم يكُن مُستعدّاً وعلى قدرٍ من الجاهزيّة بما يكفي، لمُواجَهة خطرٍ حقيقيٍّ وداهِمٍ عابِر للحدود، ويتعلَّق الأمر بالأمراض الخطرة. بل إنّ مُنظّمة الصحّة العالَميّة نفسها، بَدت مُرتبِكة وعاجِزة تماماً في هذا السياق، ما عرَّضها لانتقاداتٍ كثيرة، باعتبارها لم تتحمَّل المسؤوليّةَ في تحذيرِ دُول العالَم من الخطر قبل تمدُّدِه وتصاعُدِه، كما أنّها لم تُسهِم في بلْورة خطّة عالَميّة مُوحّدة وناجِعة لمُواجَهة الفيروس.
أمّا مجلس الأمن، واعتباره المسؤول الرئيس عن حفْظ السِّلم والأمن الدوليَّين، والذي لطالما اتَّخذ قراراتٍ صارِمة بصدد قضايا غير ذات أهميّة أو أقلّ خطورة، فلَم يتّخذ قراراتٍ في مستوى التحدّيات الكبرى التي باتت تُفرزها الجائحة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى دول الاتّحاد الأوروبي، وعلى الرّغم من المُكتسبات التي حقّقتها هذه الأخيرة، في ما يتعلّق بإرساء نظامٍ إقليمي مُتطوِّر، ومُتشابِك بعددٍ من الاتّفاقيّات، والمُعاهدات، والمؤسّسات الوازِنة التي تُجسِّد العمل المُشترَك، والاندماج على مُستوياتٍ عدّة، فإنّ محكّ تدبير الجائحة كشفَ عن تفضيلِ عددٍ من دول الاتّحاد اعتماد مُقارباتٍ انفراديّة، وتدابير أحاديّة واضحة في التعاطي مع الموضوع، تباينت من حيث سرعتها وصرامتها ونجاعتها من بلدٍ إلى آخر؛ حيث اتَّخذت بعض دُول الاتّحاد تدابير استثنائيّة، كألمانيا التي اعتمدت قراراً يقضي بمنْع تصدير مجموعة من الآليّات والأدوات المتّصلة بالوقاية الطّبيّة نحو الخارج إلّا في حدودٍ ضيّقة جدّاً.
وأمام تفاقُم الوضْع، وتمدُّد الوباء، طالبت الدّول الأكثر تضرّراً، وبخاصّة منها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، دُولَ الاتّحاد بالمُوافقة على إصدار “سندات كورونا”، للإسهام في توفير التمويل الكفيل بالحدّ من التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي خلّفتها الجائحة داخل هذه البلدان، وهو ما أثار حفيظة عدد من النُّخب السياسيّة في أوساط مجموعة من الدول الأعضاء.
وعلى الرّغم من قيام مفوّضيّة الاتّحاد الأوروبي بإنشاء صندوقٍ للتضامُن من أجل أزمة كورونا، لتقديم الدعم للدول الأكثر تضرُّراً من الوباء، ومُحاولات التقليل من أهميّة اعتماد سياسات داخليّة مُتبايِنة، تحت هول الكارثة وتسارُع تداعياتها على الأرض، كَشفت هذه الأخيرة عدم نجاعة المنظومة الأوروبيّة في تدبير الكوارث العابرة للحدود.
فبعد الارتباكات التي خلّفها تنامي الهجرة السريّة نحو بلدان الاتّحاد، وما رافقَ ذلك من تبايُنٍ صارِخ للمَواقف والسياسات المُعتمَدة، والتي غلبَ عليها الطابع الأمني السّيادي، على حساب الاعتبارات الإنسانيّة والتضامنيّة، لم يُخفِ الكثير من الباحثين والسياسيّين تخوّفاتِهم الجديّة من أن تفضي الانعكاسات السلبيّة للوباء إلى تقويض مؤسّسات الاتّحاد، مع استمرار تمدُّد الفيروس. وهو ما نبَّهت له المُستشارة الألمانيّة “أنجيلا ميركل”، عندما اعتبرت أنّ فيروس “كورونا” المُستجِدّ يُمثِّل أكبر اختبار للاتّحاد الأوروبي منذ تأسيسه.
يبدو أنّ الاتّحاد استوعبَ الدّرسَ مُتأخّراً، وما فتئ يتدارك الأمر من خلال اعتماد سياسات تضامنيّة، من خلال تقديم الدعم للدّول الأعضاء الأكثر تضرّراً، وتنسيق الجهود العِلميّة الرامية إلى إيجاد أدوية ولقاحات لأجل القضاء على الفيروس.
لم تَحِل الإمكانات الاقتصاديّة والعسكريّة والتكنولوجيّة التي تمتلكها الولايات المُتّحدة الأميركيّة، دون انتشار فيروس كوفيد 19 داخل البلاد، بصورة أضحت معها أكبر مُتضرِّرٍ على المستوى الدولي من حيث الإصابات وعدد الوفيّات. فيما استطاعت الصين أن تتجاوز الخطر بفعل اتّخاذ تدابير صارمة، كما نجحت في تحويل الكارثة إلى فرصة مع اعتماد دبلوماسيّة المُساعدات التقنيّة والإنسانيّة، والترويج لإمكانيّاتها وقدراتها كقُطبٍ دولي وازِن.
تُمثّل الجائحة، على قساوتها وتداعياتها الصعبة، فرصةً لاستخلاص كثيرٍ من الدروس، على المُستويات الوطنيّة، وكذا الدوليّة. فقد آن الأوان للنظر إلى السِّلم والأمن الدوليَّين من منظورٍ استراتيجي وشامل، كما أصبح من اللّازم أيضاً إعادة النَّظر في الآليّات الدوليّة لإدارة الأزمات وتدبير الكوارث، فيما أضحى جليّاً أنّ العالَم عاشَ لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن على وَهْمِ نِظامٍ دوليّ “عادل وكفيل بتحقيق السلام العالَمي”، كما بشّر بذلك الرئيس الأميركي الأسبق “جورج بوش” الأبّ، مع استمرار التجاوزات والنِّزاعات، ومع انكفاء عددٍ من البلدان على ذاتها، وخفوت بريق العَوْلَمة، بفعل وطأة الجمود الذي أصاب الاقتصاد العالَمي تحت ضغط الوباء.
يبدو أنّ العالَم أمام مُفترق طُرقٍ، وبخيارَين مفصليّين، الأوّل يُحيل إلى المزيد من انكفاء الدول على نفسها، والتعاطي مع الجائحة وتداعياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنفسيّة المستقبليّة، ومع مختلف الإشكالات العابرة للحدود بشكلٍ فردي، مع ما سيترتَّب عن ذلك من مَيلٍ نحو إثارة الفوضى، ومُحاولاتٍ لتصدير الأزمات، وتراجُعِ منسوب الاعتماد المُتبادَل، بما سيُعمِّق الوضعَ القائم، ويفرز أزماتٍ فرعيّة، تُرهِقُ كاهلَ الدول، ومُختلف المؤسّسات العالَميّة، ما قد يؤدّي إلى انهيارها – أي المؤسّسات – تماماً.
أمّا الثاني، وهو الخيار الأكثر احتمالاً للوقوع، فيتّصل بتوجُّه الدول نحو مَزيدٍ من التضامُن والتنسيق للتصدّي للجائحة، ومُختلف المَخاطر والتحدّيات التي تُواجِه العالَم بأسره، كما هو الأمر بالنسبة إلى تلوّث البيئة، والإرهاب، والجرائم الرقميّة، والأمراض الخطرة المُتنقّلة، وذلك تحت ضغط توجّهات الرأي العامّ الذي أصبح أكثر وعياً من ذي قبل بهذه التحدّيات، وبضرورة تجنيد الجهود الدوليّة لعَقْلَنَتها ومُواجهتها، وتفعيل أداء المؤسّسات الدوليّة في هذا الصدد، ما سينعكس بالإيجاب على أداء هذه الأخيرة، وفي مقدّمتها الأُمم المُتّحدة ووكالاتها المُختلفة في هذا الخصوص.
تَبرز الكثيرُ من المُعطيات والمؤشّرات التي تشير إلى أنّ منطق الأحاديّة القطبيّة الأميركيّة بدأ بالتراجُع منذ سنوات. وظهرَ بصورة ملحوظة مع هذه الجائحة، اتّجاهٌ نحو بلْورة نظام ستلعب فيه الصين أدواراً طلائعيّة على المستويات الاقتصاديّة والاستراتيجيّة. فهذه الأخيرة تملك كلّ المُقوّمات التي تُؤهّلها لأداء هذا الدَّور، حيث بدت مُصرّة في الآونة الأخيرة على إبراز قدراتها على هذا المستوى، عبر تحريك آليّة المُساعدات الإنسانيّة والطبيّة التي أضحت أكثر ديناميّة مع الجائحة.
لا نعتقد أنّ التمدُّد الصيني الرّاهن من شأنه أن يزيح الولايات المُتّحدة عن مَكانتها. فهذه الأخيرة ما زالت تملك كلّ المقوّمات التي تُعزِّز ريادتها وحضورها الدوليَّين، لكنّ الرغبة الصّينيّة المقرونة بإنجازاتٍ اقتصاديّة واعِدة، ودبلوماسيّة مُتوازِنة، فضلاً عن تصاعُد الدَّور الروسي على المستويَيْن الإقليمي والدولي، بعد سنواتٍ من الانكباب على إصلاح البيت الداخلي، ثمّ رغبة دول الاتّحاد الأوروبي في إرساء نظامٍ مُستقلٍّ عن الهَيْمَنة الأميركيّة، على المُستويَيْن الاقتصادي والأمني، فضلاً عن الاستياء الدولي الكبير من “النظام” الذي فرضته الولايات المُتّحدة الأميركيّة منذ مطلع التسعينيّات من القرن الماضي، هي كلّها مُعطيات واقعيّة تُشير إلى اقتراب حدوث تغيّرات في أركان النّظام العالَمي القائم، باتّجاه تعدُّديّة تلعب فيها الولايات المتّحدة دَوراً وازِناً إلى جانب قوى دوليّة أخرى كالصّين وروسيا والاتّحاد الأوروبي.
***
(*) أكاديمي وكاتب من المغرب
(*) مؤسسة الفكر العربي-نشرة افق