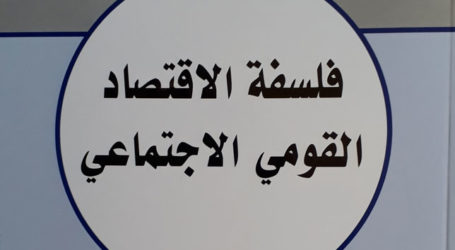المعلم علي زيعور يصوغ التاريخ من نافذة الذاكرة الفردية
زينب اسماعيل
“تدوين التاريخ بواسطة التحليل الذاتي والسيرة الشخصية”، هو كتاب شاهق ممتلئ بالذاكرة الفردية والجماعية، الكتاب الصادر عن مؤسسة الانتشار العربي، يمتد على مدى خمسة أبواب وما يتشعب منها من فصول وأقسام متنوعة، يلج منها المعلم علي زيعور لمعالجة تجربة العقل الأكاديمي منذ العام 1950 وحتى العام 2015، ويُطلق مبادرته المعروفة بالمشروع العربي في أنسنة العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وحين يؤرخ الذكريات الفردية والجماعية، يعمل على تحليلها، ثم يضعها بين يدي القارئ ، كمواد نافعة ومُعبّرة، مشيرًا إلى أنّ أكبر أخطاء صاحب السيرة الجامعية للذات العربية، هو أنه أحيانًا لا يعيّن تاريخ الحدث فيترك المجال للمحجوب والغائر والمنسي والمُهمل. واصفًا الإغفال المُتعمد لزمان ومكان الأحداث الواردة المسكوبة المؤرخة ب “المرذولات” .
تشكل الإبانة مدخلًا ذكيًا لمتن الكتاب يلج من خلالها إلى رحلة الذكريات بشغف، تُعين القارئ على تشريح وترسيخ الفهم الواسع لميدان علم السيرة الذاتية داخل المشروع العربي في أنسنة العلوم الإنسانية والمجتمعية، وبخاصة على المقارنة بين السيرة للفرد والتأرخة للمجتمع والجماعة والفكر، والعلاقة بين الطرفين هي علاقة متناضحة ومتكاملة مع كتابة التاريخ ككل، فالسيرة سواء أكانت تجربة شخصية أو شعبية أو تحليلية، تبقى بحسب المعلم زيعور، تأرخة عامة وشمّالة إجتماعية وفكرية
وقبل الدخول في قراءة متن الكتاب يلحظ القارئ أنّ ثمة علاقة وطيدة ذات بعد سيميائي بين العنوان الرئيس للكتاب الموسوم بـ ” تدوين التاريخ بواسطة التحليل الذاتي والسيرة الشخصية” وبين التقسيمات التي اعتمدها الكاتب في توزيعه للأبواب والفصول والأقسام وما يتفرع عنها من عناوين فرعية، والعنوان هو العتبة النصية الكاشفة عن مكنونات المتن النصي وبعده الدلالي، ولأنّ الدخول في سبر أغوار الذاكرة الفردية والجماعية يتخذ صفة تحليلية علمية عميقة، تستدعي الاستغراق في تشعبات الذاكرة وامتداداتها الأفقية لسبرالأغوار وكشف المطمورات الثاوية في طيات الذاكرة العميقة، فقد بدا لافتًا كثافة العناوين الرئيسة والأبواب والفصول ثم الأقسام التي تليها وما يتفرع عنها من عتبات نصية متشعبة بشكل أفقي، تتوافق وتتجانس دلاليًا ومقتضيات تشعب الذكريات، وامتدادها الأفقي في أغوار النفس.
في الباب الأول المعنون بـ “الحواري والصدامي في داخل مشكلات الصراطي مع المنشق”، يتحدث المعلم زيعور عن ذكريات القطاع الجامعي داخل قطاعات السيرة الذاتية، فيروي اهتماماته المُبكرة بعالم الفن والتلحين السماعي لمقطوعات شعرية شعبية كان يكتبها بنفسه، واختلافه مع واصف بارودي حول فلسفة التربية، ثم عثوره في طيات أوراقه القديمة العائدة إلى ما قبل السبعينيات على عدد من اللوحات الرقشية والإسلامية وكتابات فنية، وفي سياق آخر ينتقل للحديث عن رؤيته التحليلية وتفسيراته التاريخية والسياسية للمذهب الدرزي، فيرى أنّ أهل التوحيد فرقة صوفية إسلامية، إسماعيلية قرمطية، شيعية مغالية غير متمسكة حرفيًا بالكتاب والسنّة، مجافية أو بعيدة عن المذهب الجعفري الصادقي وهو السُّني الصراطي، ومع هذا الاختلاف ينفتح المذهب الدرزي، بحسب زيعور، عميقًا على البعد العرفاني والتصوف، من هنا، أطلق المعلم زيعور على الفرقة التوحيدية الدرزية تسمية الفرقة العرفانية، وقد بدت من خلال تحليلاته، أنها فكر صوفي أنتجه تفاعل اللاهوت الإسلامي مع تأثيرات حضارية عالمية (هندية، أفلاطونية محدثة، هرمسية، غنوصية، فارسية قديمة) هذه الرؤية التحليلية للمعلم زيعور دفعت بكمال جنبلاط إلى التزام الموقف السكوتي إذا صح التعبير، فيما يشبه الاختلاف في الرؤية والتفسير.
ينتقل بعدها للحديث عن المتحف الشعبي في بلدته عرب صاليم، البيت الريفي قبيل اجتياحه بالكهرباء والأثاث المديني، دارسًا تأثير الكهرباء والكنباية أو قنينة الغاز والكرسي أو التخت والزيّ العالمي، من أجل التحليل النفسي الانُثربولوجي للعادات والاحتفالات وقطاعات اللاوعي الجماعي والثقافي العربي بغية صون تلك الحافظة – الذاكرة الجماعية الشعبية التراثية التقليدية، وقد وصف الحافظة أو الذاكرة الشعبية في قطاعات الغناء والفنون الفولكلورية بالملحمة الشعرية التي تروي مراحل كفاح قرية، كان قد بدأ كفاحها ضد الظلم في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى حيث عرفت القرية حينها هجرة أعداد قليلة من شبابها.
بعض الموضوعات المحورية عند المعلم زيعور تدور حول نقاط نفسية وإناسية وألسنية قادت إلى قوله بمدرسة عربية راهنة ومتميزة في الفلسفة والتحليل النفسي والعلوم الإنسانية كافة، فمن تلك الموضوعات (الثيمات): مشاعر النقص عند بعض الفلاسفة والشخصيات التاريخية آمثال: (آدلر فرويد كانط نيتشة) في كتابه الموسوم ب “مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية”، ثم دراسته للسيرة الذاتية عند محمد عبده الأفغاني، العقاد، طه حسين، فضلًا عن تعقّبه للصحة النفسية وعصاب الارتياب عند ابن رشد الغزالي ابن خلدون وغيرهم. وقد تمحورت قراءاته حول الموضوعات (التحليلانفسية) والنفسية العيادية والإناسية والألسنية، فانكبّ على القراءة النفسانية للفلسفة الإسلامية بعامة وبخاصة القطاع النفساني داخل الفلسفة، ثم على العقليات في تحليلاته وعلم النفس المعرفي متأثرًا بالفيلسوف بياجية، فبرزت له مصطلحات خاصة به، نحتها ببراعة، منها “اللاوعي الثقافي الإناسي”، اهتم بتعميق فهمه وتصوراته للتحليل النفسي بحسب الفكرأو المدرسة العربية، وقد صدرت أفكاره الجديدة والمُجدِّدة بعناوين شديدة الإفصاح والطموح منها علم السيرة الذاتية، علوم اللاوعي الثقافي كعلم المقدس، الحلميات، الرمّازة الأسطوريات وغيرها .

الغوص في التجربة الناصرية
يفتح المعلم علي زيعور باب الذكريات على قطار التجربة الناصرية مع المذهبيات، يسرد للدراسات التي أنجزها في هذا المجال منها دراسة ميدانية غير منشورة بالفرنسية للفهم الجديد عند الشباب أو لتغيّرات تصوراتهم حول معتقداتهم الفرعية والصياغة الإحصافية لنظرية الإمام جعفر الصادق في الأولوهية والحب المحب، في المعراج العرفاني في التأويلاتية داخل الفلسفة العربية الإسلامية، وهي هنا ذكريات فرد ومجتمع ووطن وأمة. فما يحدث مع الفرد من ظواهر يحدث مع الكل ومع الروح الجماعية.
البعد الإناسي في الخصوصيات المذهبية هو ما ينبغي أن نُشدّد عليه، يقول المعلم زيعور، وإعادة القراءة للتاريخ والمستقبل هي النقطة المركزية الأشد تأثيرًا في صوغ المفردات ونحتها من نحو السُّنة والجماعة القرآن، وليس المذاهب الفقهية الفرعية للاسلام، مُشددًا على أهمية الحوار ضمن مكونات البنية الجمعية الواحدة. مُشيرًا إلى ضرورة الحوار مع القراءات الفقهية الأربعة، واصفًا إياه بالحوار المنفتح المستدام.
في ردهة الذكريات، إشارة إلى موقف أحد رجال الدين الكبار في لبنان من المذهبيات، ينتقد فيه كتب كثيرة في علم طبقات الرجال عند الشيعة، ويصفها بالكتب المذهبية المقفلة قائلًا: “الأجدى والأقرب إلى الله هو الاهتمام بالاسلام والكتاب والسُّنة، بالأمة والجماعة”.
يشير المعلم زيعور إلى استذكاراته التأريخية المؤلمة، إلى رفض التفكير بعقلانية في أمور الدين، إلى استغلال الدين في التغيرات داخل المجتمع والفكر، وهو ما بدا جليًا في استغلال الجامعة الوطنية حيث تم توظيفها في خدمة السياسي الديني. ويضيف لقد باتت الشريعة والتراثات تعرض لقوانين التحجر الفكري وتُقيّد الإرادة وتعادي التسامح والحريات، داعيًا إلى الأنسنة على كل الصعد، واصفًا تجربته مع المذهبية بغير مردودية كبيرة، فالمذهبي ينتقم لنفسه فيبهجها بأن ينشطر إلى ذات وآخر، جلاد وطريد، ملائكة وشياطين، طارحًا علاجًا جذريًا لهذه المعضلة المذهبية، باعتماد الحل الصوفي العرفاني، لأنّ الهدف الأسمى فيه هو التحقق، أي بلوغ اللحظة التي تقول فيها الأنا للآخر: “يا أنا”. وهناك تتعاطى الذات مع الذات الأخرى كما تتعاطى تمامًا الذات مع الذات عينها، وتمامًا كما تتعاطى الذات الكبرى الصراطية أوالأرومية مع الذات الفرعية، وبكلام الحداثة الراهنة، بكلام النظرية العربية في الفلسفة والمدنيات يكون المواطن معترفًا بحقوق كل مواطن وبحقوق العلائقية والوطن وبقيم المساواة والعدالة الشورانية التعاقدية.
يُمعن المعلم زيعور في الغوص في التجربة الناصرية وعلاقتها مع قطاعات وطباقات المجتمع المذهبي، يُفرد لها بابًا واسعًا لوصف تفاصيل علاقتها الحوارية مع الصراطي من جهة والمنشق من جهة أخرى، ويمكن القول إنّ ما قام به المعلم زيعور يُعدّ تجربة فردية وفريدة، وهي تجربة محصورة في دراسة شخصيات وأكاديميين عرفهم كأصدقاء ومحبين، وكان محور اللقاء معهم حوارًا متقطعًا بين قطاعات ثلاثة : الباطني، شبه الباطني أو الباطني جزئيًا وعند الأطراف نقيض الباطني وهذا كله في داخل كل مذهب على حدة. وبعد تخلٍ وتمحيص يُفرد المعلم زيعور للذاكرة مداها الواسع ليقول بجرأة كامنة غير كافية: إنّ عبد الناصر كان العامل الأقدر على التأثير، ولعلّ مُحصّل ذكريات التجربة الناصرية في المؤالفة بين الإخوة الوارثين ، يُظهر ضرورة الانطلاق من الحوار بين متساويين، ومن تعزيز قيم المساواة والانصاف والديقراطية، والحوار بين الطوائف.
ينتقد المعلم زيعور حوار المذاهب الدينية والفكرية لما فيه من عثرات في فهم النص والتكاليف واحتكار الحقيقة والكلام باسم الحق الساطع، ثم التهميش والطرد أو قتل الأخ الضال أو الخائف المنفي والمسحوق اللامرغوب..ويقول عن حوار الأكثرية مع الفِرَق أو بين الأخوة المتجافين، لقد تعلمت في الجامعة الأجنبية أنّ كل حوار، بل كل كلام يُشظّينا، إنه يُفتتّنا ويُشرّحنا، يُشتتّنا ويُقطّعنا، ثم إنّه يُعيد تركيب الذات ، يُعيد أشكلتها وضبطها، يتدفق معه ويتناقح معه أنّ الحوار الذي يستحق اسمه لا يكون إلا بين مختلفين متساوين، يذهبون من الاعتراف المتبادل بحق كل طرف في أن يكون ما يريد أن يكون وما يستطيع أن يكون.
يحفر المعلم زيعور عميقًا في سرده لتلك الذكريات فيبدو وكأنه يسائل نفسه مرة كمؤرخ ، ومرة كمُحلّل، يسبر أغوار التاريخ وأغوار الرموز والشخصيات، يطرح الإشكاليات الملحاحة، قائلًا: “هل انتقل التذكّر المؤرَّخ هنا إلى دراسة في الرمزيات، أو إلى النظر في الصحة النفسية للفرد أو الفئة الاجتماعية أو للأمة والفكر والتاريخ؟” ويُضيف يكفي أن ننتبه الآن إلى أنّ الانسحاق يُثير إما التمرد وإما ردود فعل تهدف إلى استعادة التكيف مع الشروط أوالاستقرار والتوازن وإلى بثّ الأمل.
فالمدافع عن رأيه بعناد وتعصب لا يلبث أن يتجابَه مع عناد الطرف المناقض وذاك يقودهما إلى حفرة معرفية ويستولد التفسير الأحادي الإلغائي.
وعن سرده لتاريخ الذكريات ذات الصلة بالفكر الباطني العائش ضمن “النحن المسلمة والاسلامية”، يُسائل نفسه مجددًا وبشفافية الباحث عن كنه المعارف الخفية، قائلًا: “لعليّ لم أكن في بعض الزوايا والنقاط واضحًا، لكني كثّفت واحترمت الحقوق والمكانة التاريخية لكل قطاع أو طائفة دينية كانت أو اجتماعية”، وفي السياق عينه يقول: “تُخالجني ذكرى أخرى عن غلطة ثم غسل ومحو لحادثة تشبه الزلة اللسانية: ذات جلسة حوارية كنت فيها صموتًا مستمعًا، قلت كلمة غيردقيقة، مُتسرعة وغير سديدة في محاكمتي للمذهب الإسماعيلي، ثم اعتذرت”. ولعلّ استخدام الكاتب الصياغة اللغوية “ثم اعتذرات”، لم تكن صدفة لغوية، لا سيما إذا نظرنا إليها في بعدها الأسلوبي السيميائي، إذ ترفع صاحبها من رتبة المختلف والمنفتح في آن، إلى مقام الباحث عن كنه الحقائق المعرفية الإنسانية مهما تنوعت مسمياتها الدينية، وهو ما يتوافق مع المدرسة المعرفية الخاصة بالمعلم زيعور.

رحلة في شخصية أدونيس الشاعر والبحث عن الطفولة الشقية
يُتقن المعلم زيعور فتح باب الذاكرة على مصراعيها، ويغوص في امتداداتها أفقيًا وعاموديًا، ويسبح في تشعباتها، مستخدمًا كل شيفراته المعرفية، وأدواته التخصصية في سبر أغوار النفس ومفرداتها على مستوى الفرد والجماعة والأمة.
وباب الذكريات هذا لم يقفله زيعور عند حدود الجماعات الدينية أو المذهبية أو السياسية، بل فتحه صوب الأفق الثقافي الأرحب والأكثر شفافية، والأشد كثافة في البعد التحليلي، عنيتُ به عالم الشعر وخاصته، حيث هناك يتخذ المعنى البعد التأويلي الأعمق، والمذاق السحري الخاص، وفي هذا الإطار يُفرد المعلم زيعور، فسحة تذكّرية ذات دلالة مع الشاعر أدونيس، حينها كان أدونيس أستاذًا في كلية التربية، لا يُخفي المعلم زيعور إعجابه بشخصية أدونيس، ويأخذنا معه إلى البحث عن طفولة شاقة وتجربة صدمية دفينه عند هذا الشاعر،وفي موقف لا يخلو من حس الفكاهة يذكر زيعور التهمة التي ألبسها لأدونيس حين نفى عنه الصبغة الشعرية التي اشتهر بها ونسبها لزوجته خالدة السعيد حين قال إن تلك القصائد لم يكتبها أدونيس بل كتبتها له زوجته خالدة، على إثر هذه التهمة يروي لنا حادثة جمعته مع أدونيس، هَدفَ من خلالها أن يبحث عن استكناه الجانب الطفولي المعتم في شخص الرجل، فيقول: “ملاحظتي انصبّت أثناء الجلسة على الدشداشة التي كان يرتديها أدونيس، والسيجار الضخم، لم يكن ينظر إليّ مباشرة. بدا اللقاء اقتحاميًا بيننا، وكأنه فوجيء فأجاب: هذه هدية ما بها؟ وهي جديدة. ويُضيف زيعور إنّ أدونيس كلّه كان مُلخصًا مكثفًا في هذه الجلسة، يجمع زيعور بين هذه الحادثة وبين حادثة أخرى جمعته وأدونيس، عمد فيها إلى مخاطبته بعبارة (يا شيخ أدونيس)، ثم أردفها بعبارة أخرى (الإمام أدونيس). حينها جُنَّ جنونه، يقول زيعور، ورفض اللقب والإيحاءات المرافقة والظلال التراثية رفضًا قاطعًا، وكان كلامه سافرًا افتراسيًا قتاليًا وتعبيرًا عن نرجسية شديدة العدوانية، وأنا بدوري لم أكن أرضى أن أكون مفتريًا فآثرت الانسحاب والتقهقهر، ودّعته لكن من غير اعتذار.
بعد عملية السرد هذه ينتقل زيعور إلى تحليل الحادثة ليقول: “إنّ العباءة أو الدشداشة ترمز إلى التراث والاسلام، إلى التاريخ والحضارة إلى العروبة والبداوة، وترمز أيضًا ودائمًا بحسب المدرسة العربية في الرمازة إلى الأسلاف والأهل وإلى الأب، الأب المتخيل المثالي الرمزي إلى الثروة والجاه، من هنا لم يكن ارتداء أدونيس لهذه الدشداشة أمرًا عبثيًا، إذ سرعان ما تتكشف معانيها لا سيما حين يربطها زيعور بالحادثة التي رفض فيها أدونيس لقب شيخ المشايخ ولقب الإمام، ويضيف: إنّ رفض أدونيس لهذين اللقبين بحسب المدرسة العربية الراهنة في التحليل النفسي والإناسي، هو رفض لكل ما يربطه بالتراث والدين والأسلاف والتاريخ والقيم والرموز العربية، ولعل المفارقة الدلالية تتأتى من هذا الرفض ومن قبوله ارتداء العباءة العربية بكل مدلولاتها التراثية والدينية، وهذا ما أراد أن يشير إليه المعلم زيعور في نقله لهاتين الحادثتين ليقول: إنّ أدونيس الذي عُرف واشتهر بأنه يُمثّل خطابًا قطعيًا حاسمًا في الأرومة والنبع، وأدونيس الذي أخلص في عدمانيته وفكره اللاءاتي النفياني، والذي لم يكن راغبًا في شهرة أو أمجاد جراء هذه القطيعة والانفصال عن التراث، بل قد انتفع من نقدانيته للدين والتراث، أدونيس هذا، وإن بالغ في إظهار هذه القطيعة والاهتياج والرفضانية، يبقى أدونيس ابن هذا التراث والروح الجماعية.. فالاسلام رزيحات حضارية متراكمة وتجارب زمانية نمت عبر ألاف السنين، لذا كان أدونيس كأيّ عربي أو كأيّ نص أو عقل يعود إلى الزيّ التقليدي، إلى التراث والأمة كي يستعيد التوازن النفسي، ويشعر بالصحة النفسية والروحية، كي يُقلّص القلق ويُخفف التوترات، كي يغسل ويمحو مشاعره بالذنب والتأثيم التي سببتها له تجريحاته لأبيه المظلوم وتلطيخاته لأهله ولسبعة ألاف عام من عمر مأساة العربي المستمرة.

ذاكرة الجامعة اللبنانية
باب جديد يفتحه المعلم زيعور في تضاعيف الذاكرة، عن ذكريات الفكر الجامعي العربي بين الأعوام 1950 و2000، والتغييرات في المقررات التدريسية والتي كانت شيئاً شبيهًا بالثورة على فضاء معتم قامع، وعلى ممارسات قاهرة، أو ظواهر أكاديمية غير ديمقراطية، يروي ويُحلّل ما كان يجري في أروقة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، ثم ينتقل إلى أروقة كلية التربية وغيرها من الأقسام فيقول: نحن في كلية الآداب قد افترسنا الجامعات الأخرى وضمنها الجامعة المُدلّلة، أي الجامعة الأميركية في بيروت، لاسيما في مجال دراسة الأدب العربي والفلسفات العربية والأوروبية والهندية وحتى في مجال علم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ والألسنية، ويُضيف قائلًا ليس صعبًا القول إننا باستثناء “كمال الصليبي” أعطينا مالم تعطه الجامعة الأميركية، وطوال الخمسين عامًا طحشت كلية الآداب على الصفحات الثقافية في الجرائد.
وفي هذا السياق يستذكر زيعور بعض الذين توافدوا على التدريس في الجامعة اللبنانية والذين كان لهم الأثر الطيب فيها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، المُدرّس الجامعي كمال جنبلاط المتخصص في فلسفة الدين والفكر الهندي، فضلًا عن التأرخة الفكرية والتجربة الشخصية لمحمد جواد مغنية، والذي خاض أيضًا غمار التعليم في أروقة الجامعة اللبنانية، فكان استاذًا للفلسفة الاسلامية وعلم الكلام وعن مغنية يقول المعلم زيعور، إنّ حضور محمد جواد مغنية ذاك المؤسس، لم يكن عرضيًا هامشيًا في عالم الفقهيات، وعلم الكلام المُحدَث والنقد الاجتماعي والسياسي والفلسفة الاسلامية والعربية،.. لا نعرف في أيّ عام جامعي درّس محمد جواد مغنية رصيد الفلسفة الاسلامية في الجامعة اللبنانية.. ما نعرفه عن الرجل أنّه قد مثّل طوال أكثر من عقدين النمط الكفاحي من المثقفين الذين تجنّدوا وجيّشوا للتحرر من التخلّف السياسي والإداري. وتجدر الإشارة إلى أنّ ما بين النموذجين محمد جواد مغنية وكمال جنبلاط معلومات قيّمة في السيرة الذاتية والنشاط الفكري والمعرفي في بُعده الديني المختلف والمؤتلف.
لم ينس المعلم زيعور الكتابة عن الذات، ذاته هو، عن حبّه الأول لتلميذةِ كانت تصغره بسبعة أعوام في منتصف الخمسينيات، ثم اتضح له فيما بعد أنّها قد صارت أمًا قروية لعدّة أولاد ناجحين، ولربما كانت تلك الفتاة الأولى في حياته، والحالة الأبقى والأفعل، وحين يكتب زيعورعن الذات، عن ذاته هو، يكتب عن أبيه صاحب الكارات الكثيرة واللامُتقن لمعظمها، عن بيته القروي المبني من جدران الكلّين،عن عُدّة الشاي المعقدة الوافرة وعُدّة القهوة، عن العمق الريفي الحميم والأليف، عن ضجّة الصوم في القرية، عن عينّة من العادات والتقاليد والاندماج بين الفرد والكلّ كما الذاتي والموضوعي.
واللافت أنّه حين يقترب من ملامسة ذكرياته الطفولية والذاتية، يقترب أسلوبه السردي من ملامسة اللغة الشعرية، شديدة الرهافة، وينحو السرد إلى سبر أغوارالجانب الطفولي لديه، يغلب عليه طابع التداعي الحر، فتنكشف ذاته أمام القارئ بكل تجلياتها، يبدو وكأنّه يضع نفسه تلقائيًا تحت مجهر التحليل النفسي. المجهر عينه الذي استخدمه في صياغة كل تلك الذكريات الثمينة وإن بأدوات علمية مختلفة في التأويل وسبر أغوار معنى المعنى في لحظته التجاوزية الأعمق.