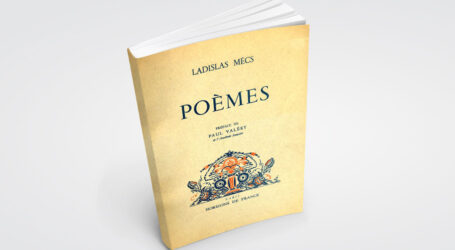الحرب الروسيّة الأوكرانيّة تَصهر التنوير الغربيّ
صلاح سالم*
انطوى مشروع التنوير، منذ بدايته، على تيّارَيْن متناقضَيْن. الأوّل (نفعيّ)، يقبع الفيلسوف ليبنتز على رأسه، منذ أراد تسخير الآخرين في بلْورة هويّة أوروبا الصاعدة وتأكيد حضورها، فدعا إلى استعمار الأقاليم المركزيّة في العالَم ومن ضمنها مصر التي حرَّض العرش الفرنسيّ، الملك لويس الرابع عشر، على احتلالها منذ القرن السابع عشر قبل أن يحضر إليها نابليون بونابرت، بعد أن وعى الدرس واستوعب الرسالة في نهاية القرن الثامن عشر ولكنْ باسم الثورة والجمهوريّة.
عبَّر هذا التيّار عن نفسه في نزعة التمركُز الأوروبي حول الذّات، التي اتَّسمت بالاستعلاء والعنصريّة في تبرير هَيْمَنة الغرب برسالة الرجل الأبيض في مدنيّة البشريّة، وفي احتلال كثير من دولها والتحكُّم في مجتمعاتها، والتي عبَّرت عن نفسها في نظريّات فلسفيّة ومعارف أنثروبولوجيّة تحدَّثت عن فكرٍ أوروبي يتّسم بالوحدة والتماسُك والاطّراد، وكذلك بالفرادة والكونيّة، يصلح لكلّ زمان ومكان كما يقول السلفيّون الإسلاميّون عندنا، ويدّعي التجذُّر في تجربةٍ أصليّة هي الفلسفة اليونانيّة، التي تأخذ هنا مكان التجربة النبويّة في المدينة المنوّرة. وعلى هذا تصبح الحضاريّة الأوروبيّة/ الغربيّة مُطلقة النقاء، خالية تماماً من الشوائب، كالهويّة الإسلاميّة في الإدراك السلفي، وعن آخر حضاري متخلّف بقدر ما هو مُختلف، كما يتصوّر السلفيّون غرباً منحلّاً، مُفتقِداً للفضائل الأخلاقيّة.
بلغت تلك النزعة نقطةَ الذروة عشيّة الحرب العالَميّة الأولى، فبدا الجميع وقد خضعوا لمنطقها. وحتّى عندما كان المفكّرون خارج الغرب يجادلون ضدّها، لم يكُن باستطاعتهم أن ينكروا التفوُّقَ الأوروبي الماثل أمامهم، بل كانوا ينكرون تفسيراته الرائجة فقط، التي تدور في فلك الدوافع العنصريّة، حتّى لا يظلّ رهينة لانتماءٍ عرقي أو اعتقاد ديني، أو تراكُم ثقافي داخل التاريخ الغربي وحده، بل يصبح نِتاجاً للتراكُم الحضاري عبر مسيرة التاريخ البشري. وعلى أرضيّة تلك النزعة جرت وقائع الحرب التي خلَّفت عشرة ملايين من القتلى على الأقلّ، ناهيك بأضعافهم من الجرحى والمُصابين بعاهاتٍ مُستديمة وأزماتٍ نفسيّة، في دراما كونيّة كانت هي الأكثر بربريّة عبر التاريخ آنذاك، ولم تتفوّق عليها سوى الحرب الثانية، الأوروبيّة أيضاً، ولكنّها ستحمل وصف العالَميّة كسابقتها، لأنّ أوروبا كانت قد مَنحت نفسَها حقّ الحديث باسم الإنسانيّة كلّها.
والتيّار الثاني (إنساني)، رمزه الشاهق هو الفيلسوف كانط، الذي دعا إلى التعايُش على أرضيّة الإنسانيّة المُشترَكة والحكومة العالَميّة. ففي “نقد العقل العملي” أكَّد على أنّ ثمّة أخلاقاً كَونيّة تتأسَّس على المبادئ الكليّة للعقل البشري، يُلهمها مفهوم “الواجب” كأساس للقيَم المدنيّة يَنبع من الإرادة الإنسانيّة الحرّة، وركيزة لمفهوم “المجتمع العالَمي”، الذي لا يُمكن أن ينشأ إلّا إذا قمنا بتمديد التزامنا الأخلاقي من مجرّد الشعور بالمسؤوليّة إزاء الآخرين كأفراد في مجتمعنا، إلى الشعور بالمسؤوليّة إزاء البشر جميعاً بغضّ النّظر عن مُعتقداتهم وأوطانهم. وفي عمله الأثير “مشروع للسلام الدائم” دعا إلى تأسيس منظومتيْن قانونيّتَيْن تسيران جنباً إلى جنب، إحداها تُسيّر الشؤون الداخليّة للمجتمع الواحد على أساس من الحريّة وصولاً إلى الديمقراطيّة، والأخرى تنظِّم العلاقات بين الأُمم على أساس من العدالة وصولاً إلى السلام، مؤكِّداً على أنّه لا يُمكن تحقيق الحريّة داخل الأُمم إذا لم يتحقّق العدل والسلام بين هذه الأُمم. وهنا اقترحَ إنشاء هيئة دوليّة تقوم على مهمّة السلام العالَمي في موازاة عمليّة تطوير الديمقراطيّة اللّيبراليّة في المُجتمعات المحليّة محذِّراً من أن تعامل هذه الهيئة مع بعض الدول المكوِّنة لها بغَير تكافؤ أو عدالة إنّما يفسد عملها وينهي السلام العالَمي، مثلما يؤدّي الخروج على فكرة سيادة القانون إلى تقويض الديمقراطيّة داخل الأمّة/ الدولة.
الحرب الروسيّة الأوكرانيّة تكشف المَستور
على الرّغم من مرور قرنَيْن ونيّف على بلوغ تلك الذروة النقديّة، فإنّ الحروب والصراعات لم تتوقّف جوهريّاً والمُجتمع العالَمي لم يتشكّل فعليّاً، إمّا لأنّ الديمقراطيّة اللّيبراليّة لم تُصبح نَهجاً سياسيّاً لجميع الدول، وإمّا لأنّ اللّيبراليّات الغربيّة اعتَبرت أنّ قيمها الإنسانيّة والتحرُّريّة حقٌّ سياديّ لشعوبها وحدها، وليس لكلّ البشر وجميع الشعوب، فكان أن هجرت كانط وسارت خلف ليبنتز. ومن ثمّ وُلدت إشكاليّة المعايير المزدوجة، التي جرى إدانتها مراراً من الدول والشعوب خارج الغرب، فيما استمرّ الغرب نفسه يغطّي عليها بطرائق ذكيّة ونجاح واضح حيناً، وبطُرقٍ فجّة وإخفاقٍ شامل أحياناً، مثلما كان الأمر في قصّة احتلال العراق.
في ظلّ الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، بَدت الإشكاليّة أكثر حدّة، مع تهاوي الكثير من القيَم والمعايير التي نُظر إليها كمرجعيّة. فضدّ احترام الملكيّة الخاصّة إلى درجة التقديس سارعت دول الغرب إلى تجميد أصول الأفراد والشركات الروسيّة على أراضيها، من أندية لكرة القدم، إلى العقارات الخاصّة، إلى شركات في قطاعات مُختلفة، ناهيك بتجميد الأموال السائلة في البنوك. هذا السلوك يمثِّل عقاباً على خطأ يُفترض أنّه محقَّق، ما يعني أنّ تلك الدول نصَّبت نفسَها حَكَماً في صراع هي أصلاً طرف فيه، إذ تقف بوضوح خلف أوكرانيا. وحتّى لو كان ثمّة خطأ روسي يستحقّ العقاب، فما ذنب مُستثمِرين ورجال أعمال وثقوا بدول الغرب، ومارسوا نشاطهم فيها؟ وخصوصاً أنّ أغلبهم ضدّ الحرب، وأنّ جميعهم لم يُستشاروا فيها. وأيضاً على قاعدة الفصل بين الرياضة والسياسة التي لاكَها الغرب كثيراً، سارعت الاتّحادات الرياضيّة في جلّ الألعاب إلى إصدار إجراءاتٍ عقابيّة ضدّ الرياضيّين الروس، تمنعهم من المُشارَكة في المُسابقات المُزمعة، حتّى أولئك الذين أعلنوا أنّهم ضدّ الحرب. كما تمّ حرمان روسيا كدولة من حقّ تنظيم أيّة مناسبات رياضيّة كانت قد أُسندت إليها، بل وحرمانها من التنافُس على المُشارَكة في المونديال القطري نهاية هذا العام. حدثَ ذلك لأنّ تلك الدول تسيطر فعليّاً على الاتّحادات الرياضيّة، وتستضيف معظم مقرّاتها الأساسيّة، ناهيك باللّجنة الأولمبيّة الدوليّة، ولذا اندفعت إلى تحطيم القواعد والأعراف التي تفرضها على الآخرين من دون أن تُلزم بها نفسها. الأمر نفسه جرى في المجال الفنّي، حيث قاطعتْ كلّ المسارح والمهرجانات الفنّانين الروس وتوقّفت عن عرض أعمالهم أو مساهماتهم في نشاطها. بل إنّ بعض المُنتديات الثقافيّة والجامعيّة أعلنت عن نيّتها التوقُّف عن تدريس أو الاحتفاء بأعمال الأدباء الروس العظام وعلى رأسهم ليو تولستوي، ودوستويفسكي، في نَوعٍ من العقاب الجماعي الذي لا يُبالي بالخطوط الفاصلة بين السياسة وغيرها، ولا حتّى بين الحياة والموت.
فضلاً عن ذلك جرت وقائع عديدة نالت بشدّة من النزعة الإنسانيّة، كقيمةٍ قارّةٍ تتبرعم فلسفة التنوير الغربي، تؤكّد على قيمة الإنسان ككائن حرّ يقبع في مركز الكَون، وتُمجِّده بصفته المجرّدة تلك، بعيداً عن أيّة انتماءات عرقيّة أو دينيّة. أوّل تلك الوقائع الفاضحة كان عند إجلاء الرعايا الأوكرانيّين إلى بلدانٍ مُجاورة، حيث جرى تمييز البيض الأرثوذكس منهم على حساب الملوّنين والمُسلمين سواء عند نقْلهم أم استقبالهم، ونوعيّة الإقامة التي مُنحت لهم، والحقوق التي يتمتّعون بها. كما تناثرت أقوال مواطنين ومُعلِّقين تُبرِّر منسوبَ التعاطُف المُرتفع مع الأوكرانيّين بأنّهم مثلهم، بيض وشقر، وليسوا شرق أوسطيّين، عرباً أو مُسلمين. ولعلّ هذا ما يُفسِّر ضعف التعاطُف الغربي مثلاً مع العرب الفلسطينيّين وشكلانيّته داخل إسرائيل والأرض المحتلَّة ضدّ القمع الإسرائيلي. حتّى عندما اغتيلت الإعلاميّة البارزة شيرين أبو عقل، على الرّغم من جنسيّتها الأميركيّة، كان تعليق لينكن، وزير الخارجيّة الأميركي، باهتاً حيث استنكرَ حقّها في جنازة هادئة كي تُوارى التراب في سكينة، ولم ينتفض مثلاً، كما تَفترض الروح الإنسانيّة الحقّ، ضدّ الجريمة الإسرائيليّة المركَّبة، التي بَلغت الحدّ الأقصى من الغباء والجنون، اغتيالاً للشخصيّة وتمثيلاً بالجنازة، في عُرف همجي لا يمتّ لروح التمدُّن الإنساني بصلة. ولعلّ أكثر ما أخشاه من ضمور النزعة الإنسانيّة وافتضاح أمر الازدواجيّة الغربيّة حولها إنّما هو تنامي عمليّات الانخلاع منها من قِبَلِ سياقاتٍ ثقافيّة وسياسيّة لم تتشبّع بها، بل عملتْ كثيراً على مُقاومتهما كعالَمنا العربي، بذريعة أنّ الغرب يوظِّف تسميتها العمليّة (حقوق الإنسان) سياسيّاً في النَّيل من مصالحنا. وعلى الرّغم من اعترافنا بأنّ ذلك يحدث أحياناً، فإنّنا نؤكّد على أنّ تلك الحقوق مصلحة أساسيّة لنا، فنحن جديرون بإنسانيّتنا دون وصاية الغرب، وبغضّ النّظر عن مراوغته.
والحقّ أنّ لهذه الإشكاليّات العمليّة جميعها جذراً نظريّاً يقع في عالَم الفلسفة، وتحديداً في نظريّة المعرفة، حيث تدور العلاقة الشائكة وربّما الإشكاليّة بين الذّات والموضوع، الذاتيّة والموضوعيّة، ويثور السؤال الكبير: إلى أيّ مدىً يُمكن للباحث العلمي أن يبقى على حياده إزاء الظاهرة التي يدرسها على الرّغم ممّا قد يحمله من وجهة نظر مسبقة حيالها، تترتّب عن وعيه الشخصي أو انتمائه الثقافي، الديني، والحضاري؟ لقد ثار الجدل طويلاً وعميقاً وتبلْوَرت في ظلّه مدارس ثلاث أساسيّة: المدرسة المثاليّة التي رأت في ظواهر العالَم مجرّد تصوُّراتٍ ذهنيّة لا أساس لها في الواقع، فأفسحت لكلّ شخص أو باحث أن يُكوِّن فكرته الذاتيّة والمستقلّة عن ظواهر العالَم، ما يعني استحالة المعرفة الموضوعيّة. والمدرسة الماديّة التي اتّخذت مَوقفاً مضادّاً، فأكَّدت على واقعيّة العالَم، وعلى أنّ ظواهره قائمة بذاتها مستقلّة عن العقل المُدرِك لها، حيث تنعكس عليه مباشرة وكأنّه سطحٌ أملس من دون تدخُّلٍ يُذكر، ما يعني أنّها قابلة للإدراك الموضوعي الدقيق، فلا مجال هنا للذاتيّة. أمّا المدرسة الثالثة، النقديّة، فقدَّمت وصفةً جدليّة، توفِّق بين الذاتيّة والموضوعيّة، حيث احترمت واقعيّة الظواهر في العالَم، مثلما احترمتْ دَور العقل ومبادئه الكليّة، ودَوره في تصنيف مُدركات الحواسّ المباشرة وتأمّلها، فصارت المعرفة وليدة منهجٍ تكامليّ، يسعى إلى تحقيق الموضوعيّة، بعيداً عن الحياد الكامل، والذاتيّة المُفرطة. وكانت خلاصة هذا الجدل أنّه إذا كان الحياد إزاء الظواهر الكونيّة التي يبحثها العِلم الطبيعي أمراً صعباً، فهو مستحيل إزاء الظواهر الاجتماعيّة التي تدرسها العلوم الإنسانيّة؛ وأنّ على الباحث أن يسعى إلى الموضوعيّة في الحاليْن فقط، قدر المُمكن، وهو ما يتوقّف على مدى إخلاصه للمعرفة، وعلى قدر التدريب العلمي الذي حصل عليه، وعلى محبّته وشغفه بمفهوم الحقيقة. اليوم، في المستنقع الأوكراني، يبدو مفهوم الحقيقة كغاية للحداثة ومَدارسها مُعرَّضا للتزييف، ومفهوم التنوير كمشروعٍ عقلاني لتشريع النظام في العالَم والوجود، مُعرَّضاً لشكوكٍ بالغة، لن يخرج منها من دون جروحٍ عميقة.
***
*كاتب من مصر
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق