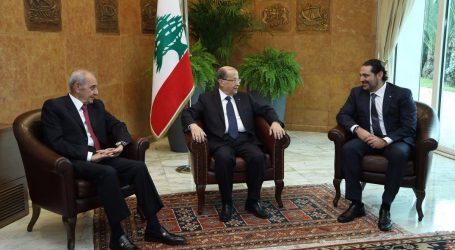الحدود البحريّة واستثمار غاز المتوسّط
عدنان كريمة*
يكفي نجاح رعاية الولايات المتّحدة في إنجاز اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، ثمّ الانتقال بموجب هذا الاتّفاق إلى دَور “الوصاية” على تنفيذه بتفويضٍ شاملٍ وبصلاحياتٍ واسعة، وبمرجعيّةٍ وحيدة لحسْمِ أيّ خلافٍ قد ينشأ، سواء حَصل ذلك بين الحكومات، أم بينها وبين الشركات المُتعاقدة معها، للتأكيد على أنّ ما أنجزته واشنطن عبر وسيطها عاموس هوكشتاين، قد فتحَ البابَ لها لتعزيز نفوذها في شرق المتوسّط، واحتلال مَوقعٍ متقدِّم في سياق التنافُس الإقليميّ والدوليّ على استثمار النفط والغاز، وخصوصاً مع التراجُع الروسي نتيجة انشغال موسكو بحربها مع أوكرانيا، وتشديد العقوبات ضدّ الشركات التي تتعامل معها، إضافة إلى تطبيق عقوبات “قانون قيصر” التي تحدّ من نشاط الشركات الروسيّة والصينيّة والإيرانيّة التي تتعامل مع النّظام الحاكم في سوريا. وربّما لذلك استعجلَ الأميركيّون إنجازَ هذا الاتّفاق الذي وَصَفَهُ الرئيس جو بايدن بـ “الفتْح الكبير”، بينما وصَفه المُراقبون بأنّه يُعلن عن “مرحلة جديدة ليس في منطقة جنوب لبنان فحسب، بل في جزءٍ أساسيٍّ من منطقة الشرق الأوسط”.
خلافاً للاتّفاقات السابقة التي تمَّت بين البلدَيْن العدوَّيْن لبنان وإسرائيل، بدءاً باتّفاق الهدنة الأوّل في 23 آذار/ مارس 1949، مروراً بتفاهُم نيسان/ أبريل 1996، واتّفاق وقف النار بعد حرب 2006، وحتّى اتّفاق ترسيم الحدود البريّة إثر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، وقيام ما سُمّي يومها بـ “الخطّ الأزرق” المُتنازع على 13 نقطة منه، وهو لا يُعتبر خطّ حدود، بل خطّ انسحابٍ للقوّات الإسرائيليّة. هذه الاتّفاقات تمَّت برعايةِ الأُمم المتّحدة وإشراف ومُعايَنة قوّاتها الموجودة حتّى الآن في المنطقة. ولكنّ الاتّفاق الحالي الذي وقِّع في 27 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022 في بيروت وتل أبيب بالمُداورة وسُلِّم في منطقة الناقورة على الحدود، وسُمّي “اتّفاق هوكشتاين”، فقد تمَّ برعاية الولايات المتّحدة واعتمادها كمرجعيّة بكلّ ما يتعلّق بتنفيذه، وهي المرّة الأولى التي تُلغى فيها مرجعيّة المُجتمع الدولي المُمثَّلة في مجلس الأمن والأُمم المتّحدة، والتي اعتُمدت طوال مسيرة الصراع العربي – الإسرائيلي بكلّ مُندرجاته ومراحله.
الوصاية الأميركيّة
ينطوي اتّفاق الترسيم على ثلاثة أبعاد أساسيّة: أوّلاً، البُعد القانوني؛ بما أنّه يتضمَّن أحكاماً خاصّة بترسيم الحدودبين الدولتَيْن، وأحكاماً أخرى خاصّة بالاقتصاد والمال، وأهمّها ما يتعلّق بوجود الوسيط الأميركي، وإيداع الترسيم لدى الأُمم المتّحدة، وتقديم كلّ طرف رسالةً تحتوي على قائمة بالإحداثيّات الجغرافيّة ذات الصلة إلى أمين عامّ الأُمم المتّحدة، إضافة إلى تحديد الحقوق الاقتصاديّة العائدة لإسرائيل عبر مُفاوضاتٍ بينها وبين مشغِّل البلوك رقم 9 اللّبناني وحصولها على تعويضٍ مالي، والتزامها بعدم القيام بمُمارَسة أيّ حقوق لها لجهةِ تطوير المخزونات الهيدروكربونيّة الواقعة في المكمن المُحتمل؛ ولذلك، فإنّ هذا الاتّفاق يرقى إلى مرتبة معاهدة تعاقديّة تقتضي تطبيق المادّة 52 من الدستور اللّبناني، وبالتالي لا يُمكن إبرامها إلّا بعد موافقة مجلس النوّاب عليها. ثانياً، البُعد السيادي، وقد رأى فريقٌ من الخبراء أنّ الشروط المُتَّفق عليها تمسّ السيادة الوطنيّة، لجهة موافقة لبنان على الخضوع لرقابة الولايات المتّحدة الأميركيّة ووصاية سلطتها، ومشاركة إسرائيل في استثمار الموارد الطبيعيّة في جزءٍ من المياه البحريّة اللّبنانيّة والمنطقة الاقتصاديّة، وبذلك لن يكون قرار لبنان حرّاً ومستقلّاً في الحصول على حقوقه الاقتصاديّة واستثمارها. ثالثاً، البُعد الاقتصادي، حيث تعود ملكيّة المَوارد من النفط والغاز والحقّ في إدارتها واستثمارها حصراً للدولة.
وفي الواقع، بعدما نجحت واشنطن في “رعاية” مُفاوضات الترسيم، فهي ستنتقل إلى دَور “الوصاية” على الخطوات التنفيذيّة؛ وذلك وفقاً للبنود الواردة في الاتّفاق، والتي تَضمن الوصاية الأميركيّة على أعمال التنقيب والاستخراج. ويَفرض الاتّفاق على “أي شركة تريد الاستثمار في الغاز والنفط في لبنان، أن تعرف أنّها خاضعة للشروط الأميركيّة ولوصايتها وإشرافها، ولضرورة إطلاعها على المعلومات المتعلّقة بأعمالها”. كما يؤكِّد “الوصي” الأميركي على الشركة المشغِّلة، أي توتال حاليّاً، أو أيّ شركة أخرى، أن “لا تكون خاضعة للعقوبات”. وهنا يَستبعد الأميركيّون أيّ شركة روسيّة أو صينيّة، ما قد يعيق جولة التراخيص الثانية التي تشمل 8 بلوكات في بحر لبنان؛ كذلك ألّا تكون الشركات إسرائيليّة أو لبنانيّة، ما يمنع أيضاً عن لبنان حقّ الحصول على حصّة شركة “نوفاتك” الروسيّة المُنسحِبة، والتي تنازلتْ عنها للدولة. ولعلّ أهم ما في الاتّفاق أن “تكون الولايات المتّحدة المرجع في تسيير المُناقشات بينهما، لحلّ أيّ خلافاتٍ بشأن تفسيره”.
حصص الاستثمار
تنفيذا لبنود اتّفاق الترسيم، وبخاصّة ما يتعلّق منها بشروط “الوصاية الأميركيّة”، وبعد التنسيق بين وزارة الطّاقة اللّبنانيّة وشركة “توتال” الفرنسيّة، ودخول شركة قطر للطاقة بحصّة في الاستثمار، أَصبح توزيع الحصص في البلوكَيْن رقم 4 في شاطئ البترون شمال لبنان ورقم 9 في جنوبه على الشكل التالي: 35% باسم شركة “داجا” الفرنسيّة المملوكة من شركة “توتال”، وكذلك 35% لشركة “إيني” الإيطاليّة، و30% لشركة قطر للطاقة. وستحصل الدولة اللّبنانيّة على المبلغ الذي ستدفعه الشركة القَطريّة، لقاء حصولها على حصّة الدولة البالغة 20%، والتي آلت اليها بعد انسحاب شركة “نوفاتك” الروسيّة. وهكذا تكون الشركة القَطريّة قد وَجدت موطئ قَدَمٍ مُهمٍّ لها على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط، وهو هدف وَضَعَتْهُ لنفسها منذ فترة، في ظلّ تسابُق الشركات النفطيّة على رخص الاستثمار في المنطقة.
أمّا حصّة إسرائيل من الأرباح المتعلّقة بأيّ أعمال استخراجٍ مستقبليّة في حقل قانا المُحتمَل، فستُحدَّد وفقاً للاتّفاق الذي سيُعقد مع شركة “توتال”، على أن يتمّ ذلك وفق كميّة الغاز الموجودة جنوبي الخطّ 23 الذي تمّ الترسيم على أساسه.
“سلاح” العقوبات
يبدو أنّ العقوبات الغربيّة عموماً، والأميركيّة خصوصاً، في ما يتعلّق منها بتطبيق “قانون قيصر”، أصبحت تهدِّد بخروج الاستثمارات الروسيّة من نفطِ شرق المتوسّط وغازِه، وبما يؤثِّر على مصالحها الاقتصاديّة ونفوذها السياسي والعسكري. وتبرز في هذا المجال أهميّة القرار الذي اتّخذته شركةُ “نوفاتك” بالانسحاب من الكونسورتيوم اللّبناني، لأسبابٍ ربطتها بفقدان السيولة بالدولار الأميركي التي تأثَّرت بالعقوبات، وانعكست عليها سلباً، ولم يعُد باستطاعتها القيام بأيّ تحويلاتٍ ماليّة إلى الخارج. ولكن هناك إضافة إلى ذلك أسباب أخرى ضمن سيناريو الانسحاب، منها أنّها ربّما وَجدت أنّ استمرارها في الكونسورتيوم مع “توتال” الفرنسيّة و”إبني” الإيطاليّة، قد يشكِّل ضغطاً معنويّاً وإداريّاً على الشركتَيْن المتبقّيتَيْن، بحكم العقوبات المفروضة على الشركات الروسيّة، وسبب آخر يتعلّق بإعادة تقييم روسيا لوجودها في لبنان، وعدم رغبتها بتغطية إطلاق جولة جديدة من الاستكشافات تحت سلطة “الوصاية الأميركيّة”.
من هنا، يرى بعض المُراقبين، ومنهم رجال أعمال ومُستثمرون، أنّ الأميركيّين عادوا الى لبنان والعمل على تعزيز وجودهم في المنطقة، ولكن هذه المرّة بالنفوذ السياسي والاقتصادي والمَصرفي والمالي، إضافة إلى اهتمامهم بشؤون الطّاقة من نفط وغاز وكهرباء. وأنّ مَسار الأحداث يقود الى أدوارٍ سياسيّة وأمنيّة مُختلفة عن السابق في ضوء التطوُّرات المُرتقَبة. أمّا بالنسبة إلى الاستثمارات الروسيّة في سوريا، فهي تتعرَّض لنوعَيْن من العقوبات، فبالإضافة إلى العقوبات الغربيّة ضدّ روسيا، هناك عقوبات قانون قيصر الأميركي الذي دَخَلَ حيّز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020، وهو يفرض عقوباتٍ موسَّعة على النظام السوري، وعلى داعميه من دولٍ وكياناتٍ ومؤسّسات. مع العِلم أنّ الكونغرس أَدخل مؤخّراً تعديلاتٍ عليه، تضمَّنت اعتبار أيّ مُعاملة تجاريّة تتعلّق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطّاقة أو المُعاملات ذات الصلة التي توفِّر دعماً ماليّاً للنظام السوري، أو قد يستفيد منها بطريقة أخرى، تَستوجب فرْض العقوبات عليها. ولذلك قد يعكس الاستثمار اتّجاهه، حيث يتوقّع أن يَخرج جانبٌ مُهمّ من رأس المال الروسي من البلاد المؤهَّلة بقوّة، لأن تعود إلى جبهةٍ للصراع الإقليمي والدولي.
وكذلك العراق، تأثَّر بدَوره بالعقوبات الدوليّة على روسيا التي تبلغ استثماراتها في قطاع النفط نحو 13 مليار دولار فقط، فضلاً عن عقود التسليح التي تمثِّل العمودَ الفقري في قطاعات المؤسّسة الأمنيّة العراقيّة. ويبدو أنّ فرْضَ العقوبات وعدم إعطاء الإدارة الأميركيّة استثناءً خاصّاً للعراق، كما حصلَ مع الاستثناء بشأن استيراد الغاز الإيراني، جَعَلَ الدولتَيْن تبحثان عن آليّةٍ لتسديد مستحقّات الشركات الروسيّة. ويسعى العراق حاليّاً إلى أن يكون في منطقة التوازن، إلّا أنّ احتياطات البنك المركزي وتعاملاته الدولاريّة تَفرض امتثالَه للعقوبات. مع الإشارة إلى أنّ بعض الخُبراء دعا المسؤولين العراقيّين إلى التفكير ببدائل عن الشركات الروسيّة.
وعلى الرّغم من ضآلة عدد القوّات الأميركيّة في شرق سوريا، ومع الأخذ بالاعتبار أهميّة وجودها ولو “رمزيّاً” لاستثمار نفوذها السياسي والعسكري، فهي تؤشِّر على حرصٍ أميركي على حماية حقول النفط في دَير الزور والحسكة، التي تسيطر عليها القوّاتُ الكرديّة، مع العِلم أنّ مناطق النفط والغاز تمتدّ إلى تدمر وريف حمص (وسط سوريا) التي تسيطر عليها القوّات الروسيّة مع الفَيلق الخامس التّابع للدولة السوريّة. ولذلك وصَفها المراقبون بأنّها أبعد من تموضُعٍ عسكري في بقعةٍ جغرافيّة محدّدة، بل تتجاوزها إلى “مثلّث جغرافي” بين العراق وسوريا، مع الأردن، ويقترب من إسرائيل، وهي حليفة واشنطن الأولى والمدعومة منها لإنجاز دَورها “الوظيفي” في المنطقة، فضلاً عن كون هذا المثلّث يشكِّل موقعاً استراتيجيّاً للحدّ من توسُّع إيران وتقوية نفوذها.
تحرُّكٌ دبلوماسيّ
في سياق الاهتمام الأميركي، وتأكيد حضوره في ظلّ متغيّرات سياسيّة تشهدها المنطقة، جرى تحرُّكٌ دبلوماسيّ لافِت، أجرى خلاله وفدٌ برئاسة نائب مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لقاءات عدّة مع مسؤولين سوريّين في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، وتطرَّقت المُناقشاتُ إلى ملفّاتٍ عدّة أبرزها، دعْم الاستقرار في المنطقة اقتصاديّاً وتنمويّاً، ومُكافحة الإرهاب، وكذلك الحلّ السياسي للوضع الشامل في سوريا، بدعمِ الولايات المتّحدة لاستئناف عمل اللّجنة الدستوريّة من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254. مع الإشارة إلى أنّ زَخَمَ تلك اللّقاءات يَبرز من خلال أهميّة أعضاء الوفد الأميركي وتنوُّع مهامّهم، وبينهم: أيان مكاري نائب منسِّق مكتب مُكافحة الإرهاب في وزارة الخارجيّة، أيان موس نائب منسِّق مُكافحة التطرُّف، سكوت تورنر نائب مساعدة وزير الخارجيّة لمكتب السكّان والهجرة واللّاجئين، إيلان غولدينبرغ العامل في الجهاز التنفيذي لوزارة الدّفاع، إضافة إلى قائد قوّة المهامّ المُشترَكة (عمليّة العزم الصلب) ماثيو ماكفارلين، وجايك ألتر المسؤول القطري لملفّ سوريا في مكتب الساسات التّابع لوزارة الدّفاع الأميركيّة.
***
*كاتب ومُحلِّل اقتصادي من لبنان
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق