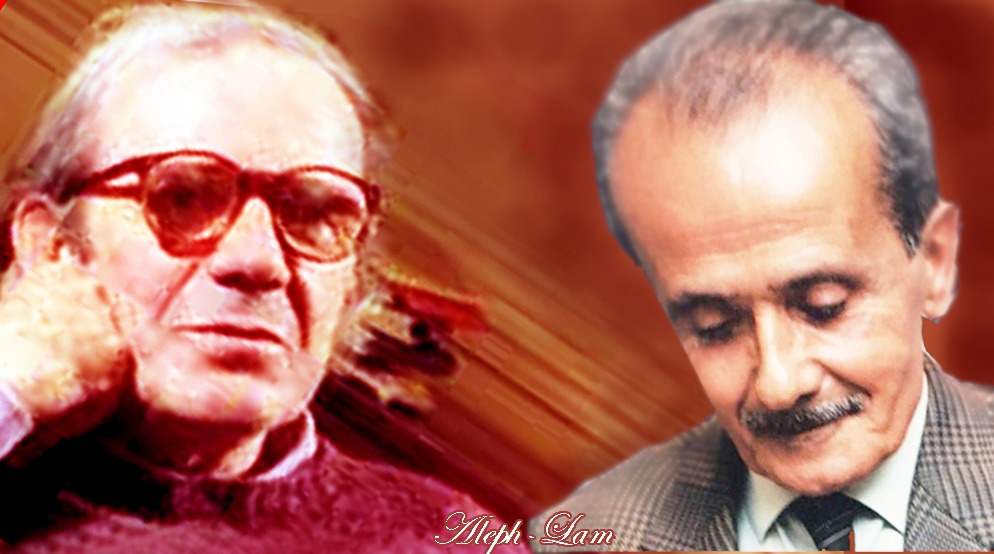جيل دولوز… الصانع فلسفته من نقد الفلاسفة
وفيق غريزي
يشدد الفيلسوف ميشال فوكو على أن القوة الكبيرة تكمن في فكر نظيره الفرنسي جيل دولوز، فقد استرجع الحدث اخيرا قوّته الخاصة وانتزع الفلسفة الوضعية الحديثة، من الفينومينولوجيا، من فلسفة التاريخ، من كمال العالم، ومن الأنا.
يرسم الحدث الفكر ويتخلّص من الجدلية والنفي والتناقض فيصبح ايجابية، كثافة، خط كسر وحياة، حاضر وفريد في الوقت نفسه، وتدفع رؤية دولوز، التي كانت خاضعة لنوع من المخيال المنطقي (الاختلاف والاعادة، منطق المعنى) تدفع الاشياء الى ما هو أبعد، وقد توصّلت بذلك الى احداث أمر عجيب؛ أي إلى فلسفة لا تترك أي مكان للنقصان، وهي في الوقت ذاته وصف حقيقي للعالم، وذلك وفق كتاب “جيل دولوز وسياسات الرغبة” الذي أعدّه وحرره الدكتور احمد عبد الحميد عطية، وتناول جوانب مختلفة من فكر دولوز.
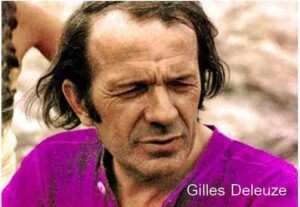
دولوز والفلسفة المعاصرة
يصف الفيلسوف الفرنسي آلن باديو معاصره دولوز بقوله “لم يكن دولوز بنيويا ولا ظاهراتيا ولا هيدغريا ولا مستوردا للفلسفة التحليلية الانغلو- اميركية، كما أنه لم يكن مفكرا ليبراليا ولا اخلاقيا مدافعا عن حقوق الانسان، لقد كان قطبا وحده”. وعلى الرغم من هذا لم تكن صلة دولوز مقطوعة بتاريخ الفلسفة بل أن جزءًا من شهرته اعتمد على قراءته المبتكرة للفلاسفة السابقين، وهو قدّم اعمالا هامة في تحليل فلسفات الفلاسفة: سبينوزا – ليبنتز – هيوم – كانط – نيتشه – برغسون وفوكو، وهذه الاعمال وثيقة الصلة بآرائه الفلسفية. بل أنه، حسب رأي انور مغيث، قد اتهم بأنه يتذرع بأعلام الفلسفة ليعبّر عن فلسفته الخاصة، ولهذا يخرج الفلاسفة معه في صورة غير متوقعة، ربما تناقض الصورة المألوفة عنهم.
ويدافع دولوز عن اسلوبه في تناول الفلاسفة السابقين، معتبرا أن أفضل طريقة لإثارة الاهتمام بالفلسفة القديمة وابراز خصوبتها هو مواجهتها بمشاكلنا المعاصرة. يقول انور مغيث: “من وجهة نظر أفضل من الطريقة العقيمة التي يتم فيها التعامل مع افكار الفيلسوف على أنها مجموعة من المعتقدات التي ينبغي حمايتها من التحريف والتغيير”. لم يفقد دولوز يوما ثقته بالفلسفة ولا بدورها في تحرير الإنسان، ولهذا رفض بشدة بعض المقولات الشائعة الموروثة من الفيلسوفين هيغل ومارتن هيدغر مثل نهاية الفلسفة وتجاوز الميتافيزيقا. كما رفض الدخول في أي جدل بشأنها واعتبر ذلك تحريفا مثيرا للضجر. إن الفلسفة مع دولوز، وفق رأي مغيث: تعود الى قضاياها ومناهجها الخاصة.
يرى دولوز دائما في نفسه فيلسوفا كلاسيكيا، ويأتي التجديد والحيوية للفلسفة من نوعية الاسئلة التي تطرحها عليها والمتعلقة بهموم العصر.
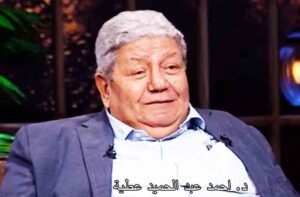
نقد التحليل النفسي
لقد كان جيل دولوز في كتاباته الأولى يهتم بمفهوم الرغبة اهتماما خاصا، ولكن لقاءه بالمحلل النفسي فيلكس غاتاري بعد الثورة الطالبية في فرنسا عام 1968 جعل فكره يخرج من الاطار الفلسفي التأملي الى مناطق جديدة اكثر عينية كالتحليل النفسي والسياسة. ويشير انور مغيث الى أن دولوز يعتبر مع غاتاري في كتابهما المشترك ضد “اوديب”، أن التحليل النفسي الفرويدي ليس إلا وسيلة في يد الرأسمالية، فهو عبارة عن عملية ملاحقة للرغبة من أجل السيطرة عليها والتحكّم فيها، وتتجلى عملية تدعيم التحليل النفسي للرأسمالية في مجموعة من التعريفات والاجراءات التي يتناول خلالها مفهوم الرغبة: “يتبنى التحليل النفسي تعريف افلاطون للرغبة باعتبارها فقدانا، ويجعل التحليل النفسي الرغبة مرتبطة بالجنس فقط، كما يجعل اللذة هي هدف الرغبة وغايتها”، بحيث يكون الحصول على اللذة تخلصا من الرغبة، ويجعل التحليل النفسي الرغبة محصورة في الإطار العائلي على تعميم عقدة اوديب، وبالتالي يقوم بتهميش الدور الاكبر للمجتمع في عملية خلق الرغبة ودور الدولة في عملية الكبت. ولقد وصلت عملية التضامن بين التحليل النفسي والرأسمالية لمواجهة الرغبة وتشويهها وحصرها الى أن اصبحت اريكة المحلل النفسي هي المكان الوحيد لمواجهة الواقع، هي الأرض الأخيرة للإنسان الغربي في عالم اليوم.

دولوز والفلسفة الكانطية
اهتم جيل دولوز اهتماما كبيرا بكانط وفلسفته النقدية في كتبه الثلاثة، وخاصة كتاب “نقد ملكة الحكم”. ويلخّص دولوز التعارض بين تصوّر نيتشه وتصوّر كانط للنقد في نقاط عدة اهمها: أن ليس العقل المشرع الكانطي بل عالم الجينيالوجيا هو المشرع الحقيقي. إن هدف النقد ليس غايات الانسان او العقل، بل الانسانية الأسمى، الانسان المتجاوز، فالأمر لا يتعلق بالتبرير بل بالشعور، صور مختلفة، حساسية اخرى. واهتمام دولوز بتعريف وظيفة الملكات يشغله في كتابه “فلسفة كانط النقدية”. ويشير الدكتور احمد عبد الحليم عطية الى أن اهمية كانط بالنسبة الى دولوز تظهر في تخصيصه كتابا حول فلسفة كانط النقدية، يظهر فيه تطور النقد من العقل النظري الى النقد العملي حتى يكتمل في في ملكة الحكم، فالعمل يتكوّن من مدخل وخاتمة وفصول ثلاثة. ويذكر تحديده للفلسفة على انها على علاقة بين كل المعارف والغايات الاساسية للعقل البشري للتأكيد على الغائية عند كانط، مقارنة بين مكانته في فلسفته من جانب، وفي التجريبية والعقلانية والدوغماتية من جانب آخر “فالتجريبيون يرونها الغائية في الطبيعة وكأنه يرجعها الى العقل، والعقلانية السابقة عليه تقر بالغايات لكن كشيء خارجي واعلى يجعل العقل ينشد وجودا، وخيرا مطلقا بينما يرى كانط مقابل هؤلاء أن الغايات موجودة في العقل”. ويؤكد عطية أن من الواضح أن الغايات من تحليلات دولوز هي بيان كيفية وصول كانط للنقد وغايته نقد الحكم، والدليل على ذلك القضايا التي طرحها دولوز. الذي يقارن بين كانط وفوكو، موضحا التمايزات بينهما. ويرى عطية أن الشروط بالنسبة الى ميشيل فوكو التجربة الواقعية، وليست شروط امكان توجد بجانب الموضوع، وفي جانب التشكيلة التاريخية، وليس من جانب ذات كلية، القبلي عنده تاريخي؛ ويدلل دولوز على كانطية فوكو بالقول: “إن الرؤى تشكل مع شروطها قابلية تلق وتأثر… وهو نفس ما نجده في الفكر الكانطي، حيث أن عفوية الأنا تمارس ذاتها على كائنات متلقية تتمثلها، اي تتمثل تلك العفوية بالضرورة كآخر، اما لدى فوكو فإن عفوية الفهم او الكوجيتو تنسحب تاركة المجال للرؤية باعتبارها شكلا جديدا للزمان والمكان. ويرى دولوز أن كانط نقل الثنائية الديكارتية، الفكر والامتداد الى ثنائية بين ملكتي الحساسية والفهم. ولهذا يقول عطية:” أن كانط لم يبحث عن تطابق بين الذات والموضوع، بل في ملكات الذهن بوصفها منظومة علاقات منفتحة هي محصلة نشاط عملي للإنسان يبتغي الحرية والجمال.
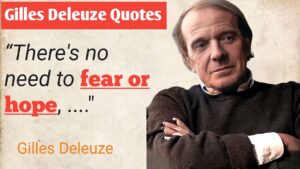
الفلسفة والعلم والفن
إذا كان العلم يعمل من خلال الوظيفة، والفلسفة تعمل من خلال المفاهيم، فإن الفن يعمل من خلال الموثرات، وتنقسم المؤثرات الى نوعين: ادراكي ووجداني. الأول خاص بعملية الإدراك الحسي للعمل الفني، فالفن يقول الدكتور بدر الدين مصطفى احمد “في الأصل مخاطبة للحواس، اي مرتبط بالمواد المشكّلة حسيا. اما الثاني فخاص بالمعنى الوجداني الذي يحاول الفنان أن ينقله لنا عبر مواده”.
والجانبان ملتصقان معا بحيث ينحو كلاهما نحو الآخر، فالمادة تتجه نحو المؤثر الوجداني في مادة تعبر عنه. وهذا يشبه الى حد كبير ما ذهب اليه الفيلسوف ميرلوبونتي من أن المعنى مباين في المحسوس، ومن أن العمل الفني يتكّون من نظيرين متلازمين، المدرك والمعنى، غير أن دولوز يربط هذه النقلة من المدرك الى المؤثر بمفهومي الصيرورة والترحال. أن الفن عند دولوز من وجهة نظر بدر الدين احمد، يحفظ المؤثر الوجداني من التلاشي، وهو اذ يقوم بهذا فإنه ليس مثل الصناعة التي تضيف مادة حافظة للأشياء كي لا تفسد، فما يحفظه الفن هو كتلة من الاحساسات، اي مركب من المؤثرات الادراكية والحسية.
هذا المركب مستقل تماما عن الفنان والمشاهد، فالعمل الفني موجود بصرف النظر عمن ابدعه، سواء شوهد ام لم يشاهد. والواقع أن فكرة الحفظ هذه قد تردد صداها من قبل لدى مارتن هيدغر، فقد ذهب هذا الى أن العمل الفني بعد انجازه يبقى هناك ليحفظ بواسطة شخص آخر غير الفنان، شخص آخر يندهش عندما يشاهد اللامألوف في المألوف، اي عندما يشاهد حدوث الحقيقة في العمل الفني، فيتخلّص من روتين الحياة والنظرة الاعتيادية للأشياء، ويغوص في الإنفتاح الذي يتخلل العمل الفني. ويؤكد بدر الدين احمد انه على الرغم من أن هيدغر يربط عملية الحفظ او دوام العمل الفني بتكشف الحقيقة، تلك العملية الجدلية التي تتم بين المشاهد والعمل الفني الذي له وجوده المستقل عن مبدعه ومشاهده، أي أن العمل الفني له بنية انطولوجية مستقلة بذاتها عن الخبرة وسابقة عليها. ونفس المعنى، يؤكد عليه دولوز حينما يقول: “ما زالت الفتاة محتفظة بالوضعية نفسها التي كانت لها منذ خمسة آلاف سنة”، وتلك اشارة لم تعد تتعلق بمن صنعها. فالعمل الفني منذ البداية يصبح مستقلا عن نموذجه. كما أنه ليس اقل استقلالا عن المشاهد.
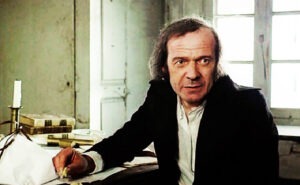
يبدع الفنان كتلا من المدركات والانفعالات عبر المواد التي يتشكل منها فنه، هذه المدركات تمثل ديمومة حتى لو تعرضت المادة التي تحملها للتغيير او التلاشي “إن الهواء يحتفظ بالحركة والنفحة والنور. التي كانت له في يوم معين من السنة الماضية، وهو لم يعد يتعلق بمن كان يتنفس ذاك الصباح”، حسب قول جيل دولوز. والاحساس لديه هو الذي يلوّن المواد ويصبغها بصبغته، على نحو ما اشار اليه سيزان في فن الرسم، كما أن الانتقال من مادة الى اخرى او من اداة الى اخرى، لا يتم الا عبر الاحساس، بمعنى أن الاحساس يختار المادة او الاداة الملائمة للتعبير، مثلما يتم الانتقال من استخدام الريشة الى الفرشاة او من آلة الكمان الى البيانو. وحتى على مستوى الأدب الذي يتكوّن من مواد عبارة عن حروف وكلمات، فإنه يحدث كثيرا أن يختار الأديب او الشاعر تعبيرا معينّا، لا يرضى عنه بديلا، او يستبدل كلمة بأخرى لأن الكلمة الجديدة تمنح مؤثرا وجدانيا ملائما لمركب الاحاسيس الذي يوجد داخل الفنان؟
ويشير بدر الدين احمد الى أن دولوز ينطلق في فهمه لوظيفة الفن من نيتشه، فالفن عند نيتشه مهمته تحرير الحياة من كل القوى المتافيزيقية التي دفعت الفن للانعزال عن الواقع، والانغماس في التجرّد والتعالي. ومن هنا النقد الذي وجهه نيتشه للاتجاهات الجمالية السابقة له، تلك التي عزلت الفن عن الحياة. وما يريده دولوز هو أن كل محاولة لتنزيه الفن وتجريده تنظر اليه من خارج التجربة الجمالية ذاتها، اي تنظر اليه من وجهة نظر المشاهد او المتلقي، من دون الوضع في الاعتبار تجربة المبدع. بعد كل هذا، لا ينفصل تصوّر دولوز للفن عن تصوّره الحيوي للطبيعة، بحيث يمكن القول أن كليهما جزء من الآخر، فالفن جزء من الطبيعة، والطبيعة يتخللها الفن، لقد تلوّنا بالوان العالم….