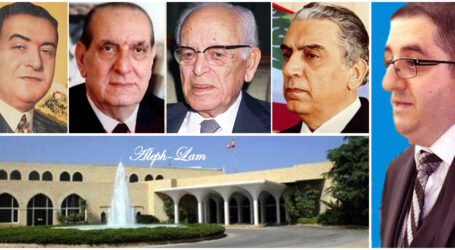ضدّ “ما قبل كورونا.. وما بعدها”
د. عز الدّين عناية*
خلال الأيّام الأولى من زحْف جائحة كورونا على إيطاليا، وقد طاش عقلي كسائر الخَلق جرّاء هَوْل الصدمة، داهمَتني هواجس جمّة، بعضها انقشعَ وبعضها لا يزال يُعاوِد الظهور. ففي أثناء انتظار دوْري لدخول “السوبرماركت” لاقتناء ما يَلزم، لَفتتني كتابةٌ على الجدار المُحاذي للطابور الطويل، تقول: “المترَفون قَتَلوا أكثر من كورونا”، فكانت بمثابة السلوى والسلوان لي في غمرة الصدمة التي كنتُ أعيش على وقْعِها.
والحال أنّه يلزم التعويل، في ظلّ هذا الضيق المُلِمّ بالبشريّة، على نصْح السرديني أنطونيو غرامشي “أنّ على المرء أن يكون مُتعفِّفاً صبوراً أمام ما تُخلِّفه الطامّة من فوضى فكريّة وأخلاقيّة، ولا تُثنيه الأهوال ولا تهزّه التفاهات، [لديه] تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة”، حتّى يتسنّى له تفهُّم ما يجري في عالَمنا والتعامُل معه برويّة.
لستُ في هذه المقالة بصدد الحديث عن جسامة الحدث الذي يعيشه عالَمنا أو التهوين من آثاره؛ ولكنّني في مُحاولة دحْض الوهْم وإزالة الغموض عمّا يلفّ هذه الجائحة من أَسْطَرة. فقد يقول قائل إنّ كورونا قد هزّت الجميع، مُترَفين ومَحرومِين، بما يحضّ على خَوْض مُراجَعة جماعيّة عميقة، في ما يشبه صحوة الضمير للخَلق. وعلى ما نرتئي أنّ ذلك وعيٌ رومانسيٌّ بسَيْر التاريخ مفعَم بالحسّ المسيحانيّ، من دون أن يُقدِّم عَوناً للضُعفاء والمحرومين للانعتاق من وطأة البؤس الجاثم على رقابهم، يَعِد بما وَعَد به النبيّ إشعياء في آخر الأزمنة: “فيسكُن الذئبُ مع الخروف ويربضُ النّمرُ مع الجَدْيِ والعجلُ والشّبلُ والمُسمَّنُ معاً وصبيٌّ صغيرٌ يَسوقُها… والأسدُ كالبَقرِ يأكلُ تِبْناً. ويلعبُ الصغيرُ على سَرَبِ الصِّلّ ويمدُّ الفَطيمُ يدَه على جُحْر الأُفعوان” (سفر إشعياء11: 6-10). فحتّى في أحلك أوقات الضيق التي نعيشها مع هذه الجائحة، لم نَسمع سادة العالَم يُعرِبون عن طيب خاطر عن تنازلهم قَيد أنملة عن امتيازاتهم وتطهّرهم من خطايا الجشع, وتبرّعوا للفقراء بكمّامة أو قفّاز يقيهم شرّ الجائحة. فلْتبقَ خرافة المراجَعة المنشودة جانباً ولتُواجِه البشريّة قدرها بعيداً عن الأحلام والخيالات. فليس بأيدي المَحرومين سوى شحْذ سلاح الوعي وتنمية رصيد الصبْر إلى حين ارتفاع هذا البلاء.
وأجزمُ أنّه آتٍ اليوم الذي تخرج فيه البشريّة من ضيق كورونا، حتّى وإنْ خلَّف زحْف الجائحة فجائعَ وضحايا وخسائر، وإنّ غداً لناظرِه قريب. ولذلك يبقى التعويل الأكبر على العُلماء الذن كرَّسوا حياتهم للمَخابر في إيجاد لقاحٍ مُضادٍّ لمَخاطِر هذا الوباء في الأشهر المُقبلة. فالجليّ أنّ الجوائح والمَصائب هي نُذُرٌ على ضفاف نهر التاريخ الجاري، حتّى يرث الله الأرض ومَن عليها، وليست انقلابات في نِظام سَيْر الاجتماع. ولهذا لستُ من مُشايعي القول بـ”ما قبل كورونا” و”ما بعد كورونا”، في ما يتعلّق بنِظام سيْر العالَم، ولا يستهويني الخَوض مع الخائضين في ذلك، وقد وجدَ رواجاً في تحليلات المحلِّلين ورؤى الرائين لِما يجري في أيّامنا. فلا أُعلّق آمالاً على اهتداءٍ مُباغِت للمُترَفين، ممّن يمسكون بمَقاليد الاقتصاد العالَمي، إلى نزوعٍ خَيريّ إنسانويّ، أو يقظة صوفيّة، بعد ارتفاع الجائحة. ولا أظنّ البتّة أنّ المَصرِف الذي يَستنزفني ويَستنزف الألوف مثلي، مع موفّى كلّ شهر، بتسديد دَيْن المسكن ودَيْن السيّارة وهلمّجرّا، سيُعفيني من تراكُم الفوائد التي تخنقني بلا شفقة، ويرأف لحالي بفضْل نِعَم كورونا.
وبالمثل لا أظنّ أنّ الدولَ المُرسْمَلة حتّى النّخاع، ستُغيّر من سياساتها الصحيّة والرعائيّة تغييراً جذريّاً، بعدما استحوذت الشركات العملاقة واللّوبيّات المؤثِّرة و”الكاستات” (الشِّلل) المُتنفِّذة على آليّة عمل تلك السياسات.
عَودة الرأسمال البشريّ إلى مِحور التاريخ
لذا لا أرى أنّ العالَم سيتغيّر كثيراً بعد انجلاء هذه الجائحة، وإنْ مَنَّى كثيرون الأنفُس بدخول قواعد جديدة، قد يكون أبرز مؤشّراتها عَودة الدولة إلى عهدها في تسيير مَقاليد الأمور، وما يعنيه ذلك من مُراعاةٍ للمصلحة العامّة، وتكثيفِ الرقابة، وتقليص التسيُّب. ومن ثَمّ تضييق الخناق على الخصْخَصة الجشعة، وما شابهَ ذلك من أحلام بعَودة الرأسمال البشري إلى محور التاريخ بعدما غدا على هامشه، حتّى طَغت فردانيّةٌ مُجحِفة على جميع مَناحي الحياة. ما هو جليّ، وبمنأى عن تلك الأحلام، أنّ التاريخ يتغيّر من داخله لا من خارجه، وأقصد أنّ البشرَ هُم صُنّاع مَساراته، بالسلب أم بالإيجاب، ضمن تحوّلٍ بطيء طويل، وليس وفْق تحوّلاتٍ مُتأتّية على وَقْع أحداثٍ خاطِفة أو جوائح مُرعِبة، مهْمَا كانت شاملة ومهما حصدت من أرواح. فلا يُمكن الحديث عن كبْح جَماح الاستغلال أو الحدّ من التفاوُت الاجتماعي، بفعْل تَوبةٍ مُباغِتةٍ للمُستغلِّين أو خشية جارِفة تُلِمّ بالمترَفين، ولكنّ الأمر كدحٌ يوميّ يصنعه المحرومون عبر نضالاتهم، بمُختلف الأشكال الإبداعيّة والعَمليّة والرمزيّة. فالجوائح والكوارث الطبيعيّة، مَهْما عظمت، لن تُغيِّر البنى الاجتماعيّة، لأنّ لتلك البنى منطقها وقواعدها الداخليّة، ولأنّها، وببساطة، تتغيّر بوقائع من جنسها تقف على نقيضها.
وما يقلقني أن تزيدَ هذه الجائحة التي نعيشها من مَنسوبِ الوهْم لدى الشعوب المُنهَكة في التدافُع العالَمي، فيُخيَّل إلى بعضها أنّ أوروبا (إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من البلدان) ليست أفضل حالاً من شعوب جنوب العالَم ودُوله على مستوى الرعاية الصحيّة. والحال أنّه ليس هناك وجهٌ للمُقارَنة بين العالَمَيْن، ففي إيطاليا المنكوبة على سبيل الذكر، وقد تهاطلَ عليها العَون من كلّ حدب، من كوبا وقطر وتركيا والإمارات العربيّة المُتّحدة ومصر وتونس ورومانيا وألبانيا وروسيا وغيرها، بعدما تلكَّأ الأقربون، يملك أفراد الشعب فيها والمُهاجرون بطاقةَ علاجٍ مجّانيّة، ولكنّ بليّة كورونا التي حصدت عدداً وافراً من الأرواح في هذا البلد، هي بليّة مُستجدّة وزاحِفة ومُباغِتة.
وما أخشاه كذلك أن يُفاقِم الهلعُ الأبوكاليبسيّ سَلْبَ المؤمِن عقله، فيغدو ترقُّب العناية الإلهيّة أفيوناً وسلوى. لأنّ العناية الإلهيّة، وببساطة، لا تأتي بإتيان سلوكاتٍ “فيتيشيّة” مُدجَّجة بالتمائم والتعاويذ، أو باستحضار وعيٍ إحيائيّ وطوطمي، في علاقة الخَلْق بالذّات الإلهيّة، ولكنْ في ما يتخطّى ذلك، بالوعي بما فرّط فيه الإنسان من عدلٍ واعتدالٍ في البيئة والاجتماع، حتّى لا نكون كالذين “كذبوا على أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون” (الأنعام، الآية: 24). وسأستعين في بيان ذلك بواقعتَين إحداهما ممّا مضى، والثانية ممّا نَعيش:
يروي أحمد بن أبي الضيّاف في “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان” (الجزء: 4، ص: 134)، أنّه حين حلَّ الوباء بتونس في سنة 1266هـ/ 1850م واشتدّت الضائقة بأهالي الحاضرة، أمرَ أحمد باشا باي، وبإشارة من القاضي الحنفيّ الشيخ مصطفى بن محمّد بيرم، بانعقاد مَوكبٍ خاشعٍ، وتمّ انتداب أربعين شريفاً من أبناء الحاضرة اسمهم محمّد، ليجتمعوا في جامع الزيتونة من الصباح إلى الظهر ليقرأوا “سورة يس” أربعين مرّة، وليدعوا الله بدعوات حرّرها لهم، ناقلاً ذلك عن بعض كُتب الصالحين، داعين الله ليضمحلّ المرض بفضله ورحمته.
ومنذ أن حلَّ وباء كورونا البغيض بإيطاليا، راجت سوق الغيبيّات. وإنْ كان هناك شيء إيجابيّ لهذه الجائحة، فهو في تعْرية زيف السياسات، وكشْف مستور المُجتمعات، التي تتبجّح حكوماتها بالعناية بالإنسان. لأنّ هناك عالَماً تُسيِّره الشركات العملاقة والعابرة للقارّات، هدفه الربح والسيطرة على الأسواق، وما الإنسان إلّا أداة في دَورة الاستغلال هذه. لا نقول كانت كورونا ضرورة وحاجة، لأنّ بؤس العالَم في غنى عن تمنّي بؤس جديد، ولكنّها كانت صيحة في وجه اللّامُبالاة، حتّى يستفيق العالَم من غفوته بعدما غدا صراخ المظلومين بلا معنى، وأنين الجياع بلا أثر، وتظلُّم المُهاجرين بلا رجْع، في ظلّ التبلّد المُعولَم للأحاسيس واللّامُبالاة الجماعيّة الطاغية.
فقد كان الفقراء والمهمَّشون والمشرَّدون، ولا زالوا، شرائحَ مُجتمعيّة خارج الحسبان في العديد من دول العالَم، ليس هناك رعاية تستهدفهم سوى من قِبَل أولئك الذين يقفون حقّاً في صفّ المَحرومين. ومع كورونا تحوَّل هؤلاء المستضعَفون إلى قنابل موقوتة على أنفسهم وعلى غيرهم، على حدّ سواء. ولعلّ الدرس المُهمّ الذي وقف عليه الجميع، ظَلَمةً وضحايا، هو هشاشة عالَمنا، فليس هناك أحدٌ، بسبب ذلك التفريط، في مَأمنٍ من كابوس كورونا، ولو كان في بروجٍ مشيَّدة. ومن هذا الباب ليس العالَم ما مضى، بل ما هو كائن وما سيكون، ومن ثمّ نحن في حاجة إلى بناء أحلاف جديدة وعهود جديدة حتّى نُنقِذ عالَماً بات عرضةً للتهديد باجتياح جوائح أخرى هي أخطر على الإنسان: الاستغلال الفاحش، والمديونيّة الخانقة، والجهود المسروقة، والبلدان المفلِسة، والشعوب المُحاصَرة، والطبيعة المُستنزَفة، هذه هي الكورونات الحقيقيّة.
تبقى وفرة التناوُل لموضوع فيروس كورونا في المجال الإعلامي والتحليلي، في مجملها، من خارج المُعالَجة العِلميّة، وهو ما يجعلها كتابةً هشّة ومائعة وليست كتابةً صلبة وثابتة، فالقول الفصل لدى العُلماء الذن كرَّسوا حياتهم للمَخابر أو رهبان المَخابر، ولعلّ ذلك ما دفعنا منذ البدء للحديث عن ضرورة نزْع الأسْطَرة عن الموضوع.
***
(*) أستاذ تونسي – جامعة روما- إيطاليا
(*) مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق