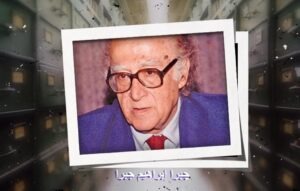“المؤثرات الأجنبيَّة في الشِّعر العربي المُعاصر”
وفيق غريزي
تنطلق الدراسات الادبية المقارنة، التي تبحث أثر الآخر في الذات، من هاجس العلاقة بالآخر، من السعي إلى التخلّص من ارث أجنبي ثقيل ترزح تحته الذات ولا تجد وسيلة للتخلص منه أو انكاره. ولا يغرّنا في هذه الحال الاعجاب الشديد بالآخر الذي تصرح به بعض الدراسات المقارنة والانسحار الشديد الذي تعبّر عنه، فالانسحار عادة ما يخبئ في ثناياه غيرة واحساسا بثقل وجود الشخص أو الأمة المؤثرة. ” ومن هنا فإن الدراسات المقارنة التي تنطلق من الاعتراف بدين الذات للآخرين تنطوي على طبيعة مزدوجة، فهي من جهة تعمل على التنقيب عن الأصل في تجربة الذات الثقافية، يدفعها الى ذلك العمل احساس بثقل وطأة ما استعارته أو تمثّلته من الآخر، ومن جهة ثانية تعمل على كتابة تاريخها غير المتجانس الذي عملت الثقافات الاجنبية على التأثير فيه والتفاعل معه “.
وفي هذا الإطار، عُقدت حلقة نقدية في مهرجان جرش الثالث عشر في الأردن، وهذه الحلقة تمثل واحدة من حلقات البحث المميزة التي انعقدت تحت قبة المهرجان العالية، وقد ضمت بين المشاركين اسماء كبيرة في النقد والثقافة العربيين وفي مقدمة هذه الأسماء الشاعر والناقد والمترجم الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، وقد جُمعت دراسات هذه الندوة، وصدرت في كتاب تحت عنوان “المؤثرات الاجنبية في الشعر العربي المعاصر”. وفي التقديم قالت نائبة رئيس اللجنة لمهرجان جرش، ليلى شرف: “لا اعرف أن عصرا من عصورنا الأدبية قد كتب عنه ونوقش وثارت حوله الخلافات عبر مراحله المختلفة تأسيسا ومعالجة للمضامين والبنيان مثل الشعر العربي المعاصر، ومع ذلك فإن موضوعا مثل “المؤثرات الاجنبية”، في هذا الشعر يبقى موضوع الساعة، بل لعله يعود الى البروز بشكل اكثر حدة باعتقادي ونحن نشارف نهاية مرحلة التأثيرات الاجنبية وبداية مرحلة جديدة “.
ومن المؤكد والثابت اننا نلج اليوم عالما فتحت فيه ابواب الاتصال والتواصل الفني والثقافي والعلمي، بل والإنساني عامة. وزالت الحواجز وقربت المسافات وانتشرت المعارف العامة، وستختلط عمليات التأثر والتأثير في النتاج الثقافيين عالمنا الجديد بشكل يصعب تحديده، ولكنه لا بد من أن يترك آثاره العميقة على التكوين الحضاري لمعظم شعوب العالم، بوعي أو بغير وعي بشكل لم نشهد له مثيلا بعد في تاريخ العالم الحديث.

تنصيص الآخر
حاتم الصكر، تناول هذا الموضوع في مداخلته فقال: “بدلا من استقصاء المؤثر الأجنبي والغربي تحديدا، كما دأبت الدراسات النقدية أن تحدد، سأحاول فحص مقولة التأثير ذاتها، لأعثر على الكيفيات المنجزة، والممكنة للصلة بالمؤثر”. ويرى الصكر أنه لا يمكننا أن ندرس موضوع التأثّر والتأثير دون إطاره المقارني. فقد نشأت هذه المقولة في ظل صعود الأدب المقارن وازدهار اطروحات المدرسة الفرنسية خاصة، حيث حدد المقارنون الفرنسيون حقل الأدب المقارن وفاعليته بالتأثّر والتأثير ومن خلال صلات “واقعية” بين الآداب والأدباء في بلدان مختلفة وبلغات مختلفة.” ونقف هنا عند تأثير ما يسمّيه فان تيغيم: “التأثيرات المتنقلة أو المشعة”، ويعني بها تلك التجسدات الحاصلة بسبب صورها عن نقطة مشتركة (كتاب أو مجموعة كتب وافكار)، وتشع هذه النقطة في اتجاهات عدة، فنجدها في بلدان اجنبية كثيرة “.
ويخلص الصكر إلى القول إنه وجد “أن المستوى الفني هو الجدير بدراسات نقادنا، لأنه يضيء نقاط العتمة والتخلّق والتطور في الأنواع الأدبية وتأسيس شعرياتها، وهو ما يريد له أن يظل تحت سلطة الهوى وعقد التفوق أو الرفض التام لأي التقاء أو الرفض التام لأي التقاء أو اشتراك إنساني في فضاء الأدب.

بنية القصيدة العربية
الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي اكدت في مداخلتها، أن: “الأثر الناجم عن احتكاكاتنا بالثقافة الغربية كان حاسما في جميع الحركات التي استهدفت تغييرا جذريا في القصيدة العربية.
فمنذ مطلع القرن راح أمين الريحاني يحدث العرب عن امكان كتابة الشعر بالنثر، وعن شعر والت ويتمان الذي تأثر به. والريحاني ابو الشعر المنثور، ولعله اكتسب اللقب لا بقدرة تأثير انتاجه من الشعر المنثور على القارئ العربي، بل بقوة تأثير الأفكار، والنظريات التي رافقت هذا الانتاج”. لقد كانت النماذج الشعرية الغربية المتحررة مثالا حاول الشاعر الحديث أن يحتذيه، ولا شك أن التعددية الثقافية حافز مستمر على التأثير والتأثّر، انما في ما يتعلق بتجارب الشعر العربي الموزون المحرر، فهذه نبعت من قلب النظام الشعري العربي، وليست هجينة عليه، بل كانت كامنة في يوم تمسك به نظام الشطرين. اما الشعر المنثور وقصيدة النثر فهذان لهما قصة مختلفة.
أما الدكتور حسام الخطيب، فقد شدد على أن قضية القصيدة العربية تشكل موضوعا ساخنا جدا على الساحة الأدبية العربية، وتثير مناقشات حادة وأنماطا جاهزة من الاتهامات والاتهامات المضادة وتبدو في أحيان كثيرة كما لو أنها الشغل الشاغل لجمهرة متذوقي الأدب وهواة الشعر، والذين يبدون تعطشا شبه محموم لتحديد مصير القصيدة العربية ومستقبلها من خلال لعبة شد الحبل بين انصار الشعر العمودي وانصار الحداثة على اختلاف اتجاهاتهم والإمداد التي تتطلع اليها تجريباتهم.
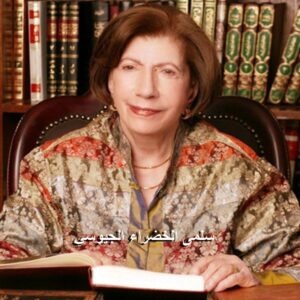
الأسطورة وتحولاتها
الراحل جبرا إبراهيم جبرا، تناول في مداخلته الأسطورة وتحولاتها في القصيدة العربية المعاصرة، وقال: ” في أواسط الخمسينيات، ولا سيما بعد نشر ترجمتي لكتاب فريزر” تموز” (أو ادونيس) برز في الساحة العربية عدد من الشعراء الذين أطلقت عليهم يومئذ في احدى دراساتي النقدية، تسمية “الشعراء التموزيين”، وقد برزت في شعرهم هذه الفكرة الساميّة القديمة من جديد، ازاء المتغيرات كان من الطبيعي للشاعر الذي اراد من الصراع غلبة الحياة على الموت أن يلجأ إلى الأسطورة الوحيدة التي تتخذ فيها كل هذه الشخصيات، الأسطورة التي ابتدعتها وتغنّت بها حضارة ارضه وأسلافه: اسطورة تموز، ومقتله بناب الخنزير، ونواح عشتار عليه وبحثها عنه في العالم السفلي، وموات الأرض في غيابهما، ثم عودتهما معا، وعودة والزهر والسنابل والثمار إلى الارض “.
ووصل جبرا إلى القول: “إن التخيّل الأسطوري يبدأ عندنا على نحو فاعل في اواخر الأربعينيات، ويشتد ويقوى طوال الخمسينيات، واذا هو في بعضه اندفاع جديد للمخيلة العربية، وتفجّر آخر لطاقات الكناية واللغة والرمزية، تحقيقا لطاقات بات الأدباء يرونها تتجسد في أساليب وطرائق في القول، وسعت الرؤية، ووسعت النفس، ووسعت من قدرات الكلمة على تفتق المزيد من فضاءات التجربة لحواس الإنسان وعقله وعواطفه، كلها معا، وعملية تفخيم النص الشعري المعاصر.”
ولم تكن مجرد موقف ينتصر للحداثة، بل كانت تحمل في ما تخفي منها تسليما مضمرا مسكوتا عنه بأن جميع محاولات التملّص من الشعر القديم والإفلات من سلطانه متعلّق لا يطال وغاية لا تدرك، ذلك أن القديم يظل دائم الحضور في اللحظة الحاضرة، لا سيما أن النص القديم، لا يمضي نهائيا، اما الحاضر (النص الحاضر – المعاصر) فإنه لا يحضر بالكل، بل يحضر معه، في تلاوينه، يحضر الماضي ويفعل في السر فعله.
هذا الأمر تناوله الدكتور محمد لطفي اليوسفي في مداخلته المعنونة “القصيدة المعاصرة- نداء الأقاصي واستكشاف الذات”، حيث أكد أن هذه القضية “تمتلك تاريخا ولها مدى”، فلقد بدأت منذ مطلع القرن وتواصلت إلى اليوم، ويكفي هنا أن نورد ما يقوله ميخائيل نعيمة في كتابه “الغربال”، وما يقوله ادونيس في بيان الحداثة.. والنصوص التي تم احتواؤها وترويضها، تلك التي صارت تحت مفعولات الترويض والتدجين والاحتواء.. وفي ضؤ منجزات النص المعاصر، يتم استكشاف واعادة بناء في ضؤ النصوص الواقعة في الهامش.. ما يقوله النص المعاصر يعتبر نداء الأقاصي واستكشاف الذات.
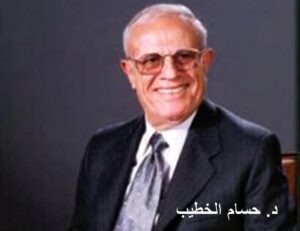
ترجمة الشعر
إن الأثر الأجنبي، عن طريق الأصل والترجمة، هو من مكونات القصيدة الحديثة المفعلة والنثرية، الشاعر عباس بيضون رأى أن “من التواريخ الممكنة لهذه القصيدة تاريخ ما دخل فيها من أثر أجنبي، وإذا عدنا إلى بدايات القصيدة الحديثة وجدنا أن الترجمات تحضر بنفس قوة الآثار المنتجة “.
ويضم الكتاب مداخلات لكل من فاضل تامر “الرمز الأسطوري والقناع في الشعر العربي الحديث”، والدكتور محسن جاسم الموسوي “تقلبات الأسطورة وتحولات الصورة والتلميح في قصيدة البياتية”، وفخري صالح “يانيس ريتسوس في الشعر العربي المعاصر، ولادة قصيدة التفاصيل”، والدكتور عبد النبي اصطيف “تحولات بغماليون في الشعر العربي الحديث، الفن والزمن”.
إن اختيار هذه الموضوعات واختيار النقّاد المميزين لمعالجة هذه الموضوعات، اثبت ضرورة إيصال هذه الدراسات إلى المتلقين العرب، ومن الثابت أن المتلقي سيجد موضوعات تطرقت الى قضية مهمة وهي المؤثرات الاجنبية في شعرنا العربي المعاصر.