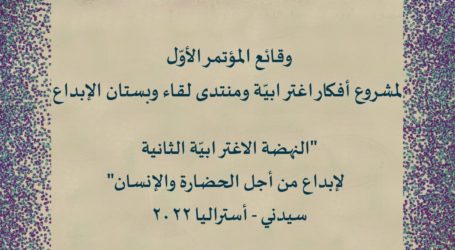لبنان التربية ضحيَّةُ جائحتين: جائحة كورونا وجائحة منظومة الفساد والإفساد
د. مصطفى الحلوة
مدخل/ لبنان التربية ضحيَّةُ جائحتين
إستهلالاً، أتقدّم بجزيل الشُكر من الهيئة الداعية إلى هذه الفعالية التربوية، إذْ أتاحت لي الخوضَ في موضوع، يتّسِمُ براهنيَّةٍ قُصوى، مما يجعله على درجة كبيرة من الأهمية. فهذا الموضوع مُدْرَجٌ بحدَّةٍ على جدول أعمال البشرية، كما هو مُدرَج، بشكلٍ أكثرَ حِدَّةً، على جدول أعمال لبنان، المُتخم بهمومٍ وشجونٍ، تُطاولُ سائر البُنى المجتمعية والإدارات العامة والمرافق الخدمية. على أن ما يُضاعف من اهتمامي بالمسألة أنَّ الموضوع، الذي نُقاربُهُ، يَردُّني إلى ثمانينيات القرن الماضي ومطلع تسعينياته، حيثُ كنتُ، بكل تواضع، في قلب المشهديَّة التربويّة اللبنانية، مع كوكبةٍ من نقابيين مناضلين، رأوا إلى التعليم رسالةً قبل أن يحسبوها مهنةً يُعتاش منها. ولقد قُدِّرَ لي القيام بهذا الدور، من موقعي رئيسًا لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الشمال، ومن ثَمَّ من موقعي في الجامعة اللبنانية، إذْ كنتُ مُنسِّقًا لـِ” لجنة المتابعة” للبناء الجامعي الموحَّد في الشمال.
وإذْ أتوفَّرُ على “المعاناة التربوية في زمن الطوارئ”، بما يخصّ لبنان تحديدًا، فقد تخيَّرتُ عنوانًا آخَرَ لمقاربتي، أكثر استجابةً للمرحلة الاستثنائية التي يُكابدُها اللبنانيون، ولنغدُوَ أمام العنوان الآتي:” لبنان التربية ضحيَّةُ جائحتين: جائحة كوفيد- 19، وجائحة منظومة الفساد والإفساد”. وتعليلُ ذلك أن الكلامَ على المعاناة التربوية في زمن الطوارئ، ينبغي ألاّ يُقتصر على النتائج دون الأسباب الفاعلة والخلفيات العميقة.
وتفصيلاً، فإن الأزمة التربوية الراهنة، بتداعياتها الخطرة، ليست نتاجَ الجائحة الكورونية وحدَها، بل ثمة جائحةٌ أشدُّ فتكًا، تتمثَّلُ في الانهيار المُريع، الذي تشهدُ البلادُ فصولَه باطّراد، وأبرزُ مشهدياته: إفلاسُ الدولة، بل تفليسُها على أيدي طُغمةٍ فاسدة ومُفسدة، والسطو على مُدَّخرات اللبنانيين، من مُقيمين ومغتربين، وإفقار الشعب، بل تجويعُهُ، وتطفيشُ الكثير من شرائحه الشبابية، لا سيما المتخصصة والجامعية، في أربع جهاتِ المعمورة. وهذا ما انعكس بشكل جِدّ سلبي على البُنية التربوية، وعلى المسار التعليمي، الذي يشهدُ تعثّرًا غير مسبوق.
هكذا، والحالُ هذه، نجدُنا أمام أزمة مركّبة، شديدة التعقيد، فإذا تيسَّرَ للبنان التعافي من جائحة كوفيد- 19- ونحن الآن في الهزيع الأخير من هذا الوباء- فإنَّ من الصعوبة بمكان مُعالجة حالة الانهيار العام، التي استعرضنا أبرزَ عناوينها آنفًا.
في هذا الإطار، ثمة أسئلةٌ/ هواجسُ، لا بُدّ من تطارحها وتفكُّرها، بصوتٍ عالٍ:
- هل تستطيعُ البنية التربوية، بكل تشعُّباتها ومرتكزاتها، البقاء في ثلاّجة الانتظار حتى يتعافى لبنان، ماليًا واقتصاديًا، وقد يستغرق هذا التعافي، بحسب تقديرات الاقتصاديين، سنواتٍ لا تقلُّ عن عشر؟
- واستطرادًا هل تُتركُ الأجيال الطالعة لمصيرها المشؤوم، حيثُ لا تبدو أقباسُ ضوءٍ في الأفق؟
- وهل يُرتجى إصلاحٌ وتعافٍ، على يد الطُغمة الجاثمة على صدور اللبنانيين، وهي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الكارثي؟
لبنان الزمن التربوي الجميل!
إذْ يذهبُ علماء المنطق إلى أن “الأشياء لا تُعرف إلاّ بأضدادها” لا بُدَّ أن نُمسِكَ بطرفِ خيطِ المسألة التي نُعالج، وذلك بالعودة إلى البدايات، إلى لبنان الزمن التربوي الجميل، الذي يُشكِّلُ النقيض من لبنان الزمن الرديء راهنًا. فهذا البلد تميَّز بريادتِهِ، تربويًا وعلميًا وثقافيًا، على مرِّ القرون الماضية. فلقد شهد الجبل اللبناني- قبل قيام الكيان (1920) – إنتشارًا واسعًا للمدارس، منذ ما يقرب من أربعمائة سنة، بسعيٍ من الرهبانيات المسيحية، لا سيما المارونية. وإلى ذلك كان الجبل موطئًا لعدد من الإرساليات الأجنبية، التي حلَّت في ربوعه. فقد وَصَلَه الكبوشيون في العام 1626، وحلّ الكرمليون في العام 1635، وتلاهم اليسوعيون في العام 1656، ولتكرّ بعد ذلك سُبحة مختلف الإرساليات الأوروبية والإنجيلية. وكان لهذه الإرساليات أن تُنشئ المدارس في أرجاء الجبل اللبناني، ولاحقًا في المدن الكبرى (بيروت- طرابلس- صيدا.. الخ)، إلى جانب المدارس الأهلية.
في استعراض تعاقبي زمنيًا، نجدُنا أمام المشهد التربوي الآتي: مدرسة حُوقة في جبَّة بشري، أنشأتها الكنيسة المارونية في العام 1624، وقد جرى نقلُها سنة 1670 إلى قنّوبين/ مدرسة دير القمر، أنشأتها الرهبانية المارونية سنة 1752/ مدرسة عين ورقة في غوسطا (كسروان – الفتوح)، وهي مدرسة مجّانية، أُنشئت سنة 1798/ مدرسة دير المخلص (صيدا) أُنشئت سنة 1831/ المدرسة الأهلية الوطنية للمعلم بطرس البستاني، أنشأها بمساعدة المبشّرين الأميركان سنة 1863. ناهيك عن المدارس التي أنشأها اللعازاريون، وأبرزها في عينطورة سنة 1834، واليسوعيون، والكرمليون والأنجيليون، وصولاً إلى مدارس البعثات الروسية (الأرثوذكسية).. وبذا كان انتشارٌ للمؤسسات التعليمية على مساحةِ الجغرافيا اللبنانية. ولا ننسى، في هذا المجال، المدرسة المارونية في روما، التي أنشأها البابا غريغوريوس الثالث عشر، في 5 تموز سنة 1584، لتُشكِّل همزة وصلٍ بين الشرق والغرب، مُشرِّعةً أبوابَها أمام التلامذة الآتين من الجبل اللبناني- ولبنان لاحقًا- لإتمام علومهم الدينية (اللاهوتية) والدنيوية العليا. وقد تخرّج منها رجالاتٌ عِظام، كالبطريرك أسطفان الدويهي، وإبراهيم الحاقلاني وجبرائيل الصهيوني، والسمعاني وسواهم.
إشارةٌ إلى أن السلطنة العثمانية لم تُنشء المدارس في الولايات التابعة لها (مدن بيروت وطرابلس وصيدا..) إلاّ بدءًا من العام 1835، وهي مدارس مُتواضعة، بالقياس إلى المدارس التي استعرضناها آنفًا.
هذه المشهدية التربوية، على صعيد المدارس، تمَّ استكمالُها عبر التعليم الجامعي، الذي عرفه لبنان، لأوّل مرة، مع الجامعة الأميركية في بيروت (1866)، وجامعة القديس يوسف (اليسوعية) في العام 1875، وكلية بيروت الجامعية (1924)، التي تحوّلت في العام 1996، إلى الجامعة اللبنانية الأميركية”(L.A.U.). ومنذ منتصف القرن العشرين شهدنا قيام عددٍ وافٍ من الجامعات: جامعة الروح القُدس (الكسليك) في العام 1950/ الجامعة اللبنانية (1951) / جامعة بيروت العربية (1960) / جامعة سيدة اللويزة N.D.U. (1987) / جامعة البلمند (1988).. وهي جامعاتٌ معتبرة، وليصل عدد الجامعات والمعاهد الجامعية في لبنان راهنًا إلى حوالي الخمسين، والكثير منها عبارة عن “دكاكين” جامعية، إذا جاز القول!
من مقلبٍ آخر، وعلى مستوى التعليم الرسمي، ما قبل الجامعي، فقد عرف انتشارًا كبيرًا، مع انطلاق المرحلة الاستقلالية، وليشهد هذا التعليم، لا سيما التعليم الثانوي، عصره الذهبي، نهاية خمسينيات القرن الماضي وستينياته وحتى منتصف السبعينيات، وغدا مُنافسًا جدِّيًا للتعليم الخاص. وقد أفضى ذلك إلى جعل الشهادة الرسمية اللبنانية ذات سُمعةٍ طيِّبة ومقبوليةٍ عالية، لدى الجامعات، خارج لبنان.

حرب السنتين ومرحلة الانحدار التربوي (1975- 1990)
كان لحرب السنتين العبثية (1975- 1976)، التي اندلعت في العام 1975، واستمرت، عبر جولات من الاحتراب المتنقل بين منطقة وأخرى، حتى العام 1990، أن تُشكِّلَ محطةً مفصليَّةً خطيرة في تاريخ لبنان المعاصر. فهذه الحرب أدَّت، فيما أدّت، إلى شلّ الحياة العامة، في جميع مجالاتها ووجوهها. وقد تمثَّل ذلك في تدمير البنى التحتية والإجهاز على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة، وتعثُّر أداء المرافق الخدمية. ناهيك عن الخسائر البشرية، بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى والمعوّقين، وإلى تهجير داخلي، وإلى هجرةٍ خارجية، هي أكبر موجات الهجرات، التي عرفها لبنان، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وفي الإطار التربوي- وهو الجانب الأساسي في مقاربتنا- فقد أُغلقت غالبيةُ المدارس، جرّاء جولات العنف، التي طاولت جميع مناطق لبنان، مما أفضى إلى تشتُّت الهيئة التعليمية والطلبة، وإلى قيام حواجز بين المناطق (شرقية وغربية).
ناهيك عن المخاطر الأمنية، التي أفضت إلى جرائم مروّعة، أبشعها القتل على الهوية… كل أولئك شكَّل بداية الانحدار، على المستوى التربوي التعليمي. ومن أول مظاهر هذا الانحدار، لجوء وزارة التربية، بداية الحرب، إلى تكثيف العامين الدراسيين 75- 76 و76- 77 في عام واحد، حتى لا تضيع سنة من عمر الطلبة. وكانت امتحاناتٌ صُوَرية، وترفيع “أوتوماتيكي”، لجميع الطلبة. ومن تجليات الانحدار أيضًا، نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي، منح طلبة الصفوف المنتهية إفادات نجاح، بدلاً من الشهادة الرسمية لتعذُّر إجراء الامتحانات الرسمية، خوّلتهم الالتحاق بالجامعات، مما أدّى إلى تراجع مستوى التعليم الجامعي، لا سيما في الجامعة اللبنانية. وهكذا، راحت الشهادة اللبنانية تفقد سُمعتها، وغدت موضع فحصٍ، لدى الجامعات في الخارج.
عودة الروح غير كاملةٍ إلى لبنان التربية (1990- 2019)
ما أن وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، مع “وثيقة الوفاق الوطني” (اتفاق الطائف)، في العام 1989، ومع قيام الجمهورية الثانية، عبر دستور الطائف (1990)، حتى راحت مؤسسات الدولة وإداراتها العامة وقطاعاتها الحيوية، تلتقط أنفاسها وتستعيد، شيئًا فشيئًا، وضعها الطبيعي أو شبه الطبيعي.
هكذا، على المستوى التربوي، كانت “خطة النهوض التربوي”، سنة 1994، التي تمّت ترجمتها وتطبيقاتها العملانية، عبر التعديلات التي شهدتها المناهج التعليمية، وهي الأكبر في تاريخ لبنان، وذلك في العام 1997 (بموجب المرسوم 10227/ تاريخ 8/5/1997)، وقد كان للانتظام الدراسي أن يشقّ طريقه، في جميع المناطق اللبنانية، وأُعيدَ الاعتبار، بحدودٍ معينة، إلى الشهادات الرسمية اللبنانية. علمًا أن القطاع التربوي (الرسمي) لم يبرأ من شوائبِهِ، بل من أعطابِهِ البنيوية المزمنة، وأخُّصها هيمنة السياسي على التربوي، أي تدخّل السياسة بالتربية، عبر ما يُعرف بالزبائنية والسلوكات النفعية. وهذا ما أفضى إلى تضخُّم القطاع التعليمي الرسمي، من خلال بدعة التعاقد، فكانت أعدادٌ ضخمة من المدرّسين غير الكفوئين، لا سيما في التعليم الأساسي. وعلى رُغم هذه الثغرات، فإن القطاع التعليمي لدينا بقي واقفًا على رجليه، ومحافظًا، بحدود مقبولة، على المستوى التعليمي وسُمعتِهِ.
لبنان التربية في ظلّ الطامّة الكبرى والانهيار المتُسارع!
حفل العامان 2019 و2020 بأحداث دراماتيكية، نقلت لبنان من ضفّة الاستقرار النسبي إلى ضفة تسودُها إضطرابات ومخاطر جمّة. ففي 17 تشرين أول 2019، انطلق حراك شعبي عارم، لم يشهد لبنان مثيلاً له، في تاريخه المعاصر، في وجه المنظومة الحاكمة، تحت شعار:” كلُّن يعني كلُّن!”، مما أدّى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الدين الحريري، بعد اثني عشر يومًا من انطلاق هذا الحراك. ومع الحكومة السابقة، حكومة الرئيس حسان دياب، بدأ العدّ العكسي للانيهار المالي والاقتصادي، بخُطى سريعة. وقد جاءت جائحة كورونا لتزيد طين الأزمة العامة بِلَّةً، فراحت البلاد إلى شلل شبه تام، على جميع الصُعُد، وجاء الحَجْرُ المتقطِّع ليزيدَ الأمور سوءًا.
ومن مظاهر هذا الشلل، على المستوى التربوي، إغلاق المدارس والجامعات، في طول البلاد وعرضها. وقد كان لانفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020) أن يرفع من منسوب الإنهيار التربوي، إذْ تضرّرت عشرات المؤسسات التعليمية، من رسمية وخاصة، الواقعة في النطاق الجغرافي، الذي طاوله هذا الانفجار.
تداركًا للوضع التربوي وإنقاذًا للعامين الدراسيين: 2019/2020 و2020/2021، عمدت وزارة التربية والتعليم العالي، على غرار دول العالم، إلى اعتماد التعليم الإلكتروني والاعتماد على المنصات الرقمية للتعلّم من بعد، بالتلازم مع التعليم الحضوري الكلاسيكي، وليكون ما دُعي التعليم المدمج، أو الهجين (HYBRIDE).
ولقد كان لهذا النمط من التعليم المستجدّ تداعياتٌ أكاديمية واجتماعية ومالية مُكلِفة، جرّاء عدم جهوزية لبنان لوجستيًا، لا سيما لجهة توفير منصّات الكترونية وشبكة انترنت قويّة، وتجهيزات وتيار كهربائي. هذا على صعيد الدولة والإدارة التربوية العُليا. أما عن عدم جهوزية الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية، كما الطلبة (والأهل)، فإن الوضع لم يكن بأحسنَ حالاً.
ومما يؤكد على حالة القصور وعدم الجهوزية، لدى السلطة اللبنانية بعامة، والسلطة التربوية بخاصة، بإزاء تداعيات جائحة كورونا، ما عكسَهُ تقرير “المنتدى العربي للتنمية”، الذي دعا إلى تسريع العمل نحو خطة العام 2030، إذْ رأى أن “الجائحة حفّزت الجميع على التحرّك والاستثمار والتطوير والابتكار، وحثَّت على التوجه نحو التفكير في الاستراتيجيات الاستباقية، عوضًا عن التفاعلية، للتغلُّب على الأزمات المستعصية” (عُقد المؤتمر في بيروت، نيسان 2021).
إشارةٌ إلى أن الأزمة لم تُطاول المدرسة الخاصة، بقدرِ ما طاولت المدرسة الرسمية، ذلك أن قطاع التعليم الخاص، يتميَّز بالمرونة، فاستطاع في مدة وجيزة أن يُُجهّزَ نفسه للتعليم من بُعد، ويعمل على تدريب كوادره التعليمية على هذا النمط من التعليم. ولكن، من مقلب آخر، فإن للقطاع الخاص همومَه، فهو يمرُّ بأزمة مالية حادّة، ولم يعُدْ قادرًا على الوفاء بمطالب سلكه التعليمي المحقّة، في وقت يعجز أهالي الطلبة عن تأدية الأقساط المدرسية الآخذة في الارتفاع، بسبب التضخّم المتصاعد في وتائره.
وبما يخصُّ الطلبة، بل أهاليهم، فهم بغالبيتهم الساحقة عاجزون عن مواكبة النمط الجديد للتعليم، جرّاء أوضاعهم المالية والاقتصادية المتدهورة، والمستوى التعليمي المتدني، لدى قسمٍ كبير منهم. وفي هذا المجال، لنا أن نتوقف عند تقرير “البنك الدولي”، حول التعليم في لبنان (صدر في حزيران 2021)، الذي جاء تحت عنوان:” التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان”، ومما جاء فيه:” إن الأزمة في لبنان، بما نتج عنها من زيادة معدّلات الفقر، خلَّفت تأثيرًا مباشرًا على طلب خدمات التعليم، ومعدّلات التسرُّب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السُكَّان دون خطّ الفقر الوطني، مع الانكماش الاقتصادي وتدنِّي القوة الشرائية، والتدهور في ظروف المعيشة. ومن المتوقّع أن يتجّه المزيد من الآباء والأمهات إلى نقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في السنوات القادمة، وأن تزداد نسبة تسرُّب الأطفال من المدارس، لا سيما ضمن الأُسَر المهمَّشة”.
في تعقيب على هذا التقرير، نرى أن الوقت لم يطُلْ، إذْ غدا 85% من اللبنانيين تحت خط الفقر، حيث كانت نسبتهم، مع صدور التقرير في حدود 50%.
استكمالاً، وبحسب التقرير، فإن تدفق النازحين السوريين على لبنان، منذ العام 2011 (وعددهم مليون ونصف المليون) صبَّ الزيت على نار أزمتنا العامة، وشكَّل ضغطًا كبيرًا على القطاع التربوي، إذْ ثمة آلاف الطلبة السوريين يتلقون التعليم في المدارس الرسمية، خلال الدوام الصباحي ودوام ما بعد الظهر.
وإذْ نروح إلى المعاناة التربوية راهنًا- أي زمن الطوارئ- بما يخصّ الوسائل المعتمدة في التعليم الإلكتروني (التعلّم من بُعد)، فقد أثبتت هذه الوسائل، بقدرٍ كبير، عدم فعاليتها لدينا، إذْ ثمة أعطابٌ بنيوية ومُشكلات مُستجدة، لدى جميع أطراف الهيئة التعليمية الأربعة (الإدارة التربوية، والهيئة التعليمية، والطلبة والأهالي). هذه الأعطاب والمشكلات تترجّح بين عوامل ذاتية، أي مختصة بهذه الأطراف، وبين عوامل موضوعية، لصيقةٍ بالأزمة العامة أي من تجلياتها، كما أسلفنا.
وإذا كان لنا أن نمنهج مظاهر هذه المعاناة، فإننا نُدرجُها على الوجه الآتي:
أ- المعاناة/ المعوِّقات العائدة للإدارة التربوية العُليا
- موارد مالية قليلة وهيكلية مخلخلة، على مستوى المرجعية التربوية العُليا.
- اتخاذ القرارات بصورة آنية (ad hoc) وفي تنفيذها.
- لا تدريب لمديري المدارس، علمًا أن المدير ينبغي أن يكون الضابط الأول للعملية التعليمية في مؤسسته التربوية.
- عدم تمكُّن وزارة التربية “والمركز التربوي للبحوث والإنماء” من إجراء دورات تدريب لجميع أفراد الهيئة التعليمية على المعلوماتية الرقمية.
- جعل عدد أسابيع العمل في القطاع الرسمي 13 أسبوعًا بدلاً من 36، وتقليص المادة التعليمية إلى حدود دُنيا.
- صعوبة تقييم عمل الطلبة في ظل النمط الجديد للتعليم.
*من باب الإنصاف، فقد كان للمركز التربوي أن يقوم بإنتاج الكتاب المدرسي الرقمي، أو الكتاب الإلكتروني، وهو تطبيق مجاني، وُضع في متناول جميع المتعلمين في لبنان، سواءٌ أكانوا في القطاع العام أم الخاص، كما لدى الأهالي، بدءًا من صفوف الروضات، بتمويل من USAID. ناهيك عن تدريب مستمر في المراكز التدريبية (عددها 33) المنتشرة على الأراضي اللبنانية، للطاقمين التدريسي والإداري، في مراحل التعليم ما قبل الجامعي (تدريب حضوري، وآخر عن بُعد، وثالث هجين، يجمع بين الصنفين المذكورين).
.. علمًا أن ثمة ورشة لتحديث التربية ووضع طرائق جديدة للتعليم قائمةٌ راهنًا على قدمٍ وساق في”المركز التربوي”، من منطلق الإدارة الرشيدة للتربية والحوكمة. وثمة لائحة من القضايا المزمع إنجازُها على مراحل مُتعاقبة، بدأت أولاها في 15 آذار 2022 (التوجهات العامة للمناهج)، وليبدأ تطبيق المراحل الأولى للمناهج في المدارس الرسمية والخاصة بحلول أيلول 2024.
علمًا أن هذا البرنامج الطموح (9 نقاط) مرهونٌ تنفيذُهُ بما ستؤول إليه أوضاع لبنان (راجع اللقاء التشاوري التربوي/ إنقاذ وتعافي التربية، بتاريخ 18/2/2022، الموقع الإلكتروني للمركز التربوي).
ب- المعاناة/ المعوّقات، بما يخصّ الهيئة التعليمية
- الأميّة المعلوماتية والرقمية، لدى غالبية القطاع التعليمي، لا سيما في التعليم الرسمي.
- عدم الإلمام التام بطريقة التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة، سواءٌ لجهة الأجهزة المُستخدمة، أو لجهة تطويع الأسلوب القديم ليتناسب مع الأسلوب الجديد في التعليم.
- عدم قدرة المعلمين، بل غالبيتهم، على تصميم دروس شاملة ومشوِّقة.
- إنفاق المعلّم تكاليف الإنترنت ومتابعته عليه لساعات طويلة من دون حصوله على أي تعويض (حُكي عن حوافز- 90 دولار بسعر منصة صيرفة- لا يمكن قبضها من كثيرين من المعلمين لوضع المصارف سقفًا للسحوبات المالية!).
- بسبب التباعد المكاني (أو الاجتماعي) بين المعلم والطالب، فإنّ من الصعوبة وجود تفاعل أو حوار تفاعلي بينهما. وهذا يُرهق المعلم كما الطالب، إذْ يتحوّل التعليم إلى تعليم تلقيني.
ج- المعاناة/ المعوِّقات، بما يخصّ الطلبة
- عدم شعور الطالب بالجِديّة والالتزام، اللذين يقدمهما له التعليم، بالطريقة الجديدة.
- عدم تحفيز الطلبة، عبر التقنية الجديدة في التعليم، وعدم حُسن إدارة الوقت.
- تقليص حجم المكتسبات، التي تقع ضمن تكوين الرأسمال الثقافي للطالب، وهذا ما يُنافي التعليم الناشط، الذي تكرِّسُهُ المناهج التعليمية في لبنان (1997).
- ارتفاع الكلفة المادية على الطالب المتعلم (بل أهله)، لا سيما في قطاع التعليم الرسمي.
- غالبية الطلبة غير مجهزين بحواسب أو ألواح إلكترونية، فهم يُتابعون الدروس من خلال هواتفهم الخلوية. وهم يعيشون مُعاناة، لا سيما عندما يُرسل المعلم ملفات أو وثائق، مما يتسبّب بإرباك لديهم، إذْ تضيع هذه الملفات والوثائق، بخلاف ما عليه الأمر حال استعمال الحاسوب.
- الحجر المنزلي للطلبة ومنعكساته السلبية على الطالب، لا سيما الصغار، وعدم القدرة على التركيز في الحصة الواحدة لأكثر من 15 دقيقة.
- عدم جلوس الطلاب الأطفال أمام الشاشة لوقت طويل، فهم معتادون على الحركة في صفوفهم.
المعاناة/ المعوّقات، بما يخصّ أهالي الطلبة
- عدم قدرة الأهل على دفع كلفة الاشتراك بكهرباء المولدات الخاصة (الكلفة فاحشة راهنًا).
- عدم استطاعة جميع الأهل، لا سيما الأمهات، مواكبة أبنائهن تعليميًا، والتسمُّر معهم أمام الشاشة، وتزداد المسألة تعقيدًا إذا كان ثمة عدد من الأبناء يُتابعون هذا النمط من التعليم، وبوجود حاسوب واحد أو هاتف خلوي واحد.
- أولوية الهم المعيشي، لدى الأهل، على ما عداه من هموم، بحيث يأتي الهم التربوي في درجة ثانية.
*بيّنت دراسة استقصائية، أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR (نيسان 2020)، شملت 10 آلاف عائلة مُحتاجة أن نصف هذه العائلات فقط تمتلك تلفازًا في المنزل، في وقت لا تملك فيه أي عائلة تقريبًا أجهزة لوحية أو حواسيب، بل تمتلك هاتفًا ذكيًا واحدًا. وعن إنفاق هذه العائلات، فإن العائلة الواحدة تنفق ما بين 25 إلى 50 ألف ل.ل. على خدمات الانترنت لهواتفهم شهريًا، مما يعني أنه إذا استمرَّ ارتفاع الأسعار بسبب التضخّم، فلن تبقى العائلة قادرة على تغطية هذه التكاليف. وقد بيَّنت الدراسة أيضًا انتشار الأمية بين هذه العائلات، بحيث أن 60% منها فقط يُجيدون العربية، و9% يُلمّون بإحدى اللغتين، الإنكليزية والفرنسية.
هـ- المعاناة/ المعوّقات، على الصعيد اللوجستي
- ضُعف شبكة الانترنت في لبنان، بحيث يتعذّر، مرّاتٍ متكرِّرة، فتح روابط الدروس بسهولة.
- شبكات الاتصالات والبنى التحتية للانترنت ما زالت غير قادرة على تلبية احتياجات الكثير من المناطق الريفية (المناطق الأطراف).
خاتمة- هل يكون التعليم من بُعد مُستقبل التعليم في العالم وفي لبنان؟
على رُغم المعاناة/ المعوّقات ، التي استعرضناها، بشكل تفصيلي، وهي من تداعيات التعليم الإلكتروني (التعليم من بُعد)، يذهب الباحث في التربية د. عدنان الأمين، إلى أن ثمة إيجابيات لهذا النمط من التعليم، يُدرجها، وفق الآتي: تعزيز الإدارة الإلكترونية/ التوثيق والمكتبات وقواعد المعلومات الإلكترونية/ تصميم المناهج (المعايير والمواد والموارد والوثائق) وتوفيرها بصيغ رقمية وغير رقمية/ المشاركة الفعلية للمديرين والمعلمين وتنفيذها على أساس المهام (Tasks) وإفساح المجال لمساهمات الطلبة وتكثيف التواصل الرقمي/ إدخال لجان الأهل والسلطات المحلية في شبكة المنظومة التعليمية. (راجع، د. عدنان الأمين، دراسة عنوانها: التعليم في زمن كورونا/ ورشة خبراء سياسات التعليم في ظل جائحة كورونا في البلدان العربية- 14 شباط 2021).
إشارةٌ، في هذا المجال، إلى أن التعليم من بُعد ليس حديثًا، بل المصطلح هو حديث. فمنذ أكثر من مائتي عام، ظهر هذا النظام واتخذ أشكالاً مُتعدِّدة، وتطوّر مع التعليم التقليدي، حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن. وقد بدأ بطريقة المراسلة، واستمرّ بعض الوقت، حتى ظهرت المحطات الإذاعية، لتقدّم هذا التعليم بطريقة جديدة، وصولاً إلى التلفزيون والمحطات التلفزيونية، وبثّ المواد التعليمية على القنوات. كان سماعٌ، ثم كانت مشاهدة المعلّم، ثم تطوّر مع ظهور الأقراص المدمجة (C.D.). وفي المرحلة الأخيرة كان للإنترنت، أهمية هذا النمط من التعليم وصول أي طالب إليه، في أي بلد من بلدان العالم، في حال توافرت اللوجستيات والعناصر اللازمة.
ويبقى السؤال، الذي يُجيب عنه المشتغلون في عالم الرقميات بـِ”نعم”: هل يكون التعليم من بُعد هو مُستقبل التعليم في العالم وفي لبنان؟
إنَّ غدًا لناظره قريب!
***
*ألقيت في قصر رشيد كرامي البلدي- طرابلس/ الأربعاء 27 نيسان 2022، بدعوة من “الشبكة العربية للتربية الشعبية/الائتلاف التربوي اللبناني”، بمناسبة أسبوع العمل العالمي للتعليم.