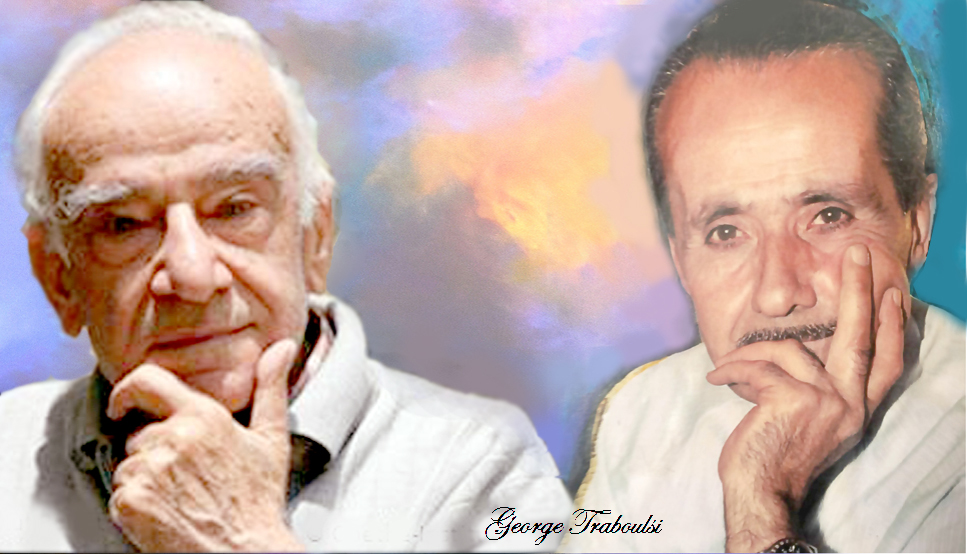شعرية فؤاد رفقة ودلالاتها الفلسفية
وفيق غريزي
إن وضع شاعر كبير بحجم الشاعر الدكتور الصديق فؤاد رفقة على بساط البحث والدراسة والمناقشة ليس بالامر السهل، نظرا لعمق نصوصه الرؤيوية، حيث تسبر كنه الفيزيق والميتافيزيق في آن معا، وتطرقها الى أدق القضايا الجوهرية الداخلية والخارجية في الوجود البشري. وقد اعطى رفقة اللغة دلالاتها الفلسفية، البعيدة المنال عن كثير من الشعراء العرب. ومهما حاولنا تحليل نصوصه الشعرية، نبقى عاجزين عن الاحاطة الشاملة الحقيقية بها، لان للشعر ابعادا من الصعب ادراكها الا بالحدس فقط.
فؤاد رفقة هو واحد من شعراء الحداثة العربية، ولقد تفرّد في قضية الوجود والزمان، ومارس السوريالية من خلال صوفيتها، ولما كانت الحركة السوريالية تهدف الى تحرير الانسان من عبثية الواقع المعطى، بفعل التصادم بين الفطرة وآلية الزمن، فكل نتاج رفقة الشعري هو تعبير عن القلق الوجودي، حيث احتل الزمن حيزا كبيرا، الزمن في الحياة والشعر معا، وسعى باحثا عن “يوتوبيا” السوريالية التي كانت تتوق الى تحقيقها.

الشاعر والشعرية والعالم
“ولك ابراجي وما غنيت فيها/اسماء الورقة/لك ضوء الحدقة/لك اشيائي الامينة/صلواتي للعصافير الحزينة”.
الشاعر -الانسان يهب وجوده وكينونته الى الآخر، سواء كان انسانا او ارضا او وطنا، عبر الكلمة المنغمة (القصيدة). فالانسان المبدع هو نقطة الدايرة، الهيولى الذي تخرج منه العناصر الوجودية والمعنوية والشعر العظيم، او النص الشعري لا يولد في كل لحظة، والشاعر لا يمارس بطولة او شهادة، وحيدا يصاحب ليل القصيدة، يسير بين الاعشاب الوحشية، والكواكب السرية، والحجارة السعيدة، فلربما يعثر يوما على ضوء يتفجر فجاة في انحاء ماء وتراب، وحيدا وهو يبصر عيلة الشعراء بكل اللغات، تشير الى نار الخلق:
“مثلهم نحن انتظار/فوق جسر الليل، نستهدي/نسوي/لشفاه الاخرين/اغنيات الحب والاسفار والحضن الامين”.
الانسان في ظلمة الوجود ينتظرالخلاص والهداية عبر اغاني الشعراء الذين هم بمثابة الضوء الذي يبدد ستر العتمة، ويفتح ابواب الحب، للقلوب الظامئة، والاسفار نحو الحرية الى الراحة الابدية. فالابداع حنين يخضع للوعي، للتقعيد، يعلن موته في حياة الآخرين، وهو بالتالي
“مراوحة بين الوعي واللاوعي، بين التذكر والتجربة والحلم، بين الاثبات والنفي”.
“ان تضيء الجهات/أن تهبط الآتي/ ومن نجمة المغور تهدى/للمسافات زهرة وحبيبة”.
حين ينهار الحلم لدى شاعرنا تفرغ الاشياء من دلالتها الأولى، وتصبح السماء خلاء، في رؤيته وروياه على حد سواء:
“يفتح عينيه/فلا يرى شيء/غبش في الهواء/يغمض عينيه/يرى كل شيء/ شموس واقمار”.
الشاعر في نص رفقة الشعري، كالساحر، والعالم بالغيب، كما كان عند العرب القدماء ومفاهيمهم التراثية – الخرافية، فهو لا يرى من حقايق الوجود سوى الظواهر (القشور) عن طريق عين الجسد، في حين يرى شاعرنا ما وراء الظواهر عن طريق البصيرة والرؤيا النبوية، ويدرك علة المعلولات، واسرار الخلق والخليقة، فكل شاعر اصيل له فضاءاته وسماواته، بنجومها وكواكبها، كما له ابعاده ومسافاته، فيقول رفقة: “في طريقي الى الوجود الشعري عبرت مرحلتين: مرحلة اولى تنتهي بمجموعتي “انهار برية” ومرحلة ثانية تشتمل على “يوميات حطاب”، و”سلة الشيخ درويش”، و”قصائد هندي احمر”، التي صدرت في المرحلة الأولى”. واضاف: “كان الرحيل وكان الضياع وكان الموت نجمتي الكبيرة”.
في هذه المرحلة كان سفينة تهزها الزوابع وما من خليج، وفي المرحلة الثانية تحوّلت قصيدته الى امكانية، فالتحمت بالكون، بعناصره، باشيائه، وفيها وجد الأمان والحماية في رياح الزمنية، بهذا المعنى تحوّلت قصيدته في المرحلة الثانية من الذاتية الى الكونية، ومن القلق الى السكينة.

من الذاتية الى الانساني الى المطلق
تخطى الشاعر رفقة بين المرحلتين رياح الزمنية العابثة، العاتية، واجتاز حدود الذاتية – الفردانية المثقلة بالقلق والاضطراب الى الانسانية – والكونية الشاملة – الى المطلق، الى سكينة الموت والاستقرار، الى “النرفانا” البوذية، أي انطلاق من الوجود المادي المحسوس الى دائرة المعنوية اللامحسوسة. يقول:
“كل مساء يدق الناقوس/يفتح الابواب/يضيء الشموع والايقونات/في هيكل الرب/يقدِّم الذبيحة ”
هذا الخط التصاعدي، في اتجاهات الشاعر، يعبر حدود الاسطورة، والقيم التوراتية – المسيحية. فالشاعر يقدّم القرابين تكفيرا عن خطايا البشر من ذاته. والشعر لدى رفقة له مظهر اللعب الطفولي، البريء ظاهريا، لكنه في المضمون ليس كذلك، فاللعب يجمع بين البشر، لكنه بحيث ينسى كل منهم ذاته في غمرة اللعب، ام في الشعر نحن نرى أن الانسان ينكب على عمق اعماق وجوده في العالم وبذلك يتوصل الى الدعة.
فالشاعر في هذا المنطلق كالمسافر ليلا، يترقب باستمرار اضاءة البرق ليرى طريقه، غير أن غياب هذه الاضاءة البرقية، يعني الليل الطويل – الازمة. والحقيقة هي أن الشاعر بمعنى الشعر، غالبا ما يسكن عالم الضيق المادي، لدرجة أن الوجود الشعري قد صار مقرونا بالتشرد، والفاقة. والامثلة على ذلك لاتعد ولا تحصى. وكم من شاعر مات منبوذا فقيرا معدما. والشاعر يزهد اراديا بكل ما هو ارضي – مجتمعي، ولكن لا يعني هذا الزهد نفي المتطلبات الحياتية للاستمرار في العطاء، فالعادة لديه وسيلة لغاية سامية، لهدف معنوي انساني، لا يمكن أن يتحقق الا عن طريق المبدعين فقط، لان الشاعر في الحقيقة “يقف كالدليل بين البشر والالهة”، بمعنى انه يشكّل جسرا بين الوجود الانساني على الارض، والوجود الالهي – السماوي. وما يبقى ويدوم يؤسسه الشعراء لا رجال السياسة. فالانسان عامة غني بالمزايا الرفيعة، لكنه يحيا شعريا على هذه الارض. والمعاناة الوجودية التي يعيش في غمرها الشاعر هي الوحدة التي تربط التراجيديا والملحمة، لان الألم لا يكون المًا حقا الا اذا كان شعلة الروح المضيئة والكونية لدى الشاعر لا تنفي حقيقة موجودة وهي “الحدودية” أي الارض التي يولد ويترعرع في احضانها، ومن ترابها ومائها يغتذي، والى هذه الارض يكون انتماؤه الأول، ومن هذا الانتماء ينطلق الى الانتماء الاوسع اللامحدود. وشاعرنا في نصوصه الشعرية الأولى قدّم لنا صورا مشرقة عن هذا الانتماء “الوطني” ليس بالمفهوم السياسي، وانما بالمفهوم الانساني، فيقول:
“تسالني يا سيد/من اي تاريخ انا اتيت/من كنف الجولان، من قبيلة هناك/تحب لون الارض/ثمارها/ونجمة كبيرة/تحب عند الضفة الاخيرة/تحب ما تجهله عيناك/ منها انا اتيت/من حفرة موشومة بالرفض”.
لأن الدخول في العالم هو في الوقت نفسه قبض على العالم، فان الولادة هي ايضا في اساس نظام عضوي يبحث عن ذاته من خلال ما يحيط به، فهي “ولادة مع العالم” وان الولد “لا يفعل اكثر من مجرد الاحساس المسبق بذلك. اما الفتى البالغ فهو الذي في ما بعد، اذ يرمي نظرة على وطنه، سيكتشف في الجهات الاربع النداءات الداخلية التي تصنع كينونته واثاره”. وهذا يتولّد في الذاكرة، فالذاكرة هنا تنظم الرؤيا – ذاكرة الأثر التي تبحث عن منابعها. وذاكرة الشاعر رفقة، غالبا ما سوف تعيد صهر الماضي، حتى ليتمكن القول انه متحرق، في شوق لا يرتوي، الى أن يعثر في تربة ارضه، على بصمة اصيلة كشف له الزمن معناها:
“من زمان لم تحاورك الاقاصي/ام يراوغ وجهك الاعصار/ لم تقرأ قصيدة/ انت يا شعبي/ولم تنصت الى الريح”.

كل شيء رماد في رماد
إن العالم يسير بسرعة البرق قافزا قفزات نوعية نحو التطور في مختلف المجالات الحضارية العلمية منها، والاقتصادية والسياسية والثقافية، حتى أنه تخطى حدود هذا الكوكب الارضي الى كواكب الفضاء الخارجي، وبلادنا ما زالت ترزح تحت عبء العصر الزراعي بكل ذهنيته وعقليته وثقافته وتخلفه، بالاضافة الى تجزئته واستعماره، والامراض القبلية والعشايرية والاقليمية والطائفية التي تنهش جسمه المترهل المفتت، وفي خضم هذا الواقع البائس اطلق الشاعر رفقة صرخته المدوية الى شعبه، لرؤية رياح العصر الجديد ومواكبتها، كى لا تقذفه الى خارج التاريخ الانساني. وازاء ذلك يقف الشاعر متسائلا عبر الالام:
“ايتها الالام/يا جذوع القلب المثقلة/متى تنعقد البراعم/وبعد فصول تندفع الثمار! ”
عندما انطلقت الشرارة الأولى للمقاومة ضد العدو الصهيوني عام 1965، تفاءل الشاعر، ولكن سريعا ما تبددت في اعماقه سحب التفاؤل المشرقة، لتحل محلها غيوم التشاؤم السوداء، وهذه البلاد التي كانت عبر العصور والمحن كطائر الفينيق الذي يخرج من رماد العدم، ها هي اليوم في سبات يشبه سبات اهل الكهف:
“هوذا فارس الضروع اليابسة/فالرماد في الحناجر/الرماد في الارحام/الرماد في الخبز/الرماد/ انه خريطة الفصول المقبلة/والفينيق غائبة الى الابد “.
كل شيء رماد في رماد حتى امسينا وكأننا في “الارض اليباب” التي حدثنا عنها الشاعر
” ت. س. اليوت “، الرماد رمز الموت والعدم، فالعدمية التي تحيط بنا اليوم ستكبر وتتناسل في المستقبل، وكأننا دخلنا في نفق مظلم لا حدود له، من دون أن نرى امامنا ومضة تزرع الأمل في قلوبنا، فعصرنا هذا هو عصر المراثي والاحتفالات الجنائزية. إن المجتمع فاعل في وجود العالم وصيرورته، غير أن مجتمعنا العربي منفعل، لم ولا يختار حياته بمحض ارادته، انه مغلول في ماضيه وحاضره بالردع والاستعباد، مبعد عن الابتكار والتحرر:
“يا رفيقي/ايها الساهر في الكهف العميق/بين عينيك روى غيم الطريق/بعد حين/ يطلع النجم ويأتي/بالمسافات التي تعبرها/خلف سور العتبة/لمدى يرفع عنا حجبه”.
إن الشاعر الصديق فؤاد رفقة، من الشعراء القلائل الذين حملوا همّ الانسان والوطن كينونة ووجودا، واعطى نصوصه الشعرية دلالاتها الفلسفية العميقة…