غزل في عَينَيّ… قراءة في قصيدة “عزف على أوتار عينيها” لـ الشّاعر منيف موسى
ابتسام غنيمه
أيّها المنيف، يا ساكن الأعالي!
تخذلني الكلمات وأنا أحاول أن أدرس سطرًا من شعرك، فكيف بقصيدة؟! أنتَ يا مَن كنتَ متنسّكًا في صومعة الشّعر والنّقد، زاهدًا بمتاع الدّنيا، دأبك البحث والكتابة.
هل أستطيع أن أقرأك شاعرًا وقد عرفتك صديقًا يغدق عليّ حنان الوالد وحكمته بمحبّة لامتناهية؟ فلئن مرّت سنون، ما أزال أشعر برهبة لمجرّد ذكراك، رهبة الطّالب أمام أستاذه، رهبة الحرف أمام الكلمة، رهبة طفل يخطو خطواته الأولى أمام سبّاق في سُبل الحياة ودهاليزها. تفتح أمامي أبوابها لأدخلها، وترشدني لئلّا أضيع في شعابها، غير أنّ المنعطفات كثيرة، وعند كلّ منعطف خبرة تُنضج فكرنا: فإمّا أن نكبر وإمّا أن نصغر. ومعك، وبك، نكبر حتّى لو كنت اليوم تنظم الشّعر ذكريات في نفوس عارفيك.
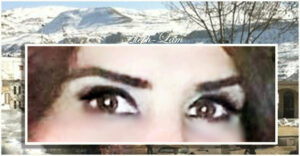
“عزف على أوتار عينيها”
بادرني د. منيف موسى، رحمه الله، يومًا، بقوله: “فازت قصيدتك بالمرتبة الأولى في…” وذكر اسم إحدى الدّول العربيّة التي سقط اسمها من ذاكرتي مع الأيّام. وأعطاني نسخة مصوّرة للقصيدة كاملة، عن مجلّة “مواسم” الصّادرة شتاء 1995.
انتشيتُ زَهوًا، وعادت بي الذّكريات إلى يوم زارني في بدايات شهر أيلول في منزلي الذي كنت أقطنه في حراجل، وكنتُ حينها طالبة عنده، وطلب منّي أن أعطيه كتابه “عاشق من لبنان” الذي كان قد أهدانيه منذ أشهر قليلة، فإذا به يفتح الصّفحة الأخيرة البيضاء التي تسبق المحتويات ويخطّ أبياتًا تشكّل القسم الأوّل من قصيدته “عزف على أوتار عينيها”، ويقول لي: هذه القصيدة كتبتها لكِ، أنتِ، يا أخت الضّباب، لأنّكِ تسكنين الجبل.
وبعد نشرها في مجلّة “مواسم” كما أشرت، نشرها في ديوان “إيقاعات على دفتر الحبّ” الذي صدر في طبعته الأولى عام 1999، ليعود فينشرها في “الدّيوان” عام 2001.
بداية، فرحت كثيرًا بهذه القصيدة، وكنت أقرأها مرارًا، أحاول أن أتقصّى أبعادها، أن أفهم رمزيّاتها، فكان الأمر يعصى عليّ أحيانًا كثيرة… ومرّت السّنوات إلى أن وجدت النّسخة المصوّرة بين أوراقي القديمة، تدعوني إلى قراءتها من منظور ناضج متجرّد من العاطفة الصّادقة والسّامية التي كنت أكنّها لأستاذي الرّاحل. وما أزال.

أخت الضّباب
قرأتُ مخطوطته الأولى، يوم كنتُ أخت الضّباب، ويوم لم يكن ثمّة عنوان للقصيدة… استلهمته، وأغلقت جميع النّسخ باستثناء المصوّرة عن “مواسم”، وبدأت أغوص في عمق بحره لأثملَ من خمرة كلماته وأدوّن ما تملي عليّ قراءاتي.
يستهلّ الشّاعر قصيدته بالمكان ويختمها بالزّمان ليؤطّرها ضمن حدود معيّنة وفترة زمنيّة واضحة. بالنّسبة إلى المكان فإنّ مصدر شوقه هو الجبل حيث ينتشر الضّباب، لتصبح الحبيبة جزءًا منه مثبتًا بذلك أنّ مقرّها الأعالي: “تسكنينني بالشّوق الطّالع من الجبل/يا أخت الضّباب”. وقد لجأ إلى فعل “تسكنينني” ليعبّر عن مدى اندماجها في كيانه واتّحادها في روحه؛ فهي ليست بعيدة عنه، إنّما تسكن قلبه وعقله والأعماق. ثمّ يتابع في تحديد المكان قائلًا: “وأنا ألقاك قطرة من ندى الزّعتر في حوافي الشّرق/الممتدّ عنفوانًا”. إنّ تعبير “حوافي الشّرق” يحيلنا إلى تفسيرين ربّما عمد الشّاعر إليهما قصدًا: فالجبال، بالنّسبة إلى لبنان، تقع في القسم الشّرقيّ منه. وقد يكون المقصود شرقيّ الكرة الأرضيّة، وربّما البلاد العربيّة، سيّما وأنّ لبنان يقع في حافّة من حوافي الشّرق، أي غربه، فهو على السّاحل المتوسّطيّ يفصل بين عالم الشّرق وعالم الغرب.
أمّا الزّمان فهو شهر زيارته للحبيبة، حين اشتدّ به الشّوق فحمله إلى أن يتكبّد مشقّة الانتقال من بيروت إلى أعالي كسروان ليراها. يقول: “ولأنّه شهر أيلول/شهر الشّعراء والعشّاق/يستفيق فيّ الجموح إلى عشقك السّامي”.

قصيدة نابضة حياة
وبين المكان والزّمان، وقّع الشّاعر أبيات “عزف على أوتار عينيها”، مستغلًّا، فضلًا عن حاسّة البصر، حاسّتَي السّمع والشّمّ، موظّفًا العناصر الملموسة لإبراز لوحة مبدعة لحبيبته ومشاعره تجاهها. فنراه يجمع أحيانًا بين الحواسّ لينحت قصيدة نابضة حياة بإزميل أحاسيسه تعبّر عمّا يتراءى له من صور ترسمها ريشة الرّؤية في سماء الشّعر.
فهو يستهلّ وصفها بما تراه عيناه العاشقتان في “سمرائه المغناج” ليدمج حاسّة البصر بالسّمع، فإذا بها “اللّون الرّفّاف في خاطر الكلمات صوتًا يوقظ الضّياء”.
وينطلق من لون بشرتها إلى جسدها الذي يصبح مصدر وحي ما إن ينظر إليه: “بين عينيّ وجسدك مسافة الشّعر”. فالقصيدة ترتسم أبياتها خلال الفترة التي يأسر فيها الجسدُ حاسّةَ البصر.
وتتابع عيناه النّظر ارتقاءً إلى العينين ليبدأ معزوفته العشقيّة من خلالهما، فنراهما تمارسان فعل السّحر عند التقائهما بعينيه. هذا السّحر الآتي من جبل البارناس موطن الآلهات الملهمات لدى الإغريق. كما تحملانه إلى اللّامتناهي، إلى “ضمير الأفق”، البعيد المنال حيث لا تطاله العين فيتّسع الخيال وتتبلور الأحاسيس أفكارًا وأحلامًا يكاد لا يدركها كائن لأنّها صعبة المنال، في عمق أعماق الأفق، في اللّامرئيّ الخفيّ، في الضّمير.

غجريّة سمراء
ويعود النّظر ليندمج بحاسّة السّمع في صورة تجعلها غجريّة سمراء: “ألاقيك أغنية في أكمام أزاهير البريّة”، إن تكلّمت بعثت الدّفء في جسده: “أدفأ في صوتك”. وتتدخّل حاسّة الشّمّ في صورة رائعة تتلاقى فيها ثلاثة عناصر مختلفة الدّلالات تشكّل مجتمعة أيقونة إبداعيّة: “وأنتِ السّابحة فوق عبير الحبّ”…
وفجأة تسقط نظراته من عينيها إلى صدرها، مصدر وحيه وإلهامه، حيث تغفو القوافي، كما يقول، “قصائد خضراء تناديني”. وتستوقفنا كلمة “خضراء” التي استعملها مرّة أخرى في قصيدته حين قال: “يا مولاتي الحلوة/وحدك الكلمات الخضراء/في دفتري…”. واللّون الأخضر يرمز إلى الحياة، إلى الاستمراريّة، إلى الفرح والتّجدّد.
ويعتبر علم النّفس أنّ “الحبّ أو الجنس هو مصدر النّشاط الفنّيّ والأدبيّ… وليست اللّذّة المتحصّلة من مشاهدة الجمال ومعاينته إلّا إشباعًا نفسيًّا جنسيًّا في حقيقتها”. فالشّاعر هنا يخرج ما يتفاعل في لاوعيه وأعماقه من مشاعر لم يشبعها إزاء حبيبته، فيعوّض عنها، ويتسامى عن الواقع الذي لم يستطع تحقيقه من خلال خلق واقع جديد متميّز يحلم به وينّفس عنه في قصيدته.
الاحتراق… عشقًا…
إنّ معاينته الجمال تجعله دومًا يعود إلى عينيها، فتبقيان العنصر الفعّال والحيويّ في معزوفته، فهو يغتسل بهما ليتطهّر، لأنّه بالعشق يتطهّر، بالنّار يتطهّر: “إحترقي فيّ […] أحترق عشقًا”، فمن خلال عمليّة الاحتراق يغيّر نظام الكون الذي يودّ أن يكون فيه موقدًا لا يضيء سبل الآخرين فحسب، كما تقول عقدة أمبيدوكل، إنّما سبل الحبّ… عندها، وبعد عمليّة التّطهّر، تتحرّك حاسّة السّمع لتقرع الأجراس مهلّلة “لمليكة العشق”.
وهما، إلى ذلك، تختصران الكون وتحتويانه، يرى فيهما الأرض والكواكب، لكن، ورغم هذه الرّحابة التي تملكها عيناها، فهما لا تستطيعان أن تضمّا كلّ الكلمات التي يمكنها أن ترسم “جمال الأنوثة في صفاء الحبّ”. فهو هنا يبدي عجز الأبجديّة في تلاقي حروفها وتشكّلها كلمات عن التّعبير عمّا يختلج في أعماقه من صور ترسم الحبيبة.
وخلال وصفه لها تبرز حالة القلق النّفسيّ الذي يعيشه. القلق النّاتج عن مشاعر مكبوتة، ينفّس عنها الشّاعر من خلال شعره، فتنطلق من اللّاوعي لتحطّ في الكلمات أحاسيسَ دفّاقة صادقة. فهو لا يخطّ حبرًا على ورق، لأنّ الشّعر كما يعرّفه في كتابه “في الشّعر والنّثر”: “صدى لعواطف القلب وأهواء النّفس”، والعواطف تتحكّم بالأعصاب، فلأنّ سمراءه في قلبه، ولأنّها تملك تفكيره، يحاول أن ينفّس بالكتابة، لكنّه لا يرتاح: “أكتبك بأعصابي/ولا أرتاح/لأنّك أشغولتي الأبديّة”. وبهذا نراه يدحض مقولة فرويد بأنّ الأديب الذي يحلم بالحبّ والمجد والسّلطة والثّراء تتحقّق له أحلامه ورغباته وأمانيه من خلال كتاباته الأدبيّة، لأنّ الشّاعر العاشق لم يجد الرّاحة حتّى بعد كتابته، فهو يعي الواقع، ويُعمل العقل، لا سيّما وأنّ العرب قد فسّرت القلب بالعقل أحيانًا، كما أنّ أبا تمّام يعتبر أنّ الشّعر صوت العقل. وفضلًا عن ذلك فهو يرى “أنّ الأصل في الفنّ… الحرّيّة في التّعبير والصّدق في التّجربة”، فنجده يعبّر بحرّيّة وبصدق عن تجربته وعمّا يخالج نفسه.

“العشق السّامي”
وبعد كلّ هذا الوصف المادّيّ تطالعنا الغرابة وتستوقفنا الدّهشة؛ فالحبّ الذي يحدّثنا عنه متوقّفًا مطوّلًا عند محطّات جسديّة، يفاجئنا بقدسيّته وسموّه؛ فهو ليس شهوانيًّا، بل مقدّسًا عمد إلى تمجيده بالكلمات التي تعبّر عن قدسيّته في القسم الثّالث من القصيدة: “ليتقدّس حبّك، أتمجّد في عينيك، في ملكوت صفائك، طقوس عشقك إنجيل حبّ، وسِفر في جمال حضورك”… إنّه غلوّ يرتقي بالحبّ إلى مراتب الألوهيّة للتّعبير عن ترفّعه في مشاعره إلى مرتبة “العشق السّامي”.
فهل مردّ ذلك إلى صراع نفسيّ يتقلّب به بين الرّغبة الشّهوانيّة والشّعور بالعجز عن المصارحة العلنيّة، سيّما وأنّ فارق السّنّ بينهما كبير جدًّا، وبتعبير آخر بين الجسد والرّوح؟ أو أنّه يعشقها إلى حدّ العبادة؟ أو أنّ حبّه لها قدسيٌّ فهي تمثّل الجمال الذي يستهويه بالمرأة لتكون منبع الوحي والإلهام، في حين أنّ أحاسيسه تجاهها سامية مترفّعة عن المقاصد الجسديّة؟ ألم يقل الشّاعر الإمام الشّافعيّ:
وعينُ الرِّضا عن كلِّ عَيبٍ كليلةٌ/ولكنّ عينَ السّخطِ تُبدي المَساويا؟
كلّها أسئلة تفتقر إلى الإجابة، غير أنّ القصيدة شكّلت في مجملها تحفة شعريّة فريدة.
عزفك أيّها المنيف سمفونيّة عشق بدأَتْ أنغامُها من عينيك لترتفع نغماتها في عينَي الحبيبة قصيدة تجمع المادّيّ بالرّوحيّ، وتسمو بالحبّ من دنيويّة هذا العالم إلى سماويّة آخر يسوده تأجّج المشاعر الصّافية، في رحاب طهارة قدسيّة تكتفي بالنّظر لتبعث مكنوناتها أغنية موقّعة على أوتار عينيها.








