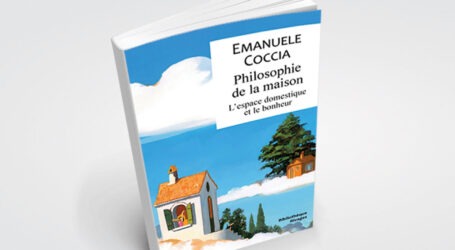الآخرون الأغيار
د. عبد الله إبراهيم*
ما من مفهومٍ اكتنفه الغموض والإبهام أكثر من مفهوم “الآخر” فلا حدود تحول دون انزلاقه من حقلٍ إلى آخر كلّما اقتضى الأمر. الآخر مفهومٌ عابرٌ للحدود الجغرافيّة، فلا يكبحه كابح قوميّ أو دينيّ أو أيديولوجيّ أو ثقافيّ. فيتلوّن بألوانها، ويخلط بين تلك الألوان، ولذلك يتعذّر تعريفه إلّا في سياقٍ متَّفق عليه، وبقدر تعلّق الأمر بالحضارات، بما فيها من ثقافات متنوّعة، فالآخر هو الدخيل المُزَعْزِع لهويّة الجماعة، باختلافه عنها، فهو المُغاير لها في الثقافة أو في المُعتقد أو في العرق أو في اللّون أو في الطبقة.
وقد يحاول الانتساب إلى جماعة هو ليس منها، وغالباً ما يخفق في مسعاه، فلا هي قادرة على قبوله بالحال التي يكون عليها، ولا هو قابل أن يتنازل عمّا ورثه من ثقافاتٍ ومعتقدات، ربما يقع نَوعٌ من التنازل يُبديه المضيّف للضيف، فيغضّ الطرف عمّا يندّ عن حيثيّاته التي تشكِّل قوام هويّته، وقد يُبادله الضيف بحسن الظنّ، ولا يجهر بما هو عليه، أو في الأقلّ، لا يتمسّك بما ورثه من مُعتقدات، وسوف يمرّ زمن طويل قبل أن تتهذّب مقاومة الطرفَيْن في عدم القبول من الطرف الأوّل، والنأي بالنفس من الطرف الثاني. إنّ حياة الأفراد قصيرة، والحقب التاريخيّة الطويلة كفيلة بابدال الإعراض إلى قبول، فاستيعاب ينتهي بنَوعٍ من الصهر والاندماج. وفي ضوء ذلك فقد كان الآخر موضوع أخذٍ وردٍّ بحسب الأحوال والغايات، إذ في ما يكون مرغوباً فيه وقت الادّعاء بالتنوُّع والتعدُّد، يصبح غير مرغوب فيه عند القول بالانسجام والتآلف.
ثمّة تمويه في إظهار الآخر على غير حقيقته، فترتهن مكانته بمقتضى تقلُّب الأحوال، فالآخر دخيل، ويقع فصمه عن نظام الانتساب العامّ لهويّة المجتمع الحاضن له، ويجري تمييزه بحسب شروط الأعراف السائدة في العاَلم الذي دخل عليه، وغالباً ما يكون موضوعَ إقصاءٍ إذا أُقحم في إطارِ جماعةٍ صافية المُعتقَد أو العرق أو المذهب أو اللّون. وحيثما وقع تقليب أحوال الآخر يرتسم نَوعُ الارتياب والالتباس. إنّ التفاخُر بقبول الآخر بما هو عليه، والزَّعم بأنّه شريكٌ كامل الأهليّة في الحقوق والواجبات، والتظاهُر باستيعابه استيعاباً تامّاً، وتكلُّف القول بأنّه بمثابة النَّفس، محض أقوال لا براهين عليها في السلوك الجمْعيّ العامّ خلال الحقب الزمنيّة القصيرة.
وليس خافياً أنّ الآخر، غالباً، ما يكون ضحيّة سوء التفاهُم الثقافي بين الأُمم حالما تشرع في تركيب صور مُتخاطئة لبعضها، وليس من قبيل البهتان القول إنّ معظم الأُمم مهووسة بتركيب صورٍ نمطيّة للأغيار لا صلة لها بحقيقة أحوالهم، فذلك هو دأبها في العجز عن هضْمِ الأغراب، وعدم قدرتها على استيعاب الدخلاء، فالآخر نتوء نافر لم يقَع محو بروزه، ولا استئصال جذره باستيعابه ودمجه. ذلك هو واقع الأمر في تجارب الأُمم عبر التاريخ، والأزمان وحدها الكفيلة بإعادة ترتيب أوضاع الآخر في المُجتمع الحاضن له إلى أن يفقد هويّته الأصليّة، ويذوب فيه بعد وقت طويل من الضيافة المتعثرة، فمآله النسيان الذي هو نوع من عدم الاعتراف به. ينبغي استئصال كلّ ما يذكّر بالماضي البعيد للآخر، فالجماعة المُضيِّفة لا ترغب في مَن يوقظها من سباتها الطويل. والحال، فتشتدّ حاجة الأُمم للاعتصام بهويّاتها الأصليّة في وقت الأحداث الجسيمة، والأزمات العميقة، والصراعات الكبيرة، فتخشى من الأغيار، وتنظر إليهم بعَيْن الارتياب، وغالباً ما تُسيء الظنّ بهم، أو في الأقلّ لا توليهم الثقة الكاملة، فالشعور الجمْعي يتوجّس خيفةً من الأغيار، ويحسبهم مصدر خطر، ولا يفتأ يرمي عليهم المساوئ، ويقدح بأصولهم، وألوانهم، ومُعتقداتهم.
ذلك هو النهج العامّ الذي نهجته معظم الأُمم في علاقتها بالأغيار، وهو نهجٌ تكراريّ اتَّخذ مظهرَ عادةٍ لا يُراد إعادة النَّظر فيها منذ الأزمنة القديمة. وكانت رهانات الأزمنة الحديثة غير تلك القديمة، فما عاد الإنسان عضواً منسوباً لجماعةٍ عرقيّة أو اعتقاديّة أو لونيّة، يتعرّف بها، وتتعرّف به، إنّما وقع تغيير في مَوقعه وهويّته، فقد أضحى ذاتاً تتعرّف بنفسها، وليس بامتدادها، تكتفي بشروطها الإنسانيّة، وليس بالروابط العرقيّة والدينيّة واللّونيّة. وبحسب هذا الزعم، فقد حلّ الانتماء الفردي للمرء محلّ الانتساب القومي أو القَبلي أو الديني أو اللّوني، فلا حاجة للتنقيب في أصله إنّما يُكتفى بهويّته الذاتيّة كائناً فاعلاً في المحيط الاجتماعي، ذلك هو رهان الحداثة، وتلك فرضيّتها العامّة. ولكن ليس من الصواب القول إنّ الأُمم كافّة قد استوعَبت ذلك التغيير، وأَخذت به، فما برحَ معظمها يرى في الآخر دخيلاً غير مرغوب فيه. فهو شخص انقطعَ عن سياق، وأَخفق في الانتماء إلى سياقٍ آخر.
الحداثة وترسيخ التبعيّة
ورّبما تكون الحداثة قد زادت من الأعباء التي تُثقل كاهل الآخر، فحمَّلته مزيداً من الأحمال الجديدة فوق أحماله القديمة؛ فلئن ذوَّبت بعض التخوم الحاجزة بين الأُمم، وفكَّكت الانحباس المُتوارَث، ومن ذلك الروابط التقليديّة، فقد أَوقدت فتيلَ خلافٍ من نَوعٍ آخر، لا يقلّ خطراً عن الأوّل، وهو إشاعة مفاهيم التفوُّق الحضاري، والثقافي، والديني، والعرقي، أي القول بتفوُّق أُممٍ على أُممٍ أخرى بذرائع كثيرة، ما جعلَ الآخر موضوعَ انتقاص، ومحلّ دونيّة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إنّما رسَّخت الحداثةُ نسقَ التبعيّة، وفجَّرت حراكاً فوضويّاً في عمق المُجتمعات التقليديّة، تأدّى عنه انهيـار الأنساق الأصليّة فيها، وبإزاء خطر التبعيّة الذي حملته الحداثة الغربيّة، أمسى من الضروري التفكير بحداثةٍ تقوم على التكافؤ، والشراكة، وليس التمايُز والتراتُب بين الأفراد والأُمم، حداثة تَضع الثقافات في منطقةٍ مُشترَكة مُتفاعِلة، وليس حجْبها وراء أسوار التفوُّق. وذلك، بصريح القول، استبداد نموذجٍ حضاريّ بالنماذج الحضاريّة الأخرى في العالَم، ما دفعَ إلى إعادة بعْثِ المُشاحنات العتيقة التي تخمّرت في طيّات القرون الوسطى، وأَمست تَظهر بإشكاليّات الهويّة، والتمدُّن، والخصوصيّة، والأصالة. ينبثق تفكيرٌ هَوسيّ بالماضي حينما يكون الحاضر مُعتماً، أو أنّه على مشارف تحوّلاتٍ جذريّة بسبب تغييرٍ داخلي يمور فيه، أو بفعل مؤثّراتٍ خارجيّة تُزعْزِع أركانه.
ثمّ إنّني أريد طرْقَ موضوعِ الآخر من زاوية القبول والاستيعاب، وليس الرفض والامتناع. فمن المحال قبول الآخر قبل التعرُّف إليه، فالتعارُف هو الخطوة الأساسيّة للقبول؛ إنّ اكتشاف الأغيار، وإدراك الاختلاف معهم، وقبول ذلك الاختلاف أمرٌ على غايةٍ من الأهميّة لأنّه يُفكِّك أواصر الانحباس في وهْم الهويّة الأصليّة، وعند توسيع القول في هذا الأمر بما يتخطّى حدود الأفراد إلى الأُمم، فإنّ كلّ تحالف بين الجماعات المُختلفة ينبغي أن يكون مسبوقاً بتعارفٍ شامل، فليس يقوم أيّ تحالف من غير تمهيدٍ بتعارفٍ يقود إليه، أقول بضرورة التعارف الثقافي قبل التحالُف الحضاري؛ لأنّ الثقافات أنظمة رمزيّة مَرنة تتّصل بالمُعتقدات، والاعراف، وهي الحاملة للأفكار والمشاعر، فتكون قاعدة للتواصُل، والتفاهُم، والتفاعُل.
وفي عالَم تنوَّعت حضاراته، ومُعتقداته، وأعراقه، فبالوسع القول إنّ ثقافاته هي الإطار الجامع لمظاهر الاختلاف، ولذا يُحسَن البدءُ بها، وبما تكون عليه؛ فقد انبثق مفهوم الثقافة من تداخُلِ جملة من المعارف، والآداب، والفنون، والأديان، والتقاليد، وانسبكت في قوالب من الأفكار، والعلامات، والرموز، والأعراف التي بها يعبّر الإنسان عن نفسه، وعن رؤيته العالَم الذي يعيش فيه، ومع ذلك، فالثقافات تتباين في تشكيلاتها، وفي قدرتها على الوفاء بما تَعِدُ به، وهو أمرٌ طبيعي، فحيثما يدور الحديث عنها، فلا محلّ للتماثُل، بل الاختلاف. وما دام الاختلاف هو السمة الرئيسة من سمات الثقافات البشريّة، فلا عجب أن تنشطر، في العصر الحديث، إلى تقليديّة ذات طابعٍ محلّي وإقليمي، وحديثة ذات بُعدٍ قارّي وعالَمي، وكلّ تيّار منهما يُعبّر عن مجتمعاته. ولا ينبغي الفزع من التبايُن الثقافي فهو محمود، وغايته استيعاب حاجات الإنسان، ولا تفلح ثقافةٌ بعَيْنها في الوفاء بها كلّها.
قال “ألان تورين” إنّ “الحداثة إنتاجٌ وابتكارٌ بمقدار ما هي وعي بالذات، وتحرير المجتمع من القوى التي ما زالت تأوي خلف جُدُر المقدّس” أي أنّها مزيج من “ابتكار الذّات بالعمل، وابتكار الحقوق الإنسانيّة”، فهي حركة ثقافيّة واجتماعيّة نزعتِ الإنسان عن هَيْمنة اللّاهوت الديني. وما اقتصر أمرها على الجوانب الاقتصاديّة والسياسيّة، فهي، في عُمقها ونتائجها حداثة ثقافيّة. الحداثة، كما أُريد لها أن تكون، وسيلة تحرير الذات الإنسانيّة من أعباء الدّين والطبيعة والتاريخ، فتُعيد تعريف تلك الذات باعتبارها ذاتاً فاعلة في ابتكار أفعالها وأفكارها. وهذا رهان لم تفلح الحداثة في حمْلِ أثقاله كّلها، فتعثّرتْ في غير قضيّة، وكَبتْ في غير مسألة، ومع ذلك شقّت طريقها بصعوبةٍ في مسالك التاريخ الحديث على الرّغم من انحباس معظم مكاسبها في الحواضر الغربيّة، وانتشار أشكالٍ مزوّرة لها في أرجاء العاَلم. ولا مُجادلة في أنّ الحداثة استُبدلت بالنظرة القديمة للإنسان باعتباره تابعاً لقوى غيبيّة نظرة مُستخلصة من كفاحه الشخصي، ومن مجمل أحداث الدنيا التي يعيش فيها. الحداثة فعل دنيوي غايته إعادة تأويل موقع الإنسان في العالَم بما يعترف به، ويكفل حقوقه، ويحسِّن أحواله، وفي ضوء ذلك انحسرت التحيُّزات الدينيّة والعرقيّة أو أنّها اتّخذت لبوساً غير ما كانت عليه قبل ذلك، وبالاعتراف الصريح بكلّ ما وَرَدَ ذكره، فثمّة وجهٌ شائن لبعض مكاسب الحداثة، التي أَنتجت قوىً جديدة عابرة للقارّات والأعراق والأديان، مثَّلتها الإمبراطوريّات الاستعماريّة والاستيطانيّة، التي جَعلت من العالَم بأجمعه مكاناً للنزاع والأطماع، وقوَّت من شوكة تلك الإمبراطوريّات بما وفَّرته لها من معارف جديدة، ووسائل اتّصال حديثة، وقوّة مفرطة للفتك بالأغيار الذين أمسوا أعداء، وأَثمرت الحداثة عن الحقبةالمُهينة في التاريخ الإنساني: الحقبة الاستعماريّة.
أُعيد رسْم العالَم في ضوء مكاسب الحداثة الغربيّة، ورمي كلّ ما هو ليس بغربيّ في خانة “الآخر” الذي استُبيحت أرضه، ونُهبت ثروته، وانتُهكت ذاته، وحُوِّل تابعاً ترغمه الإدارات الاستعماريّة على ما تريد وترغب. كان الآخر، من قبل، مستقرّاً في أرضه، ومُكتفياً بطريقة عيشه بحسب مقتضيات حياته الجماعيّة، لكنّ مكاسب الحداثة، ومنها، على سبيل المثال، التجربة الاستعماريّة، زعزَعت عالَمَه المستقرّ، ورَمته في مهبّ عواصف القتل، والإبادة، والاستعباد، والتبعيّة. باختصار، أصبحَ الآخر، بما هو عليه من إنسان وصاحب أرض، المطمع الأوّل الذي ترنو إليه العَيْن الاستعماريّة الجشعة التي أباحت قتله ونهْبَ بلاده. فكان أن رُسمت له صورة المخلوق البدائي غير المؤهَّل لإدارة شؤونه، وغير المُدرِك لذاته الإنسانيّة، وغير القادر على إعمار بلاده، فوُجب السيطرة عليه، وإرغامه على ما يريده الغُزاة له من خيرٍ حملوه له بالسلاح من وراء البحار والمُحيطات. تغيير بالعنف الغاية منه إخضاعه بذريعة تمدينه. وواقع الأمر فقد وضع الآخر في رتبة دونيّة، ولم يعترف به إنساناً كامل الأهليّة، واختُزل إلى رتبة بهيميّة.
هَيْمَنة النموذج الحضاريّ
لم تمضِ الأمور، في كلّ ما يخصّ الآخر، إلى ما ينبغي لها من تحقيق مكاسب له في ظلّ عصر الحداثة، فالتاريخ ماكر، وتقّلباته غير قابلة للحصر، ولا يؤتَمن أمره. من الصحيح أنّ كثيراً من المفكّرين توسّموا خيراً بأن تتولّى الحداثةُ امتصاصَ الاحتقانات المترسّبة في أعماق الأُمم، وتصفير أحقادها القديمة، وذهبوا إلى أنّها كفيلة بمحو الحدود بين الجماعات العرقيّة والعقائديّة، فتفتح نوافذ الثقافات على بعضها، وكان ذلك هو الأمل الذي خامرَ كثيرين منهم. وقد صدق قليل من وعود الحداثة، وتحقَّق جزءٌ من مطالبها، إذ انهارت بعض السدود الفاصلة بين الثقافات، ووقعَ تفاعلٌ لا يُمكن إنكاره في ما بينها، ولكنّه دون ما يتوقّعه المرء من ضرورة التواصل والتفاعُل، فقد أَطلق ذلك التفاعل الجزئي ضرباً جديداً من النّزاع، هو الهَيْمنة، أي هَيْمَنة النموذج الحضاري الغربي على غيره من النماذج في العالَم، هَيْمَنة اتَّخذت لها طريقَيْن إمّا بالعنف، وإمّا بالمحاكاة، وبدل المضيّ في تعديل التوازن المُختلّ في العالَم بكبْحِ جماح حضارةٍ شرهة للاستئثار بكلّ شيء، وقعَ ما يُخالف ذلك، إذ نشطت المُنازعات القديمة، وأَمست تُبعث بصورٍ متعدّدة، إمّا لإرغام الأُمم الطرفيّة بالعنف المسلَّح للاستحواذ عليها بالحملات الاستعماريّة التي شملت معظم أرجاء العالَم، وإمّا بمقاومة تلك الأُمم للغزو الخارجي. عنفٌ مُتبادَل إمّا بدواعي الهَيْمَنة، وإمّا بدواعي المقاومة، وراح الماضي يتحكّم بايقاع الحاضر، بل ويتمادى، فشرع يرسم خارطة معتمة للمستقبل.
وصار يلزم السؤال عن الأسباب التي حَدَتْ ببعض الأُمم للارتداد صوب الماضي في وقتٍ كان ينبغي أن تنخرط في صنع حاضرها ومستقبلها، والأسباب التي حَدَتْ بأُمم أخرى للإسراع صوب عالَمٍ افتراضي يقطع صلتها بالماضي. انشقاقٌ صريح بين عوالم عكفت على أصولها، وسدّت أبوابها بوجه التغيير الحقيقي، وأخرى خَلعت أبوابها ونوافذها فما عادت تفكّر بالهويّة، وتتطلَّع إلى جعْلِ العاَلم بأجمعه ميداناً لهَيْمنتها. يتعذّر الإجماع على جوابٍ وافٍ لذلك السؤال المركّب، إنّما تتوارى الأجوبة في طيّات الأفعال والمواقف والغايات، ويعود ذلك، من جهة أولى، إمّا إلى أنّ البطانة الشعوريّة للأُمم – أقصد ثقافاتها المتألّفة من تجاربِ الماضي، والتاريخ، والتخيّل، والاعتقاد، واللّغة، والتفكير، والانتماء، والتطلُّع – تؤلّفُ جوهرَ رأس مالها الثمين، وعنوان هويّتها، ولا تُفرّط به، حتّى لو أراد ذلك بعض أفرادها الفاعلين، وتعمل تلك البطانة الشعوريّة على جذْبِ الجماعات المكوِّنة للأُمم إلى بعضها أو تدفع بها للتنافُر الخفي، في ضوء فهمٍ أو سوء فهمٍ لتلك البطانة الشعوريّة، أي أنّ تلك البطانة قد تدفع بالأُمم إلى قضايا شائكة لها صلةٌ بوجودها، وآمالِها، وهويّاتها، وحتّى وجودها، بما يقود إلى التنازُع العنيف مع الأُمم الأخرى، أو قد تتراجعُ فاعليّة تلك البطانة في حِقبة من حقب التاريخ، ويخفت تأثيرها، لكنّها تمكث قابلة للانبعاث عند أيّ استفزازٍ مصيري، فكلّما خدشت تلك البطانة لاذت الأُمم بالماضي. وإمّا، من جهة ثانية، إلى ضحالة تلك البطانة الشعوريّة، أو ضمورها عند أُممٍ أخرى، لأنّ الجماعات المكوّنة لتلك “الأمم” لم تنصهر في إطار هويّة جامعة، ولم تتفاعل خيالاتها وأفكارها ومشاعرها في إطارٍ يوحّدها، فليس لديها الأعراف التي تقترح عليها ضبْط أفعالها، وتنظيم علاقاتها بالآخرين، ما تجعلها تنفرد بأعمالها النفعيّة الشرهة من دون كوابح أخلاقيّة أو اعتباريّة، فهي تصنع أفعالها بصرف النّظر عمّا تؤدّيه من ضررٍ بحقوق الأُمم الأخرى. والحال، فالعودة إلى الماضي، والانفصال عنه، أمران على غايةٍ من الخطورة؛ لأنّهما يُرغمان الجماعات البشريّة على خيارَيْن متناقضَيْن، فإمّا صوغ هويّة مُغلقة وقارّة، وإمّا التفلّت من أيّة هويّة. وحبْس النفس في سجن الماضي لا يقلّ خطراً عن إطلاقها في سراب الأوهام.
من الصواب أنّ العالم يتصدّع قوميّاً ودينيّاً وسياسيّاً، لكنّ القوى المُهيمنة فيه تزداد قوّة، وثراءً فيه، وتتحكّم في مصائر شعوبه، وتُوجِّهها صوب الجهة التي تخدم مصالحها، ولم تَعُد أحوال الأفراد في العالَم كما كانت عليه في الماضي، فقد تفرّق شملهم، وانزوت طموحاتهم، وضحل الشعور الإنساني المحرّك لهم، وما شاع بينهم من أنانيّة، وضيق أُفق، نَزَعَ عنهم قوّة التأثير الفاعل الذي مَيّزهم، فما عادوا من صنّاع التاريخ، يصوغون به مصائر شعوبهم، بل أمسوا خدماً في آلة الدولة الفاسدة، ووكلاء شركات عابرة للقارّات، وبذلك تفكَّكت الطبقات الوسطى، واختلَّ التوازن، وصار الصعود من القاع إلى القمّة من نتاج الاحتيال، والبراعة في انتهاز الفُرص، وليس من ثمار العمل، والمُثابرة، فلا عجب أن أَصبح التفاوت بين الأفراد يُحسب بالمال والنفوذ، وليس بالكدّ والمشقّة، وذلك يكشف غياباً مزعجاً للمُساواة في الفُرص، وترقية الأحوال الشخصيّة، أثمر عن فوارق لا نهاية لها بين الأفراد، وامتدَّ ذلك إلى الأُمم، وتضاعفَ الأغيار في كلّ مكان جرّاء ما تعرَّضت له الأُمم من تخريب في قيَمها، وهويّاتها، ومصالحها.
***
*ناقد وباحث أدبي من العراق
*مؤسسة الفكر العربي-نشرة أفق