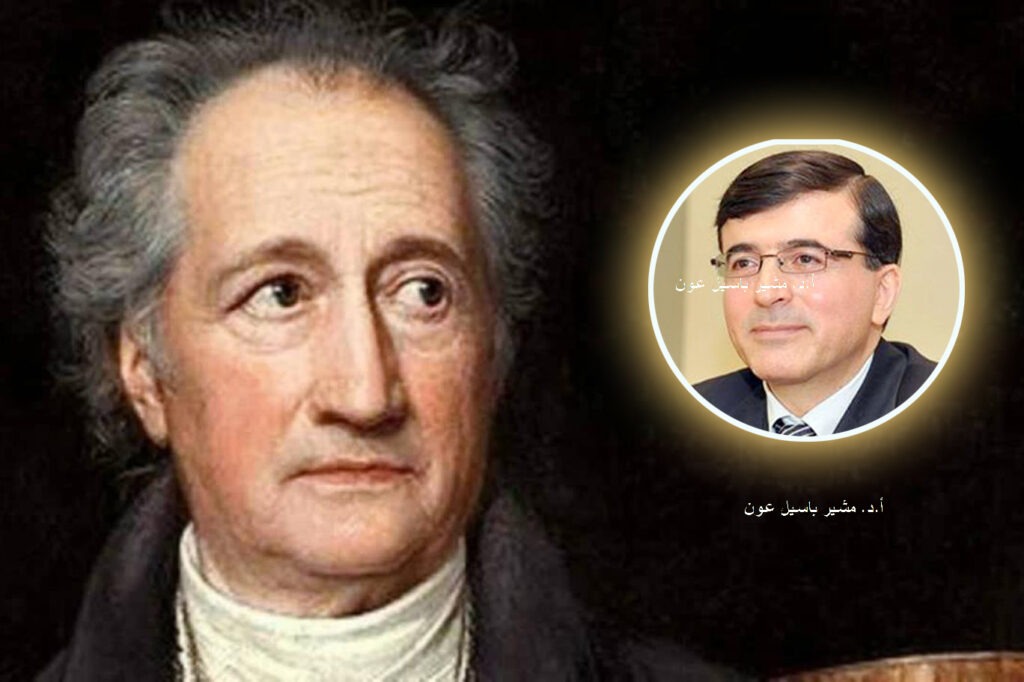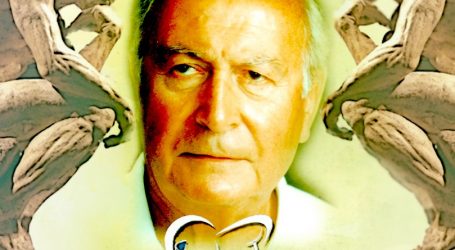غوتّه راسمًا الحياة في مشهد التنوّع اللامتناهي، مجادلًا كانط وهيغل ومعارضًا نيوتون ورابطًا الأدب بالعلم
أ.د. مشير باسيل عون
(مفكر لبناني)
يُجمع الباحثون على مقام يوهان ڤولفغانع فون غوتّه (1749-1832) في الأدب والفكر الألمانيَّين. ذلك بأنّه جمع في شخصيّته معارفَ شتّى تناول بواسطتها حقولَ الآداب والعلوم والفنون، حتّى إنّه أضحى يُعَدّ مع مارتن لوتر (1483-1546) من أعظم المفكّرين تأثيرًا في الثقافة الألمانيّة. وُلد غوتّه في مدينة فرانكفورت، واكتسب من خبرة والده، مستشارِ البلاط السياسيّ، ثقافةً راسخةً وانفتاحًا نافعًا مُغنيًا على اللغات، لاسيّما اليونانيّة واللاتينيّة والفرنسيّة والإيطاليّة. مراعاةً لرغبة والده الذي كان حريصًا على ضمان مستقبل الابن الموهوب، التحق العامَ 1765 بكلّيّة القانون في جامعة مدينة لايبتسيش، وما لبث أن أكمل الإجازة العامَ 1771 في مدينة ستراسبور الفرنسيّة من بعد أن أصابه داء السلّ وأقعده عن الدراسة طوال سنتَين.
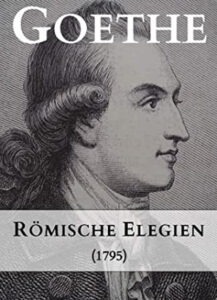
الإقامة الهنيّة في ستراسبور
في هذه المدينة التقى الأديب الألمانيّ هردر (1744-1803) الذي نصحه بقراءة الشاعر الإغريقيّ هوميروس، والأديب الإنغليزيّ شكسبير (1564-1616)، والشاعر السكوتلانديّ جيمس ماكفرسون أوسيان (1736-1796). ولكنّه سرعان ما أكبّ على تأليف بعض القصائد والأناشيد (Neue Lieder ; Sesenheimer Lieder) التي لاقت رواجًا منقطع النظير في الأوساط الأدبيّة المحلّيّة. من محاسن الإقامة في ستراسبور معاينةُ الهندسة الرائعة التي تحتضنها كاتدرائيّة المدينة، إذ إنّ غوتّه، من جرّاء تأمّله في البناء الكنسيّ الرائع هذا، أنشأ بحثًا مستفيضًا في الهندسة الألمانيّة (Von deutscherBaukunst) يمتدح الفنّ الغوطيّ الذي لم تكن الأوساط الألمانيّة توليه الاهتمام الذي يستحقّه.
عُصبة “العاصفة والاندفاع“
بحثًا عن مزيدٍ من الحرّيّة الفكريّة، انتقل غوتّه إلى مدينة دارمشتات في وسط غرب ألمانيا، وأكبّ فيها على كتابة رائعته آلام الشابّ ڤرتر (Die Leiden des jungenWerthers) التي تُخبرنا عن محنة الصداقة التي ربطته بشارلوت بوف (1753-1828) وخطيبها يوهان كريستيان كِستنر (1741-1800)، وترسم مشهد الحزن الذي استثاره انتحارُ صديقه كارل ڤيلهِلميروزالِم (1747-1772). تنتسب هذه الرواية إلى المذهب الأدبيّ الذي كان ناشطًا في تلك الأثناء، وقد عُرف بحركة “العاصفة والاندفاع” (Sturm und Drang). من خصائص هذا التيّار الاعتناء باستجلاء حقائق العاطفة الوجدانيّة وتعزيز مقامها المتعالي على العقل، وإهمال الأملاك والمكتسبات المادّيّة، والإعراض عن الظهور الاجتماعيّ، والنزوع إلى الالتزام التغييريّ عوضًا عن التفكّر الذاتيّ الانزوائيّ. رواية آلام الشابّ ڤرتر وصفت الحبّ الإنسانيّ على غير ما يتناوله الأدب المحافظ، وربطته بالعشق الشقيّ المأسَويّ، فطبعت الفنّ الروائيّ في الأوساط الأدبيّة الأُروبّيّة.
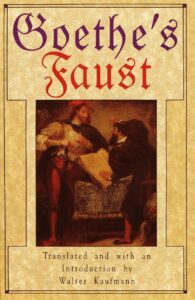
المسؤوليّات الإداريّة في ڤايمار
من جرّاء الشهرة التي اكتسبها غوتّه بفضل هذه الرواية، وقد عزّز أيضًا صيتَه الأدبيّ بنشر بعض المسرحيّات، دُعي إلى بلاط الدوق كارل أوغوسط (1757-1828) في مدينة ڤايمار التي كانت محطّ أنظار الأدباء والعلماء ورجال السياسة، تنشط فيها حركةٌ ثقافيّةٌ ثوريّةٌ بفضل الرؤية الإصلاحيّة التي كانت تناصرها والدة الدوق المثقّفة الدوقة أنّا أماليا (1739-1807). في أجواء البلاط السياسيّ استطاع غوتّه أن يكتسب ثقة الدوق الذي عهد إليه بوظيفة مشير البلاط، وأناط به مسؤوليّاتٍ شتّى، منها دائرة المناجم ووزارة المال، ولجنة الهندسة والطرُق، وهيئة الإشراف على مسرح المدينة، ومشروع إنشاء الحديقة العامّة (Park am Ilm). لا عجب، والحال هذه، من أن يرقّيه الإمبراطور جوزف الثاني إلى رتبة النبلاء.
صحيحٌ أنّ المسؤوليّات الإداريّة والمهمّات السياسيّة التي اضطلع بها منعته من المواظبة على الكتابة، إلّا أنّها جعلته يدرك مقام العمل الجماعيّ وانعطابات الفعل التاريخيّ. اضطرّ مكرَهًا إلى الالتحاق بالحملة العسكريّة المناهضة الثورة الفرنسيّة. بيد أنّ الهزيمة التي أصابت الجيش البروسيّ في ڤالمي يومَ 30 أيلول 1792 دفعته إلى التصريح بأنّ الزمن قد تغيّر: “اليوم يُفتتح عهدٌ جديدٌ في تاريخ العالم”.

جمالات إيطاليا وصداقة شيلر
في العام 1786 يمّم غوتّه شطر إيطاليا ليمضي في أرجائها زهاء سنتَين يستكشف كنوزها، ويمتدح عبقريّة أدبائهاوفنّانيها، ويُغرم بالمرأة التي أصبحت قرينته من بعد أن اختبر وإيّاها قبل الزواج شغف الهوى ومتعة الاقتران الجسديّ. بفضل علاقة العشق هذه، أنشأ غوتّه بضعةً من أروع أناشيد الحبّ (RömischeElegien). أمّا علاقة الصداقة التي وسمت حياته، فاختبرها في لقاء صديق عمره الأديب الألمانيّ فريدريش شيلر (1759-1805) الذي ما استطاب في بادئ الأمر الارتباطَ به لشدّة ما عاينه في شخصيّة هذا الشاعر من اختلاف حادّ في الطباع والرؤية والميول. ولكنّه سرعان ما أدرك أنّ بين روحَيهما تنعقد شراكةٌ وجدانيّةٌ عميقةٌ تجلّت في الانسجام الناشط بين عبقريّة كلّ واحد منهما. فإذا بعرى الألفة تتوثّق بين الأديبَين ابتداءً من العام 1794، وتُفضي إلى أبدع ما أفرجت عنه تلك الحقبة من تاريخ الأدب الألمانيّ.
من جرّاء التعاون الوثيق بين الرجلَين، أنهى غوتّه الروايتَين الشهيرتَين اللتَين تحوّلتا إلى تحفةٍ أدبيّةٍ ومرجعٍ إلهاميٍّ في أدب التنشئة (Wilhelm MeistersLehrjahre ; Hermann und Dorothea). وكذلك فعل شيلر، إذ ألهمه غوتّه وبعث فيه العزم على إنهاء ثلاثيّته الروائيّة (Wallenstein). (https://www.sliderrevolution.com/) غير أنّ الموت خطف شيلر في ذروة عطائه، فوقع غوتّه في الحزن والإحباط. ذلك بأنّ علاقتهما توطّدت حتّى الاتّحاد الروحيّ، بحسب ما أورد مؤرّخ أدب الدراما ألفرد بايتس: “لم ينفصل غوتّه وشيلر الواحد عن الآخر على الإطلاق في أذهان مواطنيهما، فسطع نورُهما نجمَين توأمَين في سماء الأدب. أحبّ الناسُ شيلر حبًّا أعظمَ، مع أنّه لم يحظَ بالمقام الأوّل، بخلاف غوتّه الذي كان إعجابُهم به فائقًا” (Alfred Bates, The Drama. Its History, Literature and Influence on Civilization).
انطفأ غوتّه في مدينة ڤايمار بعد أن أنهى مسرحيّته الشهيرة فاوست. أمّا كلماته الأخيرة قبل وفاته، فكانت تحمل أمنية الاستزادة من النور ليضيء عتمة العبور إلى ضفاف الخلود الأدبيّ. فإذا بأمير الشعراء الألمان يوارى الثرى في مدافن أمراء ڤايمار بالقرب من خليله ونجيّه شيلر.

أثر روسّو
يغالي بعض الباحثين حين يصوّرون غوتّه في هيئة العالم العبقريّ الفذّ الذي استوعب جميع المعارف وأحاط بجميع العلوم. لا ريب في أنّ المثال التكريميّ هذا (Kultfigur) نحته أيضًا غوتّه نفسُه حين دوَّن محادثاته وحفظ مذكِّراته وأنشأ ما يشبه السيرة الذاتيّة في كتابه الشعر والحقيقة (Dichtung und Wahrheit). ذلك بأنّه لم يكن يتورّع عن النظر الانتقائيّ الاستعلائيّ في تاريخ الأفكار: “أيّ تعليم أو رأي كان يبدو لي صالحًا كسواه من التعاليم والآراء؛ على الأقلّ كنت قادرًا على النفاذ إلى جوهر معناه” (غوتّه، الشعر والحقيقة). حقيقة الأمر أنّه لم يكن يخضع لأيّ تصوّر فلسفيّ من غير تمحيص ونقد واستصفاء، وفي يقينه أنّ الأفكار الفلسفيّة تحتمل الاستصلاح والتقويم.
أمّا أبرز المفكّرين الذي أثّروا في بناء فكره، فالأديب السويسريّ جان-جاك روسّو (1712-1778) الذي ألهم جيل غوتّه من الأدباء والشعراء والمفكّرين، إذ إنّه جسّد لهم نضال الوجدان في مناهضة عقلانيّة الفيلسوف الفرنسيّ دِكارت وتصوّره العالمَ في هيئة الآلة المنضبطة. فضلًا عن ذلك، كان دفاع روسّو عن الذاتيّة الجوّانيّة المسكونة بالانفعال البريء والغريزة المبدعة يحرّض كوكبةً من الأدباء الألمان الراغبين في العودة إلى الطبيعة من أجل التنزّه الهنيّ في أرجائها، واكتشاف جمالاتها الخلّابة، والانعتاق من أسر الحضارة التقنيّة الهدّامة. ومن ثمّ، اعتقد غوتّه أنّ العودة إلى روسّو تُعفيه من الاضطلاع بمسؤوليّة التنوير العقلانيّ المرهق، وتحرّر وجدانه لكي يستعيد علاقة الارتباط الحميميّ بالطبيعة، على نحو ما أفصح عنه في رسم شخصيّة بطل روايته ڤرتر المفتون بجماليّة الوجود العفويّ الطافح بالإفصاحات والتعابير البريئة.
ولكنّ غوتّه ما لبث أن عاد إلى رشده وخفّف من غلواء شغفه بالطبيعة الأصليّة المتخيَّلة، فأعاد إلى العقل مكانته، لاسيّما في السنوات التي قضاها في خدمة الإدارة السياسيّة والاحتفاء بالحياة الاجتماعيّة الصاخبة (1784-1804) التي ندّد بها روسّو أيّما تنديد. زدْ على ذلك أنّ النضج الفكريّ الذي أحرزه غوتّه دفع به إلى اعتماد مبدأ الموازنة أو التوفيق بين الوجدان والعقل، بين الشغف الانفعاليّ والالتزام الواجبيّ، بين الإبداعيّة الحرّة والانتظاميّة المنضبطة. وحده الانسجام اللطيف الدقيق بين هذه المتناقضات يصقل الشخصيّة الأدبيّة ويُفضي إلى الاكتمال الأدائيّ الكلاسّيكيّ الذي لم يكن روسّو يقرّ به.
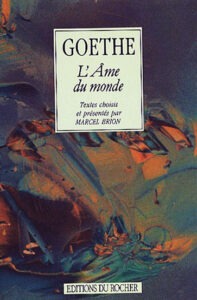
حلوليّة سبينوزا
لا بدّ أيضًا من ذكر الأثر البالغ الذي استثارته في كتابات غوتّه أفكارُ الفيلسوف الألمانيّ سبنيوزا (1632-1677) الذي كان يذهب إلى أنّ الله منغلٌّ انغلالًا لطيفًا في الطبيعة، ومتّحدٌ بها اتّحادًا صميميًّا يبلغ حدود التماهي المطلق. لذلك ينبغي للإنسان أن يتخلّق بأخلاق الصفاء الطبيعيّ، وأن يجتهد في تهذيب نفسه حتّى يبلغ مراتب الكمال الأعلى. فالسعادة، في جوهرها، ارتقاءٌ سكونيٌّ وسلامٌ جوّانيٌّ يُلهمان الفرد التعالي على اضطرابات العالم وتجاوز إرباكاته ومغالبة انسداداته.
كان غوتّه يسعى إلى معرفةٍ شاملةٍ تتناول جميع جوانب الحياة، فتتجاوز الإطار العقلانيّ الضيّق الذي رسمته الأنوار الفرنسيّة المتأثّرة بعبقريّة ڤولتِر (1694-1778). ذلك بأنّ الطبيعة، في نظر غوتّه، مسارٌ حيٌّ تفاعليٌّ تطوّريٌّ يتحقّق في هيئات شتّى، ويتطلّب إدراكًا متنوّع الملَكات والمواهب. ومن ثمّ، ظنّ في المرحلة الأولى أنّ السبيل الدِّينيّ الصوفيّ يمكن أن يُدخله في صميم هذا المسار، ويكشف له عن حيويّته المتدفّقة. ولكنّه سرعان ما آثر حلوليّة سبينوزا التي جعلته يُعرض عن المنهج الدِّينيّ ويطلب مختلف العلوم الطبيعيّة، لاسيّما علم الهيئات أو المورفولوجيا وعلم الألوان وعلم البصريّات وعلم العظام، وفي يقينه أنّ مثل هذه العلوم تُبيّن له آثار التفاعل الإنتاجيّ الناشط في باطن الطبيعة الحاوية.
جلُّ مسعاه أن يدرك الله منغلًّا في الطبيعة، والطبيعةَ ملتحفةً بالعظمة الإلهيّة، إذ كان يتصوّر الجوهر الإلهيّ نشاطًا حيًّا مطّردًا، ينتقل من مقام إلى آخر ومن تحوّل إلى آخر، باعثًا في ذاته الرحابة اللامتناهية من الأشكال الظاهرة المتحقّقة في الوجود. الحقيقة الإلهيّة أشبهُ بقوّة خلّاقة منخرطة في صيرورة لا نهاية لها، تبعث في الوجود أطوارًا متدرّجة من التحوّل الكيانيّ والنموّ المتعاظم، بحيث يعثر المرءُ في علم الهيئات النباتيّة على البنية الأساسيّة في الأوراق المزهِرة على أغصان الشجرة: “ليس كلُّ كائن حيّ وحدةً، بل كثرةٌ. حتّى لو ظهر لنا في هيئة الفرديّة المتمايزة، فإنّه لا يبرح ائتلافًا من الكائنات الحيّة المنعَم عليها بوجود ذاتيّ خاصّ يشبه سائرَ ضروب الوجود الأواخر من حيث الفكرة الناظمة والتدبير الأصليّ، ولكنّه في الظاهر وجودٌ متماثلٌ أو متشابهٌ، متمايزٌ أو متباينٌ. انعقد اجتماعُ هذه الكائنات تارةً في البداية، وتارةً في زمن لاحق. إنّها تنعزل وتعود فتجتمع، ناظمةً على هذا النحو إنتاجًا لامتناهيًا متنوّعًا”. من الواضح أنّ غوتّه كان يُصرّ على معاينة الفكرة المتحقّقة في وقائع الوجود، والتأمّل في ما يدعوه “روح الأرض” المنبعثة من صميم التدبير الكونيّ الأرحب. ذلك بأنّ تصوّر الكائنات الفرديّة في شكل البرامج المنتظمة بحسب أصنافها إنّما يقترن بمِتافيزياء أفلاطون ومثُله العليا.
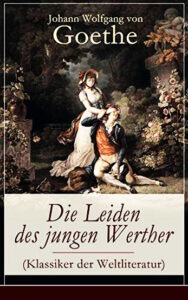
نقديّة كانط
من الفلاسفة الذين أثّروا أيضًا في غوتّه فيلسوف الأنوار الألمانيّ كانط (1724-1804) الذي اطّلع الأديبُ على فلسفته في زمن الشباب الأوّل، من غير أن يستوعب كلَّ اجتهاداته النقديّة الإصلاحيّة. ولكنّه سرعان ما عاد إليه مستنجدًا بالفيلسوف الكانطيّ الماسونيّ اللامع كارل ليونهاردراينهولد (1757-1823) الذي كشف له حقيقة المعاني التي انطوت عليها نصوص كانط. لا شكّ في أنّ غوتّه كان يؤيّد فيلسوف الأنوار في مسألة الحرّيّة الفكريّة والالتزام الأخلاقيّ الذاتيّ. غير أنّه غالبًا ما كان يصرّح بأنّ نقد العقل المحض (Kritik der reinen Vernunft) يقيّد حرّيّتنا ورغبتنا في اختبار الوجود المنبعث من صميم عفويّة الحياة. فالاختبار الواقعيّ موضعُ الانطلاق الأوّل ومستندُ المعرفة الأساسيّ، في حين أنّ التبصّر النظريّ المفرط في شروط إمكان الاختبار لا يلائم بنية الإنسان الذهنيّة المفطورة على الاستمتاع بتلقائيّة المعنى المتولّد في معترك الحياة اليوميّة. لا يمكننا الاكتفاء بالشروط المعرفيّة الاقتضائيّة المجاوِزة التي تحرمنا ملذّة الانغماس في مفارقات الوجود ومباغتاته. ذلك بأنّ نقد العقل النظريّ كالنقد الأدبيّ يُفقدنا الصلة الأصليّة بالطاقة الابتكاريّة العفويّة المنبعثة من نشاط الحياة عينها. أمّا نقد العقل العمليّ (Kritik der praktischen Vernunft)، فلا قدرة له على تغيير طباع الإنسان، إذ إنّه يُسرف في تطلّب خلوص النيّة وصفاء المقصد، ويُصرّ على الانعتاق من مساومات التاريخ. بناءً عليه، أرسل غوتّه قولتَه النقديّة الشهيرة: “المعرفة لا تكفي، إذ يجب علينا أن نطبّق؛ الإرادة لا تكفي، إذ يجب علينا أن نفعل”. على الرغم من النقد الصريح هذا، ما برح كانط في نظره من أعظم فلاسفة العصر الحديث، لاسيّما في نقد ملَكة الحكم (Kritik der Urteilskraft)، إذ كشف للجميع أنّ الطبيعة والفنّ ينطويان بحدّ ذاتهما على مقاصدهما وغاياتهما الخاصّة، ولا يخضعان لتسويغات خارجيّة تفرضها عليهما ضروراتُ المنفعة أو الإنتاج.
صداقة هردر الاستثنائيّة
من البديهيّ أيضًا أن نذكر تأثير صديقه هردر الذي جعله يكتشف أصل اللغة في طبيعة التطوّر الإنسانيّ الخلّاق، عوضًا عن افتراض الهبة الإلهيّة في نشأة اللغات البشريّة. كذلك أوضحت له أبحاثُ هردر أنّ العصور التاريخيّة أو الأطوار الثقافيّة تتساوى قيمةً وأثرًا في وعي الشعوب التي تختبرها وتنسلك في رحابة آفاقها.
التجريد النظريّ المنقطع عن حيويّة الوجود
شهد غوتّه، في زمن نضجه الفكريّ، تطوّر النقديّة الكانطيّة وتحوّلها إلى المثاليّة المتجلّية في أعمال الفلاسفة الثلاثة العظام: فيشته (1762-1814)، وشِلينغ (1775-1854)، وهيغل (1770-1831)، خصوصًا في سياق النتاج الفلسفيّ الناشط في جامعة يانا (Iena) الألمانيّة. لم تربطه علاقةٌ وطيدةٌ بفيشته الذي لم يكن يستعذب نصوص الشاعر الصوفيّة الغامضة. غير أنّ ارتباطه بشلينغ ظهر في موقف الالتباس، إذ أيّده في تصوّر السرّيّة الكامنة في الطبيعة والعصيّة على الإدراك، ولكنّه خالفه في اقتراح سبيل المعالجة النظريّة المجرّدة من كلّ سندٍ اختباريّ واقعيّ. ومع أنّ كليهما عاين في الطبيعة مسارًا حيًّا من التطوّر العضويّ العفويّ، إلّا أنّ غوتّه آثر اعتماد الجدليّة القطبيّة الجاذبة الباعثة على التطوّر، في حين أصرّ شلينغ على إبطال الثنائيّة المتجابهة وصهرها في فكرة المطلق الاستيعابيّ الأوحد.
أمّا علاقة غوتّه بهيغل، فاتّصفت بالصراحة والشفافيّة والتأثير المتبادل. ذلك بأنّ كتاب المنطق الهيغليّ ألهم غوتّه فكرة التحوّل الطبيعيّ. فالأشياء الطبيعيّة لا تبلغ، في رأي هيغل، كمالها الأعلى إلّا حين تُفصح عن مضمونها الداخليّ في تصوّر مفهوميّ خارجيّ صريح. بما أنّ عالم الفكر أسمى من عالم المادّة، فإنّ تعقّب حركة الأشياء ينبغي أن يتطوّر من مستوى المعاينة الحسّيّة إلى مستوى الوعي الذاتيّ الأشمل التائق إلى المعرفة المطلقة. ومن ثمّ، يمكننا القول إنّ غوتّه أثّر في صوغ النقد الذي وجّهه هيغل إلى مثاليّة كانط الصوريّة، إذ أبان له أنّ العقل ينبغي أن يعتني بالتحوّلات الطارئة على مسار الأمور، بخلاف ملَكة الفاهمة التي تكتفي بإثبات القضايا وتجميدها في هيئة واحدة تحتمل الاستثمار والهيمنة.
يجدر التذكير، في هذا السياق، بأنّ نظريّة هيغل في المفهوم (Begriff) الذي يدلّ على تدبير النموّ التطوّريّ اللصيق بالأشياء، تأثّرت تأثّرًا واضحًا بالتصوّر الذي ساقه غوتّه في مقولة الظاهرة الأصليّة (Urphänomen)، بحيث تقترب جدليّة هيغل المبنيّة على استجلاء حركة المفهوم الذاتيّة من علم الهيئة (المورفولوجيا) الذي وضع غوتّه أسُسَه النظريّة والتطبيقيّة. بيد أنّ هيغل غالى مغالاةً فاضحةً حين رام أن يوحّد حركة الأشياء كلّها ويصهرها في بوتقة مبحث الظواهر (الفيمياء أو الفِنومِنولوجيا) الذي يهيمن هيمنةً ذهنيّةً على أشكال الحياة. كما انتقد غوتّه تجريديّة كانط الصوريّة، كذلك عاب على هيغل إسرافَه في بناء أنظومة نظريّة شموليّة تدّعي تفسير حركة الحياة في أدقّ تفاصيلها، في حين أنّ الطبيعة تهب نفسَها على المقدار عينه من الأمانة، سواءٌ في التناول المعرفيّ النظريّ أو في الحدس العفويّ الوجوديّ المباشر.
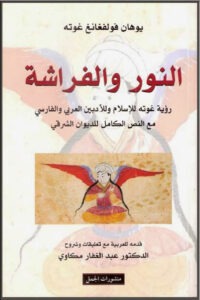
جماليّة الطبيعة مثالُ الأخلاق الإنسانيّة
في رواية القرابات الاصطفائيّة (Die Wahlverwandschaften) يقترح غوتّه أن نطبّق التحليل الكيمائيّ على المعضلة الأخلاقيّة، إذ إنّ مسار التكوّن الطبيعيّ ينطوي على حكمة التعامل الإنسانيّ: “الخاصّيّة الأساسيّة في الوَحدة الحيّة أن تنقسم، وتجتمع، وتنبسط في الكونيّ، وتستقرّ في الجزئيّ، وتتحوّل، وتتعيّن. إذا كانت الطبيعة كلّها تركيبًا وتفكيكًا يصيبان على الدوام حالَ الأشياء المذهلة هذه، كان على الناس أن يحذوا حذو الطبيعة، فيداولون بينهم التركيب والتفكيك”. لا بدّ، والحال هذه، من التبصّر في حركة الصيرورة التي تحيي الكائنات الحيّة، فتجعل الشعوب، على سبيل المثال، تنمو وتتطوّر بحسب إيقاعات اختباراتها الثقافيّة الذاتيّة. أمّا الهدف الأسمى، فبلوغ الوَحدة الحاوية التنوّعَ الكونيَّ الأرحب: “تحقيقًا لهذه الغاية، يجب ألّا نُقصي من العمل العلميّ أيَّ قوّة من قوى النفس الإنسانيّة. قاع الاستشعار، استبصار الحاضر استبصارًا يقينيًّا، عمق الرياضيّات، دقّة الفيزياء، تسامي العقل، اقتدار الذكاء، النزوة الناشطة في التخيّل الاستهوائيّ، ملذّة استمتاع الحواسّ: ذلك كلّه ينبغي أن يشترك ويتواطأ على استنهاض الفكر استنهاضًا مباشرًا مُستعذَبًا؛ على هذا النحو، يمكن الصنيع الفنّيّ الرفيع أن يُنجز الوحدة”. وحده الفنّ يستطيع أن يحقّق الرقيّ الاستثنائيّ هذا، وأن يتسامى على الإنجازات الناقصة المجتزأة. لذلك كان غوتّه يستقبح الرياضيّات العاجزة عن الإتيان بمثل هذا الإنجاز الفنّيّ هذا حتّى إنّه، في كتاب الألوان (ZurFarbenlehre) أخذ ينتقد علانيةً نظريّة نيوتون الفيزيائيّة المتعلّقة بتفسير أصل الألوان، ويناصر مبدأ الحكم الذاتيّ الذي يُسهم في تمييز الألوان بعضها من بعض. ليس من قبيل المغالاة القول إنّ هذا التحوّل في إدراك طبيعة الأشياء مهّد تمهيدًا خفرًا لنشوء النظريّات العلميّة الحديثة.
من أبلغ ما قاله أهل الأدب في أثر غوتّه العلميّ شهادةُ هاينريش هاينهِ الشهيرة: “خرج تعليمُ سبينوزا من شرنقة الرياضيّات، وأخذ يرفّ من حولنا في صورة نشيد غوتّه”. في رسالة كتبها غوتّه إلى أحد الأصدقاء يومَ 13 شباط 1829، يصف مقياسيّة الطبيعة ومعياريّتها الهادية: “الطبيعة مخلصةٌ على الدوام، رصينةٌ على الدوام، متطلّبةٌ على الدوام؛ إنّها محقّةٌ على الدوام، في حين أنّ الأخطاء والانحرافات من صنع البشر على الدوام”.
***
*اندبندنت عربيّة
*الصورة الرئيسية: الكاتب والفيلسوف الألماني غوته (متحف غوته)