أزمة الثقافة والمثقف… إعادة تموضع
محمد إقبال حرب
أزمة الثقافة والمثقف عميقةٌ جدًا ومتشعّبةٌ ولا نهاية لها. لذلك ستكون مداخلتي حول شِقّ واحد بعنوان “إعادة تموضُع”.
قيمةُ ثروات البلدان الحقيقية، خاصّة السيادية منها تتمثل بإدارتها بأفضل وأدق الوسائل، بل باستنباط طُرق إبداعية تُقلّل الهدر وتزيد من سبل الإفادة منها على مساحة الوطن أطول مدة ممكنة. إن اهمال الثروات بأنواعها على مستوى الوطن وسوء استخدامها هما ضرب من الجهل والانتحار، إذ أن معظم الثروات هي ثروات غير متجددة. لكن الطامّة الكبرى تكمن في تعريض الثروات المتجدّدة للتلف أو التخلي عنها لصالح أُمم أخرى، مقابل ثروات مادية ناضبة تُهدر على رَفاه زائف ومشاريعَ استهلاكية لا تدعم الأمن الوطني.
أثبتت التجارب والأبحاث أن أعظم الثروات على الإطلاق هي الإنسان بحدّ ذاته. كما أُثبت أن صَقل كينونة الإنسان، منذ ولادته، هو الاستثمار الأعظم وصاحب المردود الأعلى، ذلك أن الثروات البشرية متكافئة بين الشعوب من حيث الخامات والقُدرة على التحكُّم بمواردها إلى حد كبير، لدعم خزينة التعداد السكاني بخامات المواليد الجدد. في الحقيقة أن تلك الخامات تتشكل اطرادًا مع كيفية صقلها وتشكيلها لتتأهل مداميك صلبة في بنيان الوطن. بعض تلك الخامات التي أُحسن صَقلُها أضحت ثروات علمية وعملية لا تُقدّر بثمن ودرّت أرباحًا خيالية تجاوزت كلّ التوقعات.
في هذه الحقبة من الوجود البشري، أصبح واضحًا أن القيمة الإجمالية لشباب الأُمّة هي الكنز المستدام. ففي حقبات التاريخ السابقة، كان الاستثمار في استخدام الثروة البشرية متوقفًا على الحروب وأعمال السُخرة بشكل عام. وكانت المعرفة ترَفًا مقدّسًا محصورًا في الطبقة الحاكِمة والإكليروس، يسيطران من خلاله على مقادير الوطن. عمل هذا التكتّل على حجب المعرفة، بكلّ الطرق، عن العامّة قدر الإمكان وحصرِها بجماعة القصر والمعبَد. أدرك صاحبُ المعرفةِ من العوام في العصور البائدة قدْره في كونه منبوذًا لأنه “البطة السوداء” التي لا تنتمي إلى السِّرب الحاكِم، فتخفّى وستر ما اقترفه من فكر وثقافة إلى وقت يحظى فيه بفرصة لإعادة تموضعه. واليوم في بلداننا العربية نتساءل إن كان الوضع قد تغيّر جوهريًا خاصة مع انتشار العلم والمعرفة، بوجود ما يسمى بقانون “التعليم الإلزامي” المزعوم وطرح مقولة “العِلم للجميع”.
هل أصبحَت كلّ أنواع المعرفة في مُتناول الجميع؟
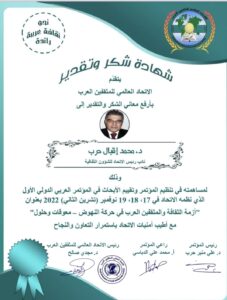
وهل أصبحَ الطريقُ معبّدًا أمام أصحاب العُقول المميّزة والعباقرةِ للارتواء بما يُفجِّر طاقاتهم إبداعًا؟
وهل صحيح أن لدى الحاكم قناعةً صادقةً بأن المتعلم والمثقف العُضوي هو فعلًا ثروة وطنية لا تقدّر بثمن أم ما زال يعتبره العدوّ الأكبر للسلطتين الحاكمتين، القصر والمعبَد؟
من المفارقات على سطح هذا الكوكب أن الدول المتقدمة علميًا أنشأت برامجَ واسعةً على مُستوى أوطانها لاكتشاف المواهِب، بل هناك تنافسٌ واضحٌ بين إدارات التعليم والمؤسسات العسكرية على اغراء الموهوبين واستقطابهم من أجل استثمارهم في مراكزَ أبحاث علميّة واستراتيجية.
في حين أن الأجهزة الأمنية في البلدان التي تسمى نامية تعمل على اكتشاف أصحاب العقول والتخلّص منهم بالطرد حينًا والتصفية حينًا آخر، قبل أن تنضَج وتُصبح خطرًا أمنيًا يحدّد صفاته صاحب الحول والقوة، نجد أن الطُرق المتبّعة في “تطفيش” العقول أتت أُكلها فلم تتقدّم البلاد خَطوة واحدة منذ عقود مع استمرار سُلطة الحاكم الديكتاتوري والجاهل في كثير من الأحيان، حتّى أضحت البلاد تأكُل مما لا تزرع وتلبس مما لا تحيك. إنه السبب الأهم في خسارة هذه العقول التي قضى معظمُها تحت المقصلة وهرب الناجون إلى أي بلد يقدّر مواهبَهم، مما أفرغ البلاد من ثرواتها الفكريّة والإبداعيّة. أستطيع أن أجزم بأن العقول التي قضت في بلادنا أكثر من تلك الهاربة تحت تصنيف “مُهاجرة”.
عندما تمّ تحديد عُنوان هذا المؤتمر بـ “أزمة الثقافة والمثقف العربي في حركة النهوض _ معوّقات وحلول” وقفت عند تعبير “حركة النهوض” وتساءلت: هل هناك حركة نهوض فعليّة في أي بلد عربي؟
ربما وُجدت في قلوب المثقفين الطموحين المخلصين وعقولهم، لكنها بالتأكيد غير موجودة على مستوى الحكومات، ولو وجدت فستكونُ حبرًا على ورق أو شكليّة من نتاج أصحاب السلطة وزبانيتهِم لذرّ الرمادِ في عيون الدول المطالبة بحقوق الإنسان وليس لخدمة الوطن.
مع انعدام حركة نهوض أصيلة نجد المثقّف العربي أو غيرَه من مثقفي العالم الثالث تائهًا عاجزًا عن تفجير طاقاتِه وتحقيق أحلامِه، إن كان من ناحية توفّر اللوجستيات المطلوبة أو الأمن والأمان على نتاجِه الفكري. ولو افترضنا أنه تجاوز تلك الأزمَة فلن يجدَ عملًا يؤمّن له بيئة علمية سليمة للعمل والإبداع بحريّة، لذلك يبدأ صاحب الفِكر البحثَ عن البديل من أجل إعادة التموضُع لإتمام مسيرته خارج الوطن الطارِد لأبنائه.
إعادة تموضُع المفكّرين والمبدعين ليس أمرًا طارئًا على البشرية، فعِبر العصور نجدُ أن الإمبراطوريات والدول التي توفر سُبل العلم بعيدًا عن القيود والعُنصرية هي التي تستقطب العُقول من أنحاء العالم. وخيرُ مثال على ذلك الإمبراطورية العباسيّة التي استقطبت عقولًا وأدمغة من بلاد مجاورة وبعيدة مثل الخوارزمي وجابر ابن حيان وغيرهما كثر. (curlygirldesign.com) كذلك الإمبراطورية الرومانية التي استقطبت عقولا وأدمغة من امبراطوريتها الشاسعة وصلت إلى العرش الروماني أمثال الامبراطور سبتيموس سفيروس الليبي، وفيليب العربي السوري، كما تألق المعمار أبولودوروس الدمشقي في روما. لم تكن هِجرة الأدمغة دائمًا بسبب الحروب، بل لعدم توفر العلوم والتسهيلات اللوجستية كما الأمن والأمان في بلادها مما أجبرَها على إعادة التموضُع الفكري حيث تجد التربة الصالحة والتسهيلات غير المشروطة لإنجاز الإبداع.
من هنا نستطيع القول إن أزمة المثقفين ليست بسب هِجرة الأدمغة وهربها خارج البلاد، بل في إدارة الثروات الفكريّة وتقبُّلها كجزء فعّال من خطط البناء المزعومة، إضافة إلى انعدام الرؤية الصحيحة لثقافة عريقة، عميقة. ما يحصل هو تعرُّض تلك الأدمغة للقمع وإساءة التوجيه مما يحدّ من ترعرعها في بيئة حاضنة وطمسِها قبل نضوجها. قلّة حالف الحظ إصرارها على العطاء واستطاعت الهرب إلى بلدان تحتضنُها وتوفرُ لها اللوجستيات اللازمة في بيئة تقدّر الجواهر البشرية. المثقفون الذين غادروا البلاد العربية في فترة السّلم تعادل نسبتُهم أو تتجاوز الذين غادروا خلال فترات الحروب. وهذا يدل على أن أصحاب الفكر والرؤى سيغادرون في السلم أو الحرب إن لم يجدوا الأمن والمقوّمات اللوجستية لإنجاز أفكارِهم. علينا التمييز بينهم وبين الهاربين من الحروب والظروف الاقتصادية، فجلّ الهاربين النازحين من الحروب من فئة الأيدي العاملة وإن تحلّت ببعض الشهادات، إذ ليس كلّ حامل شهادة ثروةً فكرية ثقافية يخسرُها الوطن. نعم الوطن يخسرُ مواطنيه واليد العاملة خلال فترات الحروب لكنها تُعوّض بعد التسويات وعودة السلم. لكن الأدمغة المهاجرة في السّلم أو الحرب من الصعب عودتِها وتعويضِها إذا لم تتوفر لها شروط الاستمرارية وحرية الإبداع.
البحث يطول ويطول، لذلك سأختصر بتوصية مُتواضعة أحصُرها بمثل واحد من عشرات الأمثلة. عندما تولى لي كوان يو رئاسة سنغافورة بكى لعدم وجود مياه شرب في بلد فقير. استثمر أكثر من 30% من ميزانية البلاد على نظام التعليم في خطة تحافظُ على الوطنيّة وتنفتحُ على العالمية رغم المعارضة الشديدة لبرنامجه. خلال عقد واحد من الزمن أصبحت سنغافورة من نمور آسيا الاقتصادية.
لا شك في أن ذلك دليل واضح عملي على أن العلم والثقافة يحتاجان إلى رؤية وإصرار مع استثمار مُستدام في حقلي التعليم والتثقيف. لا يمكن لأي بلد لا يستثمر إلا1% من ميزانيته على التعليم أن يحافظ على عقولِه المتوهّجة مقارنة بأكثر من 30% على المجهود الحربي ومثلها على مشاريع تستنزف خزينة الدولة. كيف يمكننا أن نبحث مشكلة الثقافة والمثقفين ولا تُنفق الدول العربية على برامج الأبحاث أكثر من 0.8 % من دخلها تُصرف على الرواتب والحفلات. في حين أن الدول التي تتألق بعُلمائها تُنفق أكثر من 9% من دون عوامل الفساد والعُنصرية.
لنخرُج من هذا النفق المظلم الذي يدفعُ ثمنَه الوطن مع فِرار أصحاب الأدمغة إلى حيث يُبدعون ويُنجزون في جو من الأمان الفكري والجسدي، يجب أن يكون العلم والثقافة أيقونتي حركة النهوض في رؤية واضحة المعالم على مستوى الوطن تُنفَّذُ بدقّة وجديّة. على الطبقة الحاكمة أن تتوقّف عن اعتبار المثقف عدو السُلطة وأن تعترف به راية المستقبل، فالأمان على الروح والجسد هما الضمانة الأهم لأي صاحب فِكر.
في النهاية آمل أن يستمعَ أصحابُ القرار إلى آراء المجتمعين في هذا المؤتمر وغيرِه من المؤتمرات التي تسعى بإخلاصٍ ووطنية وجدّية للخروج من مأزق التخلّف، وإيقاف مسلسل إعادة التموضُع الذي يمارسه كلّ المثقفين والمبدعين الذين لم يجدوا في وطنهم شمعةً واحدةً تُضيء لهم نفق الأمل.
***
*مداخلة في مؤتمر “أزمة الثقافة والمثقف العربي في حركة النهوض _ معوّقات وحلول” من تنظيم الاتحاد العالمي للمثقفين العرب.








