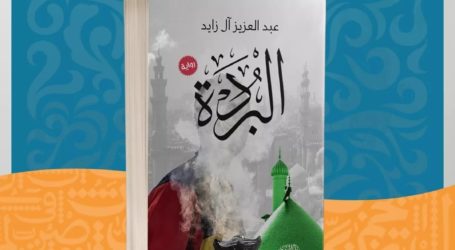“مزرعة أبو رشيد” لأنيس نصّار … فالِج لا تعالِج
الدكتور جورج شبلي
إذا كانتِ الطّبيعةُ منتزهاتِ العيون، فالرّوايةُ منتزهاتُ القلوبِ، لأنّها مُدخَلٌ لإِرواءِ عطشِ التشوّقِ الى البهجة. وفي الرواية، حيثُ تكرُّ سبحةُ الأحداثِ، يعيشُ القارئُ موَزَّعاً بين واقعٍ حقيقيٍّ مليءٍ بالمتناقضات، وبين واقعٍ افتراضيٍّ يحلمُ بهِ، مُحَفَّزاً من الواقعِ الحقيقيِّ نفسِه. وواهِمٌ مَنْ يظنُّ بأنّ في هذا التَوَزُّعِ ضَياعاً، لأنّ الإندماجَ، في الروايةِ، تَمَرُّدٌ على الضَّياع، يحثُّ القارئَ على التَّصالحِ مع نفسِه.
أنيس نصّار لم يُصدِرْ روايتَه ” مزرعة أبو رشيد ” في الوقتِ الضّائع، فهو في استِظهارِ ما حولَه، صنعَ مادةً صاغَ منها نًصوصَه، فاتِحاً آفاقاً بِما فيها من دقائقَ وجزئيّات، كانت خافيةً على الكثيرين، لكنّها، معه، انقشَعَت بُقَعُها عن إِبصارِ القارئِ إيّاها، ليصلَ الى ما وراءَها، ويلتقطَ الحقيقةَ بدونِ مواربة. لقد نادى أنيس نصّار التّاريخ، واستحضرَ منه صُوَراً وشخصيّاتٍ أسقطَها على مشاهدِ الواقع، إيماناً منه بأنّ ذاكرةَ الماضي تُنَبّهُ رُؤى أواتي الأيامِ من غيرِ إساءةٍ أو هَدم. فالتاريخُ، في مفهومِ نصّار، ليس صورةً جامدةً، أو زمناً أسطورياً يخضعُ للتَّشويهِ تِبعاً للمصالِح، بل هو معرفةٌ جَماعيّةٌ تسعى لكي تكونَ صالحةَ العِبرةِ، في كلِّ لحظة، وتمتلكُ القدرةَ على جعلِ الواقعِ المُعاشِ نموذجيّاً يَنسجُ ما بِهِ إفادة. من هنا، فروايةُ ” مزرعة أبو رشيد ” تعدَّت، في نَصِّها، حالةَ التَّعريفِ بالتاريخ، الى الكَشفِ عن العلاقةِ الجَدَليّةِ بينَ المَشهودِ والمُرتَجى، ربّما لِيُعاقَبَ المَشهودُ، لحسابِ الآتي، ويُفرَضَ عليه ألّا يَنسى جريمتَه، حتى في نَومِهِ.
روايةُ ” مزرعة أبو رشيد ” في واقعيّتِها، لا تلوحُ عليها علاماتُ الصَّنعِ، فسقَطَت عنها تهمةُ الإختلاق. لقد تلقَّفَ أنيس نصّار مادّتَه بدَقيقِ حسِّهِ، ورقيقِ بيانِهِ، ووضوحِ أسلوبِه، ليحاكيَ الوقائعَ المتدرِّجَةَ في الزّمانِ والمكان، فلم يُخُنْ صُوَرَ الواقع، بِقَدرِ ما كانَ أميناً على نَقلِهِا، بموضوعيّة، وبإِمتاعٍ ناضج، وكأنّه، بذلك، يفكُّ الأَغلالَ عن رحلةٍ في الماضي القريب، وفي الحاضر أيضاً، ومن دونِ جَلَبَة، ليعودَ موفورَ الجعبةِ من فترةٍ زاهرةٍ، وأخرى فاترة، في تَوالي زمنِ لبنان، حتى لا يدركَهما البَوار. إنّ نصّار يرى أنْ لا ظلامَ في التّاريخ، وإنّما الأنظارُ الكليلةُ هي التي تعجزُ عن رؤيةِ النّور.

إنّ تاريخَ لبنانَ الحديثَ يَعجُّ بالعيوبِ في تَدَرُّجِهِ الواقعيِّ التّاريخي، لكنّ ” مزرعة أبو رشيد ” سَلِمَت، بِنضارةِ الكتابةِ، من العُيوب، لأنّ أنيس نصّار لم يحشرْ قلمَهُ في عدسةِ آلةٍ جوفاءَ مسلوبةِ الدقّةِ بين لَقطةٍ ولَقطة. إنّ ثوبَ روايتِهِ كان ملتقى الواقعيّةِ بالإبتكار، فالواقعيّةُ سمعَت له طائعةً بدونِ احتراس، من هنا، أَبرأَ ذمّتَهُ عندَ مَنْ يريدونَ الروايةَ صورةً نطقةً لحياةِ الأشخاص، ولِتَعاقبِ الأحداث، وما يُحيطُ بها من مختلفِ الظّروف. والإبتكارُ بدا في بناءِ هيئةٍ تُبَيِّنُ المشتَرَكَ بين الإنسانِ والطّير، وهي هيئةٌ أكّدَت على حرصِ أنيس نصّار على تَتَبُّعِ أحوالِ زمانِهِ، وإسقاطِها على حكاياتِ طيورِه، وهكذا، طَمأَنَ الرّاغِبينَ بالإبداعِ أولئكَ الذين يُفتَنونَ باللّامألوفِ ويعتبرونَه أَصلَ القيمةِ في الكتابة.
لم يسخِّرْ أنيس نصّار أصنافَ الطّيورِ في ” مزرعة أبو رشيد ” لتوجيهاتِهِ وإرشاداتِه، ففي ذلك خطأٌ من الوجهةِ التّطبيقيّة، يمكنُ الطَّعنُ به. لكنّه نجحَ في تظهيرِ مقصودِهِ بمراقبةِ مواصفاتِ أجناسِ الطّير، لإسقاطِها، هي بالذات، على أهلِ عصرِه. ولو لم يتعقَّبْ أخبارَ الطّيورِ، بِوَلَعٍ، لَما استطاعَ الموازنةَ بينها وبين عالَمِنا، وكأنّ مزاجَهما واحد، ولعلَّ ذلك أَمتَنُ ما في روايتِهِ.
إنّ مُجرياتِ الروايةِ تسري على الوقائعِ المُتعاقِبة، منذُ أن اندحارِ ” الرَّجُلِ المريض “، أي السلطنة العثمانية، وتَقسيمِ المنطقةِ نفوذَين، كان لبنانُ، آنذاكَ، في عهدةِ فرنسا، أو ” أبو رشيد “. وتتوالى الأحداثُ وصولاً الى يومِنا الحاضر، نسجَها نصّار بحسنِ الطّرزِ في توثيقِ الوصفِ والتّحليلِ، بعيداً عن الإرتجال. واللّافِتُ أنّ نصّار لم يُحَكِّمْ في ” مزرعة أبو رشيد” هَواه، وهي التي تطاولَتِ النّكباتُ الى صميمِها، وتركَ الحوادثَ تجري كما أرادَت، كماءِ النّهرِ ولكن من دونِ ضَفَّة.
لقد وضعَ أنيس نصّار نفسَه، في ” مزرعة أبو رشيد “، بين فَكَّي التّاريخ، إذا ما أخَذنا بالإعتبارِ انقسامَ الناسِ، عندَنا، الى مَنْ عَرّوا تاريخَهم وانجرفوا خارجَ حلبةِ الوطنِ الى طقوسيّةٍ بائدةٍ، والى مَنْ أَبَوا تسليمَ مفاتيحِ البلدِ الى عَرّابٍ غريبٍ هَجين، ولو كانَت حياتُهم شلّالَ أَسلاك. من هنا، على الجميع أن يتَّصفَ بالموضوعيّةِ، والرّزانة، بعيداً عن نَفَسِ العَتمةِ، في مقاربةِ الرّوايةِ التي تنضحُ عن وجدانٍ وطنيٍّ، والتي تسعى نُصوصُها الى الأخذِ بِيَدِ اللبنانيّين، كلِّ اللبنانيّين، الى المَفاهيمِ المنابِعِ للكيانِ، ولمشروعِ الدولة، والى وَعيٍ صريحٍ لحقيقةِ وطنٍ ينبغي معانقتُهُ في مصالحةٍ سرمديّةٍ تَذوبُ في ذاتِهِ ذَواتُنا جميعاً، وذلك، لتنبتَ أرزاتٌ ما تعوَّدَت أن تنحنيَ مهما قَسا عليها الزّمان.
إنّ أسلوبيّةَ أنيس نصّار الإخراجيّةَ في الرّواية، بمقاربتِهِ بين الإنسانِ والطّير، لم ينفردْ بها، فقد سبقَه إليها كثيرون، أبرزُهم “لا فونتين” و “إبن المقفّع”، وكان نصّار، مثلَهم، فلم يلزَمِ السّكوتَ لإنّ فيه السّلامة. لكنّه كان مُشفِقاً، مثلَهم، على واقعٍ مَقيتٍ أرادَ تقديمَ النُّصحِ له، حتى لا يُكَرِّرَ الخطايا نفسَها، لكنّ تجربةَ “بَيدَبا” الفيلسوفِ مع ” دَبشَليمِ ” المَلِكِ تكرَّرَت، وعسى ألّا يبقى واقعُ أنيس نصّار حيثُ هو.