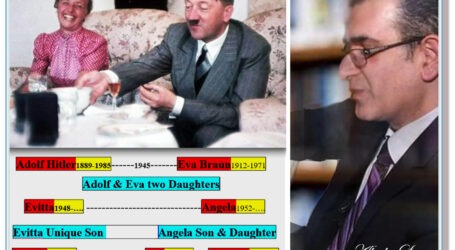الشاعر د. يوسف مارون متناولا تجربته الإبداعية واراءه النقدية: الحبّ هو الينبوع الذي أستمدّ منه أشعاري!
د.أنور عبد الحميد الموسى
الشاعر الأكاديمي د يوسف مارون، مبدأه في الحياة هو الحبّ الّذي يشكّل منطلق القصيدة وجوهر الشّعر الجمالي: أحببت لبنانا محبة شاعر/ ورسمته شعرا بفيض مشاعري!”
وكان للموت أثر سوداوي انطبع بالأسى في شعره: “حين رحلت ابنتي البكر (ديزي) في شرخ صباها، انداحت أمواج الفرح في نفسي، وصارت الحياة عبئاً ثقيلاً، وتلفّعت قصائدي بوشاح السويداء والضّياع، فرحت أمشي على أشلائي، ودرب الجلجلة يطول ويطول بفقد والديّ اللّذين كان لهما في شعري سمفونيّات حزينة، مفعمة بالوجع والألم والحيرة …”
هذه الصّورة السّوداء انسحبت على حياة الشاعر مارون، وتجلّت قصائد متّشحة بوجدان الحبّ المؤرق، والوجدان الهائم، كما كان لفقد الأصدقاء الأودّاء من شعراء ومربّين وأقارب أثر موجع في أشعاره، فرثاهم تعبيراً عن حُرقة قلب، ولهيب وجدان، وحبّ دامع. فالحياة الّتي يعيشها الشّاعر، كما يقول: هي أشبه بخميلة مفعمة بالطّيب والعسل، كما هي مليئة بالشّوك وإبر النّحل…
فما بواعث التجربة الشعرية عند هذا الشاعر الرومنسي؟ وما مفردات رومنسيته؟ وما موقفه من النقد والشعر الحر والحركة الشعرية والتراث والأصالة؟ وما جديده وغاياته ورسالته؟

ما بواعث كتاباتك الشعر؟ وهل من دور للمعاناة؟
نشأت في بيئة جبليّة ريفيّة تهوى الشّعر اللبناني باللغة العامّيّة، فنظمت هذا اللّون من الشّعر ما بين الثّالثة عشرة والخامسة والعشرين، ونظمت بعض القصائد الكلاسّيكيّة في الحبّ والغزل، معظم أشعار هذه المرحلة كانت في مناسبات وطنيّة واجتماعيّة، وعلاقات حيّيّة، وكان شعري في البدايات يشكو من خلل في الأوزان، ولعبت الفطرة والموهبة دوراً في تنمية الذّائقة الشّعريّة في قصائدي الأولى، بالإضافة إلى مطالعاتي الذّاتيّة لشعراء الزّجل اللبناني، أمثال: شحرور الوادي، وخليل روكز، وموسى زغيب، وزغلول الدّامور، وسواهم، وكنت شغفاً بشعر نزار قبّاني، وإلياس أبي شبكة، وأمين نخلة.
هذه المطالعات الشّعريّة ساعدت في تنمية الحسّ الشّعري في نفسي باللغتين العامّيّة والفصحى. فنظمت قصائد مطبوعة بالعفويّة والحبّ البريء، حيث خفق قلبي في مطلع الصّبا والشّباب، وكنت أُعجب بالجمال الأنثوي الذي يثير في نفسي الشّعور والتّحفيز للنظم، وكنت يومها مدرّساً في مراحل التّعليم الابتدائيّة.
معاناتي في البدايات طبعت شعري بالبساطة والبراءة والإخلاص، ولم يكن عندي ثقافة شعريّة تنقّح وتصوّب قبل دخولي الجامعة في السّبعينيات، وفي هذه المرحلة نمت الذّائقة الأدبيّة كثيراً، لأنني كنت من طلاب الإجازة في اللّغة العربيّة في كليّة الآداب، الفرع الأوّل بالجامعة اللبنانيّة، وقد بدأت أنظم الشّعر الحديث المسمّى بالنّيوكلاسيكي، أو الشّعر الحرّ، وكان معبّراً عن تجربتي في الحبّ والتّغزّل بالحبيبة؛ فبعد أن كتبت “رفيف الوجدان” باللّغة العامّيّة؛ كتبت أشعار “مجامر الشّوق” بالشّعر الحرّ والنّيوكلاسّيكي.
من شجّعك في الكتابة؟ وبمن تأثّرت؟
في البداية شجّعني شعراء الزّجل اللّبناني وصداقتي بهم على كتابة الشّعر العامّي باللّغة اللبنانيّة، حيث كنت أواكب جوقات الزّجل في مهرجاناتها الشّعريّة في مواسم الصّيف، وكنت أكتب هذا اللّون في الشّعر بالفطرة والموهبة والذّائقة الفنّيّة. ولما دخلت الجامعة بدأت بقراءة وحفظ أشعار من دواوين الشّعراء القدامى والمحدثين، وقد اقتنيت دواوينهم في مكتبتي، وكنت أدوّن الأشعار من هذه الدّواوين على دفاتر خاصّة، ومن هؤلاء الشّعراء: المتنبّي، وابن الرّومي، وأبو تمّام، والمكزون السّنجاري، ومن الشّعراء المعاصرين قرأت: أبو شبكة، وسعيد عقل، وأبو ماضي، وصلاح لبكي، ونزار قبّاني، والسّيّاب، وحفظت في أثناء دراستي في الجامعة اللّبنانيّة واليسوعيّة في بيروت ما يزيد على عشرة آلاف بيت شعر كلاسّيكي، وبتشجيع من الأساتذة الدّكاترة يومذاك، أذكر منهم: الشّيخ صبحي الصّالح، وأسعد علي، وسعيد البستاني، وأحمد مكّي، وفي هذه الأثناء بدأت أنظم الشّعر الكلاسّيكي بإتقان، بعد أن أصبحت متمكّناً من دراسة الأوزان الشّعريّة الخليليّة بإشراف أساتذتي في كلّيّة الآداب، وفي المعهد الشّرقي (الجامعة اليسوعيّة) في بيروت.
في مجموعتك الشّعريّة يتلاقح الوطن والحبّ والطّبيعة.
الحبّ هو الينبوع الذي أستمدّ منه أشعاري، وهو المحور الرّئيس الذي يطبع مجموعتي الشّعريّة، وثلاثيّة الحبّ في شعري تجلّت في التّغزّل بالحبيبة، والتّغنّي بالوطن، ورثاء الأودّاء والأصدقاء، وقد وضعت في هذه المرحلة “نداء البعيد”، تتمحور فيه ثلاثيّة الحبّ بألوانها المشبعة بالعاطفة، وكانت الطّبيعة المكان الآمن لكتابة أشعاري؛ في قرية ترعرعت فيها ونشأت بين أكنافها، وهي بقرقاشا (بشري) المشرفة على وادي قاديشا، وقد تكحّلت عيناي بمرأى جمالاتها السّاحرة، ومشاهدها الآسرة.
تأثّرت بغلواء أبي شبكة، فكنت رومنسيّاً بامتياز؛ حيث بدا الله والحبيبة والطّبيعة في ثلاثيّة الحبّ الجوهري في شعري، بصوفيّة شعريّة، تجلّت بصفاء بيئة نقيّة وساحرة، وقد تغزّلت في هذه القرية بقصائد من عيون شعري: “الله أعطاكِ ما لم يُعطَهُ بلدٌ”، “في عالم الخلق أو في عالم ثانِ”. مبدأي في الحياة أنّ الحبّ هبة الله، وغير مقيّد بزمن أو بعمر أو بمقياس، فهو خبزي وقوتي في عصاميّة إثبات الذّات الشّعريّة، فكانت الطّبيعة ممزوجة بالحبيبة في لوحات بعيدة المرامي، في ظلال المعاناة والتّهويمات والعذاب المرّ، وكان ديواني: “هديل الذّاكرة” صدى لتهويمات وجدانيّة امتزج فيها الألم بالوجد الضّائع، في مسرى الحبّ والجمال والخيال الأدبي.
لم تلجأ في شعرك إلى التّراث والرّموز العالميّة.
كانت انطلاقتي الأولى من التّراث الشّعري العربي القديم، متأثّراً بأشعار القدامى وبأساليبهم الكلاسّيكيّة، فأنا شاعر كلاسّيكي بامتياز، انطلقت أشعاري بصوفيّة رمزيّة تنادي الإنسان وما وراء الإنسانيّة الرّهيفة، وتناجي الوطن الشّهيد الحيّ حاضراً ومستقبلاً، وتسمو بالحبّ الجماليّ إلى أعلى مرتقى. فالشّعر الكلاسّيكي تجلّى في تهويمات حديثة من غزل، ومراثٍ، ووجدانيّات، ووطنيّات، ومناسبات اجتماعيّة، في مقاربات صوفيّة حزينة، وكان ديوان “روح العناقيد” اختصارًا لمطوّلة عمر، ولغة القلب والرّوح المهومة في أتون الحزن.
أمّا الرّموز في شعري فقد كانت مصدراً قميناً يمدّه بالمعاني التضمينيّة، انطلقت من رحم مطالعاتي ومعاناتي، ترفده ثلاثة عناصر هي: الموهبة، والثّقافة، والتّجارب الذّاتيّة، اجتمعت في نفسي، امتزح فيها الحبّ والألم بلغة جماليّة مشرقة بمأساويّة الأحزان المتكرّرة.
لم ألجأ إلى الرّموز العالميّة، لأنّني أرى أنّ الشّعر إبداع، أداته اللّغة، مثل الفنّ التّشكيلي أداته الألوان والأصباغ. تحمل اللّغة الإبداعيّة دلالات مكانيّة وزمانيّة متعانقة، لتغدو القصيدة كلّاً من الصّور الفنّيّة تشكّلت من المحسوسات؛ وارتقى بها إلى ما هو أسمى، والوزن يحمل دلالات شعوريّة تعبّر عن حالة المشاعر النّفسيّة، ولا يحتمل الوزن أي دلالة انفعاليّة بدون العاطفة التي تشكّل الموضوعيّة للقصيدة، ولكلّ شاعر في إبداعاته الذّاتيّة رموز ذاتيّة خاصّة بشعره.

أنت متحيّز للشّعر العمودي، ما هو موقفك من قصيدة النّثر؟
أنا من دعاة التّمسّك باللّغة الفصحى، في مجالات الإعلام، وفي النّدوات والجامعات والمنتديات الفكريّة، مع أنني كتبت الشّعر العامّيّ باللّغة اللّبنانيّة، في “رفيف الوجدان” ولكنّها لغة قريبة من الفصحى في بناء شعري منظوم على الكلاسّيكيّة المعروفة في الأوزان الخليليّة، لغة مطبوعة بنفحة تراثيّة راقية وجماليّة موسيقيّة متناغمة، تصوّر تعلّق الشّاعر بأرضه، وتمسّكه بالحبيبة والوطن، وقد نظمت الشّعر باللّغة العامّيّة، بأسلوب التّناغم الموسيقي، والسّبك الكلامي بأسلوب سهل ومستساغ.
نظمت الشّعر الخليلي باللغة الفصحى مستخدماً أربعة عشر وزناً في شعري بتفوّق وإتقان ودفق عاطفي، اتّسم بنزعة تراثيّة أصيلة، تختلف عن النّهج الشّعري السّائد لدى شباب العصر وهواة الشّعر، كما تختلف عن الحداثويّة المتطرّفة الّتي يسير في ركابها جيل من ناظمي الشّعر الحديث.
إنّ الشّاعر الحقّ هو الّذي يثبت قدرته في نظم الشّعر الكلاسّيكي بثوب جديد ومعاصر، فهذا اللّون هو الذي يحتضن لغتنا ويحفظها من الضّياع والانهيار، فالشّعر ينطلق من الأصالة أوّلاً، ثمّ يتجدّد في مسار الحداثة، فكلّ حداثة لا تنطلق من التّراث هي حداثة منحرفة وفاشلة، لا تخدم العروبة والعربيّة في شيء، بل تساهم في ضياعها وزوالها.
لقد كتبت الشّعر العامّي، ثمّ الشّعر الكلاسّيكي، حتّى توصّلت إلى كتابة الشّعر الحرّ المفعّل، والشّعر الحرّ المقفّى، وقد برز في ديواني “مجامر الشّوق” بدون أن ألغي التّراث والأصالة، فحافظت على هذه الأصالة بالجوهر الجمالي للّغة المنبثقة من مفهوم يقارب الأعماق الصّوفيّة. وهذا الجوهر اللّغوي الأصيل يشكّل في شعري منطلق التّجديد الملوّن بدم الوجدان، وتعب الذّات.
أنا لست معادياً لمن يكتبون قصيدة النّثر، أو الشّعر المنثور، إذا كانت هذه القصيدة تعبّر عن حالة شعوريّة في صورة إيقاعيّة ولغة أصيلة، تساهم في تشكيل المكان والزّمان اللّذين يخلقان التّشكيل الشّعري، كما نرى عند جبران وأمين الرّيحاني في “أعماق الأودية” بديباجة اللّغة الشّعريّة، فالشّاعر الحديث الّذي يتخلّى عن القافية في القصيدة النّثريّة؛ يساهم في إلغاء الصّورة الإيقاعيّة، لأنّ القافية هي نهاية موسيقيّة للسّطر الشّعري، يستدعيها السّياق المعنوي والموسيقي للبيت الشّعري.
في شعرك حنين إلى القرية، هل تعدّ القرية بمنزلة الرّحم؟
قلت إنّني ترعرعت في قرية جبليّة (بقرقاشا)، عمرها 2500 سنة قبل المسيح، فيها آثار فينيقيّة ورومانيّة. تعلّقي بأرضها كتعلّقي بأمّي، فالطّبيعة هي الأمّ التي تحتضن الشّاعر، وهي ميدان التّشكيل المكاني والزّماني، والشّاعر يحاول أن يخلق نوعاً من التّوازن النّفسي بينه وبين قريته؛ عن طريق الجمال الرّيفي الّذي يشكّل النّواة الأولى في القصيدة، والموسيقى هي الّتي تهيّئ حالة من الاندماج مع مظاهر التّناسق والإيقاع في البيئة الطّبيعيّة، والمناخ الرّيفي يؤثّر في الحالة النّفسيّة للشّاعر، ويخلق حالة من التّوافق بين الحركة الّتي تموج بها النّفس، والحركة الّتي تموج في مظاهر الطّبيعة. فالقرية هي المكان الّذي يتشكّل فيه التّوافق النّفسي والطّبيعي في نفس الشّاعر، وربط الوجود الشّعري بالوجود الخارجي.
كلّ شاعر يشعر بالغربة النّفسيّة، فالشّاعر الرّومنسي كما قلت، يهرب من الواقع إلى الطّبيعة الرّيفيّة، يستخدم الخيال في إبداعه الفنّي للتّعبير عن الحالة الشّعوريّة. يقول مورينو: “ليس بين الحقيقة والخيال صراع، فكلاهما عنصر فعّال في مجال أوسع”.
لقد لجأت إلى الطّبيعة لا هروباً من الحقيقة، بل تلمّساً بالخيال الّذي أجد فيه الحقيقة، والخيال الرّومنسي والواقع كلاهما وسيلة لنقل الحالة النّفسيّة التي يعانيها الشّاعر، في ولادة القصيدة في حضن الإبداع الفنّي. فالقرية هي مكان الإبداع الفنّي، والغربة النّفسيّة هي عنصر لازم من عناصر هذا الإبداع، والهروب من الواقع ليس هروباً من الحقيقة، بل بحثاً عن الحقيقة في عالم خيالي.
لقد كتبت الشّعر بزاد المؤمن، بصوفيّة شعريّة تجلّت صفاءً في ربوع الطّبيعة الرّيفيّة وأفيائها الظّليلة، ونسماتها البليلة، فتجسّدت مظاهرها بمفردات اللّغة الشّعريّة، واندمجت في الصّورة الفنّيّة اندماج الجنين برحم أمّه.
هل للشّعر حدود طائفيّة؟ وما دوره في تعزيز النّزعة الإنسانيّة؟
الشّعر هو الإيقاع الثّقافي الّذي يشكّل حركة إنسانيّة شاملة، بينما لا تشكّل الإيقاعات الأخرى سوى إرهاصات تودّي إلى خدمة المجتمع، فالشّعر ينماز بسمة إنسانيّة لها خصوصيّتها، هو مدرسة كما قلت في إحدى قصائدي، تعالج الإنسان في حياته ووجوده، وقد كان الشّعر قديماً “ديوان العرب” يعبّر عن خصوصيّة الأمّة والإنسان، بروح صوفيّة تنمّي ثقافتنا وحضارتنا. فالشّعر هو السّمة الوحيدة لترقية اللّغة العربيّة، بشؤونها وشجونها وجذورها الإنسانيّة، وتراثها النّثري المفعم بالتّصوّف والرّقّة والانفعال والاكتئاب، وإذا كان الشّعر يعبّر عن خصوصيّتنا العربيّة، أفلا يجدر بنا أن نتعامل مع هذه الخصوصيّة بشيء من المحبّة، وشيء من التّروّي وسعة الأفق، وذلك كيما نعمل على تطوير لغتنا بشيء من الجدّيّة والرّصانة والأمانة للعروبة والقوميّة.
ما رأيك في الحياة الشّعريّة حاليّاً؛ لجهة الأمسيات، وما ينشر في وسائل التّواصل الاجتماعي؟
يمرّ الشّعر اليوم بمرحلة صعبة، هي مرحلة الضّعف والتّضعضع والانهيار اللّغوي، وهو الّذي ترعرع في العصور السّابقة، في مناخات التّفاعل العربي والحضاري مع الثّقافة العالميّة، فهو ينزع إلى اللّغة الالكترونيّة الموسومة بهويّة تنطوي على شيء من الهجنة، مع احترامنا لمنافعها وحسناتها وخدماتها الجليلة. فلغة الإنترنت تكاد تقيم نوعاً من القطيعة بين الإنسان العربي والإبداع العربي، وهذه اللّغة الّتي يستخدمها طلّاب اليوم وباحثو الأمّة؛ تحمل في مضامينها بذور القضاء على لغتنا الأصيلة. فالّذين يكتبون الشّعر لا يبالون بجماليّة اللّغة الفنّيّة في شعرهم، ينظمون أشعارهم في حمأة لهاثهم وراء كلّ ما هو أجنبي وهجين، متجاهلين الأصالة العربيّة الّتي تطبع لغتنا بالقيم الجماليّة والعناصر الإنسانيّة.
فالشّعر العربيّ الأصيل هو عرائس مكوكبة بالعناقيد مظلّلة بموسم مُشع، ولكنّ الصرعات الشّعريّة المعاصرة تطلّ بقصائد غدت مجالات حبلى بحداثة منحرفة هجينة، وثقافة الكترونيّة حتّى بات الشّعر الحديث عسراً على يسر، كما بات النّقد في خبر كان، لأنّ حركة النّقد الأدبي باتت عاجزة عن مواكبة تطوّر الشّعر الّذي سار بخطى العمالقة، وذلك لغياب النّقّاد الّذين يحلّلون الشّعر، ويصوّبون ما يعتريه من خلل واعتوار، وأمّا الأمسيات الشّعريّة فما هي إلّا منتديات نادرة، روّادها قلّة، تكاد تتحوّل إلى ميدان للتّذهين، أو العصف الذّهني، في عصر العزوف عن مطالعة الكتاب الورقي والصّحيفة اليوميّة، والبعد عن الأصالة الشّعريّة في لغة العرب.
ماذا تمثّل في شعرك، الأمّ، الأبوّة، الموت؟
مبدأي في الحياة هو الحبّ الّذي يشكّل منطلق القصيدة وجوهر الشّعر الجمالي، وعبق الكيان في ريشتي المغموسة بحبر الألم والحزن والمعاناة، وكان للموت أثر سوداوي انطبع بالأسى في شعري، حين رحلت ابنتي البكر (ديزي) في شرخ صباها، فانداحت أمواج الفرح في نفسي، وصارت الحياة عبئاً ثقيلاً، وصحراء قاحلة، وغرقت الأبوّة بدموع الأسى الممضّ، وتلفّعت قصائدي بوشاح السويداء والضّياع، فرحت أمشي على أشلائي، ودرب الجلجلة يطول ويطول بفقد والديّ اللّذين كان لهما في شعري سمفونيّات حزينة، مفعمة بالوجع والألم والحيرة …
هذه الصّورة السّوداء انسحبت على حياتي الشّعريّة والذّاتيّة، وتجلّت قصائد متّشحة بوجدان الحبّ المؤرق، والوجدان الهائم، كما كان لفقد الأصدقاء الأودّاء من شعراء ومربّين وأقارب أثر موجع في أشعاري، فرثيتهم تعبيراً عن حُرقة قلب، ولهيب وجدان، وحبّ دامع. فالحياة الّتي يعيشها الشّاعر، أي شاعر غارق في تجارب أليمة، هي أشبه بخميلة مفعمة بالطّيب والعسل، كما هي مليئة بالشّوك وإبر النّحل، يغمرها الفرح والرّاحة، وتميل بها ريح التّرح والقلق والتّنائي، نسيمها الإخفاق النّفسي، وانهمار الذّات الشّعريّة، والرّوح المدنفة، في حضرة الحياة، حيث مملكة الجوهر الّتي يرأسها الإنسان، في جلال مهيب، يسلّيه ويعزّيه، لينقذه من وضعه المأزوم وكيانه المهزوم.
ما جديدك في الشّعر، وأنت اللّغويّ المخضرم في التّدريس الجامعي؟
لقد مارست التّعليم في جميع مراحله وصولاً إلى الجامعة، والتّفتيش التّربوي المركزي، وإعداد المعلّمين في كلّية التّربية، وأطلقت ما يزيد على ستّين مؤلّفاً وموسوعة في اللّغة والأدب والتّربية، وتعلّميّة اللّغة العربيّة، والثّقافة العامّة، والشّعر، والكتاب المدرسي، ومراجعة الكتب وتحقيقها توثيقاً ولغةً وترجمةً.
والآن أقوم بإعداد ما تبقّى من المخطوطات في المقالات الذّاتيّة والنّقديّة، وهي منشورة في الصّحف والمجلّات اللّبنانيّة والعربيّة. أمّا الجديد في الشّعر فهو ديوان: “أصداء وأنداء” يجمع قصائد نظمت حديثاً في الوطن والمرأة والحبّ والوجدان المؤرّق، وللقدس قصيدة بعنوان “حجارة تحت الرّماد”، تعبّر عن إيماني بعروبة هذه المدينة التّاريخيّة المقدّسة.
ما رسالتك وكلمتك الأخيرة؟
في النّهاية: أشكر الدّكتور أنور الموسى لتفضّله بإجراء هذه المقابلة، …
كلمتي الأخيرة أن يبقى الشّعر لغة الإيقاع الثّقافي في لبنان وبلاد العروبة، وعلى المثقّفين والمهتمّين بالأدب والشّعر أن يحافظوا على سلامة اللّغة الشّعريّة، وحفظها من الضّياع، في ظلال اللّغة الهجينة الّتي يستخدمها شباب العصر، فاللّغة الشّعريّة تشكّل حركة إبداعيّة تحافظ على المدارس الأدبيّة بأساليبها، وتفاعلها مع الأحداث الوطنيّة والقوميّة، لأنّ تكلّس الشّعر المعاصر، يوقع اللّغة العربيّة في حضيض الانهيار الثّقافي.
رجائي بأن يبقى الشّعر منحىً خلاصيّاً ينقذ اللّغة من ألاعيب التّواصل الالكتروني، فهو “مدرسة الأجيال” ومنجم ثرٍ خصب، قادر بتكامل حركته أن يشكّل ظاهرة فريدة في التّقدّم اللّغوي، والعمران الثّقافي، كما أهيب بالكتّاب والباحثين في الدّراسات الأكاديميّة أن يهتمّوا بكلّ جديد في لغتنا، لتشكيل مدرسة نقديّة جديدة، قادرة على أن تسلّط الضّوء على الانحرافات اللّغويّة في الإصدارات الجديدة، وتنقية المنحى اللّغوي من الاعوجاج الّذي يكاد يشلّ حركة اللّغة ويعرقل مسيرة تطوّرها…
إنّ وجود النّاقد بجانب الشّاعر يقوّيه ويدفعه إلى تقديم إنتاج شعري جديد، فهو شاهد من شهود الشّاعر، يتقصّى مواطن القوّة والضّعف، وعوامل الجودة والرّفعة في الشّعر المعاصر، ولنعلم أنّ انهيار اللّغة الشّعريّة قد يؤدّي إلى انهيار اللّغة الأصيلة، لأنّ أشعار هؤلاء الّذين ينظمون على هواهم، وكيفما يحلو لهم، مليئة بالأخطاء اللّغويّة، وخالية من الصّياغة المسبوكة، فضلاً عن إهمالهم الوزن والقافية، بحجّة الحداثة والعصرنة. فاللّغة المستحدثة في إطار الأصالة العربيّة، هي من سمات الشّعر الجيّد والإبداع الخلّاق.
***
(*) مجلة إشكاليات فكريّة.